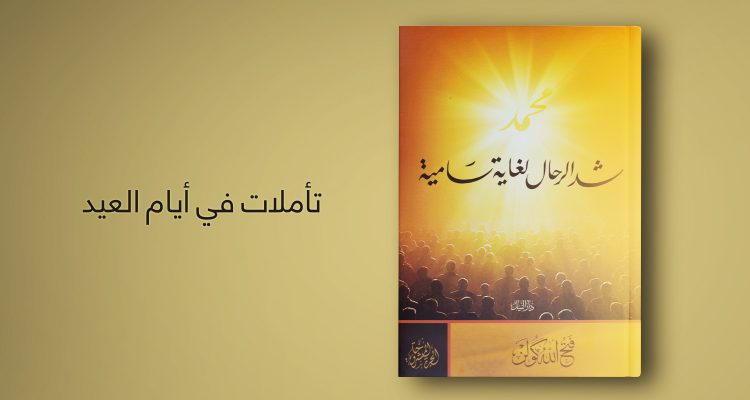سؤال: أيام العيد أيام فرحٍ وسرور، فماذا علينا أن نفعل حتى نتذوّقها بحقٍّ، وكيف يمكن استغلالها في ضوء المُحْكَمات الشرعية؟
الجواب: أيُّ عبادةٍ أو تشريع إسلامي له مغزى خاصّ، لا يُدرَك إلا بالإيمان أولًا، ثم بمبدأ التجدّد، وطريقُهُ شحذ الإرادة ضدّ الإلف والركود؛ لأنه لا يشعر بنضارة الشيء وغضارته إلا من يقدر على تجديد نفسه باستمرار، وبتعبير آخر: تجدُّدُ المنظور رهنٌ بتجدد الناظر.
يقول جلّ في علاه: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ: 14/19).
كأنّ هذه الآية تحذِّر الناس من الركود والبِلَى والرزوح تحت نِير الإلف والأنس، وتهيب بهم أن تكون أرواحهم غضة طرية تشعر بهذا الدين على الدوام؛ ومن هنا نعلم أنّ إدراك قدر شهر رمضان وأيام العيد وحُسنَ استغلالهما مشروطٌ بالإيمان القوي أولًا، ثم بتجديد الإنسان إيمانه على الدوام؛ فيتعذر أن يشعر بغضارة الأعياد ونضارتها مَن غدوا أُسارى الإلف والألفة أو مسلمين بالْهُويّةِ للدينِ في حياتِهم نمطٌ وجدوا عليه آباءهم.
رمضان والعيد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ”، قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال:”أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ”[1].
والمعنى: جددوا شأنَكم وصلتَكم بربكم ونظرتَكم إلى الأوامر التشريعية والتكوينية على الدوام، وحاسبوا أنفسكم باستمرار، وابدؤوا كل يوم بإيمان جديد، وامضوا في حياتكم على هذه الشاكلة.
ولهذا الخبر صلة بالأثر: “مَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ”[2]؛ فمن الأهمية بمكان أن يزيد المرء مستواه المعنويَّ في يومه عن أمسه، وأن يتذوق محاسن هذا الدين كل يوم أكثر؛ ولا يشعر بمعنى رمضان والعيد إلا من يسعى سعيًا حثيثًا وراء هذه الغاية وذلك الهدف.
ولما اشتمل العيد على زبدةٍ وخلاصةٍ خالصة من رمضان صار تذوق محاسن العيد مشروطًا بالقيام برمضان حقَّ القيام؛ فمن يقومون برمضان بمعناه حقًّا هم وحدهم من يتنسمون نسائم العيد بمعناه حقًّا؛ أجل، إذا نجحت القلوب المؤمنة في التفاعل الفاعل مع رمضان، تمكنت لا محالة من صيامه وقيامه إيمانًا واحتسابًا لإيمانها الكامل بالله تعالى، فأدَّت الصيام والقيام وسائر العبادات في مناخ تعبّدي، وهي على وعي بالوظيفة الملقاة على عاتقها، ثم لا تلبث أن تشعر بضيق واكتئاب خشية أن يكون رمضان قد انقضى ولم تُوَفِّه حقَّه قائلة في نفسها: “اللهم إني لا أعلم: أوَفّيتُ شهر رمضان حقَّه أم لا، أحفظته أم ضيعته، أتحصنتُ بجُنَّة الصوم من الشرور والآثام كما نعت الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وقضيت الشهر متحصنًا بهذه الجُنّة أم لا؟”، ثم تفيض مشاعرها بالرجاء، لأن العيد يوم الجائزة والمغفرة الإلهية.
العيد ساحة ذكر وشكر
الأعياد حقبة زمنيّة ساحرة تنهمر فيها الفيوضات والألطاف الإلهية على العباد، وهذا يقتضي مزيدًا من الحمد والثناء والشوق والشكر؛ فمن الخطأ إذًا أن نعدّ أيام العيد أيام لهو ولعب ومرح ليس إلا؛ إنّ أيام العيد من أبواب المغفرة التي يتفضل الله بها على عباده للعفو عنهم وغفران ذنوبهم؛ فعلى الإنسان أن يجتهد في قضاء هذه الأيام المباركة بإحساسٍ وقلبٍ يقِظ، وأن يعيشها بعمقها الأخروي وسَعتها الميتافيزيقية؛ وأشار الأستاذ بديع الزمان إلى هذا في كتابه اللمعات، فقال: “ولئلّا تقوى الغفلة في النفوس في الأعياد، وتدفع الإنسانَ إلى الـخروج عن دائرة الشرع، وَرَدَ في الأحاديث الشريفة ترغيب عظيم في الشكر والذكر في تلك الأيام؛ وذلك لتنقلب نِعَم الفرح والسرور إلى شكر يديـم تلك النعم ويَزيدها، إذ الشكر يزيد النعمة ويزيل الغفلة”[3].
عادات عيدية لا يحظرها الإسلام
لم نقف في عصر السعادة والعصور النيّرة التالية على مثل هذه الفعاليات والمهرجانات التي تُقام في أعيادنا الآن اللهم إلا مسائل تتصل بهذه الأيام المباركة تناولَتْها كتب الفقه؛ فلم نشهد في صدر الإسلام أمورًا مثل: تنظيم الرِّحلات، وإقامة المهرجانات، وسَمَر ليلة تحت ضوء القمر، وتَطواف الأطفال على البيوت في وَقفة العيد يقبّلون أيدي الكبار ويجمعون المكسَّرات؛ لكن لمّا دخل أجدادنا في دين الإسلام عرضوا عاداتهم على مُحكمات الشرع، فأبقوا على ما قوّمته ونقحته الشريعة؛ ولم يجدوا حرجًا شرعيًّا في الحفاظ على بعض عادات الأعياد مثل: تقبيل الأيادي، وزيارة الأقارب، والبشاشة في وجه الآخرين؛ وما زالت تلك العادات قائمة حتى الآن.
دفء المسامحة يحتضن الجميع
ينبغي أن تكون لحظات هذه الأيام المباركة جيَّاشة بالحبّ والصداقة والأخوّة والخير والإحسان؛ ليُنتفع ببركاتها الفيّاضة وثواب أعمالها المضاعف؛ فمثلًا جو التسامح اللطيف الذي يحتضن الجميع ويخيم على هذه الأيام فرصةٌ لترك الهجر، وللإقدام على ما من شأنه تحقيق الأخوة والمودّة بين الناس، ولتأليف قلوب الكبار بالزيارات، وغمرِ قلوب الصغار فرحًا وسرورًا بالهدايا والحفاوة والإكرام، ولتهيئة مناخ لطيف حتى مع غير المسلمين ببناء جسور للحوار بيننا وبينهم، الأمر الذي يُبرز أننا منصفون، ليس لنا موقف مسبق ضدهم؛ نعم، إنَّ لتوقير الدين والإيمان والذات المحمدية عليه الصلاة والسلام أهمية ومكانة خاصة؛ إلا أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهو -من حيث إنه إنسان- مخلوقٌ كريم لا بد من تقديره وتوقيره، وقد بات العالم كله اليوم بحاجة ماسّة إلى سلام عامّ، لا سيما هذا العصر الذي زادت فيه الوحشيّة وتضاعفت، وفتكت فيه القنابل بكل أنواعها بالإنسانية، ونُشرت بين الناس عمدًا الفيروساتُ الصناعية استُخدمت أسلحةً بيولوجية؛ أجل، ينبغي صدّ هذه الأمواج الهادرة بسدود تحول دون هلاك الإنسانية في خضم تلك المعركة الفتّاكة.
إنّ هذه الأيام المباركة فرصة عظيمة تلين فيها القلوب، فلا حرج في استغلالها للقيام بأنشطة خيّرة وإن لم نقف لها على مثل في عصر السعادة والعصور التالية وفي كتب الفقه؛ ولا يخفى ما في الليالي المباركة من بركات؛ نعم، لم يرِد عن السلف شيء نحيي به هذه الليالي ولم تأت المصادر الرئيسة على ذِكْر عبادات خاصة بهذه الليالي، لكن لا حرج ألبتة في الحث على إحيائها بالعبادة والطاعة كالإكثار من الصلاة وتلاوة القرآن والذِّكر والدعاء؛ فهذه أيام عظيمة، فللعمل فيها قيمة أعلى إذ إنها من خواصّ الأزمنة، وقُلْ مثل هذا في خواصّ الأمكنة، فنحن مثلًا نلجأ إلى الله بالدعاء في كلّ مكان، لكن الدعاء في عرفات أرجى للقبول؛ إذ إن الوقوف بها يطهِّر الإنسان حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإن بقي من دَرَنِه شيء غسلته المزدلفة وأتت عليه؛ ثم إنّ لنا في الطواف حول الكعبة طهرًا خاصًّا كذلك؛ وإنما تحقق هذا بعدما أضفى ظرفُ المكان قيمةً أعلى على ما وقع فيه من أعمال.
وبناء على ما سبق فمن الأهمية بمكان أن نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار في الأمكنة المباركة والأزمنة المباركة مثل: يوم المولد النبوي، وليلة الإسراء والمعراج، وشهر رمضان، وأيام العيد، وأن نكدّ ونسعى في سبيل الحب والأخوة والإنسانية كي ننال رضوان ربنا تبارك وتعالى.
[1] المسند للإمام أحمد، 14/328.
[2] الديلمي: مسند الفردوس، 3/611.
[3] سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة الثامنة والعشرون، ص 405.