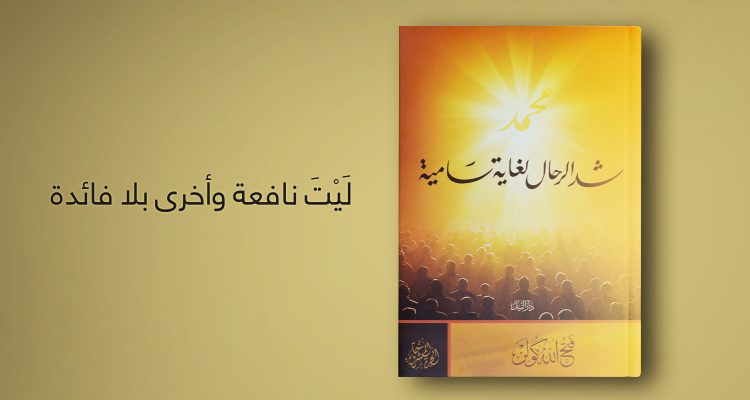سؤال: حالة التأوه والتشكي والعويل التي يُعبَّر عنها في القرآن الكريم على نحو: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلًا﴾ (سُورَةُ الفُرْقَانِ: 25/27-28)، ما الذنوب التي تُفرز تلك الحالة في الآخرة؟ وما الأمور التي يجب مراعاتها لئلّا نقع يومئذٍ في شباك حسَرات عقيمة؟
الجواب: مطلع الآية الكريمة: ﴿وَيَوْمَ﴾ إخبار عن يوم مرعب، ثم ذكرت أن الظالم في هذا اليوم المدهش يعضّ على يديه وقد غرق في مشاعر الندم والأسف، و”العض على اليدين” كناية عن الشعور بالندم في أسًى وحسرة وغمٍّ.
وكنَّتِ الآية عن الندم الذي يشعر به الظالم بهذا: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾، ولا يقتصر شعور الندم الذي يحس به الظالم على هذا فحسب، بل إن العبارات التالية لتعبِّر عن حالة الندم التي تسيطر فيها مشاعر الحزن والغم: ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ أي: ليتني لم أتخذ فلانًا الخائن الطائش صديقًا، ولم أصفق له، ليتني لم أسلك سبيل الضالين!.
بيد أن تمنياته بـ”ليت” لن تغني عنه في الآخرة شيئًا ألبتة، بل ستضاعف ندمه، إن قوله “ليت” هناك سيضاعف مصيبته لأنه بذلُ طاقة بلا فائدة، وعبارات الندم هذه ستُقال في الآخرة، أو عندما تبلغ الروح الحلقومَ حين تودِّع اليدُ أختَها والرِّجلُ صِنْوَها إبَّان الانتقال إلى حياة البرزخ أُولى مراحل عالم الآخرة، وأيًّا كان التوقيت فتلك الكلمات ملأى بالأسف والحسرة والشجن يقولها من ضيّع وأهدر ما في يده من فرص عن وعي منه.
“لَيْتَ” الكبرى
إن ثمة ذنوبًا وآثامًا كثيرةً يتلوى الإنسان منها في الآخرة ندمًا وحزنًا بل إنها تحرقه وتكويه بنارها في أعماقه، وعلى رأسها الكفر؛ لأن الكَون برمته كتابٌ يعرّف بالله بكل جملة وكل كلمة وكل حرف منه؛ أجل، حين يصغي الإنسان إلى كتاب الكون بإنصاف دون أن يستبق الأحكام سيسمع كل كلمة بل كل حرف يردد: “لا إله إلا الله”؛ ولهذه الحقيقة الواضحة أيما وضوح رأى الإمام الماتريدي أن من لم تبلغهم دعوةُ نبي مكلَّفون بالإيمان بالله تعالى، لأنهم حين ينظرون في كتاب الكون سيحكمون بلا شك بوجود خالقٍ وإن لم يعرفوه جل جلاله بصفاته العليا وأسمائه الحسنى، ولم يعرفوا ذاته تعالى من طريق النبوة والوحي، فزيدُ بن عمرو بن نُفيل عمُّ سيدنا عمر بن الخطاب –أو ابن عمه- رضي الله عنهما كان يعبِّر في العصر الجاهلي عن هذا بقوله: “اللَّهمّ إِنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيْكَ عَبَدْتُكَ بِهِ، وَلَكِنِّي لَا أَعْلَمُ”، ثم يسجد على راحلته[1]؛ فلا ندم ولا حسرة في باب “ليت” أكبر من أن تبلغ الروح الحلقومَ وقد حيل بينها وبين الإيمان بالله تعالى.
ومن الباعث على قول “ليت” في الآخرة الضلالُ بعد الهداية؛ إذ ليس بين الإيمان والكفر وبين الهداية والضلالة سوى حجاب رقيق، ورب أمرٍ صغير يزجّ بالمرء في الجانب الآخر؛ لذلك فإننا نحن المؤمنين ندعو الله تعالى أربعين مرةً في الصلوات الخمس وسننها بأن يهدينا الصراط المستقيم؛ ثم نسأله أن نسلك سبيل مَن أسبغ عليهم سبحانه نعمه قائلين: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (سورةُ الفَاتِحَةِ: 1/7)، وآيةٌ أخرى تذكر أن هؤلاء الذين منّ الله عليهم بنِعَمه هم النبيّون، والصدّيقون، والشهداء، والصالحون[2]؛ ففي كلِّ يومٍ نسأل الله تعالى في صلواتنا أن يهدينا صراطَ تلك الزُّمَر الأربع؛ ثم نستجير بكنفه تعالى ورحمته أن نكون ممن غضبَ عليهم فضَلّوا بعد الهدى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ (سورةُ الفَاتِحَةِ: 1/7).
ومن الوهم والخيال المحض أن نفكر على هذا النسق: “ها نحن قد عثرنا على طريقنا، ومن الآن فصاعدًا سنبلغ هدفنا دون أن نزيغ أو نزِلّ أو نتعثر وننتكس، ودون أن نُضَلَّ ونعلق بحبال الشيطان ألبتة ونحن في هذا الطريق”؛ فمن ذا الذي يضمن لك السير على هذا الطريق حتى تلحق بربك؟؛ بل من أمن العاقبة كان عرضة للخطر، ذلك أنه يُخشى على عاقبةِ مَن لا يَخشى على عاقبته؛ أجل، على الإنسان أن يرتعد ويرتعش في كل حين حذرًا من الضلال بعد الهدى، وعليه أن يكون دائمًا في هذا الأمر بين شدٍّ وجذب معنوي؛ فليتوسل العبد إلى الحقِّ تعالى دائمًا أن لا يكِله إلى نفسه طرفة عين، وأن يقيه هَمْز الشياطين ولَمْزهم؛ فما أثمنها من جوهرة يود شياطين الإنس والجن سرقتها وقد نصبوا لها شباكهم، إنها حقيقة الإيمان التي بها ينال المرءُ الجنةَ، ويحظى بالرضوان، ويغدو أهلًا لرؤية جمال الله تعالى، فالذي عليك فعله هو أن تستمسك بهذه الجوهرة الثمينة، وتصونها وتحرسها من شياطين الإنس والجن، وتكون على وعي ويقظة دائبة تجاه هذا الأمر.
أوجُه الضعف التي تخسف بالإنسان الأرضَ
ومما يجعل الإنسان يتأوه آهات أليمةً انحرافه عن الصراط المستقيم بوُقوعه فريسةً للفيروسات التي عددها فضيلة الأستاذ بديع الزمان في “الهجمات الست”[3]؛ فكلٌّ منها كفيل بأن يصرع الإنسان، أي كما أن حب الجاه والمكانة واللهث وراء الشهرة من المهلكات، فكذا الخوف فإنه وحده قد يُهلك العبد ويُرديه، وكذا الطمع، والعنصرية، والأنانية، والكسل، والانغماس في الترف قد تهوي بالعبد في مكان سحيق، ولما كان بوسع كل واحدة من نقاط الضعف الست الخبيثة أن يقضي على الإنسان، فإنها إن اجتمعت معًا في آن واحد لن تصرعه فحسب، بل إنها -نسأل الله السلامة- ستهوي به في أسفل سافلين؛ أجل، قد يصاب الإنسان بهذه الفيروسات في أي لحظة ولو كان من أهل الإيمان والإسلام، فمن سيطر عليه حبّ الشهرة قد يمسخ وجهَ أعمال اضطلع بها خدمةً للدين، حتى وإن كان من فئة صالحة؛ ومَن همُّه أن يكون يُشار إليه بالبنان ليمدحه الناسُ ويذكروا آثاره الرائعة قد يُخسف به مجازاة له بنقيض رغبته هذه؛ ومن مُني بشعور مقيت كهذا فهو عرضة لمثالب أخرى كثيرة أيضًا، ولا أحد يَقْدِر أن يحزو ما نوعية المثالب التي قد يرتكبها من رَكِبَتْه شهوة الشهرة مثلًا.
كل هذه الأمور مهالك ربما تعرِض لكل قلب مؤمن حتى وإن كان يعيش في بيئة مؤمنة، وقد تحمله في الآخرة على أن يقول “ليت” -نسأل الله السلامة-؛ أجل، إن من عجز عن أن يسترشد بدساتير الإخلاص، فراح يعزو إلى نفسه ما حققه من نجاح، ويستثمر ذلك في الشهرة، ويلهث وراء التبجيل والتقدير، سيتنفس الندم في الآخرة، ويتلوى أسى وأسفًا وحسرة وحرقةً قائلًا: “يا ليتني لم أضيّع هذه الأعمال ولم أهدرها بالجري وراء الثناء والتصفيق! ليتني لم أُبحر إلى العدم صفر اليدين! ليتني لم أقع في تيارات آخرُها الموت!”؛ والمؤلم حقًّا أن آهاته وحسراته لن تغني عنه شيئًا أبدًا، بل ستضاعف معاناته، وتزيد مصيبته.
تروسٌ واقية من “ليت” القاضية
على المؤمنين إذًا أن يتصرفوا ههنا بعقلانية، وأن يعدّوا النجاةَ من الكفر والضلالِ أعظمَ نِعَم الله تعالى عليهم، وأن يتجنبوا سُبُل الكفر والضلال؛ لأن المعاصي بريدُ الكفر كما ذَكَرَ الأستاذ بديع الزمان رحمه الله.
يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ: 83/14)”[4]؛ وذلك أن كلّ نكتةٍ تنكت في القلب تستدعي نكتة أخرى، والقلوب تتكدّر بالذنوب والمعاصي والسيئات وتسودّ بمرور الزمان؛ فإن لم تُطهَّر من المعاصي والذنوب بالتوبة والاستغفار ختم الله عليها، كما قال عز وجل: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (البَقَرَة:7)، ﴿وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ﴾ (سُورَةُ التَّوْبِةِ: 9/87)، ثم لا تعقل شيئًا من رسالة السماء الطاهرة، فما يكون منها إلا أن تقول في الآخرة: “ليت، ليت”.
أمّا ما لا بدّ منه هنا للحيلولة دون الوقوع في براثن “ليت” القاضية، فهو بذل المجهود في طاعة المعبود بلا تقصير أو تعطيل، والتحليقُ بجناحي الخوف والرجاء؛ وتحقيق هذا رهنٌ بالقلب الخاشع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُه”[5]؛ فخشية القلب تنعكس على الأفعال والسلوكيات، ويومًا بعد يوم تغدو الجوارح والأعضاء ترتجف من خشية الله تعالى، حتى إن قزحية العينين لتتراءى فيها ذبذبةُ الخوف من الله.
وعلى ذلك فإن نكّس العبد رأسه حياء من جلال الله وعظمته، ورجَا سَعة رحمته، وتمنّى على الله من فضله، وعاش حياته بهذا التوازن وتلك الدقة، وقى نفسَه يوم القيامة من التردّي في الندم والحسرة.
وذكرُ العبدِ الدائمُ لحبيبه جل وعلا يجنبه مثالب تسوق إلى عاقبةٍ وخيمةٍ قد تضطره إلى أن يقول في الآخرة: “يا ليتني”، يقول الشاعر التركي سليمان شلبي رحمه الله:
اذكر الله في كلّ نَفَس على الدوام فبذكره يصير كلّ شيء على ما يرام
وقد عَبّر عن هذه الحقيقة أحد أولياء الله الصالحين، فقال:
ألا ليت حِبّي يحبُّه الخلق أجمع وليت قصته مدار حديثنا وما أمتع
أجل، إننا إن ذكرنا ربّنا حيثما حللنا، ونوّرْنا مجالسنا بذكره تعالى، وأكسبْنا أوقاتنا عمقًا لا تسعه الأبعاد، كنا ممن اتقوا مثالب كثيرة سائقة إلى قول: “يا ليتنا” في الآخرة.
“ليت” من صُوَر الاستغفار
سؤال: هذه “ليت الفاجعة” فهل ثمة “ليت ناجعة”؟ وما المقياس في هذا؟
الجواب: رأينا أن هناك “ليت” لا نفع منها قطّ في الآخرة، بل تُضاعِف العذاب وتجعل المصية مصيبتين؛ وثمة “ليت” نافعة إيجابية محمودة ذات قدْر في ديننا؛ وفصلُ ما بينهما النية، ومن النافعة أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: “إِنِّي لَا آسَى عَلَى شَيْءٍ، إِلَّا عَلَى ثَلَاثٍ فَعَلْتُهُنَّ، وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ؛ وَثَلَاثٍ لَمْ أفْعَلْهُنَّ وَدِدْتُ أَنِّي فَعَلْتُهُنَّ؛ وَثَلَاثٍ وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُنَّ…” وذكر منها: “وَدِدْتُ أَنِّي يَوْمَ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ كُنْتُ قَذَفْتُ الْأَمْرَ فِي عُنُقِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: أَبِي عُبَيْدَةَ أَوْ عُمَرَ، فَكَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُنْتُ وَزِيرًا؛ وَوَدِدْتُ أَنِّي حَيْثُ وَجَّهْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الشَّامِ وَجَّهْتُ عُمَرَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَأَكُونَ قَدْ بَسَطْتُ يَدَيَّ يَمِينِي وَشِمَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ ووَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ -أي الخلافة- فَلَا يُنَازَعَهُ أَهْلُهُ”[6].
أرى أن هذا الضرب من الندم في كلام الصدّيق الأكبر رضي الله عنه ليس إلا ثمرة المحاسبة ونتاج همٍّ عميق وتشوّف إلى الفقه في الدين وجعلِ الدين روحًا للحياة بميزان دقيق؛ فما أجزله من ثواب وما أرفعها من مرتبة حازها الصدّيق رضي الله عنه بهذا الندم ما كان لنا أن نبلغها؛ وقد أشار مفخرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم إلى قدره بقوله: “لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإيمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَ بِهِمْ”[7]، إنه الصدّيق الأعظم؛ هو من فعل -بفضل الله سبحانه- في سنتين وبضْعة أَشْهُر وبضْعة عشَر يومًا ما لم تستطع الدولة العليّة العثمانية أن تفعله في 150 عامًا؛ ولم يَضطهد الدُّوَلَ الضعيفة كما يفعل المستبدّون، بل بثَّ إلهامات روحه في البلاد التي فتحها؛ نعم، لقد استهدف الوصول بالروح المحمدية إلى كلّ مكان مرّ به ويمّم وجهه إليه، والحقّ أنه هو مَن عبّد الطريق للفتوحات العظيمة التي تحققت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، إن هذا الضرب من “ليت” أضفى على قيمة هذه الشخصية العظيمة التي تفضُل الناس جميعًا قيمةً أخرى؛ ولكل مؤمن “ليت” إيجابية ترفع قدره مثل: يا ليتني أحسنتُ استغلال شبابي، واقتطعتُ ساعتين من كل ليلة أصلي فيهما مائة ركعة، ليتني جنّبتُ نفسي أهواءها، وصُنتُ يدي ورجلي وعيني وأذني عن الحرام حتى في عنفوان الشباب إذ تستثير فيه الغرائزُ والشهوات عادة، ليتني لم أنظر إلى الأغيار ولم يتسلل إلى عيني أي شبح غريب…
إن “ليت” هذه التي تزفر بها الصدور في ندمٍ مقترنةً بنية تحويل الآمال إلى أعمال لَتُعلي قدر الإنسان ومكانته؛ أما تلك التي تردّدها الألسنة في الآخرة فما هي إلا حسرة وندامة ليس إلا، فالندم في الدنيا ضرب من الاستغفار، كلّما عَرَض للمرء استغفر ربه، بل إنه ليستحيي أن يقول “أستغفر الله” مرة واحدة، وإنما يقول: “أستغفر الله ألف ألف مرة”، ويلجأ إلى الله بالتوبة والإنابة والأوبة، فإن طرَق العبد بروح كهذه بابَ رحمته سبحانه وتعالى عظم رجاؤه بأن مولاه لن يخيب آهاته وأنّاته، بل سيتغمده بواسع رحمته وفيض إحسانه.
[1] ابن كثير: البداية والنهاية، 2/237.
[2] ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: 4/69).
[3] هو القسم السادس من المكتوب التاسع والعشرين من كتاب “المكتوبات” للأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي، ويعني الأستاذ بـ”الهجمات الست”: حبّ الجاه والشهرة، والخوف، والطمع، وفكرة العنصرية، والأنانية والغرور، وحب الراحة والدعة.
[4] سنن الترمذي، تفسير القرآن، سورة المطففين، 1.
[5] الحكيم الترمذي: نوادر الأصول، 3/210.
[6] الطبراني: المعجم الكبير، 1/62.
[7] البيهقي: شعب الإيمان، 1/143.