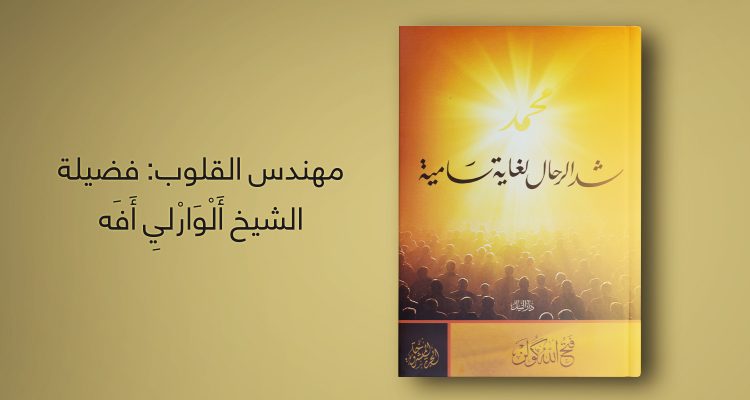سؤال: حبّذا لو أشركتمونا مشاعرَكم ومعرفتكم بفضيلة الشيخ “ألوارلي أَفَه”: شخصيته وأسرته وأُفُقه الروحي ورسائله الدَّعَوية وأثره فيكم؟
الجواب: الحقيقة أنّ الحديث عن شخصية عظيمة كهذه وإبرازَ صورتها كاملةً أمر يفوق طاقتي؛ فأعترف لِزامًا بادئ الأمر أني ليس لدي من الفقه ما يحيطني علًما بحياته، وعالمه الفكري، وأفقه القلبي والروحي بكل خلفيته؛ ثم إنه لما رحلت تلك الشخصية العظيمة وحلَّقت إلى أفق روحها كنتُ في السادسة أو السابعة عشرة من العمر؛ نعم، ما إن أبصرت نور الحياة حتى وجدتني على ضفاف هذا المنهل العذب المورود لكن أنى لفتى في هذه السن أن يستفيد بحقّ من إنسان عظيم رحب الأفق مثلِه، فليُنظَر إلى ما سأذكره وأعبّر عنه في ضوء وعْيي المحدود وضعف مهارتي ورؤيتي الفتيّة يومئذ.
دوحة نيِّرة مباركة
نشأ فضيلة الشيخ “ألوارلي محمد لطفي أفندي” في دوحة كأنها نبع مبارك فيّاض؛ فأبوه حسين أفندي وشقيقه وهبي أفندي شخصيات عظيمة جدًّا، لم أر والده لكن حسبنا في التعريف بفضل ذلك الشخص المبارك وكمالاته هذه الواقعة:
قدم الشيخ محمد لطفي ووالده حسين قِنْدِيغِي أفندي -وهما من آل البيت- إلى تكية الشيخ الكُفْرَوِي في بِتْلِيس لينتسبا إلى طريقته، فلما رآهما كأنه اكتشف ما لديهما من ملكة واستعدادٍ، فاعتنى بهما أيما عناية، واهتم بهما اهتمامًا عظيمًا، وأوعز إليهما بخلافته فورًا دون امتحان ولا سير وسلوك ولا خلوة أربعينية؛ نعم، لا يعرف قدر الجوهر إلا الجوهريّ، ولا الذهبِ والفضةِ إلا الصائغ، وهذا الشيخ الكفروي ما إن رآهما حتى عرف قيمتهما وقدّرهما لأنه جوهري يعرف قدر الجواهر، فأوعز إليهما بخلافته،؛ إنه أمر أذهل تلاميذ الشيخ الكفروي فراحوا يتطاولون عليهما في الكلام ليلًا، وإذا الباب يُفتَح على مصراعيه، والشيخ الكفروي يقول: “”يا أولادي، إن حسين أفندي ومحمد لطفي أفندي لا حاجة بهما إليّ، وإنما أتَتْنَا بهما كمالاتهما”:
وأنَّى لأرباب الكمال بلوغها إلا بِهِ
وما في فضّة ولا ذهب غِنى إذا فُقِدَ الكمال
فماذا يغني عنك الذهب والفضة ولو كان مثل كنوز قارون، ما دمتَ لم تبلغ الكمال!
وأخوه وهبي أفندي بحر أيضًا، فالصمت سمته الدائم، وكان لهذا الصمت تأثير يُحدث تموُّجات متنوعة في روح الإنسان، وكان لوالدَيَّ توجُّه صادق عميق إلى كلٍّ منهما، وكذلك كان جدي يُكِنُّ لهما احترامًا عظيمًا، وكانا ينزلان ضيوفًا عليه في منزله، وكان وهبي أفندي أكبر سنًّا من الشيخ ألوارلي أَفَه، ولما توفي رحمه الله كنت في الخامسة من عمري، وأظن أن الشيخ كتب هذا البيت في رثائه:
“بعُدْتُ عن الأخيار حتى إنني غَدَتْ “واحسرتاه” وِرد لساني!”
نغمات حرَّى تُلهب الأرواح
كان لجُوَّانية الشيخ ألوارلي أفه عمق جيّاش بالعشق والهيجان، وحاله في مجالس الذكر مثال حي لثرائه القلبي هذا، كان نقشبنديًّا وقادريًّا في نفس الوقت؛ فكانت مجالس الذكر عنده نقشبندية أحيانًا، وقادرية أحيانًا أخرى.
وفي تلك المجالس كان فضيلته يتوجّه بكل ذاته إلى الحق تعالى، وتُلهبه تلك النغمات وتحرقه، فيغيب عن نفسه أحيانًا، ويُحدث فيمن حوله حالةً روحيةً مصطبغةً بصبغته الخاصة، وينشر في القلوب نارَ العشق، فإذا انفعل أحدهم، ففاضت عيناه من الدمع سرت حالته هذه إلى الآخرين أيضًا، وأدخلتهم جميعًا في مناخ من العشق والانفعال؛ أجل، إنه مناخ عشق وانفعال ما زلتُ أشعر بأثره رغم أني كنت طفلًا عندما شهدت هذه الأحوال.
كان فضيلته عاشقًا للنبي صلى الله عليه وسلم عشقًا خالصًا، جاءه أحدهم يومًا وقال له: “رأيتُ في شوارع المدينة المنورة مخلوقات كثيرة جَربَة”، فردّه قائلًا: “صه! فمثل هذا لا يُقال ولو على كلاب المدينة! نفسي الفداء لها بل حتى لكلابها الجرباء من أجل رسول الله”؛ وكلامه هذا كان يقوله بكلّ ذاته بإخلاص نابع من صميم قلبه حتى كأنه يقوله وهو يغيب ويفنى في شخصية رسولنا المعنوية صلى الله عليه وسلم، وإليكم شعرًا له يجلّي حبَّه العميق لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنك لَأنت الشاهد المقدس، وعالمنا بشمسك قد تزيّنا
مخمس الضفائر، وحاجباك للفؤاد زَيَّنَا
والكون قاطبةً لم يبلغن مقدار شعرة منك ولا يَزِن
ففي الكونين فاح عبير عنبر من شعرةٍ منكم يا سيدي فليهنأَنْ
وكانت تُنشَد تلك المدائح النبوية في مجالسه، فتهيّج الحاضرين وهو أولهم، وكان يترنم أحيانًا بمثل هذه الأبيات:
لَكَ قَلْبي عاشقٌ يا حبيب فما السبب؟
جمالُكم كالشمسِ إذ سطَعَتْ، فيا تُرى هذا السبب؟
وحاجب منكم بدا قاب قوسين فلا عجَب
وصُورتُك سورة الرحمن، يا تُرى هذا السبب؟
وأحيانًا يرفع صوته بها حتى لكأن المكان يرتعش وكذا كلُّ من حضر.
لا يَعرف الفضل من الناس إلا ذووه
كان الشيخُ سلطانًا في الكلام، يذهب مذهب أهل العروض في شعره الذي يترنّم فيه بإلهامات روحه، ورغم أنه شاعرٌ مُفلِقٌ إلّا أنه لم يكن يضيق بما يُنشَد بين يديه لمشايخ آخرين، بل يشجّع على ذكرها، فإن كانت حقًّا أجلَّها ووقّرها أيًّا كان قائلها، ثم يتبناها وكأنها بنات أفكاره، ويَقْدُرها قدرها، وحاله هذا مقياس مهمّ لرصدِ أُفُقِه وعالمه الفكري والشعوري، ولإدراك مدى فضله وعظمته.
وإليكم حادثة سمعتها من أخينا الكبير “صالح أُوزْجان”، ولها أهميةٌ بالغة عندي؛ فهي تكشف عن فضل الشيخ وغنى قلبه:
في مطلع الخمسينات قدم الأخ الكبير “صالح أوزجان” إلى مدينة “أرضروم”، وقابل الشيخ وقبّل يديه، ثم قال له: “شيخي الفاضل، ثمة عالم يُدعى “الأستاذ بديع الزمان”، كتبَ رسائل عن الدين والإيمان، أسماها “رسائل النور”، ونحن نسعى لنشرها في كلّ العالم، ونَغُذُّ السير لإنقاذ جيل الشباب خاصّة”، فردّ عليه الشيخ قائلًا: “آه! ليت لي عيناي تُبصران لساعدتُكم في نشرها”.
أجل، الفضل هو أن تعترف بفضل أهل الفضل، وتُظهر لهم كلّ احترام وتقدير.
كلماتٌ يتردّد صداها في أذني
وأستميحكم عُذرًا في سرد حادثتين لا يمكن أن أنساهما، وقَعَتَا لهذا الشيخ العظيم الذي أشعرُ في أعماق روحي بأن معرفتي به عناية ربّانيّة:
لما شرعنا في دراسة كتاب “مُلّا جامي”[1]، توجهتُ إليه أنا وزملائي، فإذا به جالس مع عدد من أثرياء أرضروم، فلما رآني قال لهم: “سأسأل تلميذي هذا سؤالًا، فإن أجاب فادفعوا له كذا وكذا من المال”، فلم يسألني إلّا عن مواضعَ من الكتاب أعلمُها جيدًا فأجبتُه عليها كلّها، فأعطوني ما حدّده الشيخ، وأظنه نحو مائتي ليرة يومئذٍ، وربّما كانت تكفي يومئذ لأداء فريضة الحج، وكان الشيخ أعشى فلم يعرف كم جمعوا من المال، لذا سألني فأجبته، فقال: “هذا كثيرٌ عليك، سأعطيه لـ”دميرجي عثمان أفندي” ليسدّ به احتياجات المدارس”.
كنا نعيش في فقر مُدْقِع ونحن طلاب في المدرسة في “أرضروم”، حتى إننا في بعض الآونة لا نكاد نجد الخبز والجبن ثلاثة أيام أو أربعة، وكان أبي إمامًا براتب، فكان يعطيني بضع ليرات، لكنها لم تكن تكفيني… وكم قضينا من الأيام بحاجةٍ إلى ثمن الخبز!
وبينما كنّا نتلوّى من الجوع ذهبنا وبعض الأصدقاء إلى التكية مع “طيب أفندي” حفيد أخي الشيخ، وكان بجوار التكية مستودع تبن، يستخدمونه بيتًا للمؤنة، فأتيناه ونظرنا من ثقب بابه، فاشتهينا بطيخًا رأيناه فيه، وكان الشيخ يصلي، ثم فُتح الباب، فقال لنا الشيخ: “تعالوا يا أولاد، سآتيكم ببطيخ وأقطّعه بيدي”.
أجل، كم شهدنا من أمثال هذه الحوادث، فلنا أن نقول: إننا وجدناه إنسانًا بعيدَ الغور، ذا أفقٍ واسع وبصيرةٍ نافذة، يفهم المرء من حاله، ويقرأ جوانيته.
وحمادى القول: حسبي أني عرفته وإن لم أستطع أن أستفيد منه حقّ الاستفادة، وهذه عناية ربانية، فلله الحمد على هذا الفضل والعطيَّة.
أما يوم أن رحل الشيخ إلى الرفيق الأعلى، فقد كان والدي رحمه الله في أرضروم، وكنا نستريح معًا في بيت خالته رحمها الله، وفجأةً تناهى إلى مسامعي ناعٍ ينعى الشيخ، فنهضتُ من مكاني فورًا، واتجهتُ صوب مدارس جامع “قُورْشُونْلُو”، فوجدتُ الأصدقاء يبكون، فتوجهت إلى بيت شيخنا رحمه الله رحمةً واسعةً، وكان يقيم ببيت في حيّ “مُومْجُو”؛ وحضر الجنازة أيضًا مفتي أرضروم “صادق أفندي” والعلاّمة “ثاقب أفندي”؛ وغسّلاه بأنفسهما ولم يأذنا لأحد بذلك، وكان يومًا شاتيًا حمل فيه الشيخ إلى قرية “ألوار”، ودفن هناك؛ فتوافد الناس جميعًا على القرية -رغم الشتاء والثلج- ليشهدوا تشييع الجنازة إلى مثواها الأخير.
نسأل الله سبحانه أن يحشرَ هذا الرجلَ العظيمَ تحت لواء سيّدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يُسكنه معه في الفردوس الأعلى. آمين.
[1] مُلّا جامي (817ه/1414م – 898هـ/1492): هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي، نور الدين، مفسر فاضل، ولد في جام (في بلاد ما وراء النهر) وتوفي في هراة. له مؤلفات تقارب المائة. وله كتاب في النحو، صنفه شرحاً لكتاب “الكافية لابن الحاجب” لخص فيه ما في شروح الكافية على أحسن الوجوه وأكملها مع زيادات من عنده سماه “الفوائد الضيائية”.