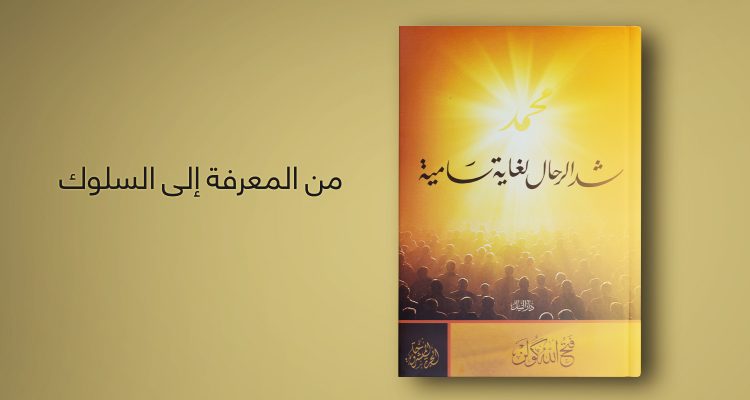سؤال: كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إذا ما نزلت آيةٌ أو سورةٌ من القرآن الكريم سارعوا إلى تطبيقها في حياتهم، أما نحن فلا نستطيع أن ننهج هذا النهج فيما نعلَمه، فما السبب يا تُرى في عجزنا عن تحويل العلم إلى عمل وسلوك؟ وكيف يتأتى لنا هذا؟
الجواب: حتى يتسنى لنا تحويل المعرفة إلى سلوك لا بدّ أولًا من أن تتجاوز هذه المعرفة كونَها معلومات سطحية بحتة بأن تتحول إلى “علم”؛ والعلم يعني إدراك جوهر المسألة وماهيتَها واستيعابَها بوعي وفكرٍ منظم؛ أمّا إن ظلت معارفنا معلومات سطحية ليس إلّا فإنها لن تثير فينا أيَّ حركة أو نشاط؛ لأنها لا تنفذ إلى القلب؛ وعلى ذلك فأول ما يجب القيام به لتحويل المعرفة إلى سلوك هو السعي إلى بلوغ العلم الحقيقي بشوق ونهَم لا يعرف الشبع، ثم إلى بلوغ اليقين؛ قال الله تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وسلم:
﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (سُورَةُ طَهَ: 20/114).
على كلِّ واحد مِنّا أن يسعى لطلب العلم، ويسير على درب “هل من مزيد؟” بشوقٍ كشوق الأنبياء، وألا يقنع بما حصّله من علم ألبتة، وأن يتساءل: يا تُرى هل هناك شيء آخر وراء هذا؟، وأن يسعى دائمًا إلى الأعماق.
مثلًا أُمرنا بقراءة القرآن الكريم أمرًا مطلقًا، فإذا لم نسعَ إلى فهم القرآن الكريم وقراءته بتدبر وإمعان فلا جرم أن خزائنه ستُغلق علينا ولو كنّا من حفّاظه، وسيتعذر علينا الاستفادة من هذا المنهل النوراني الذي يضيء العوالم كلها؛ لأنّ القراءة بحضورٍ وإمعان تفيض على قلب الإنسان معاني لا يمكن تحصيلها بطريق آخر.
أداء شكر العلم
بعد المرحلة الأولى أي مرحلةِ تحويلِ المعلومات إلى معرفة، ينبغي ملاحظة ما يلي:
قد يبلغ الإنسان عمقًا علميًّا ممتازًا، ثم يبلغ درجة علم اليقين، بل حتى أفق عين اليقين، لكنه إن لم يحوِّل علمه إلى عمل بعد بلوغ هذا الأفق فإنه لن يتمكن من إدراك حقيقة الألوهية بأسمائها وصفاتها وشؤوناتها على الوجه الأكمل، ولن يستطيع أن يكون عبدًا صادقًا لمولاه جلّ وعلا؛ رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَرَّثَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ”[1]؛ فسبيل الحصول على ميراث العلوم التي بشّر بها هذا القول المبارك هو أن يعمل المرء بما يعلم، إذًا على من بلَّغه الحقُّ تعالى مبلغًا في العلم وميّزَه على غيره أن يعطي هذه الميزة حقها دون أن يرى نفسه متميزًا، وذلك بأن يسعى ليشكر ما أُوتي من العلم، فلو كان غيرُه يصلي في اليوم أربعين ركعة، فليسأل نفسه: “ما لي لا أصلّي ثمانين ركعة شكرًا لهذه النعم التي أغدقها الله علي؟”، ولْيُبْحِرْ في عالم الإحسان.
وإليكم هذه الحادثة على سبيل الاستطراد: ذات يوم قالت لي أمي رحمها الله: “يا حاجّ، “حزبُ أنوار الحقائق النورية”[2] وِردي اليوميّ، فيا ترى هل هناك شيء آخر توصيني بقراءته؟”
إنها أصداء وأنفَاس أفق “هل من مزيد؟”.
أجل، على من حظي بلطف الله وإحسانه أن يتوجه إليه تعالى بقدر هذا اللطف والإحسان، تتحدث السيدة عائشة رضي الله عنها عن عبادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: “إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه”، وفي هذا تذكّروا إن شئتم قول الإمام البوصيري رحمه الله:
ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَا الظَّلَامَ إِلَى أَنِ اشْتَكَتْ قَدَماهُ الضُّرَّ مِنْ وَرَمِ
وأمام هذا المشهد سألته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: “لِمَ تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟”، فقال:
“أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟”[3]
وهذا القول فيه إشارة مهمة للشعور بالعبودية: على كلّ عبدٍ أن يحمد الله ويشكره، كُلٌّ على قدر ما أفاض عليه من ألطاف وإحسان؛ فينبغي أن يكون عمل الإنسان على وفق مكتسباته العلمية.
العقل العملي
ولكم أن تتذكروا في هذا الصدد فكرة الفيلسوف الألماني “إيمانويل كانط” في مؤلَّفه “نقدُ العقل المجرَّد”: أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى بالعقل المجرد، ولا يمكن الوصول إليها أي إلى آفاق معرفته إلا بالعمل، فإنْ تحقق هذا -أي تَحوَّل العلمُ إلى عمل- تكونت لدى الإنسان معرفة إلهية عميقة، ثم محبة إلهية واسعة، حتى إنه عندما يذكر الله تجيش مشاعره، فيتمنى من صميم قلبه أن تأتي ساعة لقاء مولاه عز وجل ليتخلص فيها من وحشة الدنيا، فتراه يقول: اللهم لقاءَك، اللهم لقاءَك!
يقول الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي: “اعلمْ يقينًا أن أسمى غاية للخلق وأعظمَ نتيجة للفطرة الإنسانية هي “الإيمان بالله”، واعلم أن أعلى مرتبة للإنسانية وأفضل مقام للبشرية هو “معرفة الله” التي في ذلك الإيمان، واعلم أن أزهى سعادة للإنس والجن وأحلى نعمة هي “محبة الله” النابعة من تلك المعرفة، واعلم أن أصفى سرور لروح الإنسان وأنقى بهجة لقلبه هو اللذة الروحية المترشحة من تلك المحبة”[4].
لا تُطلب اللذة الروحية التي ذكرها الأستاذ بديع الزمان، بل يهبها الله تعالى لعبده فضلًا منه؛ فإن حصلت هذه اللذة الروحية فسيظهر الشوق لرؤية جمال الله، وما كلُّ الجماليات إلا ظلٌّ لِظلِّ ظلِّ تجلي جماله، سيظهر ذلك الشوق كأنه شلّال هادر في داخلنا، فإن لم نشعر بمثل هذا الشوق والاشتياق في أنفسنا فهذا يعني أننا ما زلنا في الطريق ولم نكمل بعدُ هذه المسيرة، ولا أرمي بكلامي هذا إلى إحباط الآمال أو التيئيس؛ لكن علينا أن نعرف أن هذا هو حقّ الطريق الذي نسير فيه؛ ولذا أقول مرة أخرى: تعمَّقوا في العلم المجرد كما تشاؤون، ولكن إن لم تحوِّلوا هذا العلم إلى عمل فستظلون حيث أنتم، فإن فعلتم إلا أنكم لم تتعمقوا في هذا العمل لتصلوا منه إلى العرفان فستظلون كذلك حيث أنتم، ولن تتجاوزوا الصور والشكليات، حتى إن أداءكم للعبادات والطاعات سيكون من باب إسقاط الفرض فحسب؛ نعم، تقومون بحركات لكنكم لن تصلوا بها إلى معرفة الله، ولن تشعروا بمحبته، ولن تبلغوا اللذة الروحية.
ويشبّه القرآن الكريم من لم يعمل بما علِم بقوله: ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ (سُورَةُ الْجُمُعَةِ: 62/5)؛ لذا لا بدّ أن يكون الإنسان متحمسًا وحذرًا في هذه المسألة كيلا يتردّى في هذا الدّرْك.
أجل، إن لم يعمل المرء بما يعلم، ولم يُفعِّل علمه في حياته الخاصة والاجتماعية فسيغدو علمُه كأنه حِملٌ لا يُطاق، وسيندرج تحت العلم غير النافع وغير المثمر؛ من أجل ذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العلم المجرد قائلًا: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ”[5]، وفي هذا توجيه لنا إلى الاعتصام بالدعاء والاستفادة من طاقة التضرع إلى الله في تحويل المعرفة إلى سلوك.
آفاق تتفتح بالقراءة الجماعية
إن العمل الفردي من قراءة وتفكر وبحث وتدقيق في دراسة الحوادث والأشياء وتقويم علاقة الإنسان بالكون وبربّه أنشطةٌ ممتعة مفيدة، لكن الفضائل المستفادة من الكينونة في جو وبيئة مناسبة مع ثُلَّة من الأصفياء التقَوا على فكر ومنهج واحد تبدو متميزة أيمّا تميز، فهذا الجو وهذه المجموعة من يلج فيهما يغدو ذا صبغة جديدة تَفتح له آفاقًا جديدة؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز:
﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (سُورَةُ الفَتْحِ: 48/10)
ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ”[6].
فالآية والحديث يشيران إلى فضيلة الكينونة مع الجماعة، ويحذّر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من خطر البعد عن الجماعة، فيقول:
“عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ”[7].
يبين النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنّ الذئب لا يأكل إلا مَن يتحرك خِلاف الوعي الجماعي ويخرج من الحلقة، ولا يتحرك مع الجماعة ولا يتبع خطواتها؛ لذا ينبغي أن نجتهد في البقاء داخل إطار الجماعة، وأن نساند بعضنا، وأن نمتنع عن الحركة وحدنا.
أمر آخر لا بدّ منه هنا: لنجنّبْ مجالسنا اللغو واللهو، ولنستثمرها في التعمق بالعلم والمعرفة دون أن نضيّع ولو ثانية من وقتنا، ويؤلمني أنَّه لا يمكن القول بأنّا قد عُنينا بهذا الموضوع كما يجب، بل حتى اجتماعاتنا من أجل الدين والإيمان وخدمتهما قد نشغلها بمسائل تافهة لا فائدة منها في حياتنا الدنيوية والأخروية، وبتصرفاتٍ تخلو من الجدّ والوقار وتسوقنا إلى الغفلة؛ أرى أن على القلب المؤمن أن يوصد الباب أمام هذه الترّهات، وأن يقضي حياته على نسق نظام التكايا والزوايا؛ نرى في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضحك إلا نادرًا؛ نعم، كان وجهه المبارك دائم البشر والتبسم، لكن ذلك كان مع جد ووقار، كان في كل أحواله كأنه بين يدي ربه، ومن رأى أحواله وأفعاله بل ونظراته تذكّرَ اللهَ فورًا.
وحمادى القول أن علينا أن نستثمر مجالسنا جيدًا في بلوغ أفق القلب والروح، حتى نتزود بالعلم النافع ونجعلَ هذا العلم حياةً لحياتنا؛ أجل، يجب أن تكون أحاسيسنا وأفكارنا ومشاعرنا ومحاوراتنا ومذاكراتنا مستقيمة أتم ما يكون، وأن تتجه إلى تعميق أفق القلب والروح وإثرائهما لنهتدي إلى الطريق السوي المستقيم دون تخبطٍ أو انحرافٍ يمينًا ويسارًا أو تيهٍ أو انزلاقٍ إلى منعطفات جانبية.
[1] أبو نعيم: حلية الأولياء، 10/15.
[2] “حزب أنوار الحقائق النورية“: كتاب أدعية فيها سور من القرآن وبعض الأدعية والأوراد، أكثر من مائة صفحة.
[3] صحيح البخاري، التفسير، سورة الفتح، 2؛ صحيح مسلم، صفات المنافقين، 79.
[4] سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب العشرون، المقدمة، ص 269.
[5] صحيح مسلم، الذكر والدعاء، 73.
[6] سنن الترمذي، الفتن، 7.
[7] سنن أبي داود، الصلاة، 46.