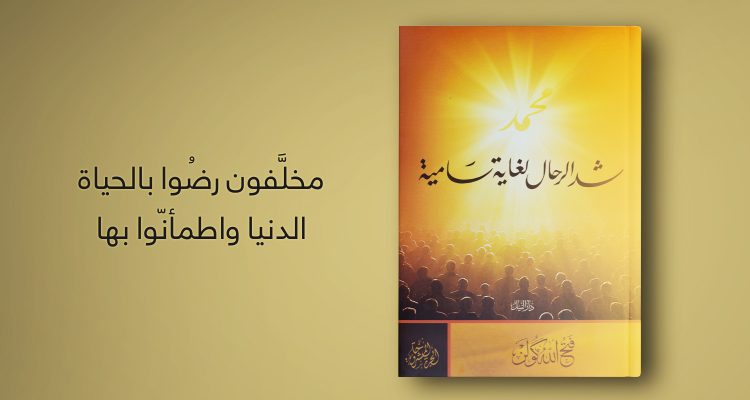سؤال: يقول الله تعالى: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (سُورَةُ التَّوْبِةِ: 9/81). إلامَ ترشد هذه الآية رجالَ خدمة الإيمان اليوم؟
الجواب: قال المفسرون: نزلت هذه الآية في المنافقين، ذمًّا لأفعالهم وتصرفاتهم حيال الجهاد في سبيل الله؛ ومع ذلك فإن الآية قد تضمنت دروسًا وتوجيهات مهمة جدًّا لكل مؤمنٍ يتقاعس عن إعلاء كلمة الله ويخلد إلى الدعة والراحة؛ فالصحابة الكرام وكثيرٌ من عظماء التابعين وتابعي التابعين وعلى رأسهم السيدة عائشة وسيدنا أبو ذر وسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعًا كانوا يعدون أنفسهم معنيّين من وجهٍ ما بكل آية نزلت في المنافقين، وذلك ما جعلهم يستنبطون منها كثيرًا من العبر والعظات لأنفسهم.
ولا جرم أنه من الخطأ أن يتهم المؤمن نفسه بالنفاق الاعتقادي؛ لأنَّ معناه الكفر، ويستحيل أن يرضى مؤمن لنفسه الكفر-معاذ الله-؛ فعلى المؤمن أن يقول دائمًا: “الحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال” كما يقول الأستاذ النورسي؛ أجل، إن من ارتضى الكفر وقع فيه؛ فليفرّ المسلم من الكفر والنفاق فراره من الثعبان والعقرب.
ابن آدم: مَن لديه قابلية لأن يكون كل شيء
لكن الإنسان لديه نقاط ضعف بشرية، ولمّا نظر الشيطان إلى سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام رأى في بنيته -لا في فطرته وماهيته- وجوهًا كثيرة من القصور والضعف مثل: اتباع الهوى، وحب الشهرة والمنزلة، والشغف بالتصفيق والتهليل، وحب الخلود إلى الراحة، والخوف مما سوى الله، واختلاس مال الغير… فقال كما جاء في القرآن الكريم: ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 7/17-16)، فهذه النقاط في الإنسان ملعب يصول فيه الشيطان ويجول، فالإنسان إذًا عرضة للضلال والنفاق والكفر.
وبتعبير آخر: لا يخلو كل المؤمنين عن صفات الكفر والنفاق والضلالة؛ لكن لا يصح ألبتة -بناء على هذا- أن ندعي أن من فيه هذه الصفات ضالٌّ ولا أن نحكم عليه بالكفر والنفاق؛ غير أن على الفرد أن يراقب سريرته دائمًا ليكتشف: أعنده هذه الصفات أم لا، فإن وجدها حاول أن يتنزه عنها فورًا.
تعساء يفرحون بخسارتهم
وبالرجوع إلى موضوعنا نقول: صدر الآية الواردة في السؤال يعبّر عن مدى فرح المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك:
﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ﴾
ومن يدري فلعلهم كانوا يعتقدون أنهم قد تصرفوا بعقلانية، وربما كانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء يحاربون إمبراطورية الروم العظمى، فسيكتوون بحرّ الصيف وسيواجهون قوة عظيمة، وسرعان ما يرتدون منهزمين؛ كانوا يطعنون في المجاهدين بسهام كلامهم هذا، ويستخفّون بهم، وهم سعداء بالخوض في مثل هذه المسائل.
تعلمون أن غزوة تبوك وقعت في شدة الحر، حتى إن درجة الحرارة في الصحراء حينها كانت تبلغ 50-60 درجة، وقد أثمرت الأشجار فرقَّت ظلالُها حتى راق للنفس الأمارة الركون إليها؛ وليس أشق على النفس من خوضِ حربٍ وتركِ ينابيع المياه العذبة والظلال والثمار اليانعة في شدة الحر، لا سيما أن الأعداء هم الروم الذين بلغوا الأردن.
وكان سلطان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه يستهدف من غزوه للرومان في فترة عصيبة كهذه أن يعلن للجميع عن وجود قوة ذات سيادة في المدينة، وأن يبسط الأمن والأمان في الصحراء.
وأخيرًا رغم هذه الظروف القاسية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين للقاء الرومان، فاستطاعوا بحول الله وقوته أن يدحروا العدو ويردّوه على أعقابه.
نعم، في جوٍّ قاسٍ كهذا كَره بضعُ مئات من المنافقين الخروجَ ورضوا بالقعود في بيوتهم متعللين بشتى المعاذير، وكان ثلاثة من المؤمنين لم ينفروا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن يدري فلعلّهم اجتهدوا وأخطؤوا، ظانّين أن الخروج لمثل هذه الغزوة فرض كفاية؛ لكنهم -أيًّا كان السبب- تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتخلفُ في مثل هذا الموقف صفة من صفات النفاق، فعوقبوا فترة مؤقتة، إلا أن هؤلاء الأبطال ثبتوا في الامتحان فنجحوا نجاحًا باهرًا، وحظوا في النهاية بعفو الله تعالى.
وقد أشار الحق سبحانه وتعالى بقوله: ﴿خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ﴾ (سُورَةُ التَّوْبِةِ: 9/81) إلى أن ما كان من المنافقين وقع مخالفًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلّ هذا أن الخروج عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ فادح قد يؤدي بالإنسان إلى الهلاك؛ فلا بدّ من امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم أيًّا كانت الظروف والأحوال.
نشرُ المرض
هؤلاء المنافقون كما تخلّفوا عن الإنفاق في سبيل الله ونأوا بأنفسهم عن تحمل المشاق والصعاب، قد شرعوا ينثرون بذور الفساد والفتنة فيمن حولهم ويؤثّرون فيهم بقولهم: ﴿لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ﴾.
نعم، ثمة أناس كنانتُهم ممتلئة بالفتنة والفساد على الدوام، الإفساد أقواسُهم والفتنةُ سهامُهم، يُشرعون أقواسهم ويطلقون سهام الفتنة دائمًا، يضخّمون الأمور ويهوِّلون الأشياء التافهة ويحاولون الصد عن سبيل الخير.
فكان أمثال هؤلاء يترددون بين المهاجرين والأنصار يحاولون أن يثنوهم عن الحرب ضد الرومان بقولهم: ﴿لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ﴾.
فقال الله تعالى ردًّا عليهم: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾
ولفظ “يفقهون” معناه سبر المسألة وتناولها في إطار العلاقة بين السبب والنتيجة والسياق والسباق، فلدى النظر يتبين أن هذا اللفظ أولى هنا من لفظة “يعقلون” أو “يعلمون” اللتين تُستخدمان فيما يسهل فهمه واستيعابه، ولعل سرّ هذا الاختيار التعريض بأنه ليت لهم شيئًا من الفقه وآفاقه، وليتهم استوعبوا هذه العلاقة بين السبب والنتيجة، ولكن هيهات! فقد عجزوا عن إدراك أيّ من هذه الحقائق رغم كل هذه التوجيهات.
لو اعتَبر الناسُ بحوادث التاريخ لَمَا تكررت
لو قارنّا أحداث اليوم بالأمس لَما وجدنا فرقًا كبيرًا بينهما، لم يستطع منافقو الأمس استيعاب هذا، واليوم لم يقدر قوم على إدراك ضرورة العمل في سبيل الله وأهميته؛ وما حدث بالأمس يتكرر اليوم، فنجد قومًا يستخفّون بالهجرة، ويحطون من شأن الجهاد في سبيل الله، ولا يُعنَون بتحليق الروح المحمدية في أرجاء العالم كافة، والمكانُ الذي لا تحلّق فوقه هذه الحقيقة لا فرق بينه وبين السجن؛ فلا بدّ من “الفقه” لنعزم على مجابهة شتى أنواع الصعاب في سبيل الوصول بهؤلاء السجناء إلى أجواء تبعث فيهم الفرح والسرور، لأن هذه المسألة لا تُدرَك بالنظرة السطحية.
والخلاصة أنه لا بدّ من تحمل شتى أنواع المشاق والصعاب مرة أخرى في سبيل إعلاء كلمة الله ليتجدد اتصال القلوب بالله، وذلك بإزالة كل عائق يحول بين الله وبين القلوب، فلْنسعَ دائمًا بأقصى سرعة دون توانٍ أو فتور لنغمر القلوب بإلهامات أرواحنا، ولنبلغ الآخرين بموروث سماوي أربى على ألف عام؛ وليُعلم أن سبيل النجاة من نار جهنم في الآخرة مرهون بتحمل الحرّ هنا؛ أجل، إن المعاناة هنا سبيل إلى الراحة هناك، والمشقة هنا طريق إلى اليسر هناك.