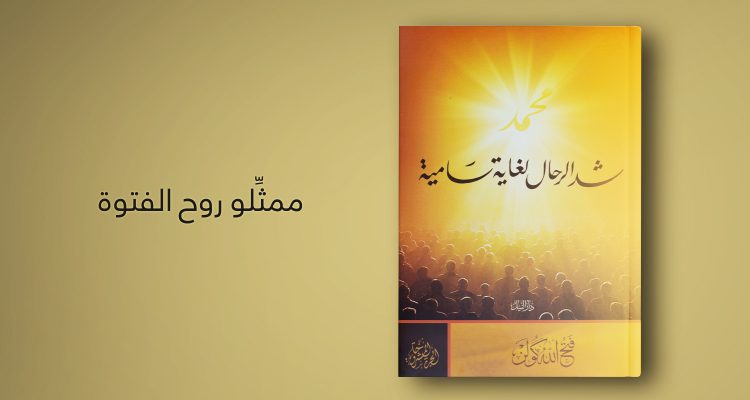سؤال: للفتوة تعاريف شتّى منذ قديم الزمان، فما معناها، وعلى مَن يُطلق “الفَتَى” في ضوء ظروفنا الراهنة؟
الجواب: الفتوة لغة: الشباب، وهي مشتقة من الجذر “ف ت ي”؛ واصطلاحًا: تشبُّع القلب بالإيمان الكامل، وحسنُ معاملة الناس كلهم، ونذر العمر من أجل الآخرين، وأداءُ المرء مهامه دون أن يرى نفسه متميزًا، وبذلُ كلّ التضحيات في سبيل القيم المقدسة، وانتظارُ ما له أجل مسمى والصبرُ عليه صبرًا يبلغ حدّ الجنون كصبر الدجاجة حتى تفقس بيضها، والثورةُ على كل المساوئ والشرور مع مراعاة العصر والزمان الذي نعيش فيه، ودون إهمال العقل والمنطق، والثباتُ وعدمُ الفزع من الأذى والمشقة التي تنتج عن كل ما ذكرنا.
رُوي في الأثر: “لَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ وَلَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَار”[1]
يشير هذا إلى أن سيدنا عليًّا كرّم الله وجهه بطلٌ يمثل الفتوة بكلّ معانيها؛ والحقّ أن الفتوة تمتد إلى ما قبل سيدنا علي رضي الله عنه بكثير، فلنا أن نعدّ كلًّا من الأنبياء العظام ممثِّلًا حقيقيًّا للفتوة في أعلى مستوياتها لأنهم أفنوا حياتهم في سبيل رسالاتهم، ورغم أنّ منهم من لم يتّبعه إلا بضعة أشخاص ومنهم من لم يتبعه أحد إلا أنهم مضوا في دعوتهم ولم يفتروا.
ترقُّب النتيجة من الله عز وجل فحسب
إن الأنبياء العظام عليهم السلام أدَّوا رسالتهم على أكمل وجه، وواصلوا أداءها بوعي وفطنة في ضوء الأوامر التكوينية، وتصرفوا في كلّ حال بحِكمة بالغة، ومع ذلك كله لم يترقبوا النتيجة إلا من الله سبحانه وتعالى، وهذا بعدٌ آخر من أبعاد الفتوة.
أجل، إن تحرّقَ المرء شوقًا وعشقًا في البداية لأداء الواجب، ثم اطمئنانَه في النهاية إلى أنه قد قام بواجبه، كلاهما معًا مؤشرٌ مهم على روح الفتوة؛ وبتعبير آخر: ثمة أمر شديد الأهمية في خدمة الإيمان والقرآن، ألا وهو أن يَشْغَلَ عقلَ المرءِ على الدوام -وهو يقوم بمهمة الإرشاد والتبليغ- أنِ “الحمدُ لله أنني امتثلتُ أمر ربي وإن لم يتبعني أحد، وله الحمد أنه لم يحرمني من تبليغ هذه الرسالة”، وأنْ يمضي في مهمته بلا خنوع ولا انكسار ولا يأس ولا قنوط.
لقد قام الممثلون الحقيقيون لروح الفتوة على مدار التاريخ بتبليغ رسالتهم حتى عندما أُشهِرت لهم المقاصل، فلم يعبؤوا بقمع السادة والكبراء واضطهادهم، واستخفوا بالحياة ومضوا في طريقهم؛ فهذا عيسى عليه السلام لم يتوانَ قطُّ في التضحية بروحه في سبيل رسالته رغم ظلم الرومان وقمعهم، ومحاولة طائفةٍ التنكيلَ به وتأليبَ الرومان عليه؛ ثم وجَّه نظرَه إلى العالم الآخر وارتقى إلى مرتبة حياتية مختلفة؛ فيمكن أن يقال: إن الفتوة التي كان يمثلها عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانت مرقاةً لرقيِّه إلى الأفق الذي هو فيه الآن.
وفي قصة سورة الكهف حول رحلة موسى عليه السلام وفتاه ولقائه بالخضر بعدٌ آخر للفتوة؛ فهذه القصة تشير إلى بعد من أهم أبعاد الفتوة وهو الخروج من سجن قوالب الطبيعة الضيقة والانفتاح على رحابة ما وراء الطبيعة للرقي إلى مستوى حياة القلب والروح، ثم التطواف باستمرار في هذا المدار؛ وإن كانت الجسمانية تستمرّ بقدر الحاجة ولا تنعدم جذريًّا في مثل هذا المستوى من الحياة إلا أن الرغبات والأهواء تتقهقر في سلم أولويات المرء؛ ولمثل هذه القصص دلالات مهمة منها أن على المؤمنين ألا يكتفوا بعلوم الظاهر فحسب، بل عليهم طلب العلم اللدنّي باستثمار عوالم قلوبهم وأرواحهم.
الفتوة والتفاني
من أهم مقوِّمات الفتوة أن يتحلّى المرء بروح التفاني؛ أي أن ينذر نفسه لغايته المثلى، ويطرح ما سواها، وعلى الروح المتفانية أن تقول: إن وظيفتي الحقيقية هي إعلاء كلمة الله والسعي الدؤوب لتحقيق هذا الهدف المنشود.
والحقّ أن كلمة الله في نفسها عالية كما أسلفنا مرارًا، ولكن لا بد من بذل الجهد ليسمعها العالمُ كله؛ فعلى من تفانى في سبيل غايته المثلى أن يهرول وراء هذه الغاية بمشاعره وأفكاره وسلوكه وأفعاله كلِّها، وأن يتضرع إلى الله تعالى أن يثبّته على هذا الأمر؛ لا بدّ لمثل هذا الإنسان أن يفيض قلبه بالرغبة في إحياء الآخرين حتى ينسى -وهو على ذلك- طريقَ بيته ووجوهَ أولاده، إلا أن علينا أن نذكر أن مِن أسُس الخدمة الإيمانية أداء المرء لما عليه تجاه أولاده وأبويه وكل من لهم حق عليه.
الفتوة والثبات
ومثل التفاني في الأهمية في هذا المقام الثباتُ والشموخ، فعلى المرء أن يثبُت حيث هو، ويقول كما قال “إبراهيم تنوري”[2]:
ما أعذب البلاء إن كان من جلالِهْ
وما أحلى الوفاء إن كان من جمالِهْ
ففي الجمالِ لطفُهُ وقهرُهُ سواء
ونقصد بالشموخ ألّا يُصاب المرء بالذعر فيتداعى ويسقط، وألا يتخلى عن رسالته مطلقًا مهما كلّفه الأمر، وإلا فالأجدر بالمؤمن أن ينحني كعلامة الاستفهام بين يدي ربه سبحانه وتعالى، بل ويخرّ على وجهه ساجدًا، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلنميز بين هذين الأمرين.
الفتوة الحقيقية هي الفناء عن الذات
أهمّ سِمَة لا بد أن يتميز بها مَن نذروا أنفسَهم لحركة المتطوعين هي ألا يروا أنفسَهم متميزين رغم أدائهم المتميز.
فإذا ما اطّلع المراقبون على ما يبذلون من تضحيات فلربما يقولون: “قليلٌ في هؤلاء وصفُهم بــ”المثاليين”؛ لأن لهم عمقًا معنويًّا خاصًّا لو مُزِّق أحدهم أشلاءَ ووُضع المنشار على رأسه فجُعل نصفين، ومُشِط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فلن يصرفه ذلك عن رسالته؛ ورغم كلّ هذه التضحيات عليهم أن ينقشوا في أرواحهم أنهم لا يتميزون عن غيرهم بشيء، بل لا ينبغي أن يرِدهم هذا الخاطر، فإن مر بهم خاطرٌ كهذا قسرًا فليُهرعوا إلى سجّادة التوبة فورًا وكأنهم اقترفوا أمرًا عظيمًا؛ أما ما يجري على أيديهم من جماليات فيرون أنها جميعًا نتاجٌ لِتفتُّح أزاهير بذور ألقاها مَن كانوا قبلهم، ثم غدت براعمَ تنمو وتُزْهِر، فسنابلَ في كل سنبلة منها ألف حبة، فهذه الجماليات ناجمة عن صدق سلفنا وإخلاصهم في جهدهم وسعيهم، وشاء الله أن يوافق عصرُنا وقتَ العناية بتلك البذور وعزق الأرض وتعهدها بالتنقية والنظافة لتغدو هذه الفسائل أشجارًا تُثمر؛ فأنى لنا أنْ ننسب لأنفسنا كلّ هذه الجماليات؟! إنه لَبخس لحقّ سلفنا ووقاحةٌ وصفاقةٌ بين يدي الله تعالى.
ولا عبرة في مقام الفتوة بالعمر أو المقام أو المنصب أو الخبرة؛ فقد يتوهم الإنسان أنّ له ميزةً على غيره لإقبال الناس عليه لعمره أو مقامه أو منصبه أو خبرته، والحقّ أنّ توقير من بدأ حمل هذه المهمة قبل غيره هو مقتضَى الأدب والتناغم بين السابق واللاحق؛ أجل، إنّ من وسائل تحقيق التوازن والتناغم بين الأفراد احترامَ الصغار للكبار وحسن الظن بهم بشرط أن يكون دون مغالاة أو مبالغة، ودون الدخول في أنانية الجماعة الأمر الذي ينفّر الآخرين؛ وليُعلَم أنّه إن لم يتحقق من نوقّرهم بالفناء عن الذات، وإن لم يدرّبوا أنفسهم على أن يروها “صِفْرًا” فقد تساورهم الأوهام والادعاءات ويعشقون المناصبَ المعنوية التي وهبَها لهم مَن أحسن الظنَّ بهم، فرب قائلٍ: “قد بلغتُ من العمر الستين، وأنا أستاذ كبير في نظر كثيرين، وها هم يجثون بين يدَيّ على الركب، ومعنى هذا أن لي ميزة”؛ فمثل هذه الخواطر نذيرٌ بالخطر ونافذة لزيغ الإنسان وضلاله، ومحوه وهلاكه؛ أمّا لو رأى المرء أن تحقيق مقتضى الخبرة مَسؤوليةٌ حتميةٌ تقع على عاتقه فهذه مسألةٌ أخرى؛ لكن إن ردّ إقبالَ الناس عليه إلى خبرته وذكائه وفطنته، واتخذ ذلك وسيلة للتحكم فيهم، فذاك شططٌ بيّن ووقاحة مضاعفة.
التواضع سمة لازمة للفتوة
ثمة حكمة يعزوها بعضهم إلى سيدنا عليّ رضي الله عنه: “كُنْ بين الناس فردًا من الناس”، فمن أراد أن يكون ممثِّلًا حقيقيًّا للفتوّة فعليه أنْ يكون فردًا من الناس حتى لا يراه الناس متميِّزًا عن غيره.
وأرى أن هذا مبدأ أساس وبُعد مهم للفتوة؛ لم يُكتب لي أن أصحب الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي لأرى حياته، لكن سمعت من طلابِه من الرعيلِ الأول في الخدمة أنه رحمه الله رحمة واسعة لا يميز نفسه عن طلابه ألبتة رغم أنه أستاذهم، وله يد عليهم، ويعرِّف نفسه دائمًا بقوله: “أخوكم”، وأشار إلى هذا في رسائل النور، فقال: “إن أساس مسلكنا ومنهجنا هو الأخوة في الله، وإن العلاقة التي تربطنا هي الأخوة الـحقيقية، وليست علاقة الأب بالابن ولا علاقة الشيخ بالـمريد، وإن كان لا بدّ فمـجرد العلاقة بالأستاذ؛ وما دام مسلكنا هو “الـخليلية” فمشربنا إذًا “الـخلّة”، والـخلة تقتضي أن يكون الأخلاء بعضهم لبعض صديقًا صدوقًا، ورفيقًا مضحّيًا، وأخًا شهمًا غيورًا…”[3].
ولنا في علاقة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بصحابته أسوة حسنة، فكلّما عرف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم شخصيتَه أكثر، ووقفوا على الحقّ والأدب الذي يقتضيه هذا المقام وذلك الموقف تضاعف احترامهم وتوقيرهم ولطفهم في معاملتهم له صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي جعله الله تعالى صرحًا للجماليات: خطيبٌ مِصْقَع يسحر السامعين، وإذا قرأ القرآن أثّر حتى على المشركين، لكنك تراه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكس الرأس، يقف وكأنّ على رأسه الطير، وأظن أننا لو جمعنا كلماته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زادت على مائتين.
فمن ذاك الذي حاز كلّ هذا القدر من التقدير والاحترام؟
هناك قول أثبت الأولياء صحة معناه وإن قال المحدِّثون بأنه لم يثبت حديثًا: “لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ”[4]؛ إنه صلى الله عليه وسلم مُرشدٌ ومبلِّغٌ لا مثيل له في شرح كتاب الكائنات وفي تفسير القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع، فتوقير الصحابة له واجبُهم وحقٌّ له عليهم.
أجل، لا يكفي أن يهبّ الأحياء من مجلسهم احترامًا له عندما تطأ قدمه موضعًا ما، بل إن على رميم العظام أن تهبّ من مرقدها توقيرًا له عليه الصلاة والسلام؛ ورغم ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا”[5].
وكان عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه بنفسه في مطعمه ومنامه ونحو ذلك، ولو أَذِن لَما تركه أهلُ بيته أو الناسُ يقوم بشيء من ذلك أبدًا، ولكن سيد الأنام عليه أفضل الصلوات والسلام لم يكن ليأذن؛ لأن عظمة الكبار في التواضع والفناء والحياء، أما التكبر والخيلاء فهو عقدة نفسية لدى الصغار، فإنه لا يليق بالعظماء استغلال توجه الناس إليهم بالتحكم فيهم.
ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا مما لا يليق به قط؛ أجل، كلّ ما كان يفعله يليق به للغاية؛ حتى إن الملأ الأعلى ليغبطه ويَعجب لِما يقوم به من أعمال.
وقصارى القول أن حياته السنيّة صلى الله عليه وسلم فيها أروع نماذج الفتوة بكلّ أبعادها وأعماقها كما كان في مكارم الأخلاق جميعها.
[1] العجلوني: كشف الخفاء، 2/447.
[2] إبراهيم تَنُّوري (ت 887ه/1482م): شاعر صوفيٌّ، له دواوين شعر منها: “كُولْزار معنوي (حديقة الورد المعنوية)”، و”كُولْشَنِ نِياز (بستان التضرع)”.
[3] سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة الحادية والعشرون، الدستور الرابع، ص 224.
[4] العجلوني: كشف الخفاء، 2/192.
[5] سنن أبي داود، الأدب، 151.