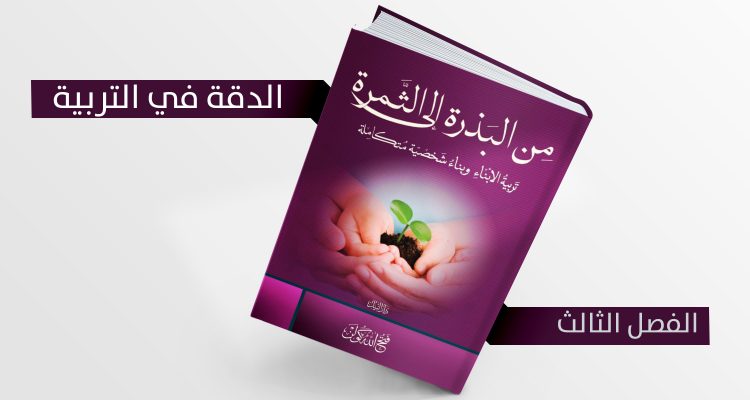لا شكّ أن البيت الذي أسّستموه أو تفكّرون في تأسيسه سيعِدُ بمستقبلٍ مشرقٍ إن كان في إطارٍ يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبتعبيرٍ آخر: إن أنشأتم ذريةً تنشدون من ورائها أن تكون أمة للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بحقّ، فما أسعدكم وأشرق مستقبل ذريتكم! وإن أنشأتم ذريتكم على خلافِ ذلك -بأن تركتموها للشوارع ولم تبالوا بدينها وتديّنها حتى أصبحت عدوًّا للمسجد والمجتمع- فما أتعسها، وأنتم مَن يتحمّل مسؤوليّة ذلك.
وهذا أولًا ظلمٌ للأولاد ثمّ للمجتمع، وليس لأحدٍ الحقّ في ارتكاب مثل هذا الظلم، ولا ريب أننا سنُحاسب على أن هذه الذرية نشأت تُضمر العداوة للإسلام وتتغذّى بالحرام وتنتهك القواعد العامة بسبب أفعالها غير المشروعة، وإن من أوائل المهام التي تقع على عاتقنا هي تنشئة جيلٍ صاحب غايات مثلى، مرتبطٍ بجذوره المعنويّة، عميقِ الفكر، واسع الأفق، رحيم، يحترم الناس ويوقّرهم… وهذه الوظيفة المهمة تبدأ بتأسيس البيت على نحوٍ واعٍ، ويُكتب لهذا البيت البقاء بعناية الله إن اقترن بالعقل والمنطق.
وعلى ذلك لا بدّ من تناول الأسرة كمؤسّسةٍ تعتمد على روح الدين، وتدور في فلك العقل والشعور، وجعلِ رضا الله تعالى أساسًا للحفاظ على بقائها، لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد آنفًا إلى أنه سيفتخر بتكاثر أمته، فإن كانت الأجيالُ لا تعرف الله ورسوله، أي لا تستحق أن توصف بأنها من “أمة محمد عليه الصلاة والسلام” فلن تحوز أيَّ قيمة عند الله، ولن تكون لها أيّة قيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغت كثرة عددها.
من أجل ذلك ينبغي أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى باستئصال شأفة النزعة إلى الشر عن طريق الاستغفار والإنابة إلى الله، وبتعزيز نزعة الخير عن طريق العبادة والقيام بالأعمال الخيّرة، كما تجب المحافظة على الانتظار النشط بمواصلة القيام بالأعمال التي لا بدّ من تأديتها قولًا وفعلًا وقلبًا.
يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ﴿قُلْ لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 5/100).
أجل، قد يُدهشكم كثرة الخبث والخبثاء، ولكن يجب أن تعلموا أنه لا يستوي الخبيث والطيب مطلقًا عند الله تبارك وتعالى، إذًا عليكم أن تهتمّوا بتربية الذرية التي قد تذكّركم بالجنة بروائحها المعنوية التي تنشرها، وأن ترعوا هذه الذرية الطيبة، وأن تعملوا على أن تكونوا آباءً معلمين ومربين لها.
1- علّة الوَهْن
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا” (يعني ستداعى عليكم لسلب أموالكم ومصادرة ممتلكاتم)، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: “بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ”، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا “الْوَهْنُ”؟ قَالَ: “حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ”[1].
أجل، إن أيَّ مجتمعٍ يعتبر الجوانبَ الجسمانيةَ للدنيا مقصودةً لذاتها، ويتّجه بقلبه وروحه إليها، ويغضّ الطرف عن مرضاة الله سبحانه وتعالى؛ بمعنى أنه يفضّل الدنيا وما فيها على الله تعالى؛ فلا قبل لنا أن نقول إنه مستقيمٌ قلبيًّا وروحيًّا حتى وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “لَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ”، وفي حديثٍ آخر ينبّه صلوات ربي وسلامه عليه إلى إهمالٍ مهمّ آخر يُفضي إلى نزع المهابة من القلوب، وهو: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإغفال الحديث عن القرآن والبعث والنشر، يقول عليه الصلاة والسلام:
“كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَقَ فِتْيَانُكُمْ، وَطَغَى نِسَاؤُكُمْ؟” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: “نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: “نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا، وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا؟”[2].
إذًا لا بدّ أن تكون أعظم غاياتنا هي تربية نشءٍ قويِّ الإيمان، قويٍّ إلى أقصى درجة من الناحية الماديّة والمعنويّة، ذي إرادةٍ يستطيع بها أن يشقّ الجبال، ذي بصيرةٍ يستحقر بها الدنيا بوجوهها الجسمانية والنفسانية، ربانيٍّ لا يسمح بسريان الوهن إلى قلبه، مفعمٍ بالحيوية والفتوّة والمهابة من رأسه حتى أخمص قدميه أمام الأعداء.
2- وظيفة المرأة
لا بدّ أن يساور الجميعَ القلقُ والخوفُ من غيرة الله سبحانه وتعالى إذا ما أُهمل الأولاد وأُغوي الشباب وصار متاعًا للشهوة والرغبات، ولم تؤدّ المرأة مهمتَها.
أجل، إن النسل الذي يطلق عنان نفسه للذنوب والآثام بمحض إرادته وينساق وراء شهواته لهو نسلٌ بائسٌ تعيسٌ، معرّضٌ في كلّ آنٍ لنزول غضب الله عليه.
من أجل ذلك كانت أوّل مهمّة تُلقى على عاتق كلِّ عائلٍ أن يُحسن اختيار رفيقة حياته من الْمُسْلِمَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْقَانِتَاتِ الصَّادِقَاتِ الصَّابِرَاتِ الْخَاشِعَاتِ الْمُتَصَدِّقَاتِ الصَّائِمَاتِ الْحَافِظَاتِ فروجَهنّ الذَّاكِرَاتِ اللهَ كثيرًا، فمن أهمّ أركان السعادة الدنيوية والأخرويّة أن تكون رفيقة الحياة معلِّمةً فاضلةً ومربِّيةً كريمةً؛ يشاطرها الرجل كلَّ شؤون حياته. أجل، لا بدّ أن تكون ذات عقل وقلب؛ حتى تفهم مشاعر زوجها الدنيوية والأخروية إذا ما حدّثها عنها، فإن كلّ طفلٍ ينشأ في هذا البيت سينمو ويترعرع تحت رعاية هذه المربية والمعلّمة الفاضلة.
3- الأسبقية للكيفية
يبين القرآن الكريم في آيات عدة أن كثرة العدد ليس لها الأسبقية، فأهميتها محدودة، فمن هذه الآيات: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ (سُورَةُ التَّوْبِةِ: 9/25).
إن غزوة “حنين” هي الغزوة التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم عقب فتح مكة، لم يتصرّف الصحابة رضوان الله عليهم فيها بدايةً بمقتضى ماهيتهم؛ حيث اعتقدوا أن الجيش الإسلامي لا يمكن أن يقهره أحد؛ ثقةً في دوام عناية الله وفضله؛ حتى قال بعضهم: “لن نُغلب اليوم من قلّة”، ولكن لـمّا انهالت عليهم سهامُ “ثقيف” أُصيبوا بدهشة مُرْبِكة مؤقّتة فتراجعوا متبعثرين، وهذا يعني أنه حتى من بين “الرِّبِّيِّين” أيضًا مَن يفكّر على هذا النحو، وأن كثرةَ العدد ليست أهمّ شيء، إنما المهم هو العمق والكيفية وسعة الأفق.
إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من المقرّبين، فإنّ رجّتهم المؤقّتة وتراجعَهم قد يُعدّ ذنبًا بالنسبة لهم وليس لنا، إذ “حسناتُ الأبرار سيّئاتُ المقرَّبين”، نعم، إن الكثرة ليست أهمّ شيء؛ وهذا هو ما وضّحه القرآن الكريم كما سلف، فعلى المسلمين أن يربطوا كلّ أمرٍ بعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وبالكيف والعمق الداخليّ لا بالكمّ، فإنكم أمة محمد عليه الصلاة والسلام مهما كنتم قليلَ العدد إن توجَّهتم إلى ربكم وكان الأملُ والشوق إلى تبليغ كلمته يحدوكم، فلا جرم أنّ التوفيق سيحالفكم بفضلٍ من الله وعنايته، ولكن إن خلدتم إلى السكون والراحة في بيوتكم، ونسيتم علاقتَكم بربّكم فلا قيمةَ لكم ألبتّة مهما كثُر عددكم.
4- واجبنا نحو الطفل
أ. تهيئة المناخ التربوي
حتى نتمكّن من تربية أبنائنا تربيةً نموذجية لا بدّ من تهيئة الجوّ المناسب للقيام بذلك، فكلّ إنسان يتشكل وفقًا للوسط الذي ينشأ فيه، بمعنى أن الإنسان ابن بيئته، ويأتي البيتُ أوّلًا في صدر العناصر التي تشكِّل هذه البيئة، فالمدرسة ثانيًا، فالأصدقاء ثالثًا، فالمذاكرة الجماعية رابعًا، إلى غير ذلك ممّا هو موجود في الحياة الاجتماعية، مثل: حانوت الخياط، وورشة النجار…إلــخ، فإن لم تستطيعوا تقييد هذا الوسط الذي يتجوّل فيه الطفل، ولم توجِّهوا نزعاته إليه، فلا مناص من أنه سيُصاب بفيروسٍ ما ذات يوم، ففساد البيئة يتمخّض عنه -لا محالة- فساد هذا الطفل في يوم ما، من أجل ذلك عليكم أن تهيّئوا الجوّ المناسب لتربية أبنائكم تربيةً مثاليّة؛ بداية من البيت وحتى كلِّ مناحي الحياة وكل موضعٍ في الطريق؛ لأنه من المتعذّر بعد أن يقع ما يقع أن نعود بالزمن إلى الوراء ونصحّح الموقف.
ب. اللقمة الحلال
ومن الأهمية بمكانٍ أن يتغذّى الطفل على الرزق الحلال المشروع؛ بدءًا من المرحلة الأولى لتخلّقه جنينًا في بطن أمّه، إنّ أيّ خللٍ أو انقطاعٍ في أيّ أمرٍ يجب أن يُربط بربّنا سبحانه وتعالى ينعكس بصورةٍ سلبيّة على الطفل، وإن بصورةٍ مؤقّتةٍ.
وعلى ذلك فما يجري في عروقكم من قطرة متكوِّنة من حرام أو فيه شبهة الحرمة قد يكون سببًا لانحرافٍ مؤقَّت أو مؤبَّد لهذا الطفل.
ج. الوقاية مِن النظرات السيّئة
وكما يجب علينا أن نهتمّ بغذاء الطفل وملبسه ومظهره بعد ولادته فكذلك علينا أن نقيه من النظرات السيّئة الغادرة.
فمثلًا: لا بدّ أن نضع في اعتبارنا أن الشرارات التي تطلقها العيون المجرمة الخبيثة التي تدنّست مشاعرُها وأفكارها وسلوكيّاتها وأقوالها؛ قد تُعرِّض بعض الأحساسيس الرقيقة لدى الطفل إلى الضعف والضمور.
وكلّ هذه الأمور هي من جملة الوظائف التي ينبغي لنا القيام بها تجاه أطفالنا تعبيرًا عن ماهية العلاقة بيننا وبين ربّنا وديننا، فإن أدّينا هذه الوظائف بدقّةٍ بالغةٍ صار مجتمعُنا مجتمعًا ملائكيًّا.
د. تنظيم محيط الأسرة
جاء في حديث شريف: “افْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِـ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ”[3].
من الطبيعي أن يكون لفظ “الأب والأم” هو أوّل ما يتلفّظ به الطفل، ولكن يجب أن تكون أوّل كلمة تخرج من فمه بشكلٍ إراديّ هي لفظ الجلالة “الله”؛ لأن الله هو الأول قبل كل شيء، وهو القديم الباقي وهو الآخِر بعد كل شيء، ثم يُبنى ما عدا ذلك على هذه القاعدة الأساسية ويُنسج عددٌ من المصطلحات حولها بما يتناسب مع عمر الطفل وأفق إدراكه مثل: الوطن والأرض والحرية…إلــخ. فلو أن الطفل يدرس في الابتدائية فليزوّد بمعلوماتٍ تتناسب معه، وإذا كان يدرس في الثانوية ويشتغل بالعلوم الفلسفيّة والاجتماعية فلا بدّ أنْ يُدَعّم بأدواتٍ ومستوياتٍ تتوافق مع هذا المستوى، فإن كان البيتُ مفعمًا بحبّ الله وتوقيره ودوام ذكره فقد رصدنا الهدف المرجوّ وهو أننا جعلنا الطفل يتصرف كما يجب.
أجل، إن البيت الذي يُذكر فيه اسم الله ويستضيء بالركوع والسجود لله وتجيش فيه العواطف عند ذكر الله يتيسّر فيه أن تكون أوّلُ كلمةٍ ينطقها الطفل هي اسم الله؛ لأنّ كلّ ما في البيت يجري على ما يرام.
هـ. ضبط جرعة المحبة
علينا ألا نغالِ في تعلّقنا بأبنائنا الذين وهبهم الله لنا فنتوجّه إليهم بقلبٍ ومحبةٍ لا حدود لها فنجعل حبّنا لهم يتوازى مع حبّنا لربّنا سبحانه وتعالى، إنّ هذا قد يُعدّ نوعًا من أنواع الشرك. أجل، لا ريب أن الانغماسَ في حبّ الولد ونسيانَ الله تعالى من الأخطاء الجسيمة، وأعتقد أنّ هذا هو الحب الممنوع عند الله؛ فإن آثرنا حبّ أيّ فانٍ على حب الله فقد يستدعي هذا الحبُّ غيرةَ الله تعالى.
أجل، لا بدّ من الاعتدال في الحبّ لأسباب، هي:
1- إنّ الله هو سلطان القلوب، فيجب ألا تحلّ أيّ محبةٍ محلّ محبته سبحانه وتعالى.
2- يجب أن نعلم قطعًا أن ما وهبه الله لنا من ولدٍ ما هو إلا أمانة استودعها الله عندنا، وإنّ حبّنا له وتعلّقنا به عبارة عن تشويقٍ ومنحة مسبقة على العناية بهذه الأمانة ورعايتها. أجل، إن حبّنا لهذا الصغير ما هو إلا منحةٌ من الله الرحمن الرحيم لنا، وقد وُهب إلينا حتى لا نقصّر في تلك الأمانة التي أودعها الله عندنا.
و. أسوة حسنة
يجب أن نبتغي من وراء مشاعرنا وأفكارنا وأقوالنا وحياتنا القلبيّة وتصرّفاتنا مع أبنائنا أن نكون قدوةً لهم على الدوام. أجل، إن أردنا تربيتَهم على الوجه الأكمل فعلينا أن نراعي هذا الأمر بدقّة بالغة، فمثلًا إن أردنا أن نجعلهم يحافظون على صلواتهم فلا بدّ أن نؤديها أمام أنظارهم باهتمام بالغ حتى يروا خشيتنا لربّنا وأدبنا معه عز وجلّ، وإن كنا نرغب في أن يكونوا صادقين فلا بد أن يكون الصدق ديدَنَنا والكذب بمنأى عنّا، وإن أردنا منهم أن يعصموا ألسنتهم من الكلمات النابية فعلينا ألا نردّد هذه الكلمات داخل البيت، وألا نسمح لها أن تأخذ حيّزًا في ذاكرتهم، وإن كنا نودّ أن يكونوا أعزاء يعيشون بشرفٍ ويحافظون على عرض وشرف الآخرين كما يحافظون على عرضهم وشرفهم فلا بدّ أن يعايشوا هذا الوضع في البيت أوّلًا، وأن نكون لهم الأبطال الأوائل في هذا الأمر، وإن كنا نحبّ أن يقرؤوا القرآن ويتعرّفوا على حقائقه فلا بدّ أن نتذاكر القرآنَ صباح مساء في بيوتنا وهم يستمعون إلينا، وأن نحترم هذا الموقع السامي للقرآن الكريم حتى لا ندفعهم إلى التناقض في مشاعرهم.
والحاصل أن الأقوال والأحوال والتصرّفات والانفعالات القلبيّة هي أنجع أسس التعليم في البيت وأكثرها تأثيرًا، فلا بدّ من استغلالها، وإلا فإننا لو أحلنا أمر التربية والتعليم إلى الآخرين واكتفينا بذلك ما كان بمقدورنا فيما بعد أن نلقّن أولادنا شيئًا.
ز. إكساب الأطفال حبّ الله والعرفان بالجميل
كما هو معلوم فإن الطفل لا يقع عليه تكليفٌ حتى المرحلة الابتدائية، بل إلى مستوى أعلى من ذلك أحيانًا، ومن ثمّ فلا يُحاسب في هذه المرحلة على أخطائه في الصلاة والصوم وسائر التكاليف الشرعية، وليس لنا أن نعاتبه أو نعاقبه ألبتة.
ولكن علينا أن نعلم أن كلّ ما نلقّنه للطفل -في هذه المرحلة التي لم يُكلّف فيها بَعدُ- لا يغيب عن ذاكرته وذهنه وقلبه طوال عمره، ولذا كان من الأمور التي يجب التأكيد عليها بهذه الدرجة في تربية أطفالنا شعورُ العرفان بالجميل. أجل، من الأهمية بمكانٍ أن نُكسِبهم شعور العرفان بالجميل، فعليهم أن يتعرّفوا على النعم التي تُساق إليهم ويشكروا ربَّهم عليها ثم الناسَ، وقد يتعمّق هذا الشعور فيصبح الطفل دائمَ الثناء والحمدِ لله على ما وهبه من نِعَمٍ، كثيرَ الشكر للناس على إحسانهم إليه.
أجل، علينا أن ننمّي مشاعر الإحسان والعرفان بالجميل لدى أطفالنا، ونجعلهم كالصيارفة يعرفون قيمة الجواهر التي تصل إلى أيديهم؛ وبذلك نرسّخ في أذهانهم المعبودَ المطلق بكلّ تجلّيات جلاله وجماله، فيعترفون بالجميل للناس على إحسانهم له فيشكرونهم، وإن واجهتهم مصيبةٌ قالوا: “اللهُ المستعانُ”، بل قد تصير مسألة العرفان بالجميل مع الوقت سمةً من سماته، فيشكر الله طواعية وبلا تكلّف على كل نعمةٍ منه سبحانه وتعالى.
وثمة أمرٌ آخر يتعلّق بهذا الموضوع وهو أن نحدّث أبناءنا عن رأفة الله واهبِ النعم ورحمتِه، علينا أن نُجيّش شعورَ الثقة والحبّ لله لديهم بأن نقول لهم: “هو الرؤوف الرحيم، يحمينا ويقينا ويحفظنا من كلّ البلايا والمصائب”، بل ونحدّثهم بلغةٍ مناسبةٍ لمستواهم عن الرزق الذي يسوقه الله لأصغر المخلوقات حتى الحشرات شفقةً منه ورأفةً ورحمةً، وبذلك نرسّخ علاقة أبنائنا بربهم سبحانه وتعالى.
وبهذا يتجسّم الكون كله في ذهن الطفل قارئًا يتلو اسمي الرحمن الرحيم؛ فيشعر حينذاك أن هناك مالكًا لكلّ ما في بيتهم من نِعَمٍ، فتبدأ النفس التي ما زالت في عملية ارتقاءٍ تجيش بمشاعر الشكر لله على نعمه، ويصير البيت وكأنه آلةٌ تنسج الشكر، غير أنه لا بد من تلقينه كلَّ هذه الأمور بما يتوافق مع عمره، فمثلًا نقول له:
بإحسانه تهبنا شجرةُ الرمان رمانًا
وبرعايته تتدفّق أضرع الحيوانات ألبانًا
وتسقط قطرات المطر من السماء برحمته
وينبت العشب في الأرض برأفته
إن لم يشأ ما نطقنا
وإن لم يُرِنا ما رأينا
وإن لم يُسمِعنا ما سمعنا
وإن لم يشغّل غددنا ما سال لعابنا
ولو شاءَ لتوقّفت كليتانا وما عملت معدتنا
أجل يا ولدي، إنه مالك كل شيء
فالكلُّ منه، وتحت تصرُّفه ورعايته وليس لنا يدٌ في شيء
إذًا يا ولدي: هو الذي أسبغ علينا كلّ هذه النعم
وهيّأها لنا هكذا بعد أن أخرَجَنا من العدم
فإن امتلأت قلوبنا وجاشت بحبّه
زادنا من نعمه وآلائه بُقربه
ولكن إن جحدنا
قطع نعمه عنّا
أو سلب من يدنا إمكانية الاستفادة منها.
أجل، علينا أن نكون كالخطباء فنحاول أن نبلّغه كلّ هذا بسلوكياتنا وأقوالنا ونظراتنا المليئة بالحماسة.
ح. التعليم بلسان الحال
من أنجع الوسائل في التربية التعليمُ بلسان الحال، لا جدال في أن تنظيم الحياة في البيت بشكلٍ لائقٍ له أهميةٌ عظيمةٌ من حيث تلقيننا لأطفالنا.
فلو صادف قيامنا لصلاة التهجد الساعة التي يكون فيها الطفل متيقّظًا، فشاهَدَنا في هذه الظلمة واقفين أمام المولى المتعال نتقلّب ونتلوّى كالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فليس لكم أن تتصوّروا قدر الإلهامات التي تصل الطفل بلا وعيٍ منه بفعل نظراته المتلصّصة علينا، فلو سألكم عن هذا وقال لكم: ما هذا الانكسار، ولِمَ هذا البكاء وانفطار القلب من الحزن؟ فعليكم أن توضّحوا له أن هذا بسبب الخوف والقلق من الحرمان من نعمه والتعرّض لعذابه يوم يقوم الأشهاد، عليكم أن تعبّروا عن هذا التوقير الكبير لربكم سبحانه وتعالى بنظراتكم المملوءة حبًّا وأملًا، وبحالتكم القلقة المضطربة، ثم تؤكدون أنكم تحت عنايته وتصرّفه.
عليكم أن تُشعروهم بنمط هذه الحياة التي نظّمتموها لأنفسكم، وإن كنتم تحملون أبعادًا معنويّةً فحاولوا أن تُظهروها لهم، وإلّا فإنكم لو حاولتم أن تلقّنوهم أشياء ليست لكم ولا تتبوّأ مكانةً في أرواحكم، فلن يمكنكم أن تُشعروهم بالأمان أو تؤثّروا فيهم.
ولـمّا سُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خُلق الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قالت: “كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن، قول الله عز وجل: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (سُورَةُ القَلَمِ: 68/4)”[4].
ومن هذا الحديث يمكننا أن نفهم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لهذا الإنسان الكامل طرزُ حياةٍ ومعيشةٌ خاصةٌ القرآنُ الكريم يجلِّي عنها.
أجل، لقد نقل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا القرآنَ بعد أن عايشه وطبّقه في حياته، وكأن القرآنَ غدا حياته، والحياةَ قرآنه، ومن ثمّ وجدت كل أقواله وأفعاله صداها الطيّب في القلوب والأفئدة النقيّة الطاهرة، فتقبّلها الجميع، وأبدوا حسنَ قبولهم بها، وحاولوا أن يعايشوها.
ولذا لا بدّ ألا تتناقض تصرّفاتنا مع أقوالنا، فهذا ما نطلق عليه “النفاق العمليّ”؛ إذ إن ما رآه الأولاد فينا من اختلاف بين الظاهر والباطن يدفعهم إلى الرياء والنفاق، ويحدث عندهم نوعًا من الازدواجية، وبالتعبير القرآني يكونون ﴿مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: 4/143).
كلّما حدّثتم الطفل عن نعم الله سبحانه امتلأت نفسه بشعور الحمد والشكر لله تعالى، وعندها يقول: “إن ما تحدّثني عنه إنما هو الله الذي خلق الإنسان وسوّاه، وأسبغ عليه نعمه التي لا تحصى، وأمدّه بالصحة والعافية، ورزقه أبويه، وأرسل له موائد نعمه المختلفة كلّ يوم، إنه الله الذي خلق الهواء والماء والتراب والشجر وسخّرها لنا، فله مِنّا ألف ألف حمدٍ وثناء”.
فإنْ عملنا على تلقين الطفل هذه الأمور، وجعلنا أحاديثنا في البيت لا تخرج عن هذا الإطار طُبع كلُّ شيء بجمالٍ خاص.
ولا ريب أن الشفقة بالأطفال لها مكانةٌ خاصّة في التربية، فقد كان نبيّنا صلوات ربي وسلامه عليه يعاملهم بشفقةٍ لا يجدون نظيرَها عند أبويهم.
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: “خدمتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، والله ما قال لي أفًّا قط، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا؟ وهلّا فعلت كذا؟ “[5].
أجل، كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع خَدَمه بشفقةٍ تفوق شفقةَ ومعاملة الأب والأم، أما مع أبنائه وأحفاده فكان صلى الله عليه وسلّم رفيقًا شفوقًا ذا قلبٍ رقيقٍ حتى إنه لا يمكن لأحدٍ غيره أن يصل إلى هذا المستوى من الشفقة.
ط. الشفقة
إن كان الأطفالُ لا بدّ أن يخافوا من شيء فيجب أن يخافوا من أن يفقدوا شفقة أبويهم عليهم لا من العصا والتهديد والتعذيب، فإن أدرك الطفل أو شعر بأن عبوسَ أبيه وامتعاضَ أمه هما أعظم عقوبة؛ فهذا في ظنّي يكفي وزيادة، ومن الأهمية بمكانٍ أن يثق الطفل بكم، وأن يصدّق أنكم تشاركونه آلامه وأحزانه، اجلسوا معه عندما يبكي، وابكوا بصدقٍ لبكائه، وشاركوه على الأقل آلامه، وكما تبكي السماء ويهتز العرش على رحيل بعض الناس أظهِروا أنتم أيضًا تأثّركم بحالهم، وشاركوهم أحزانهم؛ وبذلك ترتقون إلى مرتبة أسمى في عيونهم، وكلّ ما تقولونه لهم وتحدّثونهم به سيؤثر فيهم وينفذ إلى قلوبهم فلا تستطيع أيّ قوةٍ أن تنزع مكانتكم منها، وكل ما تقولونه فيما بعد سيجد دومًا صداه في قلوبهم وضمائرهم.
أجل، لو فكرتم في تنشئة جيلٍ مثاليّ تنتظرون منه أن يمثّلكم في المستقبل على أكمل وجهٍ فلا سبيل إلى تحقيق هذه الغاية السامية إلا بهذه الطرق.
ي. الإدارة في البيت
يجب ألا يخلو البيت من الإدارة، فإن خلا من إدارةٍ تحفظ التناغم والتوازن فيه سادت هذا البيتَ الفوضى الإدارية، وما تمكّن الأطفال من التخلّص من الازدواجية.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: 4/34).
إن الرجل في البيت مسؤولٌ في أمور معيّنة عن حفظ النظام والتناغم في البيت، بل يمكن أن يُقال إنه المسؤول الأوّل عن أمورٍ كثيرة، وفي الواقع إن الطفل في حاجةٍ إلى مثل هذا الإنسان المسؤول، فالطفل الذي يشهد الشعور بالمسؤولية داخل البيت لن تسود حياتَه فوضى ولن يتخلّلها عبث، وإلا فإن وجود أبوين غير مسؤولين وتلقّي أوامر مختلفة من جهتين يشتّت أفكار الطفل.
فضلًا عن ذلك ينبغي للطفل عندما يخاف من أحد أبويه أن يلجأ إلى الآخر، فيجد مثلًا عند أبيه مخافةً ومهابةً وعند أمه شفقةً ورحمةً، والعكس صحيح، فبمثل هذه المشاركة والتعاون يعيش الأطفال بين خوفٍ ورجاء، ولن يشعروا بالوحدة قطعًا، فإن لم تقم الحياة الأسرية في البيت على هذه المشاركة والتعاون استمرّ النزاع والخلاف والتناقض، إذ ترى المرأة في نفسها أنها رئيسة البيت، ويرى الرجل أنه رئيس البيت، وعند ذلك ينشأ الأطفال غلاظ الطباع، متبلّدي المشاعر، غير أسوياء.
وقناعتي أن الأجيال المثالية تحتاج بدايةً إلى بيت مثالي. أجل، يجب أن يرتبط البيت بدايةً بالله تعالى، فإن تناول الوالدان أو أحدهما مسألة التربية بشكلٍ يليق بـ”خليفة الله” في الأرض أصبح أهل هذه الأسرة بفضل هذه الرابطة أعزّاءَ كرماء مسيطرين على زمام الأمور، فلا مجال حينئذٍ لوقوع المشاكل في مثل هذا البيت.
5- التخّلق بأخلاق الله
أ. آداب الحديث
إنّ أول ما نتناوله هنا هو مسألة التخلّق بأخلاق الله العالية، وإن أوّل ما يجب أن نركّز عليه في جميع تصرّفاتنا وأفكارنا؛ بل وعند لقائنا برفقاء حياتنا، وفي مجالسنا وعلاقاتنا المختلفة هو ما نأمل ترسيخه خلال الفترات اللاحقة في أذهان أولادنا.
لا بدّ أن نتحدّث في بيوتنا عن أمورنا الدنيوية، غير أن علينا أن نراعي وجود الأطفال بيننا عند الحديث حولَ هذه الأمور، والأفضل أن لا نتحدّث عندهم في الأمور التي لا تهمّهم ولا تمثّل فائدةً لهم، ونتجنّب مطلقًا الأمورَ التي تضيّق الخناق عليهم وتجعلهم في حالةٍ يُرثى لها.
أجل، علينا أن نحدّد جيّدًا الأمور التي تخضرّ وتنمو في قلب الطفل وروحه في فترةٍ معيّنة، وألا نعرّضه إلى ما لا طاقة له به ويفوق قدراته.
أجل، يجب أن نراعي وجود الطفل في أحاديثنا وحواراتنا في البيت وخارجه، ولتكن أحاديثنا عن الله تعالى والإيمان به ونعمه علينا وعن الدين… وأن يكون مبدؤنا هو التذاكر والتحاور حول الأمور التي نرجو أن يتمثّلوها فيما بعد؛ حتى ينشأ لديهم شعورٌ بأن هذه المسائل من الأمور الأساسية لدى الأبوين، فإن أخذ الأبوان هذه النصائح على أنها وصفة علاجية لانحلّ جزءٌ كبيرٌ من المشاكل التي سيواجهها الأولاد في المستقبل، وهذه المشاكل سنقف عندها لاحقًا إن شاء الله تعالى.
ب. التوازن في الرأفة والرحمة
ثمّة مسألةٌ أخرى ننوّه بها هنا وهي: مسألة تنمية مشاعر الرحمة والرأفة والشفقة لدى الأطفال، وتنشئتهم ليكونوا أبطالًا للرحمة، وإنّ أقصر طريق لتحقيق هذا الأمر هو لسان الحال، فمثلًا إن طرَقَ الباب صاحبُ حاجة فأسرع الأب أو الأم أو كلاهما إليه، فأعطياه ما يحملانه في أيديهما أو حجرهما وأقبلا عليه باهتمامٍ بالغٍ وأصغيا له إصغاءً كاملًا فهذا يُعتبر درسًا عمليًّا لتربية الطفل على الشفقة.
وقد يحصل الشعور بالشفقة لدى الأطفال بالفطرة، فمن الأطفال من هو رقيقُ القلب مغْرَوْرقُ العين، فهذا الحال علامة على أن هؤلاء سيصبحون من ذوي الحسّ والشعور والرقّة في المستقبل، والحقّ أن بعض الأطفال يتظاهرون بالبكاء لاسترعاء انتباه مَن حولهم فحسب أو لإرغامهم على تلبية رغباتهم؛ والفرقُ عظيمٌ بين هذا البكاء والبكاء النابع من الرقة الخالصة، فإن أردنا أن يكون أبناؤنا كرماءَ أرقّاء شفقاء فلا بدّ أن يفوح بيتنا برائحة الشفقة الزكية والرحمة واللِّين.
إنّ نشوء الطفل على البخل وحبّ الدنيا والتّعلق بالمادة يُعدّ من الأسباب الأولية لأن يصبح أنانيًّا انتهازيًّا معتديًا عاصيًا، وإذا لم نُرَبِّ أولادَنا على التخلّق بأخلاق الله تعالى فما أتعسهم من حيث حياتهم الدنيوية وحياتهم الأخروية الأبدية.
أجل، إن الرحمة والشفقة مسألتان مهمتان جدًّا، والسخاء والمروءة مظهرٌ لهذه الحالة الروحيّة، فأبطال الشفقة في مغنمٍ دائمٍ، وغلاظ القلوب في خسرانٍ مبين، فالكريم قد يفوز بالجنة وإن كان فاسقًا، أما فوز البخيل بالجنة فالاحتمال فيه ضعيفٌ وإن كان مؤمنًا، ولذا يجب أن ننمِّي شعور الشفقة والرحمة لدى أبنائنا، ونزيد من شعور الإنفاق والإحسان عندهم؛ حتى لا يسيطر الطمع عليهم، ولا يغرقون في ملذّات الدنيا؛ فينسوا الله تعالى.
أجل، علِّم طفلك الإنفاق حتى لا يكون ماديًا، وحتى ترتبط حياته الروحية والقلبية والشخصية بالله تعالى، لكن لا بدّ أن ننبّه مرة أخرى على أن شعور الإنفاق إن لم يبرز بالفعل مع التدعيم بالقول فلا يكون لهذا أثرٌ في الطفل، فإن طبقنا هذا الشعور بأفعالنا فلا بدّ وأن تؤثّر أقوالنا فيهم وكأنها أنفاس الملائكة.
ج. المكافأة
ثمة مسألة أخرى وهي مكافأة الأطفال على قدرِ نجاحهم، وقد تعمدتُ استخدام كلمة “على قدر نجاحهم” هنا؛ لأنّ قدر المكافأة يجب أن يكون على قدر هذا النجاح صغُر أم كبُر، فإن تحقق هذا فقد رسّخنا شعور العدل لدى الطفل، وهذا يتوافق مع القاعدة القرآنية: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى $ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ (سُورَةُ النَّجْمِ: 53/39-40).
أجل، إنّ مِن متطلبات الأخلاق الإلهية المكافأة على النجاح سواء في الأمور المتعلقة بالحياة الدينية أو الدنيوية؛ المشروعة منها بالطبع.
وعلى ذلك نقول: إن الآباء والأمهات لهم دور مفكّر وحكيم ومربٍّ -ولو بقدر ما-؛ فلْيتفكروا في تربية أولادهم وليتدبّروا حتى يراعوهم حق رعايتهم.
أجل، لو لمْ يهتمّ الأبوان بأولادهما اهتمامهما بسيارتهما وبستانهما وحديقتهما؛ فبدهيٌّ أن تتبلّد مشاعر الأولاد وأفكارهم فلا تنمو أو ترتقي.
ولا بد من الرجوع إلى المنهل الأساس في كل من مسألة الرأفة والشفقة، والعرفان بالجميل، والانقياد والإذعان لله تعالى على نعمه، وفي مسألة التصرف في شؤون الطفل كلها نيابةً عن مالكهم الحقيقيّ، وهذا المنهل هو أخلاق الله تعالى، فالله تعالى يُثيب مَن يعملون الصالحات بالجنة في الآخرة على أعمالهم، ويجازي مَن يعملون السوء بالنار على ما اقترفت أيديهم.
والقرآن الكريم يقول: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ: 14/7)، إن التخلّق بأخلاق الله يقتضي أن نكون معتدلين في مواقفنا وتصرفاتنا مع أطفالنا؛ حتى لا يكلنا الله إلى أنفسنا.
د. تهيئة الطفل للمستقبل
وهناك مسألة أرى من الفائدة ذكرها في النهاية ألا وهي: الأخذ بعين الاعتبار الوسط الذي ينشأ فيه الأطفال، ومراعاة فئاتهم العمرية ومستوياتهم وأوضاعهم العلمية والثقافية، فإنْ كان الطفل في الخامسة من عمره فلا بدّ أن نتدرّج في تلقين المعلومات له مثل الأسلوب الذي نتبعه في منهج التغذية تمامًا، إذ يجب أن تكون المعلومات التي نلقّنها له في سنّ السابعة غيرَ تلك المعلومات التي نقدّمها له في سنّ العاشرة.
غير أن هناك مسألة أخرى مهمّة وهي: أن يكون ما نلقّنه للطفل يخاطب من ناحيةٍ المرحلةَ التاليةَ من مراحل حياته؛ لأنه يرى ويشعر ويعيش زمنَه على كلّ حال؛ ومن ثمّ فقد يكون كافيًا ما يتعلمه من بيئته أو معلّمه على قدر مستواه، ولكن لا بدّ أن تكون تربيتُنا له مراعيةً المراحلَ التي سيعيشها فيما بعد.
هناك مقولة يعزوها بعضُهم إلى سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: “لا تُكرِهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم”، فإن تناولنا هذا المبدأ من حيث المعرفة والثقافة العامة سنجد أنه من قصور الهمّة أن نكتفي بالثقافة والمعلومات الحالية؛ لأن هذا يعني سبق الآخرين لكم وتفوّقهم عليكم بمرور الزمن، وإن تناولناه من حيث التربية والتعليم فهذا ييسِّر الطفلَ لتجاوُزِ الزمن الذي يعيشه، ورعايتِه الفترةَ القادمة من عمره، واتّباعِ منهجٍ معيّن يتوافق معه.
أجل، يجب أن يتربّى طفلُ السادسة على مستوى تربية طفل السابعة، فإن بلغ السابعة يُطبّق عليه البرنامج التربوي لطفلٍ في الثامنة وهكذا.
والخلاصة أننا لا بدّ وأن نتدرج في تعليمنا لأبنائنا حتى سنّ الخامسة عشر الذي يعدّ متوسّطًا لسنّ البلوغ، وأن تتناسب التربية مع عمر الطفل ومستواه لا محالة؛ حتى يمكنه أن يستسيغ ويتقبّل ما يُلقى إليه، فلا يليق أن يزوّد الشاب الذي بلغ العشرين من عمره بتربيةٍ دينيّة تتناسب مع تربية طفلٍ في الخامسة عشر، وإلا نكون قد أفسدنا كلّ ما يعرفه الطفل عن الدين والإيمان والأخلاق، فكما يتطلب الجسد على كلّ المستويات رزقًا وغذاءً خاصًّا فكذلك اللطائف الإلهية مثل الفكر والعقل والحسّ والشعور والإدراك والقلب تتطلّب تغذيةً معيّنةً بقدر انكشافاتها.
وإنكم إن حاولتم تلقين شيءٍ لمخاطبٍ أُنيط بكم مسؤولية تربيته دون أن تراعوا مستواه الاجتماعي والفكريّ والعقليّ فقد أبعدتموه عنكم شعوريًّا، فإن كان بعض الشباب ما زالت مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم تحتفظ بسلامتها حتى اليوم؛ فهذا يرجع إلى عناية الله وفضله عليهم، أو أنهم لم يتطوّروا بعدُ فكريًّا؛ فرغم أنهم في الخامسة والعشرين من عمرهم إلا أنهم متخلّفون كثيرًا عن ركب عصرهم كما لو أنهم في العاشرة أو الخامسة عشر من عمرهم، ومثل هذا الشخص إن قابلَتْه يومًا أيُّ نظريةٍ مختلفةٍ دينيًّا وقوميًّا واجتماعيًّا تتجاوز مستواه فلا مناص من تزعزُعِ قِيَمِهِ الذاتيّة وربّما يرتدّ عن دينه والعياذ بالله.
ولقد أوصانا ديننا ببعض الوصايا حتى تتلاءم التربية والتوجيه مع مستوى المخاطب وعمره، أو الدفع بمستواه إلى الأمام قليلًا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ”[6]، إن الدين يفترض على الطفل الصلاةَ وهو في الخامسة عشر من عمره ويقول لنا: عوِّدوه على الصلاة وهو في السابعة أو العاشرة من عمره، وهذا يعني أنه لا بد أن نعوّدوهم على الصوم أيضًا قبل أن تأتي مرحلة التكليف، ويمكن أن نسير على نفس المنوال في باقي المسائل؛ وهذا يعني ضرورة معالجة الطفل في سنٍّ مبكّرة وتشكيله على حسب عمره.
وهنا أودّ أن أبيّن أننا وإنْ كنا قد استخدمنا جملًا قاطعة الدلالة في الأحكام والقيم فهذا يرجع إلى أننا ننظر إلى الأمر من منظور الكتاب والسنة، وأن هذا منوطٌ -على الأقل- بظنّنا القويّ في هذا الاتجاه.
إنّنا على يقينٍ من أن تلقين الطفل ما نريد وهو ما زال في سنّ صغيرةٍ سيكون له بالغ الأثر في نفسه، وقناعتنا أننا إنْ أردنا أن يؤدّي الطفلُ ما عليه من فرائض دينيّةٍ في المستقبل فلا بدّ أن يبدأ هذا الأمر وهو في سنٍّ مبكرة، وقد شاهدنا ثمارًا طيبة لهذا الأسلوب طوال حياتنا.
وهنا أريد أن أورد قولًا يُذكر أن قائله الإمام جعفر الصادق يتحدث عن المراحل العمرية: “دَع ابنَك يلعب سبع سنين، ويؤدّب سبعًا وأَلزِمه نفسَك سبع سنين، فإن فلح وإلا فلا خير فيه”[7].
أي إن مرحلة الطفولة تمتدّ حتى السابعة، وفيها يقلّد الطفل ما يراه، ويشتغل باللهو واللعب، بل إنكم إن لعبتم معه لعب معكم وتعلم ما يراه منكم وقلّدكم، وكأنّ حياته حتى هذه السن لعب وتقليد، ثم تأتي مرحلة التلقين بما يتوافق مع عمره ومستوى إدراكه، وفي هذه المرحلة يخضع الطفل باستمرار لعملية نقاهة تتناسب مع أفق إدراكه ومستوى فهمه، ويتمّ تشويقه فيها إلى قيمنا الدينيّة والمعنويّة، وهذه الفترة هي فترة تعليمه كتاب الله تعالى، وتتطلّب وقتًا مثل سابِقَتِها، وبعد ذلك تأتي مرحلة التعريف بالحلال والحرام عن طريق العقل والمنطق والمحاكمة العقلية، وتستغرق هذه المرحلة نفس الزمن الذي استغرقته المرحلتان السابقتان.
وحسب هذا التقدير في التربية لا بدّ أن يُتمّ الطفل تشكّله الاجتماعيّ والدينيّ بأكمله في سنّ الواحدة والعشرين، وهذا يعني أنه من الصعب أن يتقبّل ما يُقال له بعد هذه السنّ، وهذا يدعونا إلى أن نجعله حتى سن الواحدة والعشرين يتقبّل كلّ القيم الدينية والأخلاقية بشكلٍ لا يستطيع أن يرفضه.
لا بدّ أن يستوعب الطفل حتى هذه السن الحياةَ الدينية بأكملها بعقله ومنطقه ومعايشته النظرية والعملية؛ حتى لا تزعزعه الرياح المعاكسة المختلفة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الترمذي وأبو داود: “عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ”[8].
أجل، إن الطفل حتى تلك السن يكون قد استوعب كلّ ما تفعلونه بدافعٍ من تطلّعه وحبّ استطلاعه، غير أن ما يبقى عليكم بعد أن تمسكوا بيده وتبيّنوا له ما استوعبه بسبب تطلعه هو التنبيه أحيانًا والترغيب والتشويق أحيانًا أخرى، فإذا كان الشرح بلسان الحال هو الأساس حتى سنٍّ معينة فلا بدّ أن يكون ذلك الشرح فيما بعد هذه المرحلة متوافقًا مع منطقه ومستواه الفكري.
وفي ضوء الأدلة التي عرضناها سلفًا يتبين لنا أنه من الضرورة بمكانٍ عند الحديث عن الله تعالى المعبود المطلق أن نعامل الطفل كإنسانٍ كبير ونسعى إلى تعزيزه وتنزيله منزلة الكبار وهو ما زال في السادسة من عمره أو الثامنة أو العاشرة على الأكثر، بل ونوضّح له كلّ شيء بعزمٍ نبوي، وإن الجهود المبذولة في مسألة التدريب على العبادة تتطلّب الجدّية نفسها.
يقول صلى الله عليه وسلم: “اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ”[9]، ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: “إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ فِي قَرْنٍ، فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ”[10]، ومن ثَمّ يجب أن نركّز بكثرةٍ على الأجيال التي نرغب في تنشئتها على الحياء والأدب وهم ما زالوا صغارًا، ليتسنى لهم التحلّي بتلك الخصال والتخلُّق بأخلاق القرآن إذا ما بلغوا.
[1] سنن أبي داود: الملاحم، 5؛ مسند الإمام أحمد، 37/82.
[2] عبد الله بن مبارك: الزهد والرقائق، 484؛ أبو يعلى: المسند، 11/304.
[3] البيهقي: شعب الإيمان، 6/398.
[4] صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 139؛ سنن أبي داود، التطوع، 26؛ مسند الإمام أحمد، 41/148.
[5] صحيح مسلم، الفضائل، 51.
[6] سنن أبي داود، الصلاة، 26؛ سنن الترمذي، الصلاة، 182؛ مسند الإمام أحمد، 11/369.
[7] الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص 222.
[8] سنن الترمذي، الصلاة، 182؛ سنن أبي داود، الصلاة، 26.
[9] صحيح البخاري، الإيمان، 3؛ صحيح مسلم، الإيمان، 57، 58.
[10] الطبراني: المعجم الأوسط، 8/174؛ البيهقي: شعب الإيمان، 1/165.