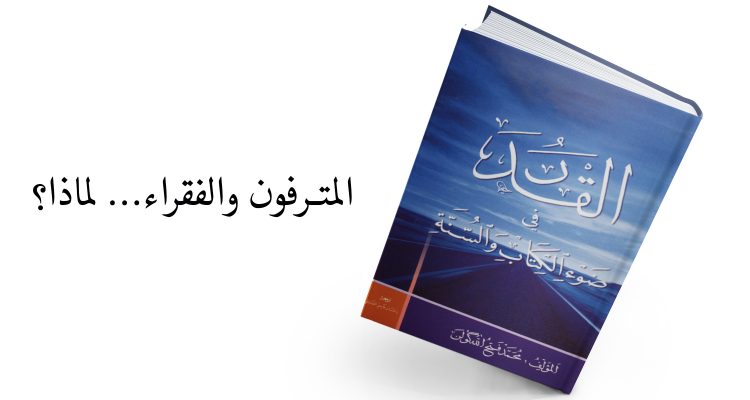السؤال: نشاهد أن الله قد أعطى الكثيرين الأموال الطائلة والسيارات الفارهة والقصور الفخمة والشرف الرفيع والصيت الذائع… بينما الآخرون يتضورون جوعًا وتصيبهم آلام وبلايا ومصائب وفقر وعلل. فيا ترى هل هؤلاء فاسدون والآخرون يحبهم الله حتى أغدق عليهم ما أغدق، بينما هؤلاء ينسحقون تحت وطأة أعباء الحياة؟
الجواب: هذا النمط من السؤال لا يُسأل إلاّ للتعلم فحسب. وإلاّ وإلا فإن السائل يكون آثماً. والحقيقة أن الذي يعاني مثل هذه المعاناة يلزمه هذا السؤال.
نعم، إن الله يعطي لمن يشاء العمارات والسيارات والخيول المسومة والأنعام والحرث… ولمن يشاء الفقر والضرورة والحاجة. وينبغي في كل هذا عدم إنكار دور الأسباب الآتية من الأسرة والبيئة المحيطة بالفرد. فمثلاً كما لا يمكن إنكار دراية شخص في كسبه المال، لا يمكن إنكار كون علمه بطرق الكسب وفق ظروفه المحيطة سبباً لكسبه. علاوة على ذلك فإن الله في الوقت الذي أظهر أهلية بعضهم، لم يعطهم المال والأولاد. ومع هذا فقد ورد في حديث ذي مغزى عميق يخص موضوعنا: «عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله: إن الله قسَم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإنّ الله عز وجل يعطي الدنيا من يحبُّ ومَن لا يحبّ ولا يُعطي الدِّين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدِّين فقد أحبَّه».( )
ومن ناحية أخرى لا ينبغي أن تعدّ الأموال خيراً. نعم، إن الله إذا شاء يؤتي أحياناً البعض الأموال والأولاد وأحياناً لا يؤتيهم. فالخير وارد في كلا الحالتين. لأنك إن كنت صالحاً واستعملت ما آتاك الله من مال في صالح الأعمال فإنه يكون لك خيراً، وإن كنت طالحاً وضالاًّ عن الصراط السوي فإعطاء الله لك ليس خيراً.
نعم، إن لم تكن لك استقامة على الطريق فالفقر يكون لك باباً للكفر. لأنه يسوقك إلى عصيان الله، ويوماً بعد يوم تزيد عصياناً لله. كذلك إن لم تكن على الصراط السوي ولم تكن لك حياة قلبية وروحية يكون غناك وَبالاً عليك وبلاء. قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾(الأنفال: 28). ولقد خسر الكثيرون في هذا الامتحان. إذ هناك الكثيرون جداً ممن غرقوا في الثروات الطائلة وليس في قلوبهم بصيص من نور بسبب كفرانهم النعم. لذا فإن إتيان الله الأموال لمثل هؤلاء إنما هو استدراج ووسيلة لإضلالهم. وهم يستحقون هذه النتيجة لأنهم أماتوا حياتهم القلبية والروحية وأفسدوا قابلياتهم التي وهبهم الله.
ولعل الحديث الشريف الآتي يوضح الأمر أكثر: «كم مِن أشْعثَ أغْبَر ذي طِمْرَيْن (صاحب ثوبين خلقين) لا يُؤْبَه له لو أقسم على الله لأَبَرّه، منهم البراءُ بن مالكٍ».( ) علماً أن البراء بن مالك أخا أنَس بن مالك ما كان له طعام يأكله ولا مَسكن يأوي إليه. فكان يعيش على ما يسد الرمق. ولربما هناك الكثيرون ممن يشبه البراء أشعث أغبر لكن الله نظر إلى قلوبهم العظيمة وأرواحهم الواسعة ومنَحهم هذه المنـزلة، فكما ورد على لسان الرسول لو أقسم على الله لأبرّه.
ولهذا فليس الغنى وحده ولا الفقر وحده مصيبة، وإنما كلٌّ حسب موقعه. الفقر في موضعٍ والغنى في موضع يعدّان نعمة إلهية. والرسول قد اختار الفقر بإرادته وقال «أما تَرْضَى أنْ تكون لهم الدنيا ولنا الأخرةُ».( ) ونرى أن سيدنا عمر في الوقت الذي وردت إليه خزائن الدنيا يكتفي بالكفاف من العيش ويرفض الزيادة عليه.
ولكن هناك فقر يكاد يكون كفراً -والعياذ بالله- فمثلاً: إن لم يكن السؤال صادراً من شخص مؤمن، بل من شخص كافر بالنعم، فهذا الشخص الذي يشكو من نعم الله يكون كافراً.
بمعنى أن الفقر نعمة في موضعه، والغنى نعمة في موضعه. والأصل في المسألة وجود المصدّق في القلب.
يا ربي! جميل ما يأتي منك،
يعجبني كل ما يأتي منك
سواء أكانت خلعة أو كفناً،
وَرْدة مفتحة كانت أو شوكة،
فلطفك جميل وقهرك جميل..
وكما يردّدون في شرقي الأناضول: كل ما يأتي منك جميل.
نعم، إن الإنسان لو كان في بحر من الغنى، وكان مع الله سبحانه فسيكون كالشيخ عبد القادر الكيلاني الذي قدمه على أكتاف الأولياء وقدم رسول الله r على كتفه. ولكن إن كان مقطوع الصلة مع الله فقد خسر ذلك الفقيرُ الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وكذا الغني الذي لا صلة له مع الله سيكون مصيره الخسران وإن كان يرفل بالسعادة ظاهراً.