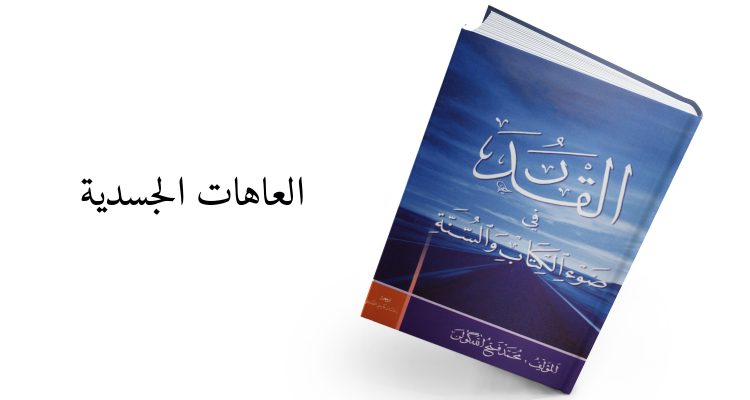السؤال: لِمَ لم يخلق الله تعالى عباده متساوين؟ فقد خلق بعضهم أعمى وآخر أعرج؟
الجواب: نجيب عن هذا السؤال قائلين:
- إن الله مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يتدخل أحد في إجراءاته قط. فالذي خلق ذرات جسمك ونظم تركيب أجزاء جسمك هو الله، والذي وهب لك الإنسانية هو الله أيضاً. إنك لم تعطِ شيئاً مقابل هذا كي تدّعي أن لك حقاً عليه. فلو كنت قد أعطيت شيئاً مقدماً فلربما كان لك الحق في السؤال: “لا تعطني عيناً واحدة بل عينين، ولا يداً واحدة بل يدين” وأمثالها من الطلب والإعتراض. فأنت لم تعطه شيئاً حتى تُسند إليه الظلم (حاشاه). إن الظلم نابع من عدم الإيفاء بحق، فأين حقك عليه الذي لم تستوفه منه، حتى تدّعى وقوع الظلم عليك.
إن الله أوجدك من العدم، ثم جعلك إنساناً، فلو تدبرت قليلاً فإن دونك كثير جداً جداً من المخلوقات. عند ذلك تجد نفسك قد نلت الكثير من النعم.
- إن الله سبحانه قد يأخذ رِجْل إنسان ولكنه يعوّضه عنها في الآخرة بأشياء كثيرة، إذ يُشعر ذلك الإنسان بأخذه ذلك الجزء منه بعجزه وضعفه وفقره ويحوّل قلبه نحوه. ولئن جَعل قلب ذلك الإنسان يشرع بالانشراح والانكشاف فلقد أَعطى له الكثير وأخذ منه القليل. فهذا يعني في الحقيقة لطف الله سبحانه بذلك الإنسان وإن كان لا يبدو كذلك. كما يرزق أحدهم الشهادة ويدخله الجنة، ويحظى بالحضور الإلهي، وهي مرتبة يغبطه عليها الصدّيقون والصالحون، حتى يقول من يراه “يا ليتنا نفوز بالشهادة مثله”. فإنسان كهذا الذي نال الشهادة لو قُطّع إرباً إرباً لما عدّ أنه فقد الكثير، إذ الذي ناله أكبر بكثير مما أعطاه.
ونادر جداً أن ينحرف بعض الذين فقدوا بعض أجزائهم إلى الشعور بالنقص والاعتراض والسخط والتشاؤم، فالكثيرون منهم أصبحت هذه النقائص وسيلة لدفعهم إلى التوجه إلى الله.. فالأصل في المسألة تنبيه روح الشوق إلى الآخرة في الناس الذين هم مخلوقون أصلاً لها.
فإن هذه العوارض تدفع صاحبها إلى الله. والآخرون يتعظون بها وتورثهم الثقة والاطمئنان بالله وعندها يحصل المقصود المتسم بالحكمة.
إن الإنسان والحيوان والنبات وجميع الموجودات لا تظهر إلى الوجود إلاّ بقدرة نافذة فيها. فتوفى مهمتها بعرْض نفسها كالمرايا لتلك القدرة، ثم تنسحب من مسرح الوجود ليحلّ غيرها محلها.
وجميع المواليد وجميع الوفيات في هذا العالم إنما هي مواضع لإجراء الامتحان. فكما أن وجود أي شيء كان دليل على موجدٍ وراء الستار، كذلك وفاة كل شيء وانتهاء وظيفته دليل على أبدية ذلك الموجد الذي وراء الستار الذي لا أول له ولا آخِر. فكما أننا والموجودات كلها ظهرنا إلى الوجود من العدم ومن “لا شيء”. وندل بوجودنا على وجود موجِد، وببصرنا وسمعنا وعلْمنا على واحد بصير سميع عليم؛ كذلك بتركنا -عند الوفاة- كل ما حملناه أمانةً على امتداد الحياة ندل على “الواحد الفرد”. فـ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾(الملك:2).
إن أهم شيء بالنسبة للإنسان إدراكه سر المجيء إلى الدنيا واجتيازه امتحان الوجود، والتهيؤ إلى الرحيل.
والآن بعد هذا التمهيد نتناول موضوع: هل آجال الذين يتوفون في آن واحد قد أتاهم معاً؟
نعم، إن أجل جميعهم قد أتاهم معاً. وليس هناك مانع قط في خلاف هذا الأمر. فكما أن الله القابض على الوجود كله يوجد كل شيء وكل الناس معاً وفق قدره بدءاً من الذرات إلى المجرات، فإنه قادر على أن يُميتهم كلهم معاً. وإن وجودهم في أماكن متعددة وبالكَيفيات المتنوعة واتصافهم بالأوصاف المختلفة لا يُشكّل مانعاً من ذلك.
لا شك أن إيراد مثال، يعكس تماماً القدرة المطلقة صعب جداً. ولكن يمكن إعطاء أمثلة كثيرة من الأشياء التي يمكن أن تكون مرايا لتلك القدرة فتنور الفكر.
فمثلاً: إن الموجودات المختلفة في الأوصاف والكيفيات المتوجهة للشمس، تمضي حياتها متوجهة إليها دون أن تسبب ما يكدر الحياة، فتأخذ أجمل الحالات تحت ضيائها متحولة من لون إلى آخر، وتنمو وتترعرع بشروقها وغروبها. ثم تنطفئ وترحل. كذلك الحال في كل شيء يتلقح في الربيع وينتشر في الصيف، ويزداد نمواً ثم يصفر في الخريف ويذبل، ولكن لكلٍّ قدرُه. فكلها يظهر وجوده حسب الطريق الذي يخططه له العلم المطلق ووفق خططه وتصاميمه وبتوجيه الإرادة المطلقة والمشيئة المطلقة، لا كيفما اتفق ولا بحسب رغبة الموجود، بل حسب ما تريده تلك المشيئة والإرادة ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾(الأنعام: 59).
فلئن كانت حياة الأشجار والأعشاب والبذور والنوى وموتها ونموها وثمراتها تراقب مراقبة جادة إلى هذه الدرجة، فهل يمكن أن يُترك الإنسان سدىً وهو أكمل الموجودات؟ إن مالك الملك الذي لا يشغله سمعٌ عن سمع ولا رؤية عن رؤية لا شك أنه يهتم بالإنسان الذي هو أعز مخلوق وأبدع صنعة لديه سبحانه، وينعم على كل فرد منه ما ينعم على نوع المخلوقات الأخرى وجنسها. ويرعى الإنسان الذي هو فهرس العوالم بشكل خاص. ويتفضل عليه من أفضاله وإحساناته الخاصة ما يتفضل، وسيشرّفه بحضوره بسَوقه الخاص.
هذه الدعوة والسَّوق الإلهي قد يكون أحياناً على فراش، وأحياناً في ساحة الحرب، وأحياناً بآفة ومصيبة، حتى قد تكون فرادى وأحياناً مجتمعة. فهذه الأمور لا تؤثر في النتيجة من حيث زاوية نظر الخالق إلى الإنسان. إن العليم المطلق والقدير المطلق، والقابض على أنفاس كل كائن حي وزمام كل إنسان ويرسله متى شاء.. هذا القدير العليم، قبضُه للأرواح وفق ما كتب عنده -سواء كان فرداً معيناً أو جماعة- أمر منطقي ومعقول جداً، وإن هذا شبيه بموعد تسريح فوج من الجيش بأمر من القائد العام، ذلك الموعد الذي كان محدداً مسبقاً.
فضلاً عن ذلك فإن هناك ملائكة كثيرين جداً مكلفون بقبض الأرواح، يمكنهم أن يقبضوا الأرواح في آن واحد في الأماكن التي انتشرت فيها الآفات، بتقدير وإشراف مالكهم الكريم سبحانه، بل ربما هناك عدد من الملائكة يمكنهم أن يقابلوا كل شخص متوفى ويستقبلوه وفق ما بين أيديهم من الكتاب.
في مثل هذه الآفات والمصائب -إذا ما لوحظ بدقة- لا يمكن للإنسان ألاّ يشاهد التقدير المسبق ومجيء أجَل المتوفين معاً. وربما نحتاج إلى مجلدات لتسجيل جميع الحوادث الخارقة والعجيبة في هذا الشأن. فضلاً عن أن المسجَّل منها والمكتوب كثير إلى حد يتجاوز المجلدات. فلا يغادر يوم إلاّ ونطّلع في المطبوعات على بضع من هذه الحوادث الخارقة.
مثلاً: أن الزلزال الرهيب الذي يجعل عالي المدن سافلها، في الوقت الذي لا يمكن إنقاذ أُلوف من الناس رغم ما يُبذل من جهود مضنية، إذا بمئات من الأطفال العاجزين حتى عن الحفاظ على أنفسهم، يعثر عليهم تحت الأرض وهم في راحة دون أن يمسهم أي ضرر. أو تدحرج عربة إلى قناة الماء ويتوفى جميع مَن فيها من العمال، وإذا بمسافات بعيدة عن الحادث يعثر على طفل في القماط فوق الماء لم يصبه أي أذى. وكذا في حادثة سقوط طائرة يحترق كل من فيها بما فيها الملاحون الماهرون جداً، وعلى بُعد مئتي متر من الحادث يُعثر على طفل محبوب لم يصبه أذى… وأمثالها من الحوادث تثبت أن الحياة والموت ليس حبلهما على غاربهما، بل يحدثان بتدبير مَن هو عليم بصير مدبّر.
إن كل مخلوق يأتي إلى الحياة فرداً فرداً أو مجموعة مجموعة، بعد أن ينهوا أعمالهم التي كُلّفوا بها والمسجلة في سجل أعمالهم الأساس وذلك بمجيء آجالهم، وبعد أن أدّوا مهام فطرتهم وفهْم دقائقها وأسرارها وكشفوا عما وراء الطبيعة من خفايا وأصبحوا مرايا لتجليات من أرسلَنا جميعاً وهو الله سبحانه.. أقول بعد أن أكملوا عمرهم يسرّحون فرداً فرداً أو مجموعة مجموعة.
إن هذا العلم بإتيان المخلوقات ثم تسريحهم من أعمالهم، أي إنهاء وظائفهم وإتيان آجالهم في آن واحد، أمر هيّن جداً على الله العليم بكل شيء من بدايته إلى ختامه، فضلاً عن أننا نعلم أن الذي يعلم الجهر وأخفى له عدد غفير من الملائكة حول كل إنسان وعدد كثير من الملائكة لقبض الأرواح.
وربما يرد هنا اعتراض على هذه الصورة:
“إن في مثل هذه المصائب يذهب كثير من الأبرياء بجنب الذين يستحقون البلاء فهل توضحون الأمر لنا؟”
فنبادر إلى القول: إن هذا السؤال نابع من خطأ في العقيدة والتصور الإيماني. إذ لو كانت الحياة مجرد هذه الحياة الدنيوية ولا توجد آخرة وليس للإنسان إلاّ هذه الدنيا، ربما كان لهذا الاعتراض ما يبرره بوجود وجه صواب فيه. بينما هذه الدنيا للإنسان ليست إلاّ مَزرعة، وساحة عمل، وصالون انتظار. أما الآخرة فهي البيْدر وموضع الحصاد وأخذ الثمرات ومكان لبلوغ السعادات والنجاة من إزعاجات الدنيا. ولهذا فلا غرابة قطعاً في موت الطيب والخبيث والبريء والمجرم معاً. بل إن جريان الأمر هكذا هو الموافق للعقل والمنطق. لأن كل إنسان سينال في البعث وجوداً جديداً حسب نياته وأطواره ويعامل وفقهما. فإما حياة سعيدة خالدة أو شقاء دائم.
حاصل الكلام: إن الموت والأجل عبارة عن انتهاء مدة البقاء والعمل في هذه الدنيا. فمثل هذه المدة ما هي إلاّ ما أعدّه البصير العليم من خطة مرسومة مسبقاً ومسجلة في السجلات الأساسية، وتنفذ في الوقت المحدد بأمره سبحانه أيضاً. ولا فرق منطقياً في هذا إن كان فرداً أو مجموعة.
وأعتقد أن السبب الأول للانحراف -كما هو هنا وفي كثير من المسائل- هو الجهل بالعلم الإلهي المطلق وبقدرته غير المحدودة. وسبب آخر أيضاً هو الخطأ في زاوية النظر إلى الأشياء والحوادث. فإن لم نتمكن من الانسلاخ من مفاهيم الطبيعة والمصادفة، ولم نرقَ وجداناً إلى التجرد، فإن باطننا سيمتلئ بالمفاهيم الزائفة ويغدو ميداناً لصراع الوساوس الشيطانية، في أثناء مواجهتنا للأحداث الجارية. وفضلاً عن ضعف عالمنا الروحي، وعدم تغذيته الغذاء اللازم، يُجرّع كؤوس الشبهات التي لا سند لها يومياً، وتلك مصيبة رهيبة جداً لا تؤدي إلى انحراف النسل الآتي فحسب، بل حتى أنّ حفاظهم على استقامتهم حالياً أمر عجيب.