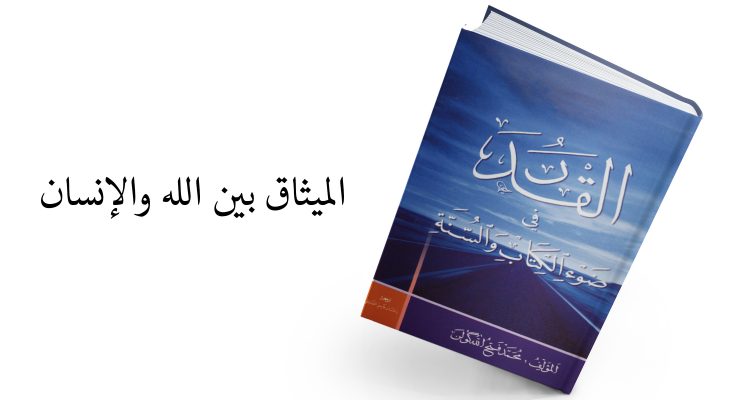السؤال: ما المقصود من :﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾(الأعراف: 172)؟
الجواب: هذه الكلمات هي جزء من العهد والميثاق الذي أخذه الخالق من المخلوقات ولاسيما الإنسان، حيث جاء الجواب ﴿بَلَى﴾ مقابل السؤال ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾
لهذه المسألة جهتان:
- لمن وُجّه هذا السؤال، وكيف سُئل؟
- متى سُئل؟
يمكن عرض الملاحظات الآتية حول الشق الأول:
أ- هو سؤال وجواب أو عقْد بـ”ماهية تكوينية”، أُخذ من الإنسان ولم يك شيئاً مذكوراً، وأجابه بـ﴿بَلَى﴾ تجاه الأمر بالخروج إلى ساحة “الوجود”.
ب- لمّا كان الإنسان في عالم الذرات، بل في عالم جزئيات الذرات، ساق رب العالمين -الذي يسوق كل شيء نحو الكمال- هذه الذرات مشوقاً إياها لتصبح إنساناً، وهو أخذ الميثاق والعهد، أي تحميل ذرة ما يفوق طاقتها بكثير، أي قول “بلى” تجاه الإيجاد الذي يترتب عليه التكليف من رب العالمين.
إن هذين الشكلين من “السؤال والجواب” أو “التكليف والقبول” كأنه لم يجر على شكل كلام ومحاورة، وعليه نظر قسْم من المفسرين إلى هذه المحاورة على أنها من قبيل “الاستعارة التمثيلية”. أي كأنه قيل كذا وأجيب عنه بكذا، فأخذت المحاورة قيمتها الحقوقية، وإلاّ فهو ليس عقداً موثقاً بالكتابة أو بالبيان الواضح.
وفي الحقيقة أن الانتهاء إلى هذا الحكم مع عدم النظر إلى فهرس “الخطاب والجواب” لرب العالمين الذي يملك ألف ألف نوع من الخطاب وألف ألف نوع من الجواب، لا يسلم من الخطأ قطعاً. وسنتناول هذا في موضعه.
ج- إن هذا النوع من طلب الإقرار وأخذ الميثاق بالشهادة، هو معرفة الإنسان بنفسه، وإدراكه أن فيه (الشاهد والمشهود عليه) هو نفسه لا غيره. فهو معرفة للنفس وهو تمثيل لحقيقة “من عرف نفسه فقد عرف ربه”( ) بوضع مرآة الماهية أمام الأنظار، وبهذا يكون شاهداً على ما ينعكس على شعوره مِن شَهْد الحقائق المتنوعة، ومن ثَمَّ إعلان هذه الشهادة. علماً أن هذا الإيجاب والقبول والتذكير والانتباه ليس سهل الاستيعاب، ربما هو من قبيل أمور تحتاج إلى كثير من الشرح لإدراكها، ومن هنا تتبين أهمية الإرشاد.
إن ما أُعطي للإنسان من أمانة “النفس” أو “أنا” فإنما أُعطيت له لمعرفة الخالق جل جلاله والاعتراف به،. وفي الحقيقة أن غاية وجوده هي هذه المعرفة والاعتراف؛ لذا فإن الإنسان يدل بوجوده هو على وجود الله، وبصفاته الجزئية على ثروته وغناه المطلق، وبعجزه وفقره على قدرته وإحساناته. فهذه الموهبة والإحسان الإلهي، إنما يتفضل بهما سبحانه مقدماً على الإنسان، وما الإدراك والعرفان المترتبان على هذا الإحسان الأول إلاّ إعلان واعتراف من الإنسان على استشعاره بوجوده عند النظر إلى كل موجود، واستبصار نوره تعالى في كل ضياء، وهذا يعني ميثاق ﴿أَلَسْتُ﴾ و ﴿بَلَى﴾.
فهذا الميثاق هو إيجاب وقبول ونتيجة لمعرفة معاني الكتاب العظيم الذي سطرته القدرة والإرادة، وإدراك أسرار سطور الحوادث.
د- يجب ألاّ يُفهم ولا يُقيّم هذا الميثاق والسؤال والجواب وفق الجسمانيات والماديات. فالله سبحانه وتعالى يأمر كل مخلوق وفق ماهية كلٍّ منه بأوامر، ويستمع إلى الأصوات المنطلقة من المخلوقات أيضاً ويعلمها ويسعف طلباتها حسب مواضعها. وإذا عبّرنا عن هذا بالمصطلحات الكلامية نقول: إن الله سبحانه الذي يفهم كل المخلوقات رغم اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم وأنواعهم. ويأمرهم كذلك ويبلغهم حقائقه حسب هذا الاختلاف المتفاوت بين الألسنة واللهجات والأنواع، وينشر الحقائق، ويفتح للأنظار كتابَي الإنسان والكون، ويتسلم من مخلوقاته كلماتهم، ويعقد مواثيق وعهوداً معهم، بحيث يبقى الإيضاح الكلامي منحصراً داخل عبارة “الكلام اللفظي”. ثم إن أنماط الخطاب الإلهي بدءً من إلهام الحيوانات إلى إلهام الملائكة، هي أنواع من الكلام الإلهي الذي هو تجلٍّ من تجليات “الكلام النفسي”.
إن كلام الله سبحانه بهذا النمط من الكلام يجري في دائرة واسعة جدّاً بدءً من الواردات في قلب الإنسان إلى عالم الملائكة. إلاّ أن لكل دائرة من تلك الدوائر كيفيتها الخاصة بها من “الأخذ والعطاء” تختلف عن الأخرى. ولهذا لا يمكن أن يُفهم أو يُدرك ما يرد إلى دائرة معينة وما ينطلق منها في دائرة أخرى قط.
وفي الحقيقة أن الإدعاء بأننا يمكننا أن ندرك كل شيء خطأ جسيم. حيث إننا أدركنا في الوقت الحاضر أن ما نعلمه وندركه من الأمور ليس إلاّ بضعاً يسيرا، ويمكن أن نبصر بالمقدار نفسه أيضاً. وهذا يعني أن العالم الذي ندركه ونشاهده لا يُعدُّ شيئاً بالنسبة لما لا ندرك ولا نبصر.
ولهذا فتكلُّم رب العالمين مع الذرات وأمْرُه الأنظمة، وتركيبه أو تحليله للأشياء تجري في أبعاد سامية رفيعة جداً، بحيث لا تسعها موازيننا الصغيرة.
إن الله سبحانه يأخذ الميثاق من الذرات، ومن الجزيئات، ومن الخلايا، ومن عالم الذرات، وفي رحم الأم، وفي عهد الطفولة… فنحن لا يمكن أن نقيس بوضوح هذه الأمور بموازيننا قطعاً، وبخاصة إن كان الأمر متعلقاً بروح الإنسان وبدايات تشكله الوجداني.
إن روح الإنسان وُجود مستقل. إذ ثبت هذا في الوقت الحاضر بوضوح تام بما لم يعد هناك ما يستدعي النقاش حوله، حيث إن علم باراسيكولوجي (Parapsikoloji) بفروعه المتنوعة التي تحيط بعالَم العلم قد حوّل هذا الموضوع إلى ما يثير فضول الإنسان ويدفعه إلى معرفة الروح ووجودها ووظائفها ورغباتها وآمالها حتى لم يبق محفل من محافل العلم أو مجلس من مجالس الطبقات الراقية إلاّ ويتكلم عنها. ولما كنا قد تطرقنا إلى مبحث الروح في موضع آخر لذا سوف نتناول فقط ما يمس منه موضوعنا الحالي.
إننا لا يمكن بحال من الأحوال أن ندرك بموازيننا للفهم والإفهام، الإيجاب والقبول المتعلق بالميثاق من حيث إنه قد عقد مع الروح، ذلك لأنها خلقت قبل جسد الإنسان. ومن ناحية أخرى إنها مالكة لماهية فوق الزمان. إذ إنْ كان كلام الروح شبيه بما في الرؤى من كلام وإدراك، وإن كانت الروح تستطيع أن تجري تفاهماً بدون الحاجة إلى موْجات صوتية -كما في التليباثي- وإن اكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة حتى في الاتحاد السوفيتي الذي يمثل العالم المعتقد بالمادية… فإن هذا يعني، بأن للروح لغة خاصة بها. هذا الكلام المتميز للروح ربما يظهر -بخطاب خاص لها- بالتداعي الخاص بها، وبنوع خاص بشخصها من الكلام، ويسجّل في وقت مناسب في مسجلات متميزة ويحفظ في كاسيتات متميزة وتستعمل لغة خاصة بها.
وبناء على هذا فقد دُعيت الأرواح في موضع الميثاق للمحاورة مع الرب الكريم ورأت الأرواح كل شيء واضحاً جليّاً لعدم توسط برزخ الجسمانية، وقالت ﴿بَلَى﴾ للميثاق. ولكن لأن الكثيرين في أيامنا هذه لم يبحثوا هذا في باب الوجدان من كتاب الروح، لم يصادفوا هذا الميثاق، ولا يمكنهم أن يصادفوه. لأنه لا اطلاع لهم ولا بحث ولا تنقيب في ذلك العالم، فليس لهم أهلية للولوج إلى هذا العالم الروحاني. وفي الحقيقة أن الكتاب الصامت الذي أراد كل من “كانت” (Kant) -بصرف النظر عما كتبه حول تعريف الخالق في جميع كتبه- و”برجسون” (Bergson) اللذيْن أدارا ظهريهما للكون لينصتا إلى ما يقوله، إنما هو هذا الكتاب.. كان لا بد للإنصات إلى الروح وإعارة السمع إلى إلهامات الروح من تأسيس مختبرات لفهم لسان الوجدان ومحاولة إظهار وجه الحقيقة بالفهارس التي تنعكس على الشعور.
هذا الكتاب بذاته شاهد صادق لا يكذب على الحقيقة السامية، فهو العقد والميثاق. إن إفهام المحرومين من هذا اللسان ليس من السهل البتة. وإذا ما تخلت العقول عن أحكامها ومقيّداتها المسبقة، سيشعر الإنسان بما قاله وجدانه ﴿بَلَى﴾ لهذا الميثاق. وفي الحقيقة أن القصد من التفكر الأنفسي والآفاقي وأبحاثهما هو هذا. حيث ينجو الذهن من ضلالاته. ويعطى للفكر حرية ويحاول قراءة هذه الكتابة الدقيقة في الوجدان بعَدَسة التفكر الحر. وهناك الكثيرون قد عوّدوا أنفسهم على النظر إلى أعماق القلب بهذا السبيل. فالواردات التي يحصلون عليها بمشاهداتهم الداخلية وبلطائفهم الداخلية، لا يمكن أن يجدوها في أي كتاب من الكتب. إن رموز الكتب السماوية وإشاراتها يمكن أن تظهر بألوانها الخاصة بها تحت هذه العدسة. فالذين لا يستطيعون أن يروا هذا الأفق وظلّوا محصورين في أنفسهم ولم يتجاوزوها، لا يمكنهم أن يفهموا شيئاً من هذا في أي وقت من الأوقات.
والآن لنبحث الجهة الثانية من المسألة: متى حدث هذا الميثاق؟ ولا بد أن نوضح مقدماً أننا لا نكاد نجد في النصوص أمراً قاطعاً حول ذلك. ولكن يمكننا أن نذكر ما قاله المفسرون فيما يخص هذا الأمر.
حدث هذا الإيجاب والقبول في أثناء سير الحيمن للإخصاب، وفي أثناء اكتساب الجنين شكل الإنسان، أو بلوغ الطفل إلى الرشد. فكل رأي من هذه الآراء لها أساليب للدفاع عنها. ولكن من الصعوبة بمكان أن يرجّح أحد هذه الآراء على غيرها بسبب جاد.
فكما حدث هذا الميثاق في عالم الأرواح يمكن أن يحدث أيضاً في أثناء تعلق الروح بذراتها نفسها في عالم آخر. وكما يحدث في أيّة مرحلة من مراحل تطور الجنين في رحم الأم، كذلك يمكن أن يحدث في أية مرحلة من مراحل النمو حتى البلوغ.
فالله الذي يخاطب الأمس واليوم معاً ويعلم ويسمع الأمس كاليوم ربما أخذ الميثاق في كل هذه المراحل. ونحن نسمع صوتاً صادراً كهذا من أعماق وجداننا ونطلع على شهادة قلبنا على الميثاق.
فكما أن المعِدة تعبّر بلسانها الخاص عن جُوعها، والجسم يعبر بكلماته الخاصة عن ألَمه، فالوجدان أيضاً -مستعملاً لسانه الخاص وفق اصطلاحاته الخاصة به- يسرد البحوث عن المكالمات والعقود، ويئن مما يشعر به من آلام واضطراب، ويقلق من أجل ألا يكون وفيا لما قطعه من ميثاق على نفسه، مُظهراً خلجاته وانفعالاته على صورة موجات متعاقبة، مثلما يلفت الطفل الأنظار إليه ببكائه، ويعدّ نفسه سعيداً بذلك، وينتابه الانكسار والخيبة عندما لا يتمكن من التعبير عما يعانيه.
فالوجدان مرآة صافية لأعظم الحقائق، ومكتبة غنية جداً، وسجل خاص، ومحفظة سامية حسب المدرك لحقيقة الوجدان.