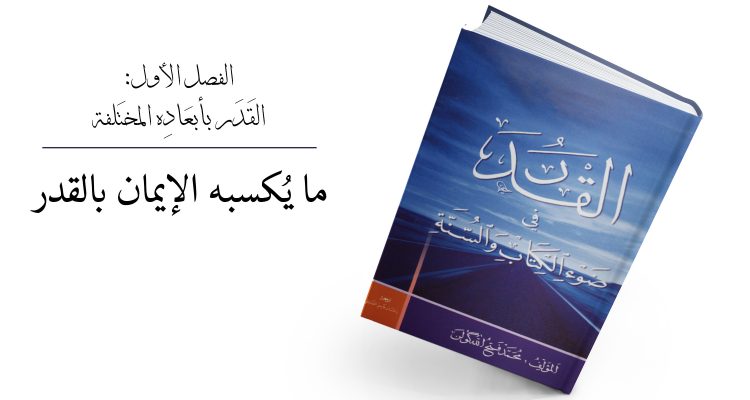إن الذي أحاط علماً بمسألة القدر وحلّ الأسرار التي تخصّه في وجدانه مرحلة تلو الأخرى كمن يحل العقد، يفوض في النهاية كل شيء إلى الله سبحانه، حتى يبلغ فهم الآية الكريمة: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾(الصافات: 96).
نعم، إن الله سبحانه هو خالقنا وخالق أفعالنا؛ فأكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا وتفكرنا وكلامنا.. كل ذلك بخلق الله سبحانه. وفي الحقيقة أن كل ما يخص الخلق، فهو مخلوق من الله سبحانه قطعاً.. هكذا يرى “المنتهِي” (صاحب الإيمان الواصل إلى أعماقه البعيدة) هذه الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار؛ وذلك بسلوكه الوجداني. وحيث إن الأمر هكذا فمن الصعوبة بمكان ألاّ يقع هذا الواصل في “الجبرية”.
نعم إن الإنسان كلما أعطى الفعل لله تجابهه الإرادة (إرادته الجزئية) في النتيجة وتذكّره بالمسؤوليّة لئلاّ ترتفع عنه المسؤولية. ولكي لا يغتر الإنسان في الوقت نفسه بفعله الحسنات يعمل القدر عمله قائلاً له: “لا تغترّ، أنت لست الفاعل”، فينقذه من الغرور. وهكذا يبلغ الإنسان التوازن، وتنتظم حياته وسلوكه بالحفاظ على هذا التوازن.
إن جميع الحسنات ما هي إلاّ من فعل الله وتقديره. فلا يستطيع الإنسان أن يتملكها. وإلاّ يقع في شرك خفي، لأن الله سبحانه هو الذي يهب الحسنات مباشرة، إذ نفْس الإنسان الأمارة بالسوء لا تطلب الحسنات قطعاً. ومن المعلوم أن المقصود من الحسنات هنا تلك الحسنات التي هي بذاتها حسنة وجميلة، وإلاّ فلا نقبل ما تتوهمه النفس الأمارة من جميل وحسَن. نعم، إنّ النفس الشريرة مدفوعة بشرها إلى كراهية الجميل والجمال ومعاداتهما.
إن النفْس الأمّارة بالسوء تطلب السيئات، لذا فالمسؤولية تقع عليها.. فالآية الكريمة الآتية تجمع هذين الأساسين معاً وتوضّح الأمر جلياً: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾(النساء: 79). ومن هنا فليس لك أن تغترّ بحسناتك التي تعود إليك، لأن الحسنات ليست لك بالذات، فكل ما هو حسَن وجميل إنما هو إحسانٌ من الله إليك؛ والإحسان يقتضي الشكر والتواضع، لا الغرور.
أما السيئات والذنوب فإن إرادتك الجزئية “شرط عادي” في خلقها؛ لذا تقع مسؤوليتها على النفس. ذلك لأنه تعالى خلق ما رغبت عمله ومالت إليه نفسك أو فكرت في القيام به، أو أي تصرف آخر في ميلك ورغبتك.
فهذه الأمور لا يمكن أن نفهمها إلاّ بالوجدان والحال. أي أن هناك شاهداً واحداً فقط على ما دار في خلدك من ميل أو أي تصرف في ذلك الميل، وهو الوجدان. فالله اتخذ وجدانك شاهداً على علمه.
أما الإنسان “المبتدئ” فهو يؤمن أيضاً بالقدر، ولكنه ينظر الى الماضي والبلايا التي تصيبه من زاوية القدر، فيقول: “إن البلايا والمصائب النازلة هي من تقدير الله”، فينجو من اليأس. أما عندما ينظر إلى المستقبل والمعاصي فإنه ينظر إليها من زاوية الإرادة الجزئية، فيقول: “سَأُحَصّل ما قُدّر لي على كل حال”، فلا يرمي نفسه في أحضان الكسل، ولا يجعل القدر وسيلةَ تسلية تجاه ما نواه من السيئة، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَنْ ليْسَ لِلإِنْسَانِ إلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم: 39).
نعم، إن الله سبحانه هو خالق كل شيء، من حسنات وسيئات، لأن الخلق يخصّه هو وحده، ولكن المسؤولية تقع على من أراد السيئة.. فهذا النمط من الإيمان هو أساس إيمان المبتدئ الذي لم يخض تجربة الإيمان بأعماقه البعيدة.
أما وراء هذا فلا يجوز الخوض فيه؛ أي لا يجوز للمبتدئ الخوض في مسألة القدر أكثر من هذا الحد وليس له أن يلوك مسائله الفرعية بلسانه؛ لأن القدر مزلّة الأقدام وهو مسألة دقيقة جداً. فقد كان الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان يمنع طلابه من مناقشة مثل هذه المسائل. وعندما كان يُسأل: “وأنت لما ذا تتكلم فيه”، يجيب: “أتكلم خائفاً وكأن على رأسي الطير”. ويقصد به: إنكم عندما تتكلمون في القدر تقصدون الغلبة والظهور على خصمكم، ولهذا أمنعُكم عن الخوض فيه.
إن الدقة المتناهية في هذا الموضوع وحظر الخوض فيه لا يكدر صفاء منطقية المسألة التي بحثت. إذ لا يجوز الكلام كيفما اتفق في مثل هذه المسائل، ولاسيما مسألة القدر، إلاّ من كان حاذقاً ماهراً مهارة الصائغ وحذاقة الكيميائي.