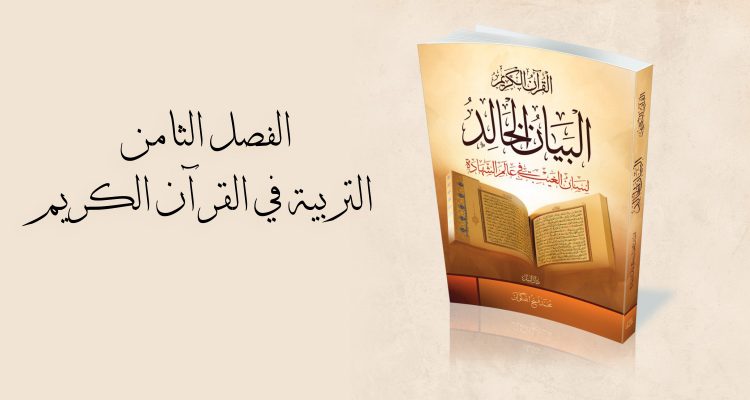أ. خطاب القرآن الكريم للفطرة الإنسانية
إن السعادة الدنيوية والأخروية- وكما سبق أن قلنا في الفصول السابقة- إنما تحصل باتباع أوامر الله المقدسة وتطبيقِ تعليمات نبيّه اللتَين نتعلم منهما قوانين الفطرة.
وكتاب الكون الكبيرُ بنظامه وتناغمه المذهل يتحدث لنا عن الله تعالى، فإذا اعتبرنا هذا الكون من هذا الجانب “صوتًا”، فإن الفوتوغراف -إن صحّ التعبير- الذي نسمع منه هذا الصوت والنغمَ هو القرآن الكريم، فإذا أَصْغَت البشريةُ إلى القرآن الكريم فإنها ستسمع منه الأحداثَ الجارية في الكون، وما تنطوي عليه من الروح والمعنى، وما تثيره هذه المعاني في القلوب من المشاعر الجياشة، وبالتالي فرقيُّ الإنسان إلى مستوى فكري ناضج، وترشحه لبلوغ الكمالات الإنسانية منوط باطلاعه على روح الكون وما فيه من الأحداث؛ كما أن كماله القلبي والروحي مرتبطٌ بانقياده المطلق لآيات القرآن المعجزِ البيانِ، وللبيانات النورانية لسيدنا محمد المصطفى الذي هو المرشد الأكملُ وقدوة الجميع.
ويمكن تلخيص ما قلناه سابقًا في مادّتين:
1- الإحساس التام بالتأثير السحريّ للقرآن الكريم في الرقي القلبي والروحي للإنسان. أجل، لم يمكن إلى يومنا هذا تنشئةُ فردٍ كامل، وأسرة متماسكة، ومجتمع منضبط إلا في ظل إرشاد القرآن الكريم، ولذلك فليس من الممكن بتاتًا أن تكون كلمات هذا القرآن الكريم المعجزِ البيانِ الذي أرشد إلى تربية الفرد الكامل والأسرة والمجتمع المنضبطين، صادرةً من قريحةِ شخص نشأ في مجتمع أمي؛ فليس القرآن إلا كلام الله فقط.
2- إن القرآن يتمتّع بقوّة فريدة، صارت منبعًا لتربية مجتمعات مثالية مَثَّلت الأخلاق والقيم الإنسانية السامية في مناطق مختلفة وفي أزمنة مختلفة؛ فهو سماويّ رباني المصدر.
أجل، إن القرآن الكريم أنار الطريق للمؤمنين وأرشدهم في حل جميع قضاياهم الصغيرة والكبيرة، ووَضْعِ المبادئ الأساسية؛ بحيث إن من ساروا في ضوء إرشاده لم يسقطوا في التشوّهات القلبية والروحية بتاتًا، ولم يعيشوا بؤسًا متماديًا؛ فقد أمر في العديد من آياته بطاعة الوالدين ورعاية حقوق الجار، وذكَّر بواجبات الفرد تجاه المجتمع، وأكّد بإصرارٍ أن الظلم والغيبة والنميمة والتفتيش عن عيوب الآخرين والسخريةَ من الناس وغيرَ ذلك من أفعال قبيحة كثيرةٍ أمراضٌ اجتماعية، ودعا الأرواح المؤمنة إلى الانتباه وتوخّي الحذر تجاهها، كما أنه ذكَّر بالعواقب الوخيمة للكِبْر والغطرسة والكذب والفحشاء وأمثالِها من نقاط الضعف البشري، ودعانا إلى اتخاذ موقف إيماني تجاهها.
وبالإضافة إلى ذلك، تناوَلَ القرآن الكريم أشخاصًا من ذوي المروءة وعلو الجانب وأصحاب الأرواح السامية، فتحدَّث عن صبرهم وعفوهم وتسامُحهم وكرمهم وشجاعتهم، فلفتَ أنظارَنا إلى نماذج إنسانية مثالية.
وإلى جانب المشاعر الطيبة يوجد في الإنسان من حيث الخلقة مشاعرُ سيئة أيضًا؛ إذ إنه بحاجة إلى هذه المشاعر السلبية حتى يكون في نشاط دائم، ويجددَ ذاته ويطورَها.
فماهية الإنسان التي هي عبارة عن خليط من الأضداد لا بد أن تكون في حراك دائم، حتى يسموَ بفضل ذلك إلى أرقى ما يمكن للإنسان الوصولُ إليه من جانب، وحتى يؤدي به هذا الوضعُ إلى اليقظة الدائمة فـلا يهمل نفسه -من الجانب الآخر- حتى لا ينحطَّ إلى أسفلِ سافلين ولا يكونَ مع الشياطين؛ فالقرآن الكريم يتناول جميع هذه المشاعر المغروزةِ في الإنسان والتي تكون إما سببًا لترقيه أو انحطاطِه، فيوجهُها إلى الوجهة الصحيحة ويقدمُها لخدمة الإنسان، وبهذا نعلم أن الإنسان لن يسبر أغوار الفطرة الحقيقية ولن يطَّلع عليها إلا بإرشاد القرآن.
ب. تربية الإنسان في القرآن الكريم
إن الله تعالى يذكِّر في سورة الفاتحة بأمر يتعلق بالتربية في غاية الأهمية قائلًا:
﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورةُ الفَاتِحَةِ: 1/2)، فكما أن الله تعالى يجعل ما في الكون من الأشياء والمواد نفسها وسائلَ لتكون ستائر لقدرته، فكذلك يجعل القوانين والمبادئ نفسها ستائر لإجراءاته السبحانية؛ فهو ربُّ بني الإنسان والحيوانات والنباتات والذرات والمجرات والملائكة، وباختصار: هو رب العالمين، ومن المفسرين من عبَّر عن عدد العالمين بقوله: هو رب العوالم الثمانية عشر ألفًا، وهذا الرقم كناية عن الكثرة، وإلا فهذا العدد قليل أمام العوالم التي ربُّها اللهُ، لأن الذي يربي عوالم لا حصر لها، ويَسُوقُ كل شيء نحو الكمال هو الله رب العالمين، والحمد مخصوص به تعالى.
وأرى من المفيد أن أشير هنا إلى مسألة مختلفة: وهي أن قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورةُ الفَاتِحَةِ: 1/2) ينطوي في مضمونه على سعةٍ وشمول، فلكل شيء نصيب من هذه الربوبية الشاملة، بدءًا من وضعه سبحانه لقوانين الفيزياء والفلك، وانتهاءً بتنظيمه للعلاقات بين خلايا جسم الإنسان. أجل، إن الله تعالى بنفس القانون الذي ينظم به العلاقات بين الخلايا أو بين ما في الخلايا من جزيئاتِ (DNA) و(RNA)، ينظم العلاقات بين الأنظمة السماوية والمجرات. صحيح أن هناك فرقًا في التجليات حسب المواهب والقدرات والقابليات المُودَعة في كل كائن، إلا أن القوانين هي هي، فالقانون الساري في تحول البذرة إلى فسيلة ثم إلى شجرة سامقة، هو القانون نفسه الجاري في مسيرة الحيوان المنوي والبويضةِ في كل مراحلهما إلى أن يولَد الطفلُ.
ولذلك فإن الإنسان إذا استطاع أن يتأمّل القرآن آخذًا بعين الاعتبار الإنسانَ وروحه وجميعَ الكون كُلًّا متكاملًا فإنه سيستطيع أن يَسمع منه صوتَ ونفَسَ الأشياء والحوادثِ برمتها، ولكن من الصعب جدًّا شرحُ هذا لمن تقوقعوا في دهاليز أفكارٍ عفا عليها الزمن، وانشغلوا بأوهامهم وأمانيهم، ودخلوا في تَشتُّتٍ بين العقل والقلب، كما سيصعب شرحُ ذلك لمن تسلوا بمجرد القوانين العلمية الجافة التي لا روح لها، وغُلبوا أمام عقولهم.
فنرى في عصرنا أشخاصًا يسُوقون الناس إلى الابتعاد عن الحياة، والعيشِ على نمط فقراء الهند، وبالمقابل نرى آخرين يقطعون أنفاس الناس عن طريق حبسهم في الحدود الضيقة للمادة، فإذا استطاعت الإنسانية، على الرغم من كل هذه السلبيات، أن تتعمق -بتوفيق الله وعنايته- في دواخلها وتتناولَ التربية الفكرية والروحية والقلبية معًا، فإنها ستنجح في التحليق مثل الفراشات في سماء الحقيقة.
أجل، إن الله تعالى يتناول الإنسانَ والكون معًا ويقيِّمهما في القرآن الكريم جنبًا إلى جنب، فانطلاقًا من هذا الأساس وامتثالًا للأثر القائل: “تخلقوا بأخلاق الله”، علينا أن نلتزم في هذا الموضوع أيضًا بأخلاق الله ونتحرك وفقًا لإجراءات الله في الكون، ونحدِّدَ موقعنا جيِّدًا، فإذا ما حدث ذلك سنكون أرواحًا راقية وسنصِلُ بسهولة إلى الذرى التي نطمح إليها، وسنحرز الموقع الذي يجب أن نحرزه.
إن القرآن يريد أن يتناول كلَّ فرد باعتبار أنه “فرد مثالي”؛ إذ لا يمكن تصور أسرة سليمة ومجتمع سليم من دون وجود الفرد المثالي؛ فالقرآن يوجه الفرد ويشكِّله ويوجهه نحو الفطرة، فيجعله مُدركًا لنواميس الكون، فإذا نضج هذا الفرد واستوى ووصل إلى قوام معين تشكَّلت من أمثاله أُسَرٌ ومجتمعات مثالية.
فلكل من الأبوين حسبَ القرآن الكريم موقع فوق موقعِ الأبوة والأمومة؛ ألا وهو موقع المعلم والمرشد؛ فلذلك نلاحظ أنه يركز في مواضع كثيرة على نصائح الآباء إلى الأولاد، ويؤكد هذا الأمر بين الفينة والأخرى، ففي معرض الحديث عن وعظ لقمان لابنه يقول: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة لُقْمَانَ: 31/13).
أجل، إن أعظم ما يُرتكب في الكون من الظلم هو اتخاذ الشريك لله، وإن من يكون قلبه يقظًا منفتحًا على نسمات العوالم الغيبية لَيرْتعدُ أمام مثل هذا الظلم، فكما أن الشرك ظلم تجاه الله، فهو كذلك تطاوُل على الحقوق الإلهية؛ فإن الله تعالى قد أعد الكائنات على هيئة كتاب ومَعرض، وزينه بشتى أنواع صنعته الرائعة وقدمه لاستفادة بني الإنسان، فإذا تعامى الإنسان عن هذه الآثار البديعة المعروضة أمام عينيه، أو أحال أمرها إلى المصادفات وقوى الطبيعة، فإنه يكون مشركًا ومرتكبًا لظلمٍ عظيم.
ج. تربية الفرد والأسرة في القرآن الكريم
ذكرنا آنفًا أن القرآن يرقى بالفرد حتى يصل به إلى قوام معين، وخَتَمْنا الموضوع بآية تتضمن نصيحةَ والدٍ لولده.
والآن نريد أن نرجع إلى القرآن لنركز من زاوية أخرى على كيفية نصيحة الوالد لولده: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (سورة لُقْمَانَ: 31/17).
فالقرآن الكريم ينقل حديث والد لولده في أهم الأمور، فيذكِّر بأهم المسؤوليات أمام الله، ويؤكد في البداية على لسان نبي من أنبيائه أهمية الصلاة: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي قم بأدائها وأنت تشعر بأنك ماثل أمام عظمة الله، في تكامل داخلي وخارجي
﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي عليك أن تبين، بأسلوب مقبول للناس الخيرَ وما هو مستحسَن ومطلوب دينًا، واحرص على إبعادهم عن الخصال السيئة، واعلم أن سلوك مثل هذا الطريق له مخاطره ومشاقه، فتَحَمَّلْ ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ والتزِمْ سبيل الصبر؛ لأنك إذا تتبّعتَ أخطاء الناس، وتدخَّلتَ في نظرتهم إلى الأمور من حيث تحسينها أو تقبيحها، فكن مستعدًّا لما عسى أن تتلقى منهم من ردود الأفعال، وما قد تأتيك من الهجمات، ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي من الأمور الجليلة التي تتطلب المثابرة والعزم، ولا يتصدى لها إلا أرباب المستوى من عظماء الرجال، فالقرآن حينما يقص علينا كلام نبي من أنبيائه، يذكّرنا بمسؤوليات والدٍ أمام أولاده.
وفي آية أخرى يتبادل الوالد والولد هذا الموقع، حيث إن الولد قد انفتحت عينه على الحقيقة، فينبري لإنقاذ والده، ويمد إليه يديه بأسلوب راقٍ: ﴿إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/42). أجل، إن الأصنام ليست بالمستوى الذي تستطيع أن تقضي لك شيئًا من حاجاتك، بل إنها عاجزة وضعيفة مثلك، فليس من الممكن أن تقوم بمساعدتك في أي أمر من الأمور.
فالابن المحظوظ هنا هو سيدنا إبراهيم، والأب الذي يعبد الأصنام هو آزر، فههنا ينذر الابن أباه وينصحه، فبمثل هذه الأمور يصور لنا القرآن الكريم النماذج المثالية من العائلات، ويلفت أنظارنا إليهم حتى نستنبط منها الأمور الضرورية التي لا بد منها في تربية أفراد مثاليين في الأسرة.
فإذا نظرنا إلى مؤسسة العائلة بعدسة القرآن، فسنلاحظ أن كل فرد في العائلة له دور وعليه ومسؤولية، فنراه تارة ينصح الولد على لسان الوالد، وتارة أخرى ينصح الوالد على لسان الولد، فيذكّر كلًّا منهما بمسؤولياته.
﴿يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/45)، أي إنني أخاف أن تتعرض لعذاب الله جراء انحرافك هذا، وبالتالي تنقطع صلتك بالله فتكون من أولياء الشيطان، فإنك إذا لم تتول الله فإن السبيل الذي تسلكه سيجعلك أنيسًا للشيطان.
فيلاحَظ هنا أن الخطاب يتوجه من الولد الذي يحاول أن يرشد والده بعبارات نابعة من صميم القلب، فهذه الآية -كما ذكرنا آنفًا- تُبين أن كل واحد من أفراد الأسرة له مسؤولية في باب الخير وعليه أن يسدي النصح في جو تَسُودُه المحبة والاحترام.
وبعد أن يؤكد الله تعالى في آية أخرى على ضرورة القيام بالعبودية لله تعالى وحده يُرْدِفه بالتذكير بالمسؤولية المهمة تجاه الوالدين بقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (سورة الإِسْرَاءِ: 17/23).
فالقرآن الكريم بهذه الآيات وأمثالها يرسم صورة للأسرة المثالية، فكل أفراد هذه الأسرة نَشِطُون، وكل فرد منهم يتحرك في إطار القوانين التربوية التي وضعها الله بصفته “رب العالمين” صوب الأهداف المقدرة له في سبيل الوصول إلى عرش كمالاته، كما أن من يلاقي هذه العائلة فسينشرح قلبه بما يسُودها من روح الإخلاص والسكينة.
والفرد الذي ينشأ في مثل هذا الجو العائلي ويؤدي وظائفه وأدواره بحقها يذكِّره القرآن الكريم بمهامه التي تترتب عليه في إطار الدولة والأمة اللتين تُعتَبَران أسرته الكبيرة قائلًا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/59)، فيوسِّع دائرة علاقاته ويفتح أمامه الباب على مسؤوليات جديدة، فيقول لنا جميعًا: أيها المؤمنون عليكم بطاعة الله الذي هو حاكمكم المطلق وطاعة رسول الله الذي هو راعيكم المطلق، وطاعة حكامكم الذين خرجوا من بين أظهركم ويقاسمونكم نفس المشاعر والأفكار.
وهكذا فإن “شعور الوظيفة والمسؤولية” الذي يبدأ بالفرد وينمو فيه تتسع دائرته إلى أن يشمل الأمة ويستوعبَها فتصبحَ مجتمعًا فردوسيًّا يتوجه نحو الآفاق السامية.
أجل، إذا انتسب الفرد إلى أسرة الدولة والأمة التي يحدد إطارَها القرآن، وأطاع جميعُ أفرادِها حكامَها المنسجِمين معهم في المشاعر والأفكار، وأصبحت العلاقة بينهم بمستوى علاقة “الأب-الأخ-الابن” فإن الشَّذى سيفوح في كل أرجاء البلاد وستهبُّ
في أطرافها نسائمُ سفوحِ الجنان عبقًا عبقًا.
لقد أَولى القرآنُ الكريم عنايةً كبيرةً بتنشئة أناس أقوياء في الروح والشخصية على كل المستويات بدءًا من أصغر آلية إدارية على مستوى الأسرة وانتهاء بالتكوينات المعقدة جدًّا كالأمة والدولة التي تنطوي على دائرة واسعة من المسؤوليات، كما أنه دل على الطريق الخارق الذي يتخلق فيه الناس بأخلاق القرآن ويظلون في نشاط دائم وعلى تربية روحية وقلبية، ويتقربون إلى الله.
﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/49)، وأول المخاطَبين للقرآن هو النبي، فكأن القرآن يقول له: “أيها النبي الكريم، عليك أن تتصرف فيما بينهم بما أنزل الله عليك من أحكام القرآن الكريم، وإياك أن تتبع أهواءهم فتنتهكَ نواهيه، ومِن المحتمل أنهم قد يريدون أن يفتنوك عن بعض الأمور التي نزلت إليك بوحي من الله فيوقعوك في اتخاذ قرارات خاطئة، فتَــثَـبَّتْ في خطواتك، وكن ذا عزيمة في كل الأحوال، وتصرفْ على حسب مقتضى أخلاقك السامية، فليس من المتوقع ممن هو في مستواك من النبوّة واستقبال الوحي وسموّ الروحِ أن يتَّبع أهواءهم، فعليك أن تعيد النظر مرة أخرى في موقعك وموقفك اللائق بذلك الموقع، وبما أنك واسطة بينهم وبين الحق تعالى.. فعليك أن تجعل احترام أحكامه مسيطرًا على القلوب وأن تجعلها متوجهة نحوه حتى تتأسّس بفضل ذلك بينهم السكينة والهدوء، ويحصلوا على فرصة مواصلة حياتهم حياة إنسانية سعيدة”.
وفي آية أخرى ينبه القرآن إلى أنه يجب على المؤمنين إذا شبَّ بينهم أيُّ شكل من أشكال النزاع أن يتحاكموا إلى النبي، وأن لا يجدوا في قلوبهم أيَّ ضيق مما يبديه من الأحكام بل عليهم أن يرضوا بها باعتباره خليفة الله، فيقولُ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/65).
فهذه الآية تؤكد أن من شروط الإيمان إبداءَ الرضا التام تجاه الأحكام الصادرة من الرسول، ولذلك نلاحظ أنها صُدِّرت بالقَسَم إشارةً إلى ما تحظى به القضية من بالغ الأهمية.
أجل، إن هذه الأمور كلها تضع لنا الإطار للمجتمع المثالي وتُعِدُّنا لأن نكون “مجتمع السكينة”.
د. وظائف الحكام تجاه الرعية
لقد تطرّقنا آنفًا بعض الشيء لما يذكره القرآن الكريم من التزامات الشعوب تجاه حكّامهم؛ فالقرآن يؤسس المبادئ في هذا الباب على الأمور التالية: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة النَّحْلِ: 16/90).
فالله تعالى يأمر الناس -وبخاصة الحكام- بأن يتحروا في مراعاة حقوق الآخرين، ويواسوهم في قضايا الطعام والشراب والمسكن ونحوها، ويعطُوهم الأولوية فيما يجلب لهم السعادة والرفاهية، وإذ يأمر الله الحكام بالإحسان فكأنه يقول لهم: “إن الله تعالى يراكم ويراقبكم ويطلع على كل أحوالكم، بل إن هناك آلافًا من الأحداث يُنبهكم الله من خلالها ويُشعِر وجدانَكم أنه يراكم، ويجعلكم تُحسون بوجوده، فعليكم أن تكونوا أثناء أدائكم لمسؤولياتكم وواجباتكم تجاهه واعين بأنه عالم بكم ويراقبكم”، ويمكن هنا استحضار تعريف الإحسان الوارد في الحديث الشريف .
كما أن الله تعالى يأمر في هذه الآية بإنفاق كل الثروات في سبيل سعادة الناس وطمأنينتهم، ويحثّ على بذلِ الجهود في جعل الفكر الإسلامي النابع من الإيمان جزءًا من طبيعة الناس وبُعدًا من أبعاده، وأن تبدأ عملية الإنفاق من أقرب دائرة إلى أبعدها، ثم تُواصلُ الآيةُ بتكليفهم بالتصدي حتمًا للفحشاء والمنكر والبغي والعصيان والطغيان، وبالتالي يحمِّلهم مسؤولية توظيف وسائل الإعلام كالتلفزيون والسينما والصحافة والمجلات ونحوها واستخدامِها في ترسيخ روح الأمة وخدمةِ جذورها المعنوية، ومنعِ استخدامها في إفساد أخلاق الأجيال وبثِّ روح الشقاق.
إن القرآن لا يتناول القضية على أساس أن يقول: “يجب على الناس أن يكونوا ذوي أخلاق فاضلة” ولا يكتفي بمجرد “التوصية”، بل يؤكد أنه لا بد لتحقيق ذلك من إصلاح أوكار الفحشاء والعصيان والطغيان؛ فهو حين ينهى الناس عن الفحشاء والمنكر يدعوهم بالمقابل إلى أن يكونوا أناسًا منضبطين ويعيشون في سمو روحي، إلا أن أداء هذه المهمة يخلتف على حسب اختلاف طبقات المجتمع.
إن القرآن الكريم حينما يخاطب المجرم أو المتمرد الذي يرتكب الخطايا جهارًا، يتَّبع أسلوبًا خاصًّا تجاهه، وبهذا يَفتح له المجالَ ليراجع نفسَه ويعودَ إلى صوابه؛ لذلك يوصي بمعاملة مرتكبي الخطايا بمنتهى التسامح ويحثّ على التعامل معهم بالعفو والصفح، سواء ارتُكبت الخطيئة في الأسرة أو المجتمع أو في بيئة أوسع من ذلك، ويوصي تلاميذه بالوقار والجدية والتغاضي قائلًا: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (سورة الفُرْقَانِ: 25/72).
أجل، إن المؤمن يتخذ موقفه من الفسق والفجور حيث يأمره الله به ويكون في هذا صامدًا تجاه الوقوع في ذلك، ولكن إذا حَدَا به الطريق من حيث لا يشعر إلى مكان يُرتكب فيه الفحشاء والمنكر ففي هذه الحالة يكون عالي الجناب قويّ المروءة، يقول: “سلامًا” ويواصل طريقَه ويَعتَبر ما يرتكبه أولئك المجرمون من باب “الخطإ”، فلا يفضحهم حتى لا يتسبب في مزيدِ نفورهم وابتعادِهم عن الدين والتدين.
ويصف القرآن الكريم أبطالَ التسامح من هؤلاء الذين اتخذوا هذه المبادئ السامية دستورًا لهم بقوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (سورة الفُرْقَانِ: 25/63).
فهؤلاء من خاصة عباد الرحمن الذين يشكِّلون بوقارهم وجِدِّهم النموذجَ الحَسن للمؤمنين، ويَعكسون بتصرفاتهم روح القرآن، فإذا مشوا ذكّروا بالله، وإذا قاموا أو قعدوا تمثلوا بأخلاق الله، ويمكن أن يرى الرائي في كل أطوارهم وحركاتهم وأعمالهم انعكاسًا من الأخلاق الإلهية والنبوية، كما أن إيمانهم بالله يَظهر مِن خلال وقارهم وجِدِّهم واحترامِهم وأدبِهم، وعبادُ الله هؤلاء هم رموز التسامح، وإذا مروا بمكان يرتاده الغافلون ألقوا عليهم السلام ولم يحْرموهم مِن أمن الله وأمانه.
وبهذه التعبيرات يبين القرآن بوضوح كيف يتصرف المؤمن تجاه العصاة الذين ليس لهم نصيب من الأدب والعلم، ويعرض أمام الأنظار مساحة واسعة تتمحور حول الأمل والصفح بأسلوب لا تكاد تجده في أي دين أو كتاب آخر.
هـ. التوجيه القرآني نحو الكمال الإنساني
إن هذه الدنيا دار امتحان وتدريب وتربيةٍ أُرسل إليها الإنسان ليترقّى فيها معنويًّا ويصبحَ أهلًا للجنة، فإذا ترقى الإنسان في الدنيا بكل مشاعره وأحاسيسه فسيحظى بمقام القرب من الله والرقي إلى مستوى التأهّل لمشاهدة جمال الله، وإذا تعرضت بعضُ مشاعره ولطائفه للتفسّخ أو الفساد ترتعد فرائصه من خوف سوء العاقبة، وسرعان ما يجدّد العهد ويؤوب إلى صوابه، فمهمة الإنسان الذي هو “إنسان” في الحقيقة هي أن يسلك طريقًا يؤدّي به إلى فطرته السليمة التي تنكشف فيها كلُّ مشاعره نحو تحقيق الهدف مِن خلقِها وغرزِها في الإنسان؛ فإنه إذا طوَّر قلبَه وعقله ووجدانه ولطيفته الربانية وسرَّه وخفيَّه وأخفاه وسائرَ أحاسيسه باتجاه استخدامها لتحقيق الحكمة والغاية مِن خلقِها فإنه سيُعتبر مؤدّيًا ومحترِمًا لِحقّ هذه الودائع الإلهية التي أودعها الله فيه.
أجل، إن التصرف بهذه الطريقة هو من مقتضى القيام بواجب الاحترام تجاه نفسه وتجاه ربه.. صحيحٌ أن الإنسان إذا لاقى ربه ولو بمجرد الإيمان به فإنه سيحظى بتكرّم من الله وسيَدخُل الجنة إن شاء الله، ولكن إيداع الله هذه الأجهزة الإنسانيةَ في الإنسان تُلقي على عاتقه حقوقًا خاصة ينبغي عليه احترامها.
وانكشاف كل المشاعر الإنسانية وتطوّرُها بحيث يصبح الشخص إنسانًا كاملًا منوطٌ بتأسيسه رابطةً قوية بينه وبين خالقه، ولن يتسنى هذا إلا بأن يقرأ الإنسان ذاتَه وماهيتَه من المنظور القرآني قراءةً جيدةً ويتبينَ موقعه ومكانته في الكون ويتابعَ ما يجري حوله
من الأحداث ويقوِّمَها بالقدْر الذي يهمه.
وقبل أن أختم هذا الموضوع الذي يتمحورُ حول اسم الله “الرب”، أريد أن ألفت النظر إلى بعض القضايا كما يلي:
1- إن الشخص الذي يستنفد كل طاقاته للوصول إلى الكمال ضمن نظام معين يتوجب عليه أن يخضع للتوجيهات التي يُؤَطِّرها الخالق العلي في القرآن الكريم.
2- وعلى هذا الفرد أن يصرف كل طاقاته القلبية والروحية والفكرية والوجدانية في سبيل إدراك ماهية الإنسان والأشياء والكون إدراكًا جيّدًا وتفسيرِها في إطار نسبتها إلى الله، ولعل هذا هو الهدف من الخلق، ونسمي هذا: “استنطاق الأخلاق الإلهية بلسان الكون”، وأما الجانب الذي ينعكس على الواقع من هذا الأمر فهو الأخلاق السامية التي يوصي بها القرآن الكريم والتي تكون ثمارُها ونتائجُها هي الفوز بالدار الآخرة، فإذا عاش الإنسان بهذه الأخلاق فإنه سيفوز بالآخرة وبرضا الله الذي حباه كلَّ شيء وبشفاعة رسوله الكريم.
إن الله تعالى بتجلي ربوبيته العامة يُظهر لبني الإنسان في ضمن قوانينه الجبرية نظامًا أخلاقيًّا، وعلى الإنسان أن يقابل ذلك النظام الأخلاقي بمراعاته وتطبيقه بلسان العلوم الكونية؛ فالله تعالى يعلمنا تلك العلوم بلسان القرآن الكريم، ويربط تطوّرنا في حياتنا الشخصية وعالمِنا الروحي والقلبي واللدني بفهمنا للقرآن؛ فنحن إذ نقول فيما لا يقلُّ عن أربعين مرة كل يوم في صلواتنا: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (سورةُ الفَاتِحَةِ: 1/1) نستحضر هذه النقاط التي تَطَرَّقْنا إليها آنفًا، ونعلن مرةً تلو الأخرى بأننا سنظل مخلصين لعهدنا.
و. التخلق بأخلاق الله
إن الله تعالى يحرّك كل ما في الكون بدءًا من كبرى المجرات العملاقة وانتهاء بأصغر جزيئات خلايا جسم الإنسان ويجعل بين الإنسان وبين هذه العوالم علاقة دائمة.
ويمكن أن نستنبط من هذه التصرفات الإلهية التي تَسُوق كلَّ شيء إلى الكمال، ونستخرجَ من هذه السنن الإلهية ما يلي:
أن نتخلق بأخلاق الله، وأن نفهم الأمور التي يريد منا أن نفهمها في العالم الخارجي (الآفاق) والداخلي (الأنفس) وكأنهما وجهان لحقيقة واحدة، يكمل بعضهما البعض الآخر، وأن نستشعرها ونقوّمها من هذا المنظور، وأن نحاول رَبْطَ كلِّ ما نحس به في هذا المجال بالقرآن الكريم ونشعرَ بها من خلاله. أجل، إننا إذا طبقنا بشكل كامل في حياتنا العملية ما وُضع في القرآن الكريم على أنه نظام حياة فإن حياتنا العامة أيضًا ستنتظم إلى حد معين، بتوفيق من الله وعنايته، وحينذاك سنتخلص من الازدواجية المقيتة.
وإننا نعتقد أن كل الاختلالات التي نعيشها في حياتنا يَكمُن وراءها انعدامُ مثل هذه النظرة الشمولية والتقويمِ الكلي، وأعزو مُراوحتنا في مكاننا على الدوام إلى مثل هذه الازدواجية، ولا ينخدعنَّ أحد بما حقَّقَتْه الدولُ المتقدمة الراهنة من التطورات التقنية والتكنولوجية؛ فإن حالتهم هذه ما هي إلا كالبرق الخاطف الذي يلمع فيغيب، وسيَظهر مغزى كلامي هذا بشكل أوضح بعد سنوات قليلة عندما نسمع أصوات التصدعات والانشقاقات التي ستتعرض لها بعض الأنظمة الشمولية .
ومن غير الممكن أن يُعمّر أيُّ نظام غير فطري وغير متوافقٍ مع القوانين السارية في الكون، فما يُلاحظ في الأمور المناقِضة للفطرة من بعض أمارات الخير فيها ليس شأنها إلا كشأن معالجة الجسم ببعض العقاقير التي تضغط على بنيته فتُنتج في الأمد القصير نوعًا من الحالة الصحّيّة المؤقتة، ولكن هذا التأثير لن يدوم طويلًا.
بل هي -بالأحرى- تُشْبه حالةَ ذلك المريض الذي يَفتح عينيه لمدة خمس دقائق فيبعث الفرحَ والمسرةَ في نفوس ذويه، ولكنه فور ذلك يرتحل إلى العالم الأخروي، فمثل هذه الأنظمة تبدو براقة وجذابة ولكنها أسست على أسس غير طبيعية ومناقضةٍ للفطرة، لذا فهي لن تُعمَّرَ طويلًا ولن تأتي للإنسانية بالسعادة.
وعلى النقيض من هذا، هناك دول ما زالت قائمة لأنها تأسست على مراعاة القوانين الجارية في الكون، وهذه هي الدول التي تتمتع بمستقبل واعد.
ومنذ زمن معين أصبح المسلمون ينكرون السنن الكونية والشريعة الفطرية إلى جانب تركهم العملَ بالدساتير القرآنية، فصاروا عرضة للذلة والهوان ومن أحطِّ المتخلفين، ولن يتخلصوا من هذا الوضع المزري الذي وقعوا فيه إلا بأن يتركوا الكسل والخمول ويجمعوا بين قراءة الآيات القرآنية والآياتِ الكونية قراءة جيدة؛ لأن كُلًّا من الكتاب المسطور والمنظور يحملان حقيقة واحدة، فكل كتاب يُكتب حول عالمنا الداخلي أو الخارجي، أو حول الوجه الآخر للكون أو حول ظاهر الكون فهو تفسير للقرآن من هذه الناحية، فإذا اعتصم بنو الإنسان بالقرآن واستمسكوا به فسيحوِّلون دنياهم إلى فردوس ويجعلونها مَعْبَرًا مؤدّيًا إلى الجنان.
ز. النظام التربوي القرآني
إن من يَدْرُس النظام التربوي القرآني فسيلاحظ أنه يفوق بكثيرٍ سائرَ النُّظُم التربوية الأخرى بشكل لا يقبل المقارنة بينه وبينها؛ لذلك ينبغي إرجاع هذا الأمر إلى كونه “كلام الله”، فإذا لم تتغذّ الأنظمة الأخلاقية والتربوية بالقرآن ولم ترتبط بأسلوب القرآن فلن تكتب لها الديمومة مهما بدت نيِّرة.
فهناك تيارات وأيديولوجيات بدت للناظر مشرقة ناصعة ولكنها سرعان ما بَهتت وخفتَتْ وانطفأت، وأما ما بقي منها فقد خضعت لعمليات الإصلاح والتطوير وأعيد النظرُ فيها مرات عديدة، وهذا خير شاهد على أنها غير كافية لحل مشاكل البشرية وغير قادرة عليها.
وبالتالي فإنه ما إن يولد نظام فكري جديد إلا ويموت في وقت قريب، وقد يكون بعضها رائجًا بين الناس اليومَ ولكنه عما قريب سيَكسُد ويعفو عليها الزمن، وأما المبادئ والدساتير النابعة من علم الله الشامل، التي لخصها القرآن الكريم؛ فإنها ما زالت تحافظ على قيمتها وطراوتها، وستستمرّ كذلك إلى الأبد.
إن المجتمعات التي تتعرض فيها الأخلاق الفردية والعائلية للإهمال لن تُكتب لها الديمومة ولن تكون مجتمعاتٍ سليمة وقابلةً للتقدم والتطور؛ لذلك فإننا نريد هنا أن نركز بشكل خاص على كيفية تناول القرآن الكريم للفرد من الناحية الأخلاقية، فإن صلاح الأسرة والمجتمع منوط باستقامة الفرد وحُسنِ أخلاقه، وإن الطغاة الذين يجنحون إلى الدكتاتورية والذين ينظرون إلى جموع الناس وكأنهم قُطعان، لا يرتاحون لوجود أفراد متعلمين متمتعين بحرية الإرادة، بل يفضِّلون أشخاصًا طيِّعين تسهل إدارتهم كالخدم والعبيد، ولا يهمهم ما يعتري الناسَ من الانحلال الأخلاقي، بل غاية همهم أن يُطِيعَهم الناسُ وينقادوا لأفكارهم المتعفنة.
إن امتلاك الفرد إرادةً قوية لذو أهمية قصوى لرُقيّه إلى مستوى حياة منتظمة، وهذا منوط قبل كل شيء بابتعاده عن الشرك وعن الأمراض التي تفوح منها رائحة الشرك، وتَغَلُّبِه على خوف الموت ولقمةِ العيش، ووصولِه إلى مستوى الإحساس بوصاية الله، وشعوره بأن وجوده ما هو إلا ظلٌّ لِظلِّ وجوده تعالى، وحفاظه على هذا الشعور والإحساس الراقي.
ولا بدّ لتحقيق هذا العمل الضخم من أن يكون هناك مرشدون مستوعبون لروح القرآن؛ فإن هذه المهمة ما أُنجزت إلى يومنا هذا إلا بأناسٍ بهذا الحجم من أرباب المستوى، وخيرُ من قاموا بها على وجه كامل والممثلون المثاليون لهذا الأمر -بطبيعة الحال- هم الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم سيد الرسل محمد، وسارَ أبطالُ الإصلاح مِن بعده على نهجه في إصلاح المجتمعات.
وما لم يتم التغلب كلّيًّا على الأمراض التي تفوح منها رائحة الشرك، ولو لم يكن هناك استقلال كامل واستغناء تام عما سوى الله فلن يمكن إصلاح الإنسانية بتاتًا؛ فإنه ليس هناك موجود ينبغي محبته لذاته أو مخافتُه أو إطاعته أو الالتجاء والاحتماء به غيره ، ولن يتسنى الخلاص من جميع أنواع الشرك إلا بقبولٍ وإذعانٍ من هذا القبيل، وإذا كان الإنسان يَحمل في قلبه بعضَ المخاوف تجاه الناس، أو يعيش خائفًا على رزقه، أو يتوجس من الموت ودخولِ القبر فإن هذا يدل على أنه لم يتغلب بعدُ على كثير
من المسائل في قضية الشرك.
ح. الدعوة إلى التوحيد
إن الطريق الوحيد إلى التخلص من كل أنواع الشرك وشوائبِه هو أن يتوجه الإنسان موحِّدًا خالصًا إلى التوحيد في الفكر والعمل، ويُفْرِدَ الله تعالى في كل الأمور، ولندع المشركين ونتساءل: ما مدى فهم المؤمنين لهذه الحقيقة وتبنّيهم لها؟
لقد بيّن الله هذه الحقيقة التوحيدية العظمى على أكمل وجهٍ وأشملِه في قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (سورة الإِخْلَاصِ: 112/1-4).
أجل، إن الله أحدٌ، وأحديته ليست نسبيّة، بل هي ذاتية وحقيقية؛ أما واحديةُ “الواحد” فواحدية إضافية بالنسبة إلى الاثنين، وأما “الأحد” فهو فرد لا يُتصور في مقابله “الاثنان”؛ بمعنى أنه لا يُتصوَّر له ندٌّ أو مثيل، فهو “أحد” ليس قبله ولا بعده شيء، ولا يَستند إلى شيء، بل إليه يَستند ويرجع كلُّ ما يُطلق عليه: واحد، أو اثنان، أو ثلاثة.
﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ﴾؛ أي الله هو الوحيد الذي يحتاج إليه كل شيء، ويرفع إليه الجميعُ أكفَّ الضراعة، وهو الذي يطرق بابه كل سائل بلسان الحال والوجدان والمشاعر، فمهما اعتمد الإنسان على شيء سوى الله وخضع له فسيرى أنه قاصر في هذا المجال؛ لأن قوله تعالى: ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ يفيد هذا المعنى، أي إنه لا يحتاج إلى شيء، بل هو الذي يقضي الحوائج كلها، وهو الوحيد الذي يسمع ويستجيب ويلبي نداءَ مَن يتوسل إليه ومن لا يتوسل.
أجل، إنه ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ وعلاقته بالأسباب عبارةٌ عن ستارات بينه وبين تصرفاته تعالى، وليس وراء ذلك تأثير حقيقي لها.. فهو سبحانه موجود وراء ما وراء الوراءات، لم يلد ولم يولد، وليس له أبوان ولا أولاد، وهو منزّهٌ ومبرّأٌ من كل هذا القبيل مما يوصف به المخلوقات ويُعدّ نقصًا بالنسبة له عما يقولون علوًّا كبيرًا.
وهذه الآيات تُبيِّن مدى قيمة الأسباب والطبيعةِ والمادةِ والطاقةِ، كما أنها تضيف التأثير الحقيقي إلى الله وحده وتُذكِّر بلزوم اتخاذ الموقف تجاه الشرك وكل ما ينبعث منه رائحة الشرك، وأنه إنما ينبغي مراعاة الأسباب؛ لأن الله أمر بها، وتُنبِّه في ضمن ذلك إلى أنه لا بد من ربطِ كلِّ ما يَجري في الكون من الأحداث بذاته تعالى في كل الأحوال والأوضاع.
أجل، يجب على المؤمنين أن يُصغوا ويستمعوا إلى هذه السورة التي تعبر عن هذه الحقيقة العظمى فتطهر قلوبهم وضمائرهم من جميع أنواع الشرك وشوائبه، وتجعلها طاهرة نقية.
إنه من المُتَحَتِّم على المؤمنين خصوصًا في هذا الزمان الذي سهُلت فيه طرائق الحصول على العلم وأصحبت وسائل النشر المكتوبة والمرئية التي تَنشر الحقائق القرآنية متاحةً سهلةَ الوصول؛ أن لا يتساهلوا في قضية حقيقة التوحيد، وأن يستغلوا هذه الإمكانات التي أتاحها الله تعالى في سبيل الإيمان بالله ومعرفته ومحبته.
فالقرآن الكريم يوجه مثل هذه الدعوة السامية إلى اليهود والنصارى -وإن لم يستوعب المشركون ذلك- فيلفت أنظارهم وأنظار أهل العلم من بينهم فيقول: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/64).
“أيها النصارى واليهود وخاصة العلماء منكم، تعالوا نتّفق فيما بيننا على كلمة مشتركة بيننا؛ أي على توحيد الله، فإن الاتفاق في حقّ الله الذي يحتاج إليه كل شيء هو من القضايا الحيوية بالنسبة لنا ولكم، فهلمَّ إلى ترك عبادة غير الله، وعدم إشراك غيره به”؛ بمعنى ألّا نكون عبيدًا لغيره تعالى، ولا نبحثَ عن ندٍّ أو شريك لمن ليس له في ذاته ندٌّ أو شريك؛ لأنه هو وحده الذي يمسك بالكون ويديره في قبضة تصرفه، وكل الأنظمة والكائنات بمثابة الذرة تجاه عظمته وألوهيّته، وبالتالي فإذا كان -سبحانه- ليس له ند أو شريك وإذا كنّا -كباقي عمومِ الكون- محتاجين ومدينين له سبحانه، فتعالوا لا نسرف على أنفسنا بأن نتخذ له في خيالنا ندًّا أو شريكًا، وعلينا ألّا ننحرف عن طريق الحق بأن نتخلى عن الله ويتخذ بعضُنا بعضًا أربابًا؛ فإننا إذا عبدنا غيره، وأعرضنا عنه باحثين عن الفوز والفلاح في وديان أخرى فإنه لن تقوم لنا قائمة، فتعالوا نتوجه بكلّيتنا إلى الله”.
وإذا أعرض هؤلاء رغم كل هذا التحذير والتنوير، فقولوا لهم: “اشهدوا بأنا مسلمون”، وعليكم بعد كل هذه التحذيرات والتنبيهات والتنويرات وإشهاد العقل، أن تُشهِدوا وجدانهم وضمائرهم على أنكم أدّيتم المهمة، ثم انسحبوا إلى الوراء قليلًا.
إن الله تعالى في هذه الآية الكريمة كما يوجِّه النداء إلى جميع أهل الكتاب، ينادي كل أهل العلم والذين يجادلون في سبيل الكتاب ويبنون مؤسّسات في إطار الكتاب من الأجيال القادمة إلى يوم القيامة قائلًا:
“يا أهل العلم، تعالوا نتّفق في أمر قد تشاركنا فيه وأدركناه بقلوبنا وتقبلَتْه ضمائرُنا وصدَّقت به، وهو حقيقةُ أنه ليس هناك معبود مطلق سوى الله، فإننا مهما اشتغلْنا بفرعٍ من فروع العلوم، فإن هذه العلوم إذا لم تستند في نهاية المطاف إلى الله الذي هو الواحد الحقيقي والواجبُ الوجودِ، فلا مفرّ أننا سنلاحظ أنها بدون أصول وجذور.
والحال أن أصحاب القلوب المؤمنة والقرآنية حينما يتناولون القضايا التي تتناولها العلوم فإن أرواحهم ووجدانهم وضمائرهم تستشعر بها بشكل مختلف تمامًا، فإذا حُلت المشاكل في هذا المجال وتم تخطيها، فستنجلي تلقائيًّا تلك القضايا الروحية والفكرية والعلمية التي كانت متأزّمة.
أجل، إن تخلُّص العلوم من الانحراف منوطٌ بتعرفها بالقرآن ضمن نظرة توحيدية من هذا القبيل.
ط. تربية الأفراد في القرآن الكريم
وكما يفهم من الآيات التي أوردناها في الفصول السابقة فإن القرآن الكريم يربي الفردَ وينقِّي قلبه ووجدانه من الشرك وشوائبه، فيَفتح له الطريقَ المؤدي إلى الإنسانية الحقة.
أجل، إن الذين تلقّوا التربية في ظلّ القرآن يتخلصون من جميع أحوالهم السابقة وتصبحُ كل مشاعرهم وأحاسيسهم متوجهة إلى الله ومنصبة في تحقيقِ مرادِه ورضاه.
ولن يصل الإنسان إلى التوحيد الخالص إلا بتركه الكلي للشرك وما تنبعث منه رائحة الشرك، فمن الصعب جدًّا أن تتحدّث عن الحقيقة لمن لم يتغلب على الأفكار الشركية الظاهرة أو الخفية.
أجل، إن هناك حاجة ماسة إلى تنقية الضمائر وتخلُّص الأدمغة من الأحكام المسبقة وتنمية القلوب بحبّ الحقيقة والتوق إلى البحث العلمي.
وقد ركزنا على الحديث عن ضرورة ابتعاد الإنسان عن الشرك وما يُشم منه رائحة الشرك، ولزومِ التوجه إلى الله باعتقادٍ خالصٍ نقيّ؛ فإن أصحاب الضمائر النقيّة التي استطاعت تحقيق مثل هذا التوجه، يتعلّقون بالتوحيد من صميم قلوبهم، حتى إنهم يفرون مما فيه أدنى احتمال الشرك، كما يفر أحدنا من الحيات والعقارب الفتاكة.. وقد أدى هذا الأمر ببعض الصالحين إلى أنهم كانوا يغتسلون في بعض المواقف، وهذه العملية قد تكون من باب الأمور غير الموضوعية والتصرفات الشخصية، كما يمكن ربطها بما تعارف لدى الناس من الغُسل، ويمكن لنا أن نلخص هذا الأمر كما يلي:
إن الإنسان قد يَغفُل عن ربه أثناء تلبيته أذواقه الفانية، ولكنه حين يتدارك نفسه بصدق يؤوب إلى ربّه أوبةً صادقة لعلها تكون كفارة لِمَا بَدَرَ منه، ومع هذا يَغسل جسمه أيضًا حتى تكتمل لديه النظافة والنقاء، بل إن مِن عباد الله الصالحين مَن إذا اعترته غفلةٌ من دون إرادة منه ولو لحظة واحدة يتوجّه إلى ربه قائلًا: “اللهم إذا كان الاغتسال كفارةً عن الغفلة الإرادية، فإني أريد الأوبة إليك من هذه الغفلة التي بدرت مني من دون إرادة”. أجل، إن أولياء الله يكونون حذرين ومتيقّظين دائمًا تجاه فكر الأغيار إلى هذا الحد.
وقد كان الرسول صاحب نظام ومنهج، وقد طبق القرآنَ الكريمَ في حياته العملية بتعليم من الله، وقد مورس عليه الضغط وأُخرج من مكة، ولكنه لما رجع إليها ودخل الكعبة قائدًا منتصِرًا، أحنى رأسه تواضعًا حتَّى إنَّ عُثْنُونَهُ لَيَكَادُ يَمَسُّ وَاسِطَةَ الرَّحْلِ .. وهذا يدل على تمثّله لانمحاء الذات وإرجاعِ كل الإنجازات والانتصارات إلى الله.
يحكى أن عمر بن الخطاب بينما كان يخطب الجمعة إذا به يتوقف ويقول: “أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم، نظير قبضة من تمرٍ أو من زبيب” ثم ينزل هذا الخليفة من على المنبر بين دهشة الناس واستغرابهم، فما علاقة هذا الكلام بخطبته؟ يتقدم أحد الصحابة، وهو سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ويقول له:
“يا أمير المؤمنين، ما أردت بهذا الكلام؟ وما علاقته بالخطبة؟ وما مناسبته؟ وما سببه؟”، فيقول عمر: “ويحك يا ابن عوف، خلوت بنفسي فقالت لي: أنت أمير المؤمنين، وليس بينك وبين الله أحد، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدرها”.
ورُويَ عن عروة بن الزبير قال: رأيت عمر بن الخطاب على عاتقه قربة ماء فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا فقال: “لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلتْ نفسي نخوةٌ (شيء من العُجْب)؛ فأردت أن أكسرها”.
فسيدنا عمر الذي كان من المقربين كان يخشى من أدنى فكر أو إحساس يختلج قلبه أن يكون انحرافًا عن الجادة، فيُعلنُ الحرب عليه كما هو شأن المقرّبين.
وذات مرة كَتب عمر بن عبد العزيز رسالة بليغة وجميلة ليرسلها إلى أحد أصحابه، ثم ما لبث أن مزقها خشية أن يقع في نفسه شيءٌ من الغرور أو الإعجاب بجمالِ ما كتبَ، فلما سئل عن ذلك قال: “وجدت في نفسي شيئًا من الغرور فمزقتها”.
أجل، إن هذا الدين من القوّة بحيث استطاع أن ينقّي مشاعر من هو على رأس قمة الدولة ويخلّصها من شوائب الشرك، كما أن الرعية لم تكن مختلفة عنه في صفاء الأفكار ونقاء المشاعر.
لقد مرت بهذه الأمة حقبة مباركة كان فيها المجتمع يستمدّ طاقته في تنمية مواهبه ممن يرأسونه من الحكام، فوصل إلى مستوى يستحيل تصويره حتى في أدبيات المدينة الفاضلة.
فما أسمى تلك المجتمعات التي أصبح أفرادها أنقياء خالصين من الشرك وشوائبه، وما ألذ العيش بين ظهراني مثل تلك المجتمعات!
لقد اهتم القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا بتنشئة أفراد أصحاء حتى تتكون منهم أُسَر ومجتمعات سليمة، وفي هذا السياق أتى بأوامر وتوصيات عديدة، حتى لكأنه رَبَط كلَّ شيء بإصلاح الفرد لنفسه ومراقبتِه لها، وقولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/105) يُذكِّر بهذه الحقيقة ويوجِّه المؤمنَ إلى وظائفه ومسؤولياته.
إن الإنسان بدلًا من انشغاله بما في الآخرين من الضلال والكفر والكفران، عليه أن يركِّز على مراجعة نفسه متسائلًا: هل هو على هدى من الله أو لا؟ وأن يضع نفسه على المحك: هل هو على الاستقامة أو لا؟ ولعل هذا هو الطريق الأقصر إلى أن يكون من الفائزين لدى الله.
أجل، إنك ما دمت على الحق فلن يضرّك ضلال الآخرين وكفرُهم وعنادهم، والقرآن الكريم ينبه بمثل هذه الآيات إلى الأمور التالية:
1- إذا كان الآخرون على الكفر والكفران فلا ينبغي للمسلم أن يقبع في زاويته منشغلًا بعباداته الشخصية ومكتفيًا بأوراده وأذكاره، بل عليه أن يكون له طريق ومنهج مرتبط بالمبادئ الأساسية بدلًا عن سبل الضلالة السلبية، حتى يواصلَ نشاطاته في هذا الإطار.
2- إن واجب المسلم أن ينشر القيم الكونية المرتبطة بجذوره الروحية والمعنوية، ويوصلها إلى القلوب المحتاجة إليها، وبهذه الطريقة سيكون منقذًا للأرواح البائسة والمكتوية بنار الفراغ الروحي، وسيهيئُ لها بيئة مناسبة تمنحهم التنفّس المعنوي.
3- على المسلم أن يحمل عزيمة التغلب -بإذن الله وعنايته- على كل ما يعترض طريقه، ويصممَ على المسير في الطريق الذي يراه صحيحًا من دون أية زعزعة.
ويُفهم من هذا كله أن القرآن الكريم يركز قبل كل شيء على سلامة طبيعة الفرد وحسن أخلاقه، وكأنه يَبني كلَّ ما سوى ذلك على هذا الأساس، كما يدل على أنه ليس من الوارد أن تتكون أمة أو مجتمع من أفراد لا يتمتعون بالاستقامة في حياتهم الشخصية، فإذا كان الشخص غير مخلص في صلاته وعباداته وتوجهه إلى الله وتعامله مع الناس فلن يأتي بخير للمجتمع الذي ينتسب إليه.
والرسول يلقي الضوء على هذا الموضوع من هذه الناحية فيقول: “مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ” ، والمفهوم المخالف لهذا الحديث هو أنه إذا كان الشخص لا يصلي صلاتنا ولا يستقبل قبلتنا ولا يأكل ذبيحتنا فليس له ذمة عند الله ورسوله، ففي أيامنا هذه هناك كثير من الذين نعرفهم قد دخلوا ضمن هذه الفئة واسودّ عالمهم القلبي من ناحية الاعتقاد، وواجب هؤلاء علينا أن نقيم معهم حوارًا أكثر حميمية وننقل إليهم مشاعرنا القلبية.
إننا نعتقد بأن الإنسان مهما كان على مستوى من الرفاهية فقد لا تجلب حالته هذه له السعادة، إذ لا يمكن أن ينال الإنسان السكينة والاطمئنان ما لم يستنِر قلبه ووجدانه بالقرآن وبالإيمان بخالقه. أجل، إن أكبر غاياتنا هو أن نجعل الجميع يتعرّف على جوٍّ إيماني يبعث فيهم الحياة، وأن نكون وسائل لتحقيق السكينة لهم في الدنيا، وإيصالهم إلى رضا الله تعالى في الآخرة.
وحينما يراد تحقيق أي مشروع فلا بد له من بنية تحتية مناسبة له، فمثلًا إذا كنا نفكّر في جعل كل الناس يستفيدون مما حبانا الله به من نعمة الإيمان والقرآن، فعلينا أن نمزج بين العلوم الدينية والعلوم الكونية، ونُثبتَ جدارتنا في العلوم والتكنولوجيا، حتى نمحو من أذهان مخاطبينا ما عَلِقَ بها من أننا أمة متخلفة تحتاج إلى من يأخذ بيدها حتى تقف على قدميها، وبذلك نكون قد أَفَقْنَا من غفوتنا ورجعنا إلى صوابنا.
أجل، إن هيمنة ما يأتي به الإسلام من الأمن والسعادة على القلوب يعتمد -إلى حد ما- على ما يحقّقه المسلمون من التطور المادي والعمق الروحي، فأهم ثمار هذا العمق والتطور هي السعادة الأخروية، وإلى هذه الحقيقة يشير قول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ (سورة النازعات: 79/40)؛ بمعنى أنه إذا كان الشخص يحمل في قلبه كل لحظة مخافةَ المثول بين يدي ربه للحساب، ويعيش في حياته الدنيا وهو يفكر ويشعر بأن الله يراه ويراقبه، فهذا في طريقه إلى الجنة، وسيحظى بالجنة في آخرته، وهذا في الواقع يعني أنه في مأمن من أمره في دنياه وآخرته.
فأمثال هذه الآيات تدل الإنسانَ على طريق الفوز بالجنة فتثيرُ في قلبه الشعورَ بالسعادة، كما أنها تَحُدُّ من رغباتِه النفسانية والشيطانية فتُرقِّيه إلى مستوى الإنسان القدوة، فهناك الكثير من هذا القبيل تطمئن أرواحهم وتسعد للغاية حينما يجري الحديث عن البعث في الآخرة ولقاءِ الله فيه ورؤية جمال الله ذي الكمال، وأما من كان فاقدًا لمثل هذا الفكر والشعور فإنه سيُحرم من السعادة الأخروية ولن يحظى بالسكينة والسعادة الدنيوية أيضًا.
أجل، إن الإنسان إذا استقرت مخافة الله في قلبه وتعمق عنده الشعورُ بالمحاسبة والإحساسُ بالمسؤولية، فإنه سيضبط نفسه، وسيُولِي الأهمية القصوى لئلا يكون عنصرًا مضرًّا في الحياة الاجتماعية، وسيحاول ألا يخطئ تجاه الآخرين؛ لأنه سيتحرك دائمًا وهو واعٍ بأنه تحت المراقبة الإلهية، وأما المجتمع الذي لم يَصِلْ أفراده إلى هذا المستوى فمن الصعب إيقاظ الشعور بالسعادة الأخروية لديه كما يصعب تحفيزه إلى الطمأنينة الدنيوية، ولعل أقصر الطرق الواقعية لحل هذه القضية هو تنشئة أجيال مرتبطِين بمشاعرِ مخافة الله ومهابته، فالمجتمعات التي لم تتم ترقية أفرادها إلى هذا القوام ستَبقَى كلُّ المشاريع التي تُخطَّط لها في المستوى النظري ولن تتحول إلى واقعٍ عملي بتاتًا.
وليس الأمر منحصرًا في الشباب، فإن الشيوخ أيضًا لن يَسعدوا إلا بفكر الحظوة بلقاء الله ومشاهدة جماله، فإذا كان الشيخ يحمل مثل هذه العقيدة فمهما كبُرَ سنُّه وتقوّس ظهرُه وشابَ رأسُه، فإنه يستطيع أن يظلّ صامدًا مثل شاب قوي، ينتظر عاقبته السعيدة بقلب مفعم بالسكينة والطمأنينة.
أجل، إنه سيقول: “لقد دخلت هذا الطريق ليؤدّي بي إلى لقاء الله، وها قد اقترب موعد اللقاء به”، فيعيش بأفكاره ومشاعره سعادةَ معيةِ الله، ويتخيلُ أنه في الجنة قبل أن يدخلها، وأما إذا لم يتعرّف مثل هذا الشيخ الكبير على الجو الإيماني الفسيح، فإنه سيظل قلقًا متوجّسًا من الموت، وستتحول حياته كل يوم إلى كابوس مؤلم.
فالذي يقع على عاتقنا هو أن نجعل كلّ واحد من الشبان والشِّيب يُحسّ في داخله بنشوة الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن نَغمر قلوبَهم المحتاجةَ إلى السكينة بالمسرة والحبور، فإذا تناولنا الفرد بهذه الطريقة وذكَّرناه بإنسانيته وجعلناه يواصل حياته -بتوفيق الله وعنايته- واعيًا بثقل هذه المسؤولية الكبيرة فستعود الأمور إلى سيرها الطبيعي، وسيجد الفردُ والمجتمع أنفسهم في جو غامر من السكينة والهدوء.
وقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن القرآن الكريم والرسول الكريم قد أسسا معظم إرشادهما وتبليغهما على الفرد، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ (سورة الْمُدَّثِّرِ: 74/38-39).
أي إن كل إنسان مرهون بأعماله، وكأن ما اكتسبه من أعماله السلبية تجعله مكتوف اليدين والرجلين، باستثناء أصحاب اليمين الذين يتَّسمون باليمن والسعد، ويأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم؛ فإن هؤلاء وإن كانت أنفسهم رهينة إلا أنهم قد حرروها
من هذا الرهن بالإيمان والعمل الصالح.
أجل، إن النفس مرهونة بما تعمل، ولا سبيل لأحد إلى الخلاص من هذا الأمر؛ ولن ينتفع الإنسان بما كان لدى الأجداد من الصيت والشهرة وما يملكه من المال، ولا بانتسابِه إلى كبار عباد الله الصالحين من دون رابطة قلبية أو روحية معهم، وإلى هذا أشار الرسول حينما خاطب قبيلته وقومه -وبالأحرى أمته في شخص قبيلته- قائلًا: “يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- اشْتَرُوا أَنْفُسَكُم، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا…” إلى آخر الحديث .
إن كل أحد سيَلقَى ربه بما عمل في الدنيا، وسيُعامَل على حسب عمله، ومن هذه الناحية فإن الصحة القلبية والسلامة الروحية تَحظيان بالأهمية القصوى، ولذلك نرى الرسول ضيَّقَ الدائرةَ شيئًا فشيئًا في الحديث السابق إلى أن قال: “وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا”، ثم توجَّه بخطابه إلى من هو أقرب إليه ألا وهي فلذة كبده وثمرة فؤاده سيدتنا فاطمة قائلًا: “وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا”، وهكذا وضَّح الأمر بأنصع أشكاله ليُذكِّر كلَّ أحد بمدى أهمية المسؤولية الفردية.
أجل، يجب على كل إنسان أن يقوم بمراجعة نفسه والبحثِ عن التخلص من هذا الرهن على أملِ أن يأخذ مكانه في الصفّ خلف سيدنا محمد ضمن المنعتقين؛ لأنه هو الذي طبق المشاريع والخطط المتعلقة بهذه القضية، ونبَّه الناسَ إلى مسألة “فك الرهان”، وحَقَّق لها القبول الحسن لدى القلوب، فكلنا مدينون له، كما قال الشاعر محمد عاكف:
وكُلُّ ما يَملكه العَالمُ هبة منه وعطاء
والمجتمع كله مدين له وكذلك الأفراد سواء
والبشرية برمتها مدينة لهذا المعصوم ذي الأنوارِ
اللهمَّ فاحشرنا يوم العرض معه بهذا الإقرار
فالشاعر المرحوم إذ يؤكد في شعره هذه الحقيقة يذكِّر بأنه وسيلة النجاة، ولكن إلى جانب هذا لا بد من التذكير بأن كل فرد سيقدِّم حسابه بنفسِه منفردًا، فهذا أمرٌ مهمٌّ في باب فهم روح الدين.
فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/164) يدل على أنه لا يُدان أحد بما اقترفه غيره، وأن كل شخصٍ مسؤولٌ عن نفسه، ولا يدخل أحد النارَ بذنوب الآخرين كما أنه لا يدخل أحد الجنة بحسنات غيره، وكل فرد يقع على عاتقه مسؤولياتٌ، ولا يصبح الشخص إنسانًا فاضلًا إلا بأداء هذه المسؤوليات، كما يدل عليه قوله تعالى:
﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (سورة الْمُدَّثِّرِ: 74/38).
وهذا المضمون يتطابق تمامًا مع قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى﴾ (سورة النَّجْمِ: 53/39-41).
ي. تربية الأسرة في الإسلام
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (سورة الزُّمَرِ: 39/41).
في هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى رسوله قائلًا: أيها الحبيب ذو الشأن، من حازَ الهداية فقد سلك طريقًا ينفعه، ومن خرج من هذا الطريق الصحيح وحاد عنه فقد سلك طريقًا سيكون في نهاية المطاف مضرًّا به.
أجل، إنَّ مَن توجَّه إلى الهداية فسيكون مستخدِمًا لإرادته في الخير، وفي المقابل سيُشعل الله تعالى في قلبه نور الإيمان ويوصله إلى الهداية، وأما الذين يُصرّون على السلوك في طريق الضلال والانحراف فيقول الله لرسوله فيهم: “أيها الحبيب، إنك لست وكيلًا عليهم”، وبهذا يحدد الإطار لحدود صلاحيات الرسول ومسؤولياته، كما أنه يبعث السلوان في القلب النقي لرسوله، وقولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (سورة التَّحْرِيمِ: 66/6)، يربط بين هذين الموضوعين.
يعني -والله أعلم- لا تَجعلوا أنفسكم وأفراد أسرتكم وقودًا لنار جهنم، ووجِّهوهم إلى الاستقامة في الأفكار والمشاعر. أجل، إذا تحقق هذا فإن كل فرد من أفراد الأسرة سيواجه ذاته ويراجعُ نفسه فيحظى بالاستقامة.
إن الأسرةَ مهمّةٌ جدًّا لتكوُّنِ مجتمعٍ سليم، فلن تجدَ أمةً سعيدة تعرّضت للانحلال الأُسري والتفكّك العائلي، ولن تُكتبَ الديمومة للمجتمعات التي خاض فيها الأبوان في السفاهات وأهملوا واجباتهم تجاه أولادهم وتركوهم مشردين عديمي الإحساس والشعور، ومهما عاش المجتمع مدةً بدون إحساس وشعور فلن يصمد على الدوام، وليس له أن يتقاسم مع الأمم الأخرى نِعَمَ الدنيا وإمكاناتها، فنحن من هذا المنطلق نؤمن بأنه لن تبقى الأسرة ولا المجتمع في سلامة إلا بمقدار ما تكون فيها العلاقات بين الأبوين وأولادِهما، والزوجِ مع الزوجة مبنيةً على أسسٍ سليمة ومتينة.
فمن الواضح أنه إذا لم يؤدِّ الوالدان واجباتهما تجاه أولادهما، أو قصَّر الأولاد في الوفاء بواجباتهم تجاه الوالدين، فلا مفرّ من أنه ستحدث بينهم مشاكلُ جرّاء ما انحلّ من أواصر المحبة والاحترام، ولا بد لحل هذه المشكلة من أن يؤدّي كلُّ فرد ما يقع على عاتقه حقّ الأداء، وأن يحاول تنشيط ما بينه وبين ذويه من روابط المحبة والاحترام، وأن يقوم بما يَكْفَل الحفاظ على هذه الروابط.
ولم يتعرض الآباء والأمهات في عصر من العصور لإهانةٍ من قِبَلِ أبنائهم وأحفادهم مثلما يتعرضون له في عصرنا، فقد أصبح الآباء والأمهات يُعتبرون في البيوت وكأنهم من العناصر الزائدة، فيُودَعون في “دُور رعاية المسنين” في مرحلة هم فيها بأمس الحاجة إلى الرعاية والمودة من أولادهم وأحفادهم، ولا يعني إيداعُ الوالدَين في هذه المراكز والدُّور إلا التخلصَ منهما عن طريق وضعهما في سجون لها أبواب ونوافذ ولا ينقُصها سوى القضبان الحديدية.
وقد يبدو من هذه المعاملة وكأن الأولاد يؤدّون واجبهم تجاه أبويهم باحترام، ولكن الحقيقة هي أن الأولاد يقولون لهما بلسان الحال: “اذهبا ودبِّرا أمركما، ولا تكونا عائقَين أمام أخذِنا حظنا من ملذات الحياة”.
ومهما سمَّينا هذه المراكز بأسماء زاهية حتى نبعث الراحة النفسية في قلبيهما فلن يغير هذا من الواقع شيئًا؛ فإن هذه المعاملة في حدّ ذاتها من أكثر القرائن دلالةً على أن الأبوين غير مرغوب فيهما.. ومما لا يُنكَرُ أن كثيرًا من الآباء والأمّهات -باستثناء قلّة قليلة منهم- يستحقون مثل هذه المعاملة، لأنه من المحتمل أنهم لم يقوموا في السابق بما يجب عليهم القيام به تجاه الأولاد، وهذا يُصدّق المثل القائل: “لقد حصدتَ ما زرعتَ”، فهذا يعني أن الأبوين لم يزرعا في السابق خيرًا حتى يحصدا الخير، ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأن السبب في إيصالِ الأبوين إلى “دُور رعاية المسنين” ليس الأولاد،
بل السبب هو الآباء التعساء الذين لم يرعوا أبناءهم في السابق؛ فهم الذين هيؤوا لأنفسهم هذه النتيجة.
ك. بنية الأسرة المثالية في الإسلام
ومهما كان الأمر فللوالدين مكانة سامية في البيت المسلم، وفي هذا تقول الآية الكريمة: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/36).
﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ يعني أذعِنوا من صميم قلوبكم بأن الله منزّه عن الأنداد والشركاء، من حيث “توحيد الألوهية” و”توحيد الربوبية”، ثم اعبدوه وَحْدَه
من منظور “توحيد العبودية” ولا تشركوا به في العبادة ندًّا أو شريكًا.
فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد مترابطة فيما بينها ترابطًا وثيقًا؛ لأن الله تعالى واحدٌ في ربوبيّته وتصرّفاته، وعلى العباد الذين منحَهم اللهُ الإرادةَ أن يوحدوه توحيدًا نابعًا
من أعماق قلوبهم.
وعقب هذا الأمر مباشرة يثَنِّي الله بالأمر بالإحسان إلى الوالدين.. وبهذا التعبير يعطي الله للوالدين حقًّا كبيرًا ويأمر الأولاد بأن يَبَّروهما بمشاعر الإحسان التام وأن يَمُدُّوا إليهما يدَ الحماية والرعاية والاهتمام، وبعد أن يضع القرآن الكريم الأبوين في مركزِ الاهتمام يوسّع الدائرة إلى أن يشمل هذا الإحسانُ الأقاربَ واليتامى والمساكين والجارَ القريب والجارَ البعيد والصاحبَ القريب وابن السبيل والعبيدَ والخدمَ ومن شاكَلهم.
وهناك آيات عديدة في القرآن تُذكِّر بحقوق الوالدين على الأولاد، وبعد النهي عن الإشراك بالله تَذْكُر عقبه مباشرةً قضيةَ الإحسان إليهما باعتباره فرضًا على الأولاد، وإليك مثالًا من تلك الوصايا الماسية:
﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ (سورة لُقْمَانَ: 31/13-14).
وفي آية أخرى يَذكُر الله التفاصيلَ المتعلقة بأفكارنا وتصرفاتنا تجاههم قائلًا: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (سورة الإِسْرَاءِ: 17/23).
فيلاحَظ أن القرآن الكريم يَلفت الانتباه دائمًا إلى الوالدين اللذَين يُعتَبَران حجر الأساس للأسرة، ويَبنِي كلَّ شيء عليهما، وإنه لذو مغزى كبير أن تتحرر مسألة التربية من إطار القبيلة والعشيرة إلى إطارٍ يتشكّل من الأبوين والأولاد.
وفي الأسرة هناك حالتان: إحداهما من المركز إلى المحيط، والآخر من المحيط إلى المركز؛ فالأبوان يشكِّلان نواة الأسرة، وبالتالي فهما أحقّ أفراد الأسرة بالاحترام والطاعة، وقد بلغت قيمتهما أفاقًا عالية حَدَتْ بالنبيَّ إلى أن يجعل الجنةَ -التي هي رمزٌ على رضوان الله تعالى- تحت أقدام الأمهات، قائلًا: “الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ” ، كما بيَّن في حديث آخر أن من أهم وسائل دخول الجنة طاعةَ الوالدين، فهذا موضوعٌ يستحقُّ التركيز عليه.
وبالمقابل إذا قام الوالدان بما يترتب عليهما من الواجبات تجاه الأولاد، فأثبتا جدارتهما بهذا المقام السامي، فحينئذ سترتقي تلك العائلة إلى أن تصبح عنصرًا مهمًّا في المجتمع، وسيحصل الوالدان على نتائج ذلك الاحترام المطلوب من الأولاد، وسيحصدان أضعاف ما بذراه إلى ذلك الحين، وهذا هو ما ينعكس من المحيط إلى المركز.
إن الإسلام تَناوَل مؤسسة الأسرة فحرَّرها من تأثيرات العشيرة والقبيلة، وأعطاها شكلًا جديدًا، فهناك رابطة قوية بين أفراد الأسرة التي تتشكل بالروح الإسلامية، ومن الطبيعي أن يَنتُج من جُزَيئات مثل هذه الأسرة المترابطة مجتمعٌ قويٌّ.
وأعود فأُذكِّر بأن مركز الثقل في مثل هذا المجتمع هو الأبوان؛ حيث يقول الرسول: “إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ -ثَلَاثًا-، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ” … فهذا الحديث يؤكد هذه الحقيقة ويلقي الضوء على الخطّ الممتد من المركز إلى المحيط مذكِّرًا بلزوم رعاية كل منهم على حسب درجته، وهذا هو ما نسميه: من المركز إلى المحيط، كما أن قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/36) يوسِّع دائرة الإحسان بدءًا من الوالدين ثم الأبعد فالأبعد.
وقد محا الإسلام بهذا عقليةَ القبيلة والعشيرة والمباهاة بالأجداد، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/134)، وبذلك أرسى موقع الأسرة ووضعها في موقعها الذي تليق به.
وفي ذلك يقول الرسول: “إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء…” ، ولكن النهي عن الفخر بالآباء لا يسوِّغ مسبتهم والطعن فيهم، وإنما الذي ينبغي التركيز عليه هنا هو أن يتخلى الناسُ عن التفاخر فيما بينهم ويصبُّوا همتهم على مواقفهم ومواقعهم هم ومراجعتهم لأنفسهم.
وخلاصة القول أننا حاولْنا ولو بشكلٍ مختصرٍ أن نحدد حدود الأسرة الداخلية، وإلا فإن الأسرة المثالية التي يؤسّسها الإسلام تكون لها علاقة خارجيّة بقبيلتها وعشيرتها كما أن لها علاقات بآبائها وأجدادها، وأيضًا هي مجموعة تشكِّلُ النواة المتكوّنة من الجد والجدة، والأبوين والأولاد والأحفاد، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (سورة التَّحْرِيمِ: 66/6)، فقوله “وأهليكم” يحدّد المسؤولية التي يجب على الإنسان القيام بها تجاه أسرته.
ومن الخصال المهمّة في الإسلام الإيثار، والقرآن الكريم يشير إشاراتٍ خفيةً أو واضحةً في مواضع كثيرة إلى هذه الخصلة الإنسانية ويلفت النظر إليها، وقد فُسِّر الإيثار بأنه ترجيح الإنسان غيرَه بشيء مع كونه محتاجًا إليه، فإذا أنفق على غيره وسد المؤثِرُ حاجة غيره بشيء هو أحوجَ إليه من المؤثَرِ فذاك من أسمى أنواع الإيثار.
وقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (سورة الْحَشْرِ: 59/9) وغيرها من الآيات المشابهة للتنويه بشأن أولئك المباركين المتسمين بهذه الخصلة السامية، ولا يؤثِّر في الإيثار عوامل القرب والبعد، بل غاية ما فيه أن المؤمن يؤْثر أخاه المؤمن على نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى، ولكن مهما كان هذا الأمر محمودًا فله حدودٌ لا بد من الوقوف عندها، ومن ذلك الأسرة؛ حيث إنه إذا كان للإنسان أسرةٌ يعولها فعليه أن يسدّ حاجاتها قبل الآخرين، فهذا من الأمور التي تتقدّم على الإيثار، وبالأحرى إذا كان الأمر يتعلّق بحقوق الوالدين، فإنها تحوز أهمية تجعلها تسبق خصلة الإيثار في الرتبة.. ففي الحديث: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: “مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: “أُمُّكَ”، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: “ثُمَّ أُمُّكَ”، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: “ثُمَّ أُمُّكَ” قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: “ثُمَّ أَبُوكَ” .
وفي هذا الصدد يأتي هذا الحديث الذي يرويه سعد بن أبي وقاص ، حيث يقول: عَادَنِي النَّبِيُّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: “لَا”، قَالَ: فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: “الثُّلُثُ يَا سَعْدُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ”، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: “إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ” .
فهذا الحديث يدل على أنه تدخَّل في الأمر مباشرة ووَضَعَ الحدَّ في الإنفاق بكل وضوح حينما رأى أن هناك حقوقًا للأسرة وأنّ هناك أبوين أو أولادًا يستحقّون الميراث.
وقريبٌ من هذا ما جرى لسيدنا كعب بن مالك، فقد تخلّف عن غزوة تبوك من دون أيّ معذرة، ولكنه لم يَلجأ إلى المعاذير الكاذبة، بل إنه ظلّ يستغفرُ الله إلى أن نزل فيه قرآنٌ يبشره بِقبولِ توبتِه، وحين ذلك أرادَ كعب أن يُنفق كلَّ أمواله في سبيل الله تعالى شكرًا لله تعالى وتصديقًا لتوبته؛ حيث جاء في سياق ما قاله في القصة المشهورة: “يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أنخلِعَ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله: “أمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ” .
والمقام يضيق عن سرد الأمثلة العديدة، فهناك نماذج أخرى من العهد النبوي السعيد تدل على أنه حينما يتعلق الأمر بحقوق الأسرة فإن نطاق التصرفات يضيق على حسبها.
إن الإرشاد والتبليغ من الأمور الإلهية السامية في الإسلام ومن فروض الكفاية على المسلم في الظروف العادية، ولكن هناك ظروفًا خاصة (كالنفير العام) تحوِّلهما إلى فرض عين، ولامتثال هذا الأمر المهمّ جاء صحابي إلى الرسول فقال له: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ، قَالَ: “أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟” قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: “فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ” .
فإذا كان الرسول يوجِّه نظر الأولاد إلى الأبوين حتى في مسألة معدودة في عداد الفروض العينية؛ فهذا يعني أنه لا بد من الوقوف مليًّا عند مسؤوليات الأولاد تجاه والديهم.
الْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله، وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بالله، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
وَصَلِّ اللهمّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ.. وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِه۪ أَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ بِعَدَدِ عِلْمِكَ وَبِعَدَدِ مَعْلُومَاتِكَ، اٰمِينْ.