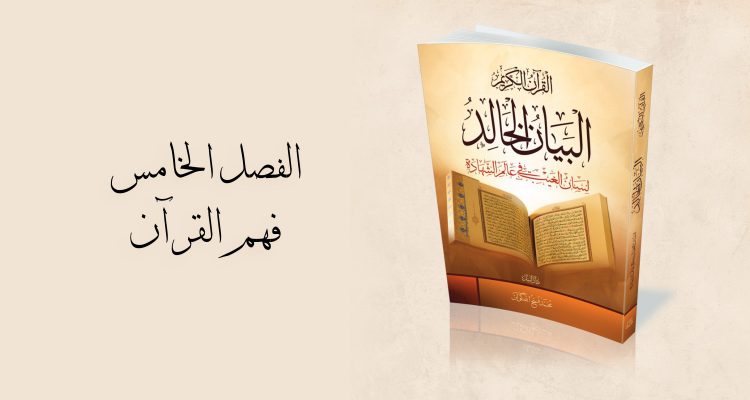إن القرآن من السعة بحيث يشمل جميع جوانب حياة البشر ؛ فقد وضع القرآن أحكامًا تتعلق بجميع مجالات الحياة؛ سواء منها الفردية أو العائلية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو الاقتصادية، فعلى مَرِّ العصور نجد كثيرًا من البشر رجعوا -بشكل أو بآخر- إلى الأسس التي جاء بها القرآن واستلهموا منها جميعَ ما يهمّهم من الأمور ونظَّموا حياتهم وفقًا لها، ومع أنه حصلت بعض الانحرافات في الفهوم أثناء الرجوع إلى تلك الأسس القرآنية، إلا أن القرآن ظلّ المنبع الوحيد الذي يدلّ البشرية على سبل الخلاص إذا تم الرجوع إليه بقلب سليم وفي أُطُرِ عقلية الصحابة الكرام وصفائهم.
فلذلك علينا أن ننبه بدايةً إلى أن الانحرافات التي حصلت في فهم القرآن إنما حصلت لعدم تناولِه من منظور عقلية الصحابة الكرام، وإلا فإن هناك آلافًا من المجلدات ظلّت تؤلَّف في كل عصر حول تفسير القرآن، وهذه المؤلفات من المنابع الفياضة بالنسبة لنا من زاوية التاريخ الثقافي الإسلامي.. صحيح أن لهذه المؤلفات جوانب نقص يأسف لها الإنسان باسم القرآن إلا أن ميزاتها وإيجابياتها هي الغالبة عليها بصبغة عامّة.
فأكبر النقائص التي يمكن للإنسان أن يتحدث عنها هنا هي تفسير القرآن تفسيرًا مرتبطًا بعصر ما أو متأثرًا بثقافة عصر ما؛ بمعنى أن بعض المفسّرين لم يستطيعوا أن يتخطوا المستوى العلمي والفكري لعصورهم التي كانوا يعيشونها، وراحوا يخوضون في أمور تُعتبَر تفاصيل من زاوية المستوى العلمي لعصورهم، فلم يستطيعوا أن يحافظوا على التوازن، بل إن هناك بعضًا من المفسرين حاولوا أن يُخضعوا النظرة إلى القرآن للعقلية العلمية التي لم تكتمل في عصرهم، فالمحاولات التي من هذا القبيل مهما كانت تحمل في طيّاتها من نوايا صادقة ومقاصد طيبة إلا أنها تُعدّ تدخُّلًا في مفهوم ومقاصد القرآن، وهو تدخّلٌ هابطُ المستوى وغير حكيم حتى وإن صاحَبَتْه نيةٌ حسنة، لكنّنا مع ذلك، وانطلاقًا من أدبنا الإسلامي نشكر هذه المساعي التي بذلها أناسٌ مخلصون، ولا تحمل نوايا سيئة، ونقول: شَكرَ اللهُ سعي هؤلاء وجهودَهم التي بذلوها في هذه السبيل.
ولْنستعرض هذا الأمر ضمن التطوّر التاريخي له:
إن الصحابة الكرام هم أناس سعداء حباهم الله بِحَظوةِ تَعَلُّم القرآن من منبع الوحي؛ فقبل كلِّ شيء هم شهدوا نزول القرآن، فاستقرّ معنى القرآن في قلوبهم وعقولهم وهو لا يزال في طور نزوله بكل حيويته ومعناه وطراوته.. فإن أحدهم كان إذا أشكل عليه شيءٌ من القرآن يحُلُّ ذلك عن طريق الرجوع الفوريِّ إلى من أُنزل عليه القرآن، ولم يكن يحتاج ما نحتاج إليه من تلك القواعد المنهجية التي وُضِعت لفهم القرآن.
وقد كانوا يتذاكرونه فيما بينهم ويطبّقون ما ينزل من الوحي عقب نزوله، وكأن هذا نوع من الإجماع الضمني فيما بينهم.
صحيحٌ أن هذه العملية ما كانت في تلك الأيام تسمى “إجماعًا” بالمعنى الاصطلاحي، إلا أن هذه العملية أصبحت مصدرًا لما وضعه العلماء لاحقًا من المصطلحات.
وحينما جاء عصر التابعين كانت هذه الفعاليات التي تُجرى حول القرآن لا تزال تحافِظ -بشكل ما- على صفائها على غرار ما كانت عليه في عهد رسول الله ؛ حيث كان الصحابة الذين هم المرجع الوحيد للتابعين في هذا العهد لا يزالون على قيد الحياة، كما لم يكن في هذا العهد أيُّ تدخُّل خارجي أو تأثير لثقافة خارجية، وأما حصول نوع من الخلل في تلك النظرة الصافية إلى تفسير القرآن فقد حدث في العصور اللاحقة، حيث إنه قد تسرّبت ثقافة تلك العصور وعقليتها إلى التفسيرات والتأويلات، ويمكن القول بأن التفاسير أصبحت -من جهةٍ- مجامع للتأويلات بحيث تعكس العقلية العلمية والثقافية لتلك العصور.
ولنختم هذا الموضوع بإبداء ما تحصَّل لدينا من القناعة قائلين: إنه لو تم الحفاظ على جميع ما كان عليه الصحابة وتَحقَّق نقل نظرتهم تلك إلى يومنا هذا سواء في القضايا الأساسية والأصول أو في المسائل المتعلقة بالفروع، لكان فهمُنا للقرآن وتفسيرُنا له أكثر ثراءً وغناءً.
أ. التفاسير القرآنية ذات النظرة الشاملة، والمفسِّرون الذين فاقوا عصورهم
لقد سبق منا آنفًا أن أكّدنا في موضوع فهم القرآن: أن الصحابة هم الذين فهموا القرآن الكريم فهمًا جيّدًا وفسروه على أحسن وجه، وذكرنا أن هذه العقلية والفهم استمرّا إلى حدٍّ كبير في عصر التابعين.. فالحقيقة أنه تَربّى في عصر التابعين أئمة أعلام على مستوى المجدّدين بحيث يستطيع كل منهم أن ينوّر عصورًا عديدة.
وكان هذا العهد عهدًا ولودًا مباركًا؛ فقد كان سعيد بن جبير وعكرمة وطاووس بن كيسان من الشخصيات العملاقة التي تتبادر إلى الأذهان.. وقد كان سعيد بن جبير يقول: لقد أخذتُ القرآن من أوله إلى آخره مع تفسيره عن ابن عباس، وتلقّيت منه مباشرةً هذه الرسالةَ التي انتقلت إليه من النبي صافيةً نقيّة، وقد كان كل من هؤلاء علمٌ على رأسهِ نار، يُهتدى به في حالك الظلمات.
وكان في المدينة المنورة من هذه الشخصيات العملاقة خلقٌ كثير؛ منهم -على سبيل المثال-: أبو العالية وزيد بن أسلم، وفي العراق علقمة بن قيس، ومن تلامذة سيدتنا عائشة مسروق، ومنهم مُرَّةُ الهمداني، والوجه المشرق للبصرة الحسنُ البصري، فهؤلاء بتفسيراتهم للقرآن قد نوّروا عصورَهم بل والعصور التي تلت عصورهم، بالإضافة إلى أنه كان من المتاح للإنسان في ذلك العهد أن يلتقي بأمثالهم من القامات السامقة في أي بلد مسلم يزوره.
ومن بعد ذلك أُلِّفت في مجال الدراية والرواية آلاف التفاسير المستقلة المستمدة من فهم وعلم هؤلاء الأعلام النوابغ.
وفي سياق ما بذلوه من الاهتمام تجاه تفسير القرآن سنحاول أن نشير إشارة عابرة إلى بعض هذه التفاسير التي تُعتبر نموذجية، على أمل أن يكون ذلك نبراسًا للسائرين في هذا الطريق.
1- نماذج التفسير بالرواية:
أ. تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)
المؤلف هو ابن جرير الطبري .. (224-310هـ) ويعتبَر من رواد التفسير بالمأثور، وقد طبع تفسيره في ثلاثين مجلدًا، وقد ضمَّن تفسيره آراءه الفقهية؛ لأنه كان في الوقت نفسه مؤسّسًا لمذهب فقهي وكان له أتباع كثيرون، فهو فقيه ذو صلاحية ودراية وصاحبُ رأيٍ واجتهاد.
وقد التزم الطبري في تفسيره هذا بفهم الصحابة وحافظَ على الأمور التي نُقلت عنهم والتي نسميها: “الأثر”، وإلى جانب اطلاعه على ثقافة عصره، يُلاحَظ أنه قد سبق ثقافةَ عصره في تفسير بعض الآيات؛ فعلى سبيل المثال نرى أنه في تفسيره لقوله تعالى:
﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ (سورة الْحِجْرِ: 15/22)، قد اعتمد على ما روي عن ابن عباس وبذلك يكون قد اقترب من الرؤية العلمية الراهنة أكثر بكثير من الذين أتوا من بعده.
وأما الذين أتوا من بعده فقد فهموا تلقيح الرياح الوارد في الآية كما كشفه العلم بعد ذلك من “تلقيح الرياح للأزهار” أي جمع البذور المذكرة مع المؤنثة، والحال أن هناك أمرًا آخر لم يُكتشَف إلا في الآونة الأخيرة، وهو تلقيح السحب وهو من الوظائف المهمة للرياح، فبهذا تتداخل أجزاء السحب وتتراكم، و-بتعبير بسيط-: هكذا يتكوّن المطر.
يقول ابن جرير: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن ابن عباس “لَوَاقِحَ” قال: “تُلقح الشجر وتُمري السحاب” .
فنلاحظ أنه في تفسيرٍ أُلِّف قبل أحد عشر قرنًا تُقدَّم معلومات تُطابِق المعطيات العلمية لعصرنا.. وأنا شخصيًّا أعتقد أن الطبري إنما وصل إلى هذه النتيجة بالتمسّك بعقلية الصحابة، في حين أن الذين أتوا من بعده لم يرقَوْا إلى هذا المستوى لأنهم اعتبروا معارف عصرهم وكأنها حقائق مطلقة.
ب. تفاسير أخرى
ويمكن أن نضيف إلى تفسير الطبري في باب التفسير بالمأثور، تفسيرَ “بحر العلوم” لأبي الليث السمرقندي (ت: 373هـ)، و”الكشف والبيان عن تفسير القرآن” للثعلبي (ت: 427هـ)، و”المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز” لابن عطية (ت: 542هـ).
فهؤلاء قد جمعوا كلَّ ما روي عن الرسول فيما يتعلق بالتفسير وسجلوه في مؤلّفاتهم، فنحن بدورنا نرى في الغالب من خلال هذه التفاسير كيف تَحقق فهم القرآن صافيًا نقيًّا وعلى مستوى أفق الصحابة، ومعلوم أن فهم الصحابة كان مرتبطًا بفهم سيدنا محمد الذي هو مهبط الوحي.
ونرى في العصور اللاحقة في مقدمة المفسّرين في هذا الباب مؤلف تفسير القرآن العظيم أبا الفداء ابن كثير (ت: 774هـ) الذي عاش قبل خمسة أو ستة عصور تقريبًا، وهو في الوقت نفسه من كبار النقاد، وقد نقَّى التفسير من كثير من الإسرائيليات، وأسهب في الكلام عن بعض الأحاديث من حيث الجرح والتعديل.. كما نرى بعده بحوالي قرن من الزمن مؤلّف “الدر المنثور” جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ)، وهو بدوره حاول أن يجمع جُلَّ ما كُتب في باب التفسير بالرواية.
ولسنا هنا بصدد الحديث عن كل ما قيل حول التفسير بالمأثور، بل كان قصدُنا أن نقدم فكرةً من خلال التطرّق لأهم ما كُتب في هذا المجال، وهؤلاء المؤلفون قد جمعوا في مؤلفاتهم حوالي عشرين-ثلاثين ألفًا من الأحاديث، والذين جاؤوا من بعدهم من بعض المحقّقين قد قاموا بتحقيق هذه الأحاديث ونقدِها.
ولقد نشأ في مجال التفسير بالدراية والرأي أيضًا علماء عباقرة لا يقل مستواهم عن علماء التفسير بالرواية والمأثور، وهؤلاء العلماء أيضًا قد أدرجوا مؤلفاتهم كثيرًا من ثقافة عصرهم، ولكن علينا أن نعترف أن كثيرًا من محتوَيات هذه التفاسير تُعتبر بالنسبة لنا كنوزًا معرفية حافظت على صحةِ وسلامةِ ودقّةِ معلوماتها.
2- نماذج التفسير بالدراية:
أ. فخر الدين الرازي (مفاتيح الغيب)
وحين يُذكر تفسير الدراية يتبادر إلى الذهن تفسير الرازي، فهذا المفسر العملاقُ الذي عاش قبل ثمانية قرون (544-606هـ) وألّف التفسير المسمى: “مفاتيح الغيب”، قد أدلى بدلوه في تفسيره هذا في كل المجالات؛ من التفسير والكلام والفلسفة والمنطق، وفي الأحكام الفقهية واللغة والبديع والبيان والإعجاز القرآني، ويمكن القول: إن فخر الدين الرازي شخصيّة أسطورية بكل معنى الكلمة، ومؤلفاته من الكثرة بحيث تتجاوز قاماتنا.-
فقد ناقش في تفسيره الذي ألفه قبل ثمانية قرون قضيَّة كروية الأرض، ودورانها حول الشمس، بل تحدَّث بطريق غير مباشر عن وجود الجاذبية الأرضية، ولكن الذي يحزّ في النفس أن كل هذه المزايا تُسنَد في كتبنا المدرسية إلى أمثال “غاليلو (Galilei)” و”كوبرنيكوس (Copernicus)”، مع أن فخر الدين الرازي قد تحدَّث قبلهم بأربعة قرون عن هذه الأمور إما بطريق مباشر أو غير مباشر.
ومن هذه الزاوية نستطيع القول: إنه من غير الممكن العثور على قوم مثلنا يُشْبهوننا في مسألة الجحود والعداء لأجدادهم، وكأن أدمغتَنا مشحونةٌ بالحقد والنفور تجاه أجدادنا وأسلافنا، فعلينا أن نأخد تفسير فخر الدين الرازي ونضرب به وجوه كل هؤلاء الجاحدين للنعمة، الناكرين للجميل، ومن الضروري أن نبين لهم مدى ما هم فيه من الكفران والجحود، ويبدو أنه ليس هناك مِن وصف يضاهي صفةَ كفران النعمة وعدم الوفاء في درجة الهبوط بصاحبه وانحطاطه، ولكننا لا يليق بنا نحن المسلمين أن نقوم بكفران النعم، بل يجب أن نصفق لمن قدم للإنسانية خدمة ولو كان من غير المسلمين.
أجل، إننا لن ننكر الجميل كما فعل الأوروبيون، بل إننا نذكر المصادر التي أخذنا منها ونُقِرّ بالفضيلة لصاحب الفضل، في حين أنهم نسبوا الاختراعات التي اكتشفها المسلمون إلى أنفسهم، وبدلوا أسماءَ العلماء المسلمين بأسماء أوروبية، فترى أن العالِم المسلم الجابري المعروف باسمه وعلمه وكتبه قد تحول في أيديهم إلى شخصيّة مجهولة، وتحوَّل ابن سينا (ت: 427هـ) إلى “أويسنَّا (Avicenna)” وابن رشد (ت: 595هـ) إلى “أوروس (Averroes)”… وهناك الكثير مما يمكن أن يُسرد في هذا الموضوع، ولكننا نختصر الكلام تحاشيًا للخروج من الموضوع.
يقول الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/22): “الأرض جسم عظيم، والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهَد كالسطح.. ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشًا ألا تكون كرة واستدل بهذه الآية على أن الأرض ليست كرة، وهذا بعيدٌ جدًّا، لأن الكرة إذا عظُمت جدًّا كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الاستقرار عليه” .
فيا لَلغرابة! إن هذه الأمور مما قيل وكُتب قبل ثمانية قرون.
ومن يراجع تفسير الرازي فسيرى فيه مئات من الأمثلة حول الفقه والصرف والنحو وقواعد البلاغة، كما يركّز بإلحاح على موضوع الإعجاز أيضًا، ويدافع في كل مناسبة عن ربّانيّة القرآن وسماوية منشئه، وأنه وحيٌ لا يمكن له أن يكون من تأليف بشر، وقد اهتم الرازي كثيرًا بقضايا علم المنطق والفلسفة، ممّا أدى بالبعض إلى أن انتقدوه، بل أدى الإفراطُ في هذا الانتقاد إلى أن قيل عنه: فيه كل شيء إلا التفسير، وهذا فكرٌ يخصّ هؤلاء ويَعكس آفاق نظرتهم الضيقة إلى القرآن.
ب. تفاسير أخرى: ومن العلماء الذين ألفوا في تفسير الدراية وسبقوا الرازي إلى ذلك صاحبُ الكشاف الزمخشري (ت: 538هـ) الذي هو من أئمة المعتزلة، وقد تطرق إلى موضوع كرويّة الأرض أيضًا، فجاء بعبارات قريبة من عبارات الرازي بفروق طفيفة فقال: “فإن قلتَ: هل فيه [أي في قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا﴾] دليلٌ على أنّ الأرض مسطحة وليست بكروّية؟ قلت: ليس فيه إلا أن الناس يفترشونها كما يفعلون بالمفارش، وسواء كانت على شكل السطح أو شكل الكرة، فالافتراش غير مستنكر ولا مدفوع لِعظم حجمها واتساع جرمها وتباعُد أطرافها” ، فنراه قد اقترب بحِرفيّة ودقّة من الآفاق العلمية لعصرنا.
وممن قال بكروية الأرض البيضاويُّ (ت: 685هـ) مؤلِّفُ تفسير “أنوار التنزيل وأسرار التأويل” الذي عاش بعد الزمخشري، وكان التلامذة في المدارس القديمة يُعبِّرون عن هذا التفسير بـ”الحُبيبات الحديدية”، تعبيرًا عن صعوبته ورصانته، حيث إن مؤلفه يتناول المواضيع فيه بدراية فائقة ودقّة متناهية.
ومن علمائنا المفسّرين الذين سبقوا “غاليلو” و”كوبرنيك” بسنين في القول بكروية الأرض ودورانِه حول الشمس أحد مشاهير وجهابذة شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية أبو السعود أفندي (ت: 982هـ)، مؤلف تفسير “إرشاد العقل السليم” .
وكما حاولنا التعريف الموجز ببعض كتب التفسير نود أن نعرِّف ببعض آخر منها ثم ننهي الموضوع:
ولا شك أن الإمام النسفي (ت: 710هـ) يندرجُ ضمن قائمة الذين سعوا جاهدين في إبراز عظمة القرآن وذلك من خلال تفسيره: “مدارك التنزيل”، ويمكن عده كاختصار لتفسير الزمخشري، وقد ركز المؤلف كثيرًا في هذا التفسير على الحديث والأثر أيضًا، إلى جانب ما يحمله من الروايات الإسرائيليّة القليلة.
ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نتطرق لتفسير “لُباب التأويل” الذي ألّفه الصوفي البغدادي: الخازن (ت: 741هـ)، ونسبةُ الإسرائيليات في هذا التفسير أكثر مقارنة بغيره، ومع أن فيه مواضيع من علم الفقه والكلام إلا أنه يركز في الغالب على ما رُوي عن الصحابة.
وليس لنا أن نُغفل أو نُهمل ذكرَ البغدادي المرحوم الآلوسي وتفسيره “روح المعاني”، فهذا الكتاب المؤلف من ثلاثين مجلدًا يُعتبر شبْهَ خلاصةٍ للتفاسير السابقة.
وأيضًا هناك التفسير الذي ألفه المفسر التركي العلامة: أَلْمَالِلِي حَمدي يازِرْ (Elmalılı Hamdi Yazır) (ت: 1942م)، والحقيقة أن هذا التفسير يستحقّ أن يسمَّى: تحفة التفاسير، فقد كتب المؤلف تفسيره الذي أسماه: “الدين الحق ولسان القرآن (حَقْ ديني قرآنْ دِيلِي (Hak Dini Kur’an Dili))” بأسلوبٍ قريب من أسلوب “روح المعاني”، ولكنه أحيانًا يستدرك على كثير من المفسرين وينتقدهم.
وأيضًا مع إبقاء باب التحفظات مفتوحًا هناك تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري الذي حاول أن يفسر القرآن تفسيرًا علميًّا، وهو تفسير موسّعٌ تطرّق فيه المؤلف لمختلف العلوم الكونية؛ ولأنه تحدث في تفسيره هذا عن معظم العلوم التي تتعلق بالكون فقد سمّاه البعض بالموسوعة.
ولا يسعنا في هذا المقام أن لا نتحدث عن تفسير سيد قطب (ت: 1966م) “في ظلال القرآن” الذي حاول في تفسيره هذا أن يقدم وجهة نظر قرآنية حول القضايا المتعلقة بالحياة الاجتماعية، ومع أن لهذا التفسير جوانب يمكن انتقادها، إلا أنه يمكن القول بأنه في كتابه هذا قدم وجهة نظر جديدة في التفسير، علاوة على ما يتمتع به أسلوبه من الجزالة والشعرية والانسجام.
وبالإضافة إلى هذا كله هناك كثير من المؤلفين الصوفيين من أمثال محيي الدين بن عربي (ت: 638هـ) والقُشيري (ت: 465هـ) قد فسروا القرآن من النافذة الصوفية الإشارية.
وباختصار نقول: كلما كتب في أي عصر من العصور كتاب بغرض تفسير القرآن وتأويله، فإن كل ذلك يبين أن القرآن في غاية العمق والسعة، وأنه لا نظير له، وأنه
من الروعة بحيث لا يمكن أن يكون من قريحة البشر، وليس هناك مجال من المجالات إلا وللقرآن فيه كلام كثير يخاطب به مدارك أهل كل عصر ويجعلهم يقولون به.
وعلينا أن ننبّه إلى أننا أثناء سردِنا الحديثَ عن التفاسير لم نتناولها على الترتيب الزمني ولا من حيث جوانبها التقنيّة، حيث إننا لسنا بِصدَدِ دراسة التفاسير من هذه الجوانب، بل غاية همّنا أن نبيّن كيف أن القرآن قد فُسِّر على حسب المراحل التاريخية، وأنه لم يزل ينطوي على مبادئ غضة طرية في ساحات العلوم والفنون والتكنولوجيا، ومن البدهيّ لدى الجميع أن مثل هذا الموضوع من السعة بحيث تضيق عنه هذه الصفحات.
ولا يحقّ لنا أن نتحدّث عما إذا كان أجدادُنا وأسلافنا قد قاموا في عصورهم بما يترتب عليهم من الوظائف أو لم يقوموا بها، ولكن غاية ما نستطيع أن نقوله بكل راحة بال هو أنهم قد بذلوا كل سعيهم وجهودهم في سبيل فهم القرآن وتبليغه، وهم إلى جانب كل ما بذلوا من الجهود قد تأثّروا -إلى حدٍ ما- بثقافة عصورهم وقيمها والنظرة السائدة في تلك العصور نحو الدنيا والعقبى.
ونحن إذ نتذكرهم بما بذلوه من تلك المساعي العريضة والمخلصة، نلتجئ إلى القرآن ونقول: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة الْحَشْرِ: 59/10).
نعم، إن القرآن هو الذي يعلِّمنا هذا الدعاء، ونحن بدَورِنا نستغفر الله لهم، ونسأله أن لا يحرمنا من هذه النظرة القرآنية.
ب. كيف ينبغي أن يفسَّر القرآن الكريم؟
حينما ننظر إلى الطبيعة العامة للقرآن ومحتواه، نشاهد أنه يهتم بكل ما يتعلق بالإنسان ويحيط بكل جوانب حياته، فقد تَناوَل في دائرة واسعة من الأزل إلى الأبد، داخلَ الإنسان وخارجَه وسعادتَه الدنيوية والأخرويّة، وتحدث عن كلّ ذلك، فكما أنه نظَّم للإنسان حياته الاقتصادية والمادية، فقد شرح للأنظار بكل دقّةٍ جوانبه الروحية التي تتعلق بوجدانه وسرّه ولطائفه المعنوية.
إن النظام الذي وضعه القرآن ليس عبارة عن نظام متعلِّق بالدنيا، بل إنه يستوعب العالم الآخر إلى جانب هذا العالم، وباختصار: إنه كتاب يُحقق التوازن بين عالمي الدنيا والآخرة.
ولو أن القرآن حصر النظر في التكوين المادي للإنسان، واكتفى بتحقيق سعادته المادية فقط، -وهذا هو السائد في الغرب في العصر الراهن، حيث النظرة أحادية، ومتمحورة حول المادة، وخادمة للبدن والجسد، وبالتالي لا تبشر بسعادة حقيقية-.. وكذا لو أنه لم يأخذ ضمير الإنسان بنظر الاعتبار ولم يوجه الأنظار إلى عالمه الداخلي ومشاعره المعنوية، لكان هذا فيه -من دون شك- نقصًا بيِّنًا، ولَانعكس ذلك النقص على روح الإنسان بالأثر السلبي.
ولن تتحقق السعادة الدنيوية والأخروية إلا بأن يكون هناك تواؤمٌ بين البنية الداخلية والخارجية للإنسان، ولهذا نلاحظ أن من أهداف القرآن مراعاة مشاعر الإنسان، وقد ركّز عليها بين فينة وأخرى، وقبل كل شيء إذا أمعنَّا النظر فيه فسنرى أنه راعى مستوى مخاطبيه على الدوام؛ بحيث إن كلّ من خاضَ فيه بفكره فسيجد فيه خطوطًا لها علاقة بأعماقه الروحية، وأعتقد أن هذا من المواطن التي تكمن فيها إحدى المزايا المهمّة للقرآن، فعلى الإنسان أن يبحث على الأقل لمدة ساعة من أصل أربع وعشرين ساعة عن ذاته في القرآن وأن يحاول العثور على حقيقة نفسه فيه.
أجل، إن خطاب القرآن للإنسان هو خطاب خالق الكون له بلسان القرآن، وهذا يقتضي أن يكون هذا الكتابُ شارحًا للتكوين المادي والمعنوي للإنسان، وأن يتميز بالحديث عن لدنياته ولطائفه بقدر حديثه عن تكوينه الاجتماعي، فالواقع هو أن الإنسان يود أن يكون الكتاب الذي يقرؤه ملامسًا لدواخله، وملاطفًا لمشاعره، وأن يستثيره إلى المنافع ويحذّره من المخاطر، ويوجه أسرته وأمته ويدير عقولهم وإرادتهم.
ومن استطاع أن يُمعن النظر فسيرى أن كل هذه الخصائص موجودة في القرآن المعجز البيان، بل إن ذلك موجودٌ في كل آية منه، ومن لم يتعمّق في القرآن لِنَقْصٍ فيه، وكان يعيش في وادٍ والقرآن في واد آخر، فلن يتصوَّر أن يكون القرآن في مجتمع كهذا منبعًا للهداية.. ونعتقد أن هذا هو السبب الذي يكمن وراء ما تعيشه الأمم المسلمة من الذل والهوان منذ عصور، وزوالُ هذا البؤس منوطٌ برجوع الأمة إلى القرآن بكلّ صدق وإخلاص.
وإذا كنّا نودّ أن يتنفس الناس على وجه الأرض الفكرَ القرآنيَّ، فعلينا أن ندقّق النظر مرة أخرى في تفسيرات القرآن المتعلقة بالإنسان، ونظرته إلى المجتمع، وشرحِه للعلاقة بين (الله-الإنسان-الكون)، فلا نستطيع القول: إنه تم إلى يومنا الراهن معالجة القرآن من هذا الجانب على الوجه اللائق، ويلاحَظ أنه لم يُؤلَّف تفسير من منظور علم النفس رغم أنه من الواضح مدى علاقة هذه الأمور بالإنسان.
وعلم النفس من العلوم التي ينبغي أن تتناول الجهات الملكوتية الحقيقية واللّدنية معًا، فهناك حاجة ماسّة إلى تفسير للقرآن يشمل هذه الجوانب أيضًا.
إن علم النفس في عصرنا قد تحدَّث عن أمور جديدة، ولكنه لم ينجح في الإدلاء بتفسير للإنسان بحيث يتناوله بأعماقه الحقيقية، وأقول بكل صراحة إنه من غير الممكن أن يضع علم النفس أسسًا ويتحدث عن قواعد حول الجوانب الروحية للإنسان بحيث يلبي رغبة العقل السليم في هذا المجال.
وقد تَعتبرون قولي هذا مجرّد ادّعاء، إلا أنني أقول هذا من منظور شمولية القرآن؛ لأن القرآن كتاب نزل من أجل الإنسان، وهو يقدم في مجال العلوم والفنون والاجتماعيات حضارةً محورُها الإنسان؛ ذلك الإنسان الذي خُلق وكأنه هو الكون العظيم بربيعه وصيفه وزهره ونحله.. وهذه هي الحقيقة التي عبر عنها سيدنا علي كرم الله وجهه بشعره فقال:
وتحسب أنك جرم صغير
وفيك انطوى العالم الأكبر!
أجل، إن العوالم فيه مكنونة، وهو كخلاصة للعالم، ومع أن الإنسان الذي انطوى فيه كثير من الحقائق ما زال يتعرض صباحَ مساءَ في أجواء مختلفة لبعض الحالات الروحية والنفسية؛ بحيث إنه يتدنى أحيانًا إلى بعض المراتب النباتية، وأحيانًا يتحول إلى كائن يستنشق الهواء ويخرجه، بينما ينحطّ إلى مرتبة الحيوان أحيانًا أخرى، فلا يشعر في هذه المرتبة إلا بالمشاعر البهيمية والشهوانية.. وفي مقابل هذا كله تمرُّ أحيانٌ تكون فيها الكائنات أمام قدميه وكأنها كرة صغيرة، وتمتد آفاقه الفكرية إلى مشارف العرش الأعظم، ويلبس السدرة وكأنها قميص، ويقترب من موطِئِ قدم الرسول في المعراج، ويسبق كل المخلوقات، وهذه الأمور مما تضيق عن فهمها وتعجز عن قياسها قدراتُ مختبرات العلوم الحالية.
والآن نتساءل قائلين: هل يمكن تفسيرُ هذا كله بالاندفاع الغريزي؟ وكيف لنا أن نفسّر الانفعالات وردّات الفعل والعواطف والدموع وآلافًا من ألوان الغضب بمثل هذه التفسيرات الواهية البسيطة؟!
ج. التفسير القرآني القائم على الإنسان
ليس لبني الإنسان أن يشرحوا ويُفسّروا حقيقة ذات الإنسان بكلّ خصائصه وجوانبه، ولا يستطيع ذلك إلا الله الذي خلقه وبَرَأَه.
وقد أودع الحقُّ في ماهيته مشاعرَ ولطائف على هيئة رموز وشِفرات، وكما أن القرآن يُفسر الكون فكذلك هو الذي يفسر الإنسان، فمن هذا المنطلق نستطيع القول: إن المعلومات المتعلقة بداخل الإنسان وخارجِه موجودة بكاملها في القرآن. أجل، إن الأطوار الروحية التي يمرّ بها الإنسان في كلّ دقيقة، والظواهر النفسية التي يتعرض لها موجودة بكاملها في القرآن على هيئة رموز.
وليس الإنسان جسمًا عاديًّا يمكن تموقعه تحت التلسكوب أو المجهر حتى يمكن الاطلاع على تكوينه. أجل، إنه لا ولن يمكن تحديدُ لدنيّاته بالتلسكوب، كما أنه من الصعوبة بمكانٍ القولُ بأن علم النفس قد حقق نجاحًا في كشف حقيقة روح الإنسان وآليات النفس.
ولعله من غير الممكن الوصولُ إلى نتيجة حول الإنسان من خلال التجارب التي تُجرى على القطط والكلاب والفئران.. وتحليلُه بناءً على أسسِ جدليةِ الماديين نوعٌ من العبث والهراء؛ لأن محاولة تحليل الإنسان الذي هو أغلى وأشرفُ موجودٍ في الكون بمثل هذه الطرائق السفلية المنحطة، أكبرُ جناية تجاه الإنسان وما يتجلى فيه من الأسماء الإلهية، ويُعتبَرُ سوءَ أدب حيالَ ما أُودِع فيه من اللطائف.
لقد تناولَتْ شتى المدارس العلميّة في الغرب الإنسانَ في مراحل زمنيّة مختلفة، وحلَّلَتْ معظمَها في إطارِ ما ذكرناه آنفًا من الانزلاقات الفكرية، وهي في الغالب نظراتٌ تناولت الإنسان بطريقة سفلية منحطّة يندى لها الجبين. أجل، إن “برجسون (Bergson)” و”باسكال (Pascal)” وعددًا قليلًا غيرهما تناولوا الإنسان بحصافة وإنصاف إلى حدٍّ ما، واحتضنوا الإنسان بأعماقه الداخلية والخارجية، وأظن أن هؤلاء لو كانوا قد ظفروا بالقرآن لكانوا قالوا أشياء هي أقرب إلى حقيقة الإنسان، إلا أنهم حُرموا من ذلك.
ومن جانب آخر، نرى “فرويد” ممثّلًا لتيار آخر يربط كل قضية بالمشاعر الشهوانية ويخوض في البوهيمية بشكل مخْزٍ للإنسان، وحينما يحلّل الإنسانَ ينوط كلَّ ما يتعلق به من الأمور بجانب قبيح بَشِع، كما أننا نرى في جانب آخر أناسًا من أمثال “سارتر” يكادُ معظمُهم لا يرون تشريحات لدنيات الإنسان وعالمه المعنوي، ويتناولونه على غرار سائر الحيوانات، ونلاحظ أن هؤلاء للأسف، يربطون بين أمور بعيدة في حقيقتها عن بعضها البعض، فينظرون إلى الإنسان وكأنه من المخلوقات الغريبة التي غُلّت أعناقُها بأغلال الشهوة.
بالله عليكم، هل الإنسان مخلوقٌ عاديٌّ بهذا المستوى؟! صحيح أن هؤلاء كانوا يستخدمون المنهج التحليلي حينما يسردون أفكارهم، إلا أن هذا المنهج يتطلّب أناسًا مؤهّلين، وإني أرى أنه لا أحد من هؤلاء في مستوى الأهلية في هذا الباب، إلا أن من يتخبط في فراغٍ فكريٍّ وروحيّ هائل لا بد أن يتلقى أفكارهم بآذان صاغية ويتقبلها بقبول حسن على أنها حقائق علمية.. إن فرويد يربط كل قضية بالشهوة والرغبة الجنسية، حتى إنه يربط ارتضاع الطفل الرضيع من أمه بالمشاعر الشهوانية، ويتوهّم وجود هذا الإحساس وراء كل موقف بشري.
والآن أرجوكم، تصوروا، هل يستحق الإنسان الذي خُلق مكرمًا وعزيزًا وتفوَّق على الملائكة.. هل يستحق كلَّ هذا الاستحقار؟ وإذا كان الإنسان لا يستحقّ ذلك فما معنى قبول صاحب العقل والإذعان لمثل هذا التحليل والتشريح حول “الإنسان”؟ سأترك للقارئ تقييم الموضوع.
والآن يا ترى، كيف لا يندهش الإنسان حينما يرى الفرق بين التحليلات والتعريفات القرآنية التي أظهرت حقيقة الإنسان وقيمته وبين تلك التحليلات التي ألقت به في المزابل؟!
وإنه لذو مغزى عظيم من حيث عظم قيمة الإنسان لدى الله أن يرتقي مفخرةُ الإنسانية الذي هو من أفراد بني البشر إلى سدرة المنتهى متقدّمًا على أعزّ ملك من الملائكة. أجل، فقد وصل جبريلُ ليلة المعراج إلى نقطة ووقف قائلًا: لو تجاوزتُ لأحرقت بالنور، وفي رواية لو دنوتُ أنملة لأحرقت.
أجل، هكذا نعلم ما هو الإنسان وهكذا نعرفه.. وهكذا يكرمه الله تعالى، وهكذا يعرِّف به ويحلله في قرآنه، فهل هناك في العالَم الحديث علمٌ أو بحثٌ يُجِلُّ الإنسان ويعزّزه إلى هذا الحد، ويا لها من جناية على روح الإنسان ومحتواه حين يحلله بعض الناس بنظرات تنزل به إلى الحضيض!
ولذلك نقول: إنه قد آن الأوان لاكتشاف الإنسان مرة أخرى في القرآن، وتأليفِ تفسير قرآنيٍّ يستنبط معانيه العميقة من خلال الآيات التي تتناوله بتجهيزاته المادية والمعنوية، وتنزيهِ الإنسان الذي هو كائن مكرم من تلك التحليلات المحمَّلة بالخَباثات، فقبل كل شيء يقول القرآن الكريم: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (سورة الذَّارِيَاتِ: 51/21)، فيَلفت الأنظارَ إلى أن الإنسان صرحٌ للمعجزات.
إنه لا يمكن تعريف الإنسان وتحليله من دون التدقيق في ماهيته وحياتِه اليومية والتحوّلات التي يمر بها في كل حين، فلذلك نقول: إن هناك حاجة إلى تحليل القرآن حتى للعلوم الدنيوية، ولا بد مِن أخذِ هذه الأمور بعين الاعتبار أثناء تفسير القرآن؛ لأنه سوف يأتي يوم يتحقّق فيه الرجوع إلى القرآن على مستوى الفرد والمجتمع والمادة والمعنى، فحينذاك لا بدّ من إعادة النظر في كل مستويات الحياة في ضوء الرسالة التي جاء بها القرآن.
إن المقام يضيق عن سرد كل الأمور التي يجب أن تُقال أو تكتب في هذا الباب، وما نقوله أو نكتبه هنا لا يتجاوز عُشر معشار ما يلزم قوله حول هذا الموضوع، إلا أن الأمر الوحيد الذي يبعث فينا الأمل هو أن هناك تطورات مبشّرة بالخير باسم القرآن وباسمنا نحن المسلمين، حيث إننا حينما نشاهد في توجّهات شبابنا رجوعًا إلى القرآن وإلى جذوره -نسأل الله اليمن والبركة- وإلى التطورات بشكل عام، فإننا نؤمن بقرب تلك الأيام التي سيُكتب فيها مثل هذا التفسير الكلي للقرآن الكريم، فإن لم تتحقّق اليوم ففي الغد القريب إن شاء الله.
د. التحليلات النفسية في القرآن الكريم
إن علم النفس علم يدَّعي التعرف على العالم الداخلي للإنسان وتحليلَه من خلال النظر إلى التصرفات الخارجية، وكان هذا العلم يسمَّى في تاريخنا “علم الروح”، وكان هذا العلم في تلك المراحل يبحث في معظمه عن لدنّيات الإنسان وعالمه الداخلي وجوانبه الملكوتية، وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين كان يُسمّى: “علم النفس”، وفي السنوات الأخيرة سُمّي في بلادنا: “البسيكولوجيا (Psychology)”، وأخيرًا أُطلِق عليه اسم “البسيكولوجيا الحديث”.
وأريد أن أقولَ مقدمًا: كل هذه المصطلحات المتعددة من “علم النفس” أو “علم الروح”، وما يستعمله الغربيون من تعبير “بسيكولوجي/سيكولوجي” وغيرها لا تكفي للتعبير عن ما يرد في القرآن من “الحديث عن لدنيات الإنسان وتشريح جانبه الروحي”.
أجل، إن علم النفس رغم تطوُّر آليّات عمله بأنظمة عديدة وبحوث منهجية، لم يستطع أن ينفذ إلى أعماق الإنسان على مستوى القرآن، ولم يستطع أن يكتشفه ويعبر عنه على الوجه اللائق، فالخطى التي خَطاها علم النفس في هذا المجال تبقى ضئيلة جدًّا مقارنةً بما قدمه القرآن، وما قدمه علم النفس لا طعم ولا لون له إذا قارناه بما أتى به القرآن.
ولم يتيسّر لغير القرآن أن يَتناول لدنياتِ الإنسان بشكلٍ متكامل، وأن يحلله ويدققه بشكل يشمل قلبه وسرّه ومشاعره وكذا لطائفه وأحاسيسه التي لم تنكشف إلى الآن، فالقرآن يتناول الإنسان بكل أعماقه الداخلية، ويتعقّبه خطوة فخطوة بكل مشاعره الظاهرة والباطنة، وأعتقد أن نفوذ القرآن إلى ضمير الإنسان، واكتشافه للطائفه، ونظرته إلى كلّ أحواله بنظرة فاحصة، تكفي دليلًا على أنه معجزُ البيان.
وكل من يستمع إلى القرآن، ويتلمّس عن كثبٍ ما فيه من التناسب بين اللفظ والمعنى، سيطلع فيه على حالته الروحية، بل إنه سيجد فيه شرحًا وبيانًا لأحواله اللدنية التي كان يصعب عليه فهمها بنفسه من غير القرآن، وهذا الأمر منوطٌ بنفوذ الإنسان بكل مشاعره إلى روح القرآن وولوجه عالم القرآن. أجل، إنه لا يمكن ولوج القرآن إلا بالقرآن وبالاعتصام به، وإذا تسنى للإنسان أن يدخل مرة واحدة من خلال المنافذ التي فتحت أمامه وتوصل إلى طاولة التشريح القرآني، فإنه سيشاهد ذاته في هيئة مختلفة جدًّا بروحه ومشاعره ووجدانه. أجل، إن علاقة القرآن بالإنسان في هذا المستوى إنما هي
في مستوى عال من التداخل والوثوق.
حتى إن الإنسان لو لم يجد ذاته في آية من الآيات، فإنه سيكاد يرى في آية أخرى أن كلمات القرآن تحيط به، وتداعب فؤاده، وتتحكّم في نبضاته، ولكن يبدو أنه ليس من السهل الميسور لمن لم يتوجّه إلى القرآن بكل فؤاده أن يفهمه ويجد فيه ذاته ويفهمها. أجل، إن الله جعل في القرآن شفرات الإنسان، فإذا حُلَّت هذه الشفرات وفُكَّت رموزُها فسيُفهم كل شيء، فالقرآن أكبر نعمة من الله وإحسان وهدية إلى هذا الإنسان الذي وَجد نفسَه في زاوية نائية من الكون وحيدًا فريدًا، فبقدر تأسيسه صداقة مع القرآن سيعرف ذاته، ويلوذ بخالقه، ويتخلص من كل أنواع الوحدة.
ولا يدرك الإنسان ماهية القرآن إلا إذا دخل في عالمه؛ فكأن القرآن مجموعة إحداثيات تربط بين الإنسان والكون، بل إن القرآن كما يلفت نظر الإنسان إلى الدنيا فكذلك يوجه نظره إلى الآخرة، فيجمع بين جوانبه التي تتعرض للفناء والتي تتمتع بالبقاء فيؤلّف بينها، ويوضح تركيبته اللدنية كما يُشَرِّح تركيبته المادية.. فمن الممكن أن نجد في القرآن ما يحققه الإنسان من التطور والرقي أو ما يتعرض له من الانحطاط، وكذلك يمكننا أن نرى فيه ما يمر به الإنسان من المراتب والمقامات حينما يتحول من شكل إلى شكل أو حال إلى حال أو طور إلى طور، كما يمكننا التعرف من خلاله على ما يحمله الإنسان من مشاعر وعواطف جياشة وسَير روحي.
فعلم النفس الحديث ما زال بعيدًا عن معرفة الإنسان بهذا الشكل، وأود أن أؤكد بقوّةٍ أنه ليس هناك علاقة بين القرآن وبين المناهج التجريبية التي طورها علم النفس. أجل، إنه لن يكون هناك ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بين الآيات القرآنية وبين تلك المبادئ التي يفسَّر بها الإنسان والتي تم التوصل إليها من خلال التجارب التي أجريت على الحيوانات، ولن يفهم علم النفس مغزى الآيات القرآنية إلا إذا توصل إلى أقصى ما تصل إليه يده وحصل على أدق ما يكتشفه من المعلومات.
ومن الأهمية بمكان أن نعلم أن الآيات التي سنركز عليها ونُورِدُ منها أمثلةً، ليس من الممكن شرحُها بموازين العلم المسمى “علم النفس” الذي ألبسوه شيئًا من الروعة الخيالية فسموه فيما بعد “سيكولوجي”، فعندما نشرح ونحلل الأمثلة من القرآن لن ننحو منحى أفكار شخصيّة حتى نضفي على الموضوع الصبغةَ العلمية، وذلك من مقتضى توقيرنا للقرآن الكريم؛ فإنه إذا لم يتحقّق تفسير القرآن وشرحه بطريقة موافقة لأدائه وأسلوبه الفطري، فسيؤدي ذلك إلى خللٍ في المقصود، فمن أكبر التجنّي على القرآن أن نستخدم في بيانه بعض الموازين والمبادئ التي لم تصل بعدُ إلى مستوى القطعية؛ فالذي ينظر إلى القرآن عليه أن يزيل ما بعينيه من الرَّمَص المصطنع؛ حتى لا ينكسر طول الموجة الشعاعية بما فيه من نصاعة وضياء وثراء، ويبصِر ما فيه من البهاء والوضوح بكلّ عمقٍ واتّساع.
هـ. تحليل لدنّيات الإنسان من المنظور القرآني
إن القرآن يتناول الإنسان بمجموعه، ويقوِّمه كُلًّا متكاملا بحيث لا يهمل أيًّا من مشاعره وأحاسيسه الإنسانية وجوانبه اللدنيّة.. وبتعبير آخر نقول: يكاد يكون من الممكن أن نجد في القرآن الإنسانَ بكلّ أنماطه وأشكاله ومواقفه.
والحقيقة أنَّ شرح لدنيات الإنسان ليس بالأمر الهيّن؛ لأن الإنسان يشبه الكون العظيم في تحوله كل حين من طور إلى طور، وتنقُّله بسره وخفيِّه وأخفاه من شكل إلى شكل، فما هي الأمور التي تحوِّله من شكل إلى شكل؛ فمرّةً تزيده شوقًا وطرَبًا، ومرة أخرى تلقي به في حالٍ من الخمول والاستكانة؟!
ما زالت هذه القضايا تشغل بالَ البشر على مَر التاريخ الإنساني، وهناك في الغرب عددٌ كبير من الذين يبحثون في لدنيات الإنسان، ولكن كل واحد منهم حاول -وما زال يحاول- أن يقوّم الإنسان من جهة واحدة ومن الجانب الذي يتراءى له من زاوية نظرته الشخصية؛ فمثلًا منهم من أخذ ما في الإنسان من الحدس بنظر الاعتبار وأبدى ملاحظاته التشريحية على حسب ذلك، وهناك مَن حلَّل الإنسانَ نظرًا للمشاعر التي تُحرِّكه، وهناك من تَناوَله من جانب منطقه، ولكن لم يستطع أحد أن يقوم بتحليله تحليلًا جامعًا وشاملًا.
فالقول الفصلُ في هذا المجال أيضًا إنما هو للقرآن: أجل، إن القرآن هو الذي يؤكد على أن الإنسان كائن “جامع”، ولا يتم التعبير الحقيقي عن كل نموذج وموقف إنساني إلا في القرآن، بل فيه يتم بيان كل الأحوال والأطوار الإنسانية؛ فما هي الحالة النفسية للإنسان المجرم المذنب؟ وما هي الأحاسيس التي يتشبّع بها أثناء حديثه مع الناس واختلاطه بهم؟ وما هي مظاهر التدهورات الروحية والكآبات المعنوية التي تَظهر على مَنْ لا يستطيع التفلت من الإخفاقات بحال من الأحوال؟ وهكذا يستطيع الإنسان أن يشاهد انعكاسات كل من الآمال الخائبة، والأضواء الخافتة، والآمال المتزعزعة، أو الصدور المفعَمة بالأمل، والأحلام الوردية، والعيون المتلألئة بالثواب، والوجوه المسودَّة بالذنوب، والقلوب النابضة بالشوق والاشتياق، والأرواح المتشائمة المستسلمة للخيبة والخسران.
وأيضًا من سماته الخاصة بصوته ونفحاته أنه يربت على الأرواح المفلسة، ويوجهُ لطائفها نحو المشاعر العُلوية، ويجيّش القلب في سبيل تخطي شتى أنواع العراقيل والعقبات.
ونرى في القرآن دون سواه كيف أن الذين انكسرت قلوبهم وجُرحت مشاعرهم قد وجدوا فيه التسلية فتوجّهوا نحوه ونحو الأوراد.
ولأهل الإدارة ومن يتقلّدون المناصب العليا نصيب في القرآن، كلٌّ حسب موقعه ومستواه؛ حيث إنه يوجههم -بأسلوب أخاذ- نحو الهدف المنشود مباشرة من دون أن يجرح كرامتهم، أو يمسَّ شخصيتهم وأنانيتهم بسوء. أجل، فإذ يجذبهم القرآن إلى ما يستهدفه لهم؛ نراه من الجانب الآخر لا يهمل -بتاتًا- صبَّ الحقائق السامية في قلوبهم وإثارة أشواقهم على طول الطريق.
ومن روائع الأسلوب القرآني أيضًا تحليلُه لنفسيّة الأبوين؛ ففي حين يتمّ تحليل العلاقة بين الأبوين والأولاد حسب أدقّ الحالات الروحية؛ تؤسَّس هذه العلاقات بحيث تحتضن الروح وتُرقّيها نحو المعالي.
أجل، إن الأسرة يتم تناولها في القرآن بأسلوب دقيق وأنيق بحيث تتداخل أفراد الأسرة ويتوجه الكبار نحو الصغار بالشفقة والرحمة، ويتوجه الصغار نحو الكبار بالتوقير والاحترام.
لقد اتخذ أجدادُنا من دساتير القرآن أسسًا أقاموا عليها أنظمتهم، فالجيوش الانكشارية أيضًا كانت مؤسَّسة ومدرَّبة حسب هذه الأسس.. وبفضل ما استخدمه القرآن من المبادئ العامة والخاصة التي تكتشف لدنيات الإنسان؛ تمكنوا من تربية هؤلاء الجنود؛ بحيث يتمتّع كل جندي بشخصيته وذاتيته من جانب، ويتجرد من هذه الشخصية والذاتية مذعنًا لأوامر وليّ الأمر من جانب آخر.
لذا نستطيع أن نقول: إن السبب الذي يكمن وراء تفسّخ هذه المؤسسة وفسادها إنما هو ابتعادها عن القرآن وتخليها عن التغذّي بالقرآن، فلقد أدى التعامي عن المبادئ القرآنية التي تحلل الحياة اللدنية وتشرّحها، بإحدى أقوى دول العالم وأكثرها انضباطًا إلى الانهدام والدمار؛ فقد كان القرآن بمثابة روح ذلك المجتمع وأفراده، وبفضل القرآن كانوا يتكاتفون فيما بينهم ويحافظون على وحدتهم، فتلك القامات السامقة التي ساندت الإسلام كانت شديدة الارتباط فيما بينها بوشائج روحية، وإلا فمجرد اجتماع الأجسام والتواصلِ البدني وتوجُّهِ الوجوه نحو وجهة معينة لم يكن كافيًا لذلك النظام الهائل.. والدليلُ على عدم كفايته هو أن الانكشارية والنظام العسكري الذي أُسّس من بعده لم يحظ بالديمومة والتوفيق. نعم، إنه لم يوفَّق على الرغم من الاستفادة -بأقصى ما يمكن- من مبادئ علم النفس السائدة آنذاك، ومما لدى الغرب من الخبرة العسكرية؛ وما ذلك إلا بعلة الفروق الهائلة من حيث المعنى والمحتوى بين روح الأمة وبين تلك الأمور التي تم تطعيمهم بها.
ولنا أن نعود فنقول: إن النظام التربوي الذي قدمه لنا القرآن كان فيه ما يكفينا وزيادة، ولم يكن لعلم النفس ولا لعلم التربية الحديثِ أن يباريا القرآن وينافساه في ميدان تحليل الإنسان، ولذلك يجب أن تولِّي الأمم المسلمة وجوهها مرة أخرى شطر القرآن ولكن بنظرة أكثر جدية وحيوية.
ونحن في سياق التأكيد على ضرورة هذا الأمر سنقدّم بضعة أمثلة من القرآن، وليس غرضنا أن نقدم درسًا في علم النفس؛ فلسنا من أهل هذا الشأن، كما أنه ليس من مهماتنا، إلا أنه يجب على من يتصدى لتقديم درسٍ كهذا أن يعلم أنه لا يمكن النفوذ قطعًا إلى أعماق الإنسان بحقٍّ من دون الرجوع إلى القرآن والاستفادة مما جاء به.
والقرآن يفتح في كلِّ فرد نافذة يدخل منها، ومن ثم يتجوّل في لطائف ذلك الفردِ فيكشفها بأخص خصوصياتها، ثم يقدم تشخيصاته الصائبة حيالَها، وكما أن الأشعة تنفُذ إلى داخل الأجسام وتتسلّل إلى كلّ الجهات، فكذلك القرآن ينفذ إلى دواخل الناس من خلال النوافذ الروحية، فيفسرها ثم يوجهها إلى الإيمان والإسلام عن طريق التحولات التي يُحدثها فيها، فيدلها إلى سبل الانبعاث، وليس هذا الإرشاد والتبليغ أمرًا منحصرًا في القلوب المؤمنة فحسب؛ بل إنه يَنفذ بين فينة وأخرى إلى داخل الملحد والمنافق فينبههما إلى النور على حسب استعدادهما.
والآن تعالوا بنا نُلْقِ نظرة عابرة على كيفية ولوج القرآن إلى لدنيات الإنسان وما يحققه من التشريحات والتحليلات:
فمثلًا: إن بداية سورة البقرة تتناول أحوال المؤمنين وتكوينَهم النفسي، وتُحلّل وضعهم على سبيل الإجمال على الطريقة التي سبق أنْ تَحدثْنا عنها، إلا أننا نريد أن نركز هنا على الآيات المتعلقة بالمنافقين من السورة نفسها:
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/8-13).
وقبل أن نخوض في تحليل الآيات نودّ أن نلفت الأنظار إلى هذين الأمرين على سبيل الخصوص:
1- إن هذه الآيات تضرب صفحًا عن الكافر بالكلية وتتحدّث عن حال المنافق وما لديه من المشاعر، فكأنها بهذا الأسلوب تقول لهم: “إنكم لستم كفارًا” فبهذا يبقى باب الأمل مفتوحًا أمامهم، وكأنه قيل لهم: “إنكم بين الحين والآخر، تدخلون في طرق متعرجة، فأحيانًا تنحرفون عن الحق، وأحيانًا تدخلون في دائرته، فلو صبرتم قليلًا حين تدخلون في دائرة الحق لوصلتم إلى مستوى الإيمان. أجل، إذا استطعتم أن تتغلبوا على ما بدواخلكم من العداوة والبغضاء والأفكار المسبقة والحسد، وضربتم بها عرض الحائط، وتجرّدتم بعض الشيء عن الأهواء والغرائز البشرية، فإن قلوبكم ستلين، وستتجهون نحو الإيمان”.
2- في هذه الآيات تُلفت الأنظار إلى قسم من الناس وليس لجميعهم، وفي ذلك مراعاة لأهداف سامية جدًّا، سواء من الناحية التربوية أو النفسية.. بمعنى أن الأنظار تُوجَّه إلى المنافقين بتعبيرِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾، بأسلوب مجرد عن التشخيص، ولا تُحدَّد الأسماءُ، فلا يقال مثلًا: الشخص الفلاني، أو القبيلة الفلانية، بل تقدم المسألة على وجه العموم؛ لأن الغرض الأساسي هنا هو الإرشاد، والأصل في الإرشاد ستر حال المدعوين كستر حال المريض عن الآخرين أثناء معالجته، وليس تشهير حاله وقد فتحت جروحه، وإنما يحافظ على كرامة المريض بهذه الطريقة.
وقد كان الرسول يمارس الإرشاد والتنبيه بهذا الخلق القرآني. أجل، إنه لم يقع منه أن شهّر بأحد بسبب ما ارتكبه من الأخطاء، وما عنّف أحدًا على مرأى ومسمع من الناس بحيث يجرح كرامته، بل إنه كان يجمع الناس فيخاطبهم بقوله: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا..”، وبهذه الطريقة كان يرشد مرتكبَ الخطيئة إلى الصواب من جانب، ومن جانب آخر يحذِّر الجماعة من اقتراف مثل تلك الخطيئة. أجل، بمثل هذا الإرشاد لن تُجرح الكرامات، ولن تُهتَك الأستار، كما أن طبيعة الأمر تتطلب مثل هذا الرفق والملاطفة.
وإضافة لما قلناه آنفًا علينا أن نتنبه لأمر آخر أراه جديرًا بالذكر:
وهو أن القرآن حينما يقوم بشتى التحليلات والتأويلات لا يصرح بذكر الأسماء والأشخاص، وبفضل ذلك يحظى كل واحد بنصيبه مما فيه من الثناء أو التنبيه، ولو أن القرآن عيَّن الأشخاص قائلًا: الشخص الفلاني أو العلاني، لَمَا اهتم به الآخرون ولما استفادوا من دروسه على الوجه اللازم، فحينما يكون المخاطب مبهمًا يعتبر كلُّ شخص نفسه مخاطبًا لما فيه من المدح أو التنبيه، فيراجع نفسه على حسب ذلك، وهذا هدفٌ مهمّ جدًّا من ضمن الأهداف العامة للإرشاد، فإذا نظر الإنسان إلى الأمر من هذا المنظور فسيتابِع بحذرٍ أو شوقٍ، وهو يتلو كل آية ويتساءل: ماذا ستأتي به الآية التالية وماذا ستقدمه من شرحٍ وتحليل وتدقيقٍ للشعور النفسي.
ولكن مع ذلك نلاحظ أنه حينما يعالج القرآن في آياته جوانبَ الحالات الروحية، يستحضرُ الذهنُ بعضَ الأشخاص بطريق التداعي. أجل، سرعان ما تتراءى للعين بين الحين والحين أوضاعُهم الإيجابية أو السلبية، وأطوارُهم الصالحة أو الطالحة بأمكنتهم ودُورهم وأحوالهم ومساراتهم، حتى إن بعض المنافقين حينما يستمعون إلى تلك الآيات تنتابهم الرهبة والقلق ويتوجّسون قائلين في أنفسهم: “ها هو ذا كاد يصرّح بأسمائنا، ويفضحنا كلنا، ويَعُدُّ كل ما اقترفناه عدًّا”.
ولما كان القرآن يتوخى أهدافًا سامية في عملية التربية فإننا نجده حينما يُصوّر هؤلاء على هذه الشاكلة يعمّم خطابه في البداية ثم يوجه الناس إلى مسألة معيّنة، وسواء أكان الذين يُصوّرهم منافقين أم غير منافقين، فإنه حينما يتحدّث عن الهموم التي تَشغل بالهم، وتُصوِّر اشمئزاز قلوبهم جرّاء ما يصيبهم من البلايا والمصائب، فإنه يسبر أغوار عوالمهم الداخلية؛ بغية الكشف عما يشعرون به من امتنان أمام تلك الآيات التي لم تفضح أمرهم، ومن ثمّ استثمارها في طريق الإيمان، فإن اطمأنوا أنهم نجوا من الوقوع في هذه الحالة الحرجة، وعزموا على الإتيان بكل أوامر الله جعل القرآن وعودَهم وآمالَهم -وإن كانت ضئيلة- وسيلةً للإرشاد مرة أخرى؛ وبعدما يرفع من مستوى شعورهم إلى هذا الحد يخاطبهم قائلًا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/21)، فيدعوهم إلى قبول الحق.
وأما موضوع ولوج القرآن إلى لدنيات الإنسان عند تحليل الإنسان في إطار الآيات (8-13) من سورة البقرة وكذا ما استخدمه من تشريحات وتحليلات في هذا السياق، فذلك أمر آخر يجب الوقوفُ عليه بشكل مستقل.
أجل، إن كل من يسمع تعبير: “وَمِنَ النَّاسِ” يشعر في داخله بميلٍ نحو مضمون هذه الآية، فالسامع يستعدّ تمام الاستعداد منتظرًا لما يُلقى إليه، ومِن بعد ذلك تقع له بعض التوجّسات، فيبدأ بالتساؤل فيما بينه وبين نفسه: يا ترى هل ستتحدث الآية عن قبائحنا؟ وهذا الانتباه قد يكون بمثابة أُولى الأمارات التي تهيِّئ القلوب والعقول لقبول نداء الحق واتّباع الإرشاد والتنبيه.
ومن بعد ذلك يشرع القرآن فيما يريد أن يذكره؛ وإذ يبدأ بذلك ينفذ إلى الأرواح والقلوب بحيث إن الإنسان إذا ما خوطب بتعبيرات على هذا النحو، تَسارعت إلى ذهنه بعض التداعيات، وكما أن الإنسان إذا شاهد هضبة مرتفعة تتداعى إلى ذهنه قباب المساجد، فكذلك السامع لمثل هذه الآيات الكريمة يتفتح ذهنه على تداعيات ذهنية مختلفة يتولّد عنها أمورٌ كثيرة؛ بحيث إنه كلما سمع ذلك البيان القرآني تداعى له العديد من الأسرار.
فلنفرض أنك شاهدت شخصًا يصلي على تلة مرتفعة، وأثَّر حاله هذا في أعماق دواخلك، فإنك كلما شاهدت تلة مرتفعة فإن اللاوعي منك يبدأ بالتحرك، فيتذكرُ ذلك الإنسان الذي كان يصلي فوق التلة، ومع أنه لا يوجد -حسب الظاهر- علاقة بين المَشْهدين، إلا أن الإنسان إذا أمعن النظر فسيرى أن هناك علاقة قوية بينهما.
إن المنافقين يقولون: ﴿آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ والله يقول ردًّا عليهم: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ لأن في قلوبهم مرضًا ولذلك فهم إنما يقولون: “آمَنَّا” لبعض الأغراض الدنيوية، ويُظهرون الإيمان مع عدم إيمانهم في حقيقة الأمر للحصول على الغنائم والاستفادةِ من بعض المصالح الدنيوية التي يحصل عليها المؤمنون، أو تفاديًا للتعرّض لبعض المخاطر.
فالإنسان الذي يشعر بمثل هذه الحالة الروحية إذا سمع هذه الآيات فإنه سرعان ما يشعر بأن دواخله تُشرَح وتُبيَّن تركيبتُه الروحية، ولكن عدم التصريح باسمه يوقظ في داخله مشاعر الامتنان تجاه صاحب هذا البيان الذي لم يَفضَحْه، فكأنه يقول له فيما بينه وبين نفسه: “إنني أشكرك على أنك -على الأقل- لم تصرح باسمي ولم تفضحني على رؤوس الأشهاد”، ويضيف قائلًا: “إن هذا يعني أن صاحب هذا الخطاب يعلم سري وعلانيتي”.
وحينما يقول القرآن: ﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ولا تثيروا البلابل والفوضى، تتداعى إلى أذهانهم سلسلة الجرائم التي ارتكبوها، وحين يرتجفون تجاه هذه التداعيات التي بدواخلهم يفتح القرآن أمامهم بابًا يدعوهم منه إلى الإيمان.
فهؤلاء المنافقون ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/13)، وحينما تُفضَح قبائحهم وعيوبهم، وتُعرض للأنظار من خلال الآيات القرآنية، يتزلزل كيانهم، فترى بعضهم يسارع للإيمان فينجو، وترى بعضًا منهم يستمرّ في كفره معاندًا، وقد يكون ذلك انعكاسًا للعالم الروحي للإنسان؛ ما إن يجرح شعوره نوعًا ما حتى يُخرج ما في جوفه من الأراجيف، ولكن القرآن لا يقضي بتاتًا حتى على آمال المنافق الذي انحدر إلى هذا الوضع المهين، ولا يخيِّب رجاء الإنسان الذي وقع بروحه في هذه الحالة الضعيفة، بل يترك له باب الأمل مفتوحًا ويبعث فيه الرجاء.
وهنا درس مهمّ للغاية ينبغي للذين دأبوا على مهمة الإرشاد والتبليغ أن يعتبروا به، وهو أن القرآن الكريم كان يستهدف قلوب المنافقين لينفذ إليها فيهديهم، رغم أن تلك القلوب امتلأت بالفساد والمرض؛ فلا ينبغي لرجال الإرشاد والتبليغ أن يبلّغوا الحقائق ثم يتنحّوا جانبًا؛ لأنه إذا كان لنشر الحق والحقيقة قيمة عند الله، فستكون لتحقيق قبولها لدى الناس وتبنيهم له قيمة فوق القيم؛ بمعنى أنه ليس لأحدنا أن يقول: “دعُوني أقول الحق والحقيقة بشكل أو بآخر وأنادي بها على رؤوس الأشهاد، ولا يعنيني بعد ذلك هل اقتنعوا بها أوْ لا”، بل علينا أن نقول: “يا ترى كيف لي أن أقول هذا حتى يقبله الناس بقبول حسن، ويؤثرَ فيهم ويبعثَ فيهم الحماس ويحركهم نحوه!!”.
أجل، إنه من الواجب علينا أن نحمل في دواخلنا على وجه الدوام همَّ سلامة الأسلوب والإخلاص والمهارة.. فالحديث عن الحقائق المألوفة قد يؤدي بالناس
إلى رد فعل سلبي، فينحرفون إلى الطرق الخاطئة، ويكونون معارضين لذلك الحق، ولذا علينا أن نبحث عن الذين يتقبلهم الناس بقبول حسن فنمنحهم الفرصة لدعوة الناس إلى الحق، وذلك من أجل الحفاظ على الحق.
فالقرآن الكريم يهدف إلى تحقيق ذلك، ويحاول أن يحصل على الثمر ولو كان من أرض سَبْخَة مثل النفاق؛ فلذلك لا بد أن تُقدَّم الحقائق بأسلوب يبعث في النفوس الأمل في رحمة الله ولو كان المستمع إليه منافقًا، فأرباب مثل هذه النفوس إذا لم يُفضَحوا مباشرةً، فكثيرًا ما تلين قلوبهم نوعًا ما ويؤوبون إلى الله نادمين.
وأظن أنه سيكون من المفيد أن نزيد في شرح كيفية تناول القرآن للدنيات الإنسان:
يقول الله : ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/14).
فالملاحَظ هو أن القرآن في أثناء حديثه عن الأمور التي تجذب الإنسان يذكُر المرأة أيضًا.. وللمرأة في نظر الإسلام مكانة عالية.. إلا أن الأمر أسيء استخدامه، فجُعلت -ولا تزال تُجعل- المرأة “محرابًا”.. فمثلًا: إن نظام “فرويد” مدرسة تَبَنَّت الإفراطَ في هذا الباب، كما أن هناك فئات من شتى التيارات النسائية بَنَتْ أفكارَها على هذه النظرة وتورّطت في الخطإِ نفسه، فإن المرأة في نظرتهم بمثابة محراب للأحاسيس الشهوانية
بل هي بمنزلة “معبود” لها، وأكثر من ذلك هي مِثل “العلة الغائية” لوجود الإنسان.
وكذلك حب الأولاد، فهو ليس دون المرأة في كونه جزءًا لا يتجزَّأ عن الحياة البشرية، ومن الجانب الآخر: حب المال من الأمور الأخرى التي يشغف بها الإنسان، وأيضًا تخصُّ الآيةُ بالذكر “القناطيرَ المقنطرة من الذهب والفضة”، وبذلك تلفت الأنظار -من وجهٍ ما- إلى كل الذين يلهثون وراء المنافع، والمرابين والمحتكرين والسماسرة والمضاربين في الأسواق.
نعم، إنه يؤكد بقوله: ﴿وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ﴾ على أنه لا بد من التنبه تجاه النقود وسائر الأموال المعطلة التي لا تتحرك في الساحة التجارية، والتي يُحتفَظ بها في زاوية من الزوايا فتكون مهيأة لتعقيد الأمور في اقتصاد السوق.. حتى يحذر الناس هؤلاء الذين يستنزفون قوت الناس، فيكدِّسون النقود ويعيشون على المراباة والاحتكار.
ففي مثل هذه الطريق التي تكون فيها الأموال مكدسةً مرصودةً، والخيولُ والسياراتُ مجهزةً للَّهو، فلا مفر من أن أصحابها سيكونون في قمة البذخ والكبرياء والخيلاء، وسيعيشون حياتهم أمام الناس بطرًا ورياءً، بل قد ينحرفون أحيانًا بالكلية إلى وقاحة تامة تجعلهم يمسون عزة الخالق وينتهكون حقوق المخلوقين.
أجل، إن كل هذه الأمور بمثابة المزالق التي من شأنها أن تنحدر بالإنسان رأسًا على عقب؛ ولكنها تُعتبر -بالنسبة لمن يستثمرها- درجاتٍ في المعارج النورانية.
ثم إن قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يؤكد أن هذه الأمور دنيوية، والمفهوم منه أن هذه الأمور إن لم تُستثمَر في سبيل الحق، فستكون من حبائل تجر صاحبها إلى الطرق الشيطانية، وحتى لا يقع الإنسان في مثل هذه الحبائل، تقول له الآية: “إن فيك ضعفًا مهمًّا نحو النساء، وفيك ميل قوي إلى الأولاد والعيال، ولديك محبة تجاه متاع الدنيا”، وبذلك تُذكِّره بما فيه من الفراغات النفسية، ولكن ليس له الاعتراض بحجةِ أن الله هو الذي أَودَع كلَّ هذه الأمور في فطرة الإنسان، وكأنه يتساءل: “كيف نؤاخذ بما جُبلْنا عليه”.. صحيح أن هذا الميل الفطري والمحبة الجبلية قد أُدْرِجَتا في الفطرة البشرية، إلا أن الحياة ليست عبارة عن هذ الميل وتلك المرغوبات فحسب. أجل، فالإنسان لم يُخلق ليتشبع بهذه الأمور؛ بل فيه ميول ورغبات أخرى متوجهةٌ نحو أهداف عالية وغاياتٍ سامية.
ففي الوقت الذي ينبري فيه الإنسان لتلبية نزواته مسترخيًا، إذا به يخاطبه القرآن الكريم قائلًا: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فيقصم ظهر ما في طبيعته من هذه الأمور الرذيلة، ويوجهه نحو المعالي بأسلوب يَقلِب حلاوة الأذواق إلى أمور مريرة، واللذائذِ إلى الآلام، ويعصف بعالمه الذهني ويغيِّر وجهة عالمه الفكري.
أجل، إن هذه الأمور كلها متاع الحياة الدنيوية، والدنيا لا تقف عند حدود الاستمتاع، بل تذيق الإنسان أحيانًا مُرَّ الثمار، وهي بصنيعها هذا تَحُول بين الإنسان وبين روحه وتسحبه إلى مهاوي الجسمانية.
والحقيقة أن الإنسان يعيش حياته بين مثل هذا المد والجزر، فتراه يميل إلى الدنيا بأحاسيسه ونزواته إلى درجة العبودية لها، وأحيانًا أخرى تهب في دواخله نسمات طيبة فيبتعد عن الدنيا وعن متاعها كل البعد، فيتجول في آفاق القلب والروح، فالقرآن يسلّط الضوء على ما في الإنسان من هذه المشاعر المختلفة واحدة تلو الأخرى.. فينفُذ إلى دواخله وكأنه يجري منه مجرى الدم، وبذلك يوجِّه روحه نحو الغايات السماوية والمعارج الأخروية.
أجل، فحينما يقال: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ تُفاجِئُنا الآية في المكان المناسب بالتأكيد على أن النعم والأذواق ستنتهي وسينطفئ بريقها بعد حين، وتترك مكانها للآلام والأكدار، وأنه سوف يأتي يوم يخلُف فيه المشيبُ الشبابَ، ففي هذه الأمور التي تتعاقب وتتقلب تذكيرٌ للسامع وتنبيه له إلى مدى تناقض حياة الإنسان وعدم تناسقها.
نعم، إن الإنسان سيَفقد نعم هذه الدنيا واحدةً تلو الأخرى، وسيفقد شبابه ويقع في شِباك المشيب، وفي نهاية المطاف سيتركه كلُّ شيء ويُطرح من هذه الدنيا في مكان لم يكن في حسبانه، ومن يدري؟! فقد يَترك كلَّ شيء ويمضي في الوقت الذي كان يظن أنه قد تم له كل شيء فيه، وحين يروح سيُمحى اسمه من الأذهان، وتضمحل ذكرياته واحدة تلو الأخرى.
فهذا هو الوجه الحقيقي للدنيا، وهذه هي عاقبتها الأليمة، وكلما شعر الإنسان بشتى طرائق التداعي يحترق فؤاده، وكلما شعر أنه ظفر بالدنيا وطفحت مشاعره لاعتقاده بأنه نال السكينة والطمأنينة اختنق بهذه الأفكار وانهدمت الدنيا على رأسه كل يوم عدة مرات.
ففي مثل هذه الحالة يميل الإنسان من حيث لا يدري إلى البحث عن مخرج، ويظل يبحث عن مستند يكون مصدر تسلية له، وتسوقُه أحاسيسُه ولدنياته إلى آفاق المَلجإ والمنجى، فإذا قال له أحد في حالته هذه: “أيها الصَّديق، إن يذهب شبابك في دار الدنيا فإني أعِدك بشباب سرمدي، وإن تذهبْ دنياك فإني أوصيك بالتوجه إلى دار أجمل من الدنيا، وإن تكن تعرضتَ في مالك وملكك لعاقبة ذابلة باهتة، فسأدلك على دارٍ بها سعادةٌ أبدية لا تذبُل ولا تَبهت بل تُداعبُ كلَّ أحاسيسك ومشاعرك…”، فإنه سيميل إلى ذلك النداء من فوره؛ لأنه في حالته هذه يكون قد خارت قواه وخابت آماله، ووجود باب للرجاء ومنبعٍ للتسلي مثل هذا الباب سيُثلج صدره، وحتى إنه لو لم يظفر به في الواقع فحالته النفسية ستصدقه وتعوّل عليه وسيقول -فيما بينه وبين نفسه-: دعُوني أعيش ما بقي لديّ من الدقائق في راحة بال بما يبعثه منبع التسلي هذا..
ففي مثل هذه النقطة التي تُخَيِّب كلَّ آماله، ينجده القرآن ويأخذ بيديه بوعود متناهية في الصدق وبريئة عن أدنى خُلْف، ويربت على كل أحاسيسه ومشاعره وروحه، ويدعوه إلى جنة تكون بدايتها في قلب هذا الإنسان.
﴿وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ أي إن كل المحاسن والأفراح والمعايش الزاخرة بالسعادة، وكلَّ النعم التي لا تذبُل ولا تَبهت لهي عند الله.
ولنتصور نفسية شخص في مثل هذه الحالة تجاه هذه البُشرى، وكم سيتشبث بكل ما يملك من قوة، بما انفتح أمامه فجأة من باب الرجاء هذا، فلْنتخيلْ تلك الفرحة تَلُوح على وجهه جراء ما تَبدَّى له من الأمل في تلك الحالة المتأزّمة التي ضاق فيها ذرعًا ووصل إلى حدّ الاختناق، حتى ندرك مدى تعبير القرآن عما يدور في دواخل السامعين وإفصاحه عن مشاعرهم.
والحقيقة أنه لا يوجد فينا أحد لا يتصور هذه الأمور في الحياة الدنيا، وهل منا مَن لا يتوجع قلبه إزاء ما يفاجئه من النوائب التي تذهب بكل ما يملكه بعدما كان يتقلّب فرحًا وسرورًا في النعم التي تأتي إليه؟ فالإنسان مجبول على كل هذه الأنواع من الصعود والهبوط والطمع في الدنيا، والافتتان بشتى أضرُب المنافع، والقرآن زاخر بالحديث عن نقاط الضعف هذه مع الإتيان بحلول لها.
والواقع أن القرآن يتتبع الإنسان خطوة خطوة، ويستمر في تعقبه على الدوام، وإن القرآن يتعقبه ليتداركه في الوقت المناسب الذي يكون فيه ضعيفًا ويكون قلبه راغبًا ومهيَّأً، فيقولَ له على لسان رسوله: ﴿أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/15)، أي هل أخبركم بشيء هو خير من الدنيا التي خضتم فيها وتوجهتم إليها بكليتكم وثملتم بأذواقها وانبهرتم بما حصلتم عليه من الإمكانات، فبطرتم بمالها وملكها؟
وفيما تكون الروح مستعدة لأن تجيب عن هذا السؤال بـ”نعم”، إذا بالسياق يتدارك قائلًا: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَالله بَصِيرٌ بِالْعِبَاد﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/15).
فالقرآن المعجزُ البيانِ خير ملجإٍ وملاذ لأولئك الذين يحملون في قلوبهم هَمَّ الدنيا، ويتوجّسون من فقدان أموالهم وأملاكهم، ويتخبطون يائسين من مستقبلهم بقلوب منكسرة، ويتلوَّوْن في تخوُّف مما يؤول إليه حالهم حينما يُبعثون بعد الموت.
أجل، إن هذه الرسالة القرآنية لهي وحدها الملجأ ومنبع الوسيلة لكل من يستغيث قائلًا: “ألا هل من منقذ يُرقِّيني إلى كمال الإنسانية، ويوصلني إلى أعلى علّيّين؟
والقرآن يعطي مقابل ما يفقده بعض الناس من جنان الدنيا وسعاداتها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، وهذه التعبيرات فوق كونها تسلية هي مبشرات بحقيقة عظمى وحياةٍ تمتدّ إلى الأبدية.
والله تعالى يقول من بعد ذلك ﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾.. فالذي يحلل آيات القرآن واحدة تلو الأخرى ويمعن النظر فيها بشكل جدي، سيرى أنه يتتبع الإنسان ويعبر عن كل مشاعره وأحاسيسه.
وإلى جانب تعبيره عن المشاعر اللدنية، هناك أمر آخر لم يُغفله القرآن ولم يبعده من اعتباراته، وهو أنه يفعل كل ما يفعل مِن تناوله للقضايا وشرحِه للأحاسيس بغرض توظيفها في سبيل الإرشاد والتبليغ، ويمكن مشاهدة هذا الهدف السامي في جميع آيات القرآن الكريم، ومن هذه الناحية يمكن القول: إن القرآن هو المصدر الذي لا يمكن أن يستغني عنه المخلصون والمضحُّون الذين نذروا أنفسهم لمهمّة الإرشاد والتبليغ.
أجل، إنه يجب قطعًا على الذين يريدون أن يستخرجوا قواعد كلية ومبادئ عامة تتعلق بالإرشاد والتبليغ أن يستعرضوا القرآن من أوله إلى آخره ويحللوه من هذا المنظور على وجه الخصوص.
و. القرآن يخاطب الفطرة
إن حضارة عصرنا ثمرةٌ لعقليّة مادية.. كما أن التيارات المادية والعقلانية المتعاقبة أفسدت الإنسان من الناحية المعنوية، وجرفته نحو تكثيف همته حول المادة.
فهذه الأفكار والمقاربات المادية هي التي أبعدت الإنسان عن فطرته، وجعلته متوحّشًا بذهنه وفكره تجاه كثيرٍ من القضايا لا سيما عالَمه اللدني، وللأسف نرى أن مثل هذه الأفكار المادية عكّرت صفوَ أذهان بعض المسلمين، فحضارة عصرنا المريضة من بعض النواحي والتي نسميها “الحداثة”، قد سَرَت إلى كل مؤسسات العالم الإسلامي وكأنها مرض معدٍ، فشلَّت حركتها.
ولا شك في أن الفطرة الإنسانية هي أكثر المتضررين من هذه الظاهرة.. حيث إنه صار من شِبه الأمور المنسية أن يستمع الإنسان إلى ذاته ويفهمها ويسيطر عليها.
لقد أصبحنا متوحّشين تجاه ذواتنا منذ سنين عديدة، لذلك نعتقد أنه من الضروري لحياتنا الإسلامية أن يتوجه إنساننا إلى ذاته، ويجد نفسه في القرآن، فيفسر ذاته وكل الأشياء الأخرى على حسب ذلك، وهذا من القضايا التي يجب تناولها باستقلال من زاوية علم النفس، وهو مدى أهمية استماع الإنسان لذاته وتحكّمِه فيها وتعمّقِه داخليًّا.
فحصول الإنسان في هذا الباب على نتيجة، وتحديدُه لهدف التحكم الداخلي، وتعمقه الداخلي، وفهمه لمعناه وماهيته من الأمور التي لا يتسنى البلوغ إليها إلا بالقرآن، فإذا لم تُفهم المقاصد والأهداف القرآنية فإن كل ما سيبذله الإنسان من الجهود ستذهب سدى ولن تغني عنه شيئًا.
فماذا يفعل الإنسان حينما يستمع إلى ذاته؟ وماذا يحصُل حينما يتعمّق داخليًّا؟ وماذا يتحقق له إذا اطلع على لطائفه ومشاعره وأحاسيسه الداخلية؟ أجل، إنه لا يمكن العثور على جواب عن كل هذه وما شابهها من الأسئلة إلا في القرآن، والذي لم يتعمق في داخله ولم يرتق إلى مستوى الاستماع إلى ضميره ولم يَمثُل بين يدي مولاه كل يوم مرات عديدة بهدف محاسبة نفسه فليس له أن يفهم مقاصد بيان القرآن المعجز التي تتعلق بهذا الأمر.
فلأجل أن يفهم الإنسان القرآنَ عليه أن يستمع دائمًا إلى صوت ضميره، ويتوجهَ كل يوم مراتٍ عديدةً إلى دواخله، ويحاسبَ نفسه، ويستمعَ إلى صوت روحه، ويتخلص من عبودية نفسه، فالإنسان الذي لا يفهم نفسه ليس له أن يفهم القرآن.
أجل، إن التعمّق الداخلي يعتبر تمهيدًا لِفهم القرآن، وقد سبق أن لفتنا النظر إلى ثلاثية (القرآن-الإنسان-الكون)، لأن بين هذه الثلاثة ارتباطًا وثيقًا دائمًا، والقرآنُ يشرح الإنسان والكون في مئات من آياته، ولا يوجد هناك كتاب ثان يضاهيه في هذا المجال، فحتى علم النفس الحديث لم يصِل -ولن يَصِل- آفاقَ القرآن في باب شرح الإنسان وتحليله وإن أي علم من العلوم مهما بلغ من التقدم والرقي لن يستطيع الوصول في هذا المضمار إلى أدنى المعارف التي بينها القرآن وسيكون القرآن قد سبق كل المعارف مرفرفًا برايته السبّاقة.
وحينما يتحدث القرآن عن الإنسان يسلك طريقًا ينساب من خلاله إلى مشاعر مخاطبيه، فيستحثهم خطوة فخطوة نحو الإيمان، ويحفِّز أحاسيسهم، وكأنه يستخرج الحي من الميت، ويستثير فيهم ملكاتهم التي تفيدهم في حياتهم الأخروية، فتراه يلفت الأنظار إلى حالتهم الروحية فيتحكم فيهم من خلال أضعف جوانبهم ويستأصل منهم الميل نحو الدنيا، بمعنى أنه يستثمر كل ما أُودِع فيهم من القابليات فيعدُّها لقبول الحق والحقيقة.
ز. القرآن الكريم والإرشاد
1- الاستقامة في الإرشاد
إن القرآن المعجز البيان حينما يرشد الإنسان فإنه دائمًا يسلك طريق الاعتدال والاستقامة، ولا يفتح المجال للإفراط والتفريط في تنبيهاته وتنويراته.
أجل، إنه لا يوجد في القرآن شيء من الأمور المفرطة التي تُخلّ بـتوازن الإنسان الروحي، وتقلب تناغمه المعنوي والعاطفي، فحينما يتحدث عن المجرم لا يحطم كرامته وكذلك لا يُطْري في مدح صاحب العمل الصالح كي لا يعجب بنفسه. أجل، إنه حينما يدغدغ المشاعر ويراعي الأحاسيس ويقوم بمختلف التشريحات والتحليلات، يراعي دائمًا هذا التوازن، ولا يحيد عنه قطعًا..
فالبعد عن الإفراط والتفريط الذي نعبِّر عنه بـ”الاستقامة في الإرشاد” لهو أمرٌ مهم في باب تحليل الإنسان؛ فمِن الناس مَن إذا دُغدِغت روحه -ولو قليلًا- فإنك تراه يرتخي بل قد تتميع لديه روح العبودية، كما أن هناك -بالمقابل- من إذا نُقِّبَ -ولو قليلًا- عن مساوئه التي اقترفها ومُسَّ كبرياؤه فإنه سرعان ما يتخبط في أوحال اليأس والقنوط.
وكم من أناس ظنهم الآخرون سالمين، لكنهم سقطوا رأسًا على عقب وهلكوا بسبب ذنب صغير اقترفوه، إذ كل من يذنب يكون قد خطا خطوته الأولى نحو هذا الهلاك، فـ”في كل ذنب هناك طريق يؤدي به إلى الكفر” .. وليس أحد من بني الإنسان معصومًا من المعاصي.
أجل، إن مقاومة المعاصي أمر صعب جدًّا، إذا لم يكن لدى المرء إيمان راسخ وإرادة قوية، ويصعب الأمر بشكل كبير على أبناء هذا الزمان الذين أحاطت بهم المعاصي من كل جانب، ومن هذا المنطلق ينبغي عدم المبالغة في التحامل على من اقترف ذنبًا، ولكن يجب -في الوقت ذاته- عدم التّساهل في المعصية أيضًا، وقد يهلك العاصي بما عصى إذا لم يكن هناك يد تمتد إليه، وتنقذه مما تورط فيه خطأً وغَلبت عليه مشاعره، وتنتشله من عالمه إلى آفاق السلامة، وتربطه برحمة أرحم الراحمين.
فلذلك سيكون من المهم بالنسبة للمجرم الذي تعرض لمثل هذه الحالة أن تُفتح له أبواب الأمل ويُربَّتَ على أحاسيسه، حتى يؤمن بسعة الرحمة الإلهية فيَخلصَ
من المستنقع الذي وقع فيه.
وبالمقابل إذا كان هناك من قام بأعمال صالحة فإن الإطراء في مدحه والمبالغةَ في جرعة التوجه والالتفات إليه قد يؤدي به إلى البطر والغرور من حيث لا يدري، فيكون من الخاسرين في معرض الربح.
وهذا يعني أن تعديل الجرعة وضبطَها بالغُ الأهمية في باب الإرشاد والتبليغ.. وهذا ما نعبر عنه بـ”الاستقامة في التبليغ والإرشاد”.
فهذا الشخص الذي انتُشل من المستنقع من ناحيةٍ، ينبغي حمايته من ناحية أخرى دون الوقوع في الإفراط والتفريط حتى يفيد إرشاده شيئًا، وهذا من الأمور التي يخطئ فيها كثير منا في هذا العصر، بل إن للعلم في هذا الميدان أخطاء لا تعد ولا تحصى، ولكنك لن تجد في القرآن المعجز البيانِ أي شيء فيه انحراف عن خط الاستقامة، فكل ما فيه هو في موقعه المناسب، ومراعاة الطبيعة والفطرة هي في إطار الموازين الصحيحة.
وكما أننا نجد في القرآن توازنًا بين الخوف والرجاء، نجد فيه أيضًا موازنة بين التواضع والكبرياء، والمحبة والبغضاء، ولا يوجد وصف للجرعات الحساسة الموزونة بالموازين الدقيقة إلا في وَصفات القرآن، ولا تُلخَّص آليات الموازنة بين الدنيا والآخرة، والمفاضلة بين الإيمان والكفر، وتحليل وتدقيق شخصية المؤمن والكافر والمنافق إلا في بيان القرآن فقط.. ولذلك نقول: إن العلم الحديث والإنسان المعاصر يحتاجان دائمًا إلى القرآن، فحينما يربت القرآن على روح المجرم ويلاطفها لا يداريه في إجرامه، بل يبقى في حدود ما يتوعد به فيرغِّبه إلى الأعمال الحسنة لينتشله من إجرامه.
كما أن القرآن يحتوي على وصف أقصر الطرق الطبيعية المؤدية إلى استجابة الدعوات.
إن القرآن لا يخاطب عقل الإنسان فحسب بل ينادي روحه أيضًا، وبذلك يحرك مشاعره ويرشده إلى الطرق المؤدية إلى السعادة الأخروية، والقرآن يُسخِّر كلَّ الأدوات في سبيل الإرشاد والتبليغ، ويتناول أصغر الأمور على النحو المطلوب، ولا يتجاهلها ولا يهملها، ويتناول الإنسان باعتباره كلًّا متكاملًا بمادته ومعناه، ويضعه على طاولة التشريح، ويكشف عن المرض ويشخِّصه، ويبعث الأمل في الإنسان ويشجعه ويجذبه نحوه، والقرآن يوارب الأبواب دائمًا لأولئك الذين فسدت أرواحهم ويتيح لهم فرصةً تلوَ الأخرى.
إن القرآن هو الذي يبيّن أن الله: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ (سورة الرُّومِ: 30/19)، فليس في القرآن كلمة واحدة تؤدي إلى التراجع والجمود وإلى ما يفسد الأخلاق والمعنويات.
ويستطيع الإنسان أن يجد ذاته في القرآن بظاهره وباطنه ومن كل جوانبه.. ورسالة القرآن إنما هي رسالة ذات استقامة في التوازن بين الظاهر والباطن، كما أن المعرفة الصحيحة والموازين الدقيقة الحقّة التي لها دور في التربية وتحليل نفسية الإنسان لهي من الأمور التي لا توجد إلا في ثنايا صحائف القرآن المعجز البيان.
2- إرشاد النفوس العالقة في أوحال المعاصي
لقد ركزنا منذ البداية وإلى الآن على أن القرآن هو كلام الله من كل الوجوه، وأنه يستحيل على البشر أن يأتوا بمثله.. وكان هدفنا من لفت الأنظار إلى أسلوبه في إرشاد الناس من مختلف المستويات والثقافات والعقائد، هو أن نبين مرة أخرى ونَعْرِضَ للأنظار مدى تفرده من بين سائر أنواع الكلام، فإن الإنسان إذا تمعّن في القرآن بتدبر عميق فسيقول في نهاية المطاف: “ليس هذا إلا كلام الله”، وقد رأينا هذا الجانبَ من خلال الأمثلة التي أوردناها إلى الآن، وليس لنا أن ندَّعي أننا بيَّنَّا في هذا المقام ما يتمتع به القرآن من تلك الجاذبية الخاصة به، وإنما غاية ما في الباب أنني أردت أن أنقل للآخرين ما شعر به قلبي وروحي من المعاني التي استلهمتها من القرآن ذاته.
إن فهم القرآن والإحاطة بأسلوبه الفريد يتطلب معرفة جادة به، ونحن بدورنا لم نرجع في عملنا هذا إلى أي مصدر آخر غير الكتاب والسنة الصحيحة حتى لا يتكدَّر صفوُ أذهاننا بسائر الآراء والأفكار وبذلك حاولنا تقديم الحقائق التي تكوّنت من التقاء هذين المصدرين.
أجل، إن القرآن الكريم يتولى أمر إبراز جاذبيته بنفسه، ويكفي في ذلك أن تتسامى الأرواح وترتقي نحوه، ولا تتوجه إلا إليه، والقرآن يشرح قضيته ويعبر عنها بأسلوب لا يفوقه أي بيان وتعبير، وحينما يكشف عن الحالة النفسية للناس يجعل السامع يشعر وكأن القرآن يجري في دمه وعروقه.
والآن كمثال على هذه الأمور التي تَحدَّثنا عنها؛ تعالوا بنا نتابع الحالة الروحية والمشاعر الداخلية لعبد اقترف الخطيئة، من خلال قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/31).
وعليَّ أن أعترف أنه لا يمكنني أن أعكس حقيقة جمال الآية من خلال مثل هذا التفسير المتواضع.
أجل، إن التفسير مهما كان دقيقًا فمن المحقَّق أن هناك حقائق عديدة يتم التعبير عنها في الآية عبر مختلف أوجه الدلالات إلا أن التفسير يعجز عن نقلها إلى لغة أخرى، فأنَّى للتفسير أن يعبر عما في البيان الإلهي من الإشارات أو التلميحات إلى بسمة أو طرفة عين أو قسمات وجه، فكم في تلك التعبيرات الغنية من الإشارات أو الرموز أو مستتبعات التراكيب التي يستحيل إبرازها من خلال التفسير، فتدبّروا في قول الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/31).
فتخيلوا أن هناك إنسانًا تلطخت يداه بالدماء، واحمرت عيناه بالدماء، ويسطو على ما حوله يمنة ويسرة، حتى بلغت به هذه الحالة الجنونية إلى أن يدمر ويحرق ما حوله، فهذا الإنسان إلى جانب مقارفته المعاصي هو لا يحترم القوانين الكونية ويشاكس من حوله بمنتهى الفظاظة.. وهذا ما نفهمه من تعبير “كبائر”.
فكل المعاصي الكبيرة التي تتبادر إلى الذهن تدخل في نطاق كلمة “الكبائر”، فهذا الإنسان إلى جانب ارتكابه للمعاصي والكبائر والمنكرات فإنه ينشرها -في الوقت ذاته- إلى ما حوله، ويشجع عليها ويقوم بالدعاية لها، والأدهى والأمر أنه يقوم بتأسيس مدرسة للمعاصي والعصاة.. فتخيلوا مجرمًا بهذا المستوى يسيلُ لعابه وهو يهجم على من حوله، فإذا بالقرآن يهمس في أذنيه وهو على هذه الحالة: “إن تجتنب هذه الأعمال التي ترتكبها…”، فيبثّ روح الأمل فيه قائلًا: “إن تأخذ موقفًا صارمًا تجاه الكبائر، وتغمضْ عينيك عن المعاصي فور رؤيتك لها، وتتوَخَّ الحذر بيديك ورجليك وعينيك وأذنيك تجاه الخطايا، فإننا سنجعل ذلك كفارة لما اقترفته من المعاصي”.
فنلاحظ أن المطلوب من المجرم شيءٌ قليل، وهو أن يتخذ موقفًا تجاه الشرور التي تترصد حياته القلبية والروحية لتهلكه.. أجل، إن المطلوب منه هنا هو التخلي -فقط- عما يرتكبه من المعاصي، ليكون موقفه هذا كفارة لجرائمه، وإن لم يبدأ بعدُ في الأعمال الصالحة، وأظن أن كل من أصغى إلى صوت ضميره فسيعتبر مثل هذا النداء من الله بشارة للخلاص؛ فإنه لم يُطلب منه بعدُ الشيءُ الكثير من الخير والحسنات، بل قيل له فقط: “إذا صادفتَ السيئات فدعها وشمر عن ساعديك متجهًا نحو الشاطئ الآخَر من دون أن تتلوّث بالمستنقع”، فإذا وصل إلى الشاطئ الآخَر نظيفًا فإنه سيفوز بالوجود والخلاص الأبديَّين.
﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ تقول الآية الكريمة: إن تقوموا بهذا العمل على هذه الشاكلة فإننا سنسمو بكم من أسفل طبقات الإنسانية إلى أعلى عليين منها، وسندخلكم -بصفتكم أناسًا ذوي أصل كريم- الجنةَ التي هي دار الأعزّاء.
فمثل هذه التعبيرات تُهدّئ روح كل مجرم تقريبًا وتوارب له باب الأمل، فإن الواقع هنا هو التغير العمودي الذي يُشْبه الارتفاعَ بسرعة الصاروخ من قعر بئر إلى رأس المَنارة، بالإضافة إلى أن هذا الإنسان لا يتحمل من عناء هذا السفر الغالي سوى إغماض العين تجاه الحرام.
فالآن تصوَّروا -من جانبٍ- قُبْحَ الكبائر التي تجعل المذنب يشعر وكأنه وصمة عار في الحياة.. ومن الجانب الآخر، تصوّروا حجم اللذة الروحانية والحماس المنبعثين في روحه بسبب البيان الرباني الكفيل بخلاصه من مستنقع المعاصي الذي يتخبّط فيه، ومِن بعد ذلك حاوِلوا أن تفهموا كيف يُهيّج القرآنُ المعجزُ البيان مشاعرَ الناس وأحاسيسهم وحماسَهم وأشواقهم، وكيف يصبح منبعًا فياضًا لِبعث الأمل في الأرواح التي فَقدت آمالها، افعلوا ذلك حتى تفهموا أنه معدن الإرشاد الذي ينشر أنفاس الحياة.
ولنتصور في أذهاننا نوعًا من المجرمين، ولننظر إلى المشهد الذي يُعرض فيه أولئك الذين هاجموا المؤمنين، وساموهم سوء العذاب بسبب دينهم وإيمانهم، ولم يتبعوا الرسل والرسالات ولم يستسلموا للحق والحقيقة، ولننظر إلى الآيات وهي ترسم صورة الذين اتخذوا العصيان شعارًا لهم من خلال ارتكاب شتى ألوان المساوئ، أولئك الذين دأبوا على تعذيب المؤمنين وممارسة الظلم عليهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ (سورة البُرُوجِ: 85/10).
فهذه الآية الكريمة تَعرض للأنظار -بشكل وجيز- كلَّ أولئك الغوغائيين من الكَفَرة الفَجَرة الذين تسلّطوا على المؤمنين والمؤمنات دون تمييز لأحد، وهددوا حياتهم الدنيوية والأخروية بلا هوادة، ولكن علينا أن ننظر إلى الموضوع من زاوية قوله تعالى في سياق الآية ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾؛ فإنهم حينما ينظرون إلى الموضوع من زاوية ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ فإنهم سيظنون أنه ليس لهم مَخرج وباب للأمل، ولكن قوله:
﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ يَعِدُهم ضمنًا بمفاجآت، فحينما يسمع المجرم هذا الكلام يشعرُ وكأنه على جسر يوصله إلى شاطئ السلامة وبر الأمان.
أجل، إن الذين يدأبون على إجرامهم، ولا يتخلون أبدًا عن المعاصي، والذين لا يستطيعون التخلي عن ارتكاب المحظورات، يستحقون عذاب النار يوم القيامة، ولكنهم إذا أرادوا فهناك دائمًا باب مفتوح يستطيعون الخروج من خلاله من سجن المعاصي الذي وقعوا فيه.. إنه باب التوبة، وباب التوبة مفتوح دائمًا أمام كل أحد.
فلنتصور مدى تألم الروح المجرمة تجاه تهديدات هذه الآية، وشدةَ تلك العواصف التي تثور بداخله جراء سماعه الحديثَ عن “العذاب الإلهي”، ثم لنتخيلْ كيف يفتح قولُه تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ له باب الأمل، فيكون كيوم ولدته أمه إذا تخلى عن قبائحه، فحينذاك نغدو وكأننا نرى رأيَ العين كيف تُرَبِّتُ الآيةُ على قلوبهم وعواطفهم.. وهذا يعني أن القرآن الكريم حتى حينما يتناول المجرمين لا يحيلهم إلى اليأس والقنوط قطعًا، ولا يصدمهم بمعالجة القضية من جانب المعاصي فقط، وحينما يُصدر الحكم يوارب لهم باب الأمل والرجاء، وبهذا يعطي الفرصة لأمثال هؤلاء حتى يتخلوا عن المعاصي ويتوبوا.
3- القرآن الكريم وطاعة الرسول
من أهداف إرسال الرسل بالرسالة السماوية هو أن يطاعوا من أَجْل الله، والقرآن الكريم يَعرض للأنظار هذه الحقيقة الكلية من خلال بعض الآيات الكريمة، ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/64)، ولذلك اعتُبرت معصية الرسول والتمرّد عليه من كبائر الذنوب.
فالتمرد على الله ورسوله وعلى القيم التي يجب التمسك بها علامة على فساد في الطبيعة البشرية وانزلاقٍ في الروح، وأما تعرُّض مجتمع بأكمله لمثل هذا الانحراف الكبير فهو يدل على تدمير المقومات الأساسية التي تحافظ على قيام المجتمعات، مما يعني أنه من المستحيل أن يعيش هذا المجتمع لمدة طويلة.. ولم يهلك الذين أخبر عنهم القرآن من عاد وثمود وقوم لوط وأقوام كثيرة غيرهم إلا لهذا السبب.
فعدم الإطاعة، الذي يعبَّر عنه بالعصيان والتمرد وسوءِ الطبع وغيرِ ذلك لهو مثل الأمراض المُعْدية، فإذا لم تتم السيطرة عليه في الوقت المناسب فسيسري إلى كل المجتمع، وحينذاك يختل التوازن في المجتمع ويؤدي به في نهاية المطاف إلى الهلاك والدمار.
ويمكن أن نوضح هذا الموضوع بمثال كما يلي: لنفرض أن هناك مجموعة عسكرية صغيرة تضم قليلًا من الجنود، ومن بين هؤلاء الجنود جندي متهور لا يطيع ضابط الصف مما يجعل هذا الضابط يريد ويحاول أن يعاقبه على تهوره، ولكن هناك ضابطًا أعلى يعفو عن هذا الجندي، وكنتيجة طبيعية لهذا الأمر يبدأ الجنود الآخرون بالتمرد على ضابط الصف، بل ويستخفُّون بأوامره ويسخرون منه، وهذا يعني أن السلسلة التراتبية بدأت بالاختلال والانقلاب رأسًا على عقب، ويمكن أن نعمم مضمون هذا المثال البسيط على سائر وحدات الجيش.. وكما هو ملحوظ هنا لما لم تُعَالَج المشكلةُ في مراحلها الأولى على الوجه المطلوب، استفحلت وسَرَى مرضُها إلى بقية الصف، وشملت كل وحدات الجيش.
ويمكن تطبيق هذا المثال نفسه في نطاق النبي وأمته؛ فالقرآن الكريم في سياق هذا الخطر المحتمل ينبه الأمة في آيات عديدة، وإذ ينبه على ذلك يستخدم أسلوبًا في منتهى اللين واللطف، بالإضافة إلى لفت الأنظار إلى توقير مقام النبي : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/64).
فنلاحظ أن هذه الآية تخاطب -أولًا بشكل خاص- المجرمين الذين قصَّروا في احترام الأوامر الدينية، وتمرّدوا على الأوامر التي يجب طاعتها، ولم يحترموا الكبار، وباختصار: ظلموا أنفسهم.. ولم يأت في الآية أسلوب يجرح عواطف المذنبين ويؤنّبهم ويُخجلهم.. فصار هذا الصنيع من العناصر المؤدية إلى تليين قلوبهم.
وثانيًا: هناك أمر آخر، وهو أنه لا بد في ترك التمرد على الرسول من الرجوع إليه ، لأن الطريق إلى رحمة الله الواسعة يمر عبر النبي . أجل، إن سلطان الأنبياء بمثابة الجسر المؤدّي إلى رضا الله ورضوانه، ومن المستحيل على العبد أن يلقى الله من دون المرور عَبره.
وهذا الحديث جعلنا نتطرق إلى موضوع يجدُر ذكره في هذا المقام: وهو أنه لا يوجد في الإسلام واسطة بين العبد وبين الله، فللعبد أن يؤسّس علاقة بينه وبين ربه حيثما أراد ومتى شاء، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حيال هذه النقطة أن الرسول هو الذي علَّمنا طريق هذه العلاقة.. فلذلك يُعتبَرُ هو أهم وسيلة فيها.
أجل، إنه وسيلة باعتبار ما علَّمَناه.. وسيلةٌ بمثابة الغاية، إلا أننا نرى كثيرًا من الأرواح التي فيها جفاء لم تدرك هذا الجانب، ونظرت إليه وكأنه ساعي بريد، وبذلك حادت عن الصراط المستقيم.
وثالثًا: إن ذكر وصفي الله : “التواب” و”الرحيم” ينطوي على منتهى الملاطفة لقلوب المجرمين، ويزيد لديهم الأمل في العفو عنهم وفي قبول توبتهم، ويشير إلى أن التوبة والاستغفار أسهل وأقصر طريق للإقلاع عن الخطايا.
أجل، إن هناك كثيرًا من الناس الذين رأوا ما في القرآن من عميق التسامح من خلال هذه الآية وما شابهها من الآيات فأَتَوْا إلى حضرة صاحب الرسالة واعترفوا بخطاياهم وطلبوا تطبيق الحدود عليهم حتى وإن أدى بعض منها إلى الموت؛ فما مجيء ماعز والغامدية التي شاركته في اقتراف جريمة الزنا إلى النبي واعترافهما بذنبهما إلا واحدٌ من تلك الأمثلة على هذه الحقيقة التي ذكرناها، وأظن أنه سيكون من الصعب على إنسان عصرنا أن يدرك ويشرح مدى مشاعر الندم لدى هذين الصحابيين اللذين أتيا إلى النبي واعترفا بذنبهما بطريقة تؤدي إلى تضحيتهما بحياتهما الدنيوية، فهو أمر يفوق حدود تصوُّر أهل هذا العصر ومداركهم.
والحاصل أن عصيان الرسول من الجرائم الكبيرة، وقد يأتي يوم تؤدي هذه الجريمة إلى هلاك المجتمع بأكمله؛ ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم ركز على هذه النقطة بحساسية بالغة، وقَرَنَ بين طاعة الله و طاعة رسوله، بل إنه وَضَع أحكامًا وعقوبات تدل على أنه ينبغي على المجتمع كله أن يكون على هذا النهج وهذه العقيدة، إلا أنه لم يَدفع المذنبين الذين لا يمتثلون هذا الأمر إلى اليأس والقنوط، بل وَضع أساليب تؤدي إلى إصلاح طبائعهم وتكوينهم الروحي، ودلهم على ما يخرجهم مما هم فيه.
4- المصائب والصبر عليها
إن من مقتضيات قَدَر الله أن تكون المصائب على حسب وضع المصاب بها، فهي إما وسائل لتكفير الذنوب أو للاستدراج.
أجل، إن المصائب بذاتها لن تكون مكفِّرة للذنوب، والأمر الذي يجعلها مكفِّرة للمعاصي إنما هو عدم تمرد الشخص المبتلَى على الله وعدم عصيانه له، بل إبداؤه الرضا عن الله بأقواله وأفعاله.
وسيدنا يعقوب خير مثال لنا في هذا الباب، فهذا النبي العظيم تعرض لمصائب تفوق طاقة أي بشر، ولكنه تجاه كل هذه المصائب عبّر عن مشاعره وأحاسيسه بما هو فيه من الضعف، وأسندها إلى نفسه قائلًا: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/86)، فقوله هذا يرسم لنا موقفه النموذجي.
أجل، إن اتخاذ مثل هذا الموقف النبوي تجاه المصائب، يقرِّب الإنسان من ربه ، ويُرقِّيه إلى موقع يتبوَّؤُه من صلى النوافل على مدى آلاف الأعوام.
وقد يكون من المفيد لنا أن نلقي نظرة سريعة على هذه الحقيقة التي تَحَدَّثَ عنها القرآن على لسان يعقوب ، وأعتقد أن هذه الآية الكريمة ترسم الطريق لمن فَقَدَ السعادةَ -نوعًا ما- جراء ما نزل به من المصائب والبلايا، ويدلُّه على المخرج الذي يخلصه مما وقع فيه من الأزمات الفكرية والروحية، فهذا الطريق هو من العقلية والمنطقية بحيث إنه يمكن للذي يسلكه أن يصعد في قفزة واحدة إلى أعلى عليين، فمقتضى الإيمان هو الصبر على كل أنواع المصائب، ثم التوجهُ بعد ذلك إلى المولى المتعال وطلبُ المعونة منه فقط..
وعلى الخط نفسه يقول الله تعالى في آية أخرى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/153).
أجل، إن المثول كل يوم بين يدي المولى والصبرَ على كل شيء باعتباره أمرًا قدّره الله، لهما إكسيران حيويان يطفئان أُوار صدمات المصائب ويوصلان الإنسان
إلى عمق فكريٍّ وعمليٍّ.
ويقول الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/154)، لافتًا الأنظار إلى بُعد آخر من القضية.. كما أنه يعبر عن الحقيقة نفسها في سورة آل عمران: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/169).
فالأمر الذي تبينه هاتان الآيتان هو أن هناك نمطًا من الحياة لا يرقى إلى إدراكه وعيُ الإنسان، وما يترتب على الإنسان في مثل هذه الأمور التي لا يرقى إلى إدراكها شعوره هو أن يستقبلها بالإيمان والاطمئنان والتسليم. أجل، هذه هي الوظيفة الملقاة على عاتق المؤمن.
وهناك أمر آخر وهو أن الآية تحتوي على رسالات مهمة إلى أقارب الذين استشهدوا وارتحلوا إلى دار البقاء، ففيها تسلية لهم، وفي إطار هذه الحقيقة التي تتحدث عنها الآية الكريمة تعالوا بنا نتصور الرسول الذي استشهد عمه في أحد، وأعتقدُ أنه لولا هذه الآية الكريمة لَتَفطّر قلبُه المرهف الحساس بسبب هذه المصيبة.. ولتفطر قلب جابر بن عبد الله من تلك الصدمة التي تلقاها في أحد أيضًا حيث استشهد والده آنذاك وخلَّف وراءه عددًا من الأيتام وكمًّا من الديون، مما ترتب عليه أن يتحمل في مقتبل العمر كل ذلك العبء الثقيل، فلا مرية في أنه مهما كان في مستوى من الإيمان فإنه قد انقلبت مشاعره وأحاسيسه رأسًا على عقب واحتاج إلى ما يسليه، وقد قامت هذه الآية بدور التسلية المهمة لجابر وأمثال جابر.
والواقع أن كثيرًا من ساداتنا المفسرين العظام يذكرون أن الآية السابقة من آل عمران نزلت في استشهاد سيدنا عبد الله هذا، ويكاد يذكر كثير من التفاسير حديث جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ الذي يقُولُ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ رَسُولُ الله :
“يَا جَابِرُ، أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لأَبِيكَ؟”، قُلْتُ: بَلَى، قال “مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمُنُّ عَلَيّ أُعْطِكَ قَالَ: يَا رَبِّ، تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فأَبْلِغْ مَنْ ورائي، فأَنْزَلَ اللهُ هَذهِ الآيَةَ: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/169)” .
ومع انتفاء العلاقة المباشرة لما نحن بصدده إلا أنني لا أود أن أنتقل إلى موضوع آخر قبل أن أذكر ما يلي: تذكر كتب المغازي أنه بعد حوالي أربعين سنة من غزوة أحد، جرى السيل نحو مقابر شهداء أحد التي كانت بسفح الجبل، فخشي الصحابة من انجرافها، فاجتمعت الآراء على نقلها إلى مكان آخر، وفي ذلك يقول جابر: فحُفر عنهم فوجدتُ أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدنا جاره في قبره عمرو بن الجموح ويده على جرحه، فأزيلت عنه فانبعث جرحه دمًا.. ويقال: إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك، رضي الله عنهم أجمعين … ويفهم من هذا كله أن الشهداء يكونون في طبقة مختلفة من الحياة البرزخية.
ولنرجع إلى موضوعنا قائلين: إن محتوى هاتين الآيتين وارد بالنسبة لأولاد وعيال عمرو بن الجموح الذي استشهد هو أيضًا في أُحد، ولا ننسى مشاعر زوجة حنظلة بن أبي عامر الذي شارك في أحد وهو عريسٌ واستشهد بها.
والآن تعالوا نفكر في مدى تسلية كل هؤلاء بهاتين الآيتين.
كما أن علينا أن نتصوّر مدى قوة تأثير ما تفيده الآيتان في نفوس أُسَر الآلاف من أبناء الشهداء حول العالم.
والحاصل أن هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء، وأن كلّ شخص لا بد وأن يُبتلى بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وأن الفائزين هم الذين يصبرون على ذلك. أجل، إن الصبر هو منبع الفوز في الدارين.
5- توبة العصاة
إن المعصية عنوان على إساءة الأدب مع الله، واتخاذ موقف سلبي تجاه أوامره ونواهيه، لكنها -في الوقت نفسه- من مقتضى الفطرة الإنسانية، كأن أحدهما جزء من الآخر ولا يفارقه.
وأما التوبة فهي الأمر الوحيد الذي يلجأ إليه العصاة، كما أنه عملية رجوع الإنسان إلى ذاته، وليس من الصواب اعتبار كل المرتكبين للمعاصي في مستوى واحد وجمعُهم في كفة واحدة؛ فمنهم من يعيش حياته بالمعاصي وهو مرتاح لهذا النمط من الحياة، كما أن منهم من يشعر بالندم ويرتجف فؤاده بل ويتفطر قلبه وينكسر، وتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويعيش حالة من الاختناق بسبب ما يشعر به من هذا الضيق.
فالإنسان العاصي سواء كان من الفئة الأولى أو الثانية إذا لاذ بالتوبة ورفع أكف الضراعة إلى الله الذي يعتبره الملجأ والمنجى الوحيد، وطلب منه تعالى المغفرة فإن الله سيغفر له.. فقد ثبت في كثير من الآيات والأحاديث أن الله تعالى قد غفر وسيغفر للعبد الذي يتوجه إليه. أجل، إنه غفار لمن تاب، وقد سبقت رحمتُه عضبه.
ففي القرآن الكريم عديد من الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، وأظن أنه لا يوجد أحد يرى تلك اللوحات التي ترسمها هذه الآيات، ثم يتمالك نفسه من البكاء، وبالأحرى أستصعب في ذهني أن أتصور أن هناك إنسانًا ذا قلب مؤمن حي لا يتوجه نحو باب مولاه تعالى ثم يتخيل نفسه في مكان ذلك المجرم الذي ترسمه تلك الآيات.
فمثلًا قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/193).
فهذه صرخات المنكسرة قلوبهم الذين ضاقوا ذرعًا بذنوبهم، وسئموا من معاصيهم، فأكثر ما يلفت الأنظار هنا من التعبيرات، هو طلب الذين يرجون المغفرة أن يكونوا من “الأبرار”، فـ”الأبرار” اسم يطلق على المرشحين للوصول إلى القمة في طريق الوصول إلى الله، وبعد ذلك بخطوة هناك مقام المقربين، فالمقربون هم الخواص الذين حظوا بمعية الله تعالى.. فمن هذا المنظور إذا كان النبي من المقربين -وهو كذلك-، فإن أصحابه إنما هم من الأبرار، وبين هؤلاء فروق في العموم والخصوص، وكما يقال “حسنات الأبرار سيئات المقربين”؛ ومن حيث إن الذين انغمسوا في الخطايا قد يكون من الصعب عليهم أن يرتقوا إلى مستوى المقربين -وإن لم يكن مستحيلًا-، فإنهم يطلبون أن يكونوا من الأبرار.
وتُواصِل الآية قائلةً: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/194).
أجل، إنه لا يُتصور أن لا يستجيب الخالق ذو الجلال لهذه الصرخات وهو الذي يلبي نداء من يناديه، ويهرول نحو من يأتي إليه ماشيًا كما ورد في الحديث القدسي ، فهو الذي استجاب لعباده هؤلاء الذين توجهوا إليه بإخلاص:
﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/195).
وهناك أمر آخر في هذه الآية الأخيرة غير قضية استجابة الله لدعائهم وقبولِه لتوبتهم، وهو أن الله تعالى من خلال الحديث عن استجابته دعاءهم يُذكِّر الناس بما ينبغي عليهم فعله من التصرفات، وهي المجالدة والمجاهدة في سبيل الله والتضحية في سبيل ذلك -إن اقتضى الأمر- بالهجرة والقتال وغيرهما.
أجل، إنه، من جانبٍ، يلاطف القلوب التائبة المنيبة، ويقبل دعاءهم ولا يخيب حسن ظنهم، ومن جانب آخر، يُذكِّرهم بوظائفهم ويدعوهم إلى الصراط المستقيم، وهكذا فإن الذين ارتكبوا المعاصي ودخلوا في حالة من اليأس والقنوط؛ فإما عَزَلَهُم المجتمع أو انعزلوا هم بأنفسهم عنه، واستسلموا للأمر الواقع وخارت عزائمهم، فهؤلاء يسترجعون حيويتهم مرة أخرى بما يسمعونه من هذه التعبيرات القرآنية، وينجون من الغرق في مستنقعات اليأس، فيراجعون حساباتهم مرة أخرى ويصبحون أفرادًا صالحين في مجتمعاتهم.