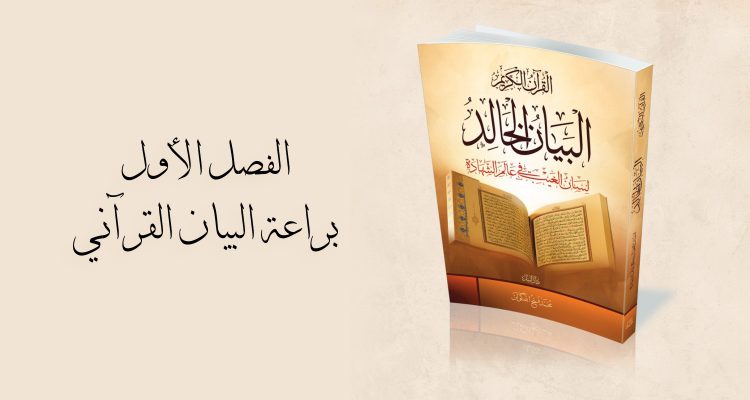القرآن كلام الله، وفي أسلوبه البياني وطرزه الخاصِّ دلالة على استحالة كونه من كلام البشر، ولا يقاس به غيره في أساليب موضوعاته؛ فهو منزه عن ضروب المقارنة كلِّها؛ لأنه أجلُّ مِن أن يقارَن مع غيره من أيّ وجه.
ويتميز القرآن الكريم بأنه حينما يتناول القضايا المتعلقة بالجوانب النفسية للإنسان فإن المرء يشعر بلذة وكأنه يشرب ماء الكوثر، وأن روح القرآن تختلط بكرياته البيضاء والحمراء وتسري في عروقه مع دمه إلى قلبه، وتمرّ بكل منطقة من مناطق دماغه؛ لذلك لا يمكن أن نجد تأثيرًا بهذا المستوى لأي كتاب آخر.
لنفرض أنك أمام خطيبٍ مفوَّهٍ، ولحركاته التعبيرية وإيماءاته البدنية وقْع وقوَّة تُعزِّز خطبته ولو قليلًا، فإذا استمعتَ إليه وأنت مغمض العينين، وعيت عنه نصف ما يعيه المشاهد؛ لأنك فقدتَ معزّزاته البيانية لإيصال الرسالة من حركات معبّرة وتلويحات باليد يمنة ويسرة ونحوها، وأمَّا إن كانت مكتوبة فستفقد كثيرًا من رونقها وتأثيراتها وقوة أسلوبها وبعض أهدافها لأن الإلقاء ركن فيها؛ أمَّا القرآن فتأثيره هو هو قراءةً واستماعًا، فحينما نُغمض أعينَنا ونستمع إليه فإن براعة التصوير في عباراته تكاد تجعلنا نشاهد إشاراته ومَراميه وأحداث قصصه ماثلة أمامنا، وإذا ما كتبنا تعبيراته فسنسمع تأثيرها بكل ما فيها من قوة كأنها أمواج البحر في مدّه وجزْره.
وهذه من خصائص القرآن، ولا عجب فهو كلام الله الذي خلق الكون والإنسان وسائرَ المخلوقات، فكما أن صنعه لا يشبه صنع البشر، فكلامه أيضًا لا يشبه كلامهم، لكن لا يخلو كلامه من تنزّلات مراعاة لعقول البشر.
وإذا كانت البلاغةُ مطابقةَ الكلام لمقتضى الحال ومراعاة حالة المخاطب مع الإيجاز في بيان المراد دون أن يختلط الأمر عليه، فالقرآن هو المعجزة البلاغية، ولا يأتي أحد بمثله، ولو جمعنا ما خطته الأقلام إلى يومنا هذا، وقارناه بالقرآن، فسنجد أنَّها أمام القرآن ليست سوى يَراعٍ طلعت عليها الشمس سرعان ما تخبو تِباعًا؛ فليس لديها ما تهبه للقلوب التي استمعت إلى القرآن وأُشرِبَتْه.
أجل، فلا صوت للعقعق إذا غردت البلابل؛ أين تغريدها المُعجب المُطرِب الذي يشنّف الآذان من صوت عقعق تَمُجُّه الأسماع وتعافه الأفئدة؟! وهذا التمثيل لا يليق لكنه للتقريب وتيسير الفهم، فهو قياسٌ مع الفارق لعجزنا عن التعبير بشيء آخر، وإلا فلا مقارنة بين كلام الله وكلام البشر، ومهما استقصينا في التشبيه والتمثيل، فسنظل عاجزين -وقد عجزنا- عن التعبير عن مدى الفرق والتفاوت بين القرآن وغيره.
وإن نزول القرآن الكريم على أمة أميّة وَعَتْهُ وفهمتْ مقاصده لهو الدليل الواضح على براعة القرآن في البيان حتى إن العوام الأميين يدركون هذا.
وهذه الجماعة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب لم يكن لها مؤرخون وكُتّابٌ يدوِّنون الوقائع، والحاجة داعية لذاكرةٍ تعي أحداث التاريخ، فكان الشِّعر أقصر طريق؛ لذلك عُني المجتمع بالشعر أكثر، وبه خلَّدوا أهم الوقائع وتناقلتها الأجيال.
كان الشعراء يومئذ مشهورين مرموقين في الجزيرة العربية كالسياسي أو الثريّ الذي يعرفه الناس جميعًا ويودّ بعضهم لو كان مثله، وكانوا مثالًا يُحتذى، وتفتخر بهم القبائل أكثر من افتخارها بكُمَاتها، ويشرع الناس بقرض الشعر منذ الصِّغر؛ لذا تقدَّم الشعر إلى أن فاق كلَّ شيء، حتى أصبح شغلَهم الشاغل وصنعتَهم التي يتقنون؛ فجاءهم القرآن ليظهر صدقَه وعجزَهم من الوجه الذي يُحسنون، ومعجزات الأنبياء هكذا كانت تكون.
في عهد سيدنا موسى برع الناس في السحر، فواجَهَ موسى بعصاه السحرَ والسَّحَرةَ، وأبطل ما جاؤوا به وكان لا بدَّ أن يبطل؛ لأن سيدنا موسى كان يمثل الحقَّ ومعه الحق سبحانه، وكانت اليد البيضاء معجزة يملأ الأفق نورها، فيتحلق الناس أفواجًا حوله ليرونها، ولقد انهزم فرعون أمام معجزات سيدنا موسى، ورماه بالسحر بهتانًا وزورًا وعنادًا، وأعيته حيلة غلبه بها نبي الله، فلجأ إلى القوة والتعذيب، وجرب أساليب التهديد والوعيد كلها، ثم تطاول فكانت “غيرةُ الله”، وكانت نهاية فرعون، فلم يُقبَل منه إشهاره إسلامه حين أدركه الغرق، وبغرقه غَرِقَ العالَم السحري الفرعوني في الماء وغُلب السحر أيَّما غلبة.
وفي أيَّام سيدِنا عيسى برع الناس في الطب، يُروى أن الرومان كانوا يُجْرُون عمليات جراحية للدماغ، وهذا يومئذ خارق للعادة كإحياء للموتى، فجاء سيدنا عيسى -وهو روح الله- بمعجزات بزَّت ما كان عليه علمُ الطب يومئذ؛ فكان يُحيي الموتى بإذن الله، وينفخ الروح في البِلى، فيبعث الحياة في الرِّمم بإذن الله.
وأما عصر سلطان الأنبياء فساد فيه سحر البيان في نبض الكلمات، وكانت تهتاج المشاعر وتهبُّ الجموع لكلمة، فَلِسِحْرِ البيان طاقة كأنَّ الناسَ بها يُؤْخَذون.
فهذا “لبيد” كان يهيّج الناس بشعره، فيقتتلون أو يتصالحون بسحر كلماته، وهذا “الأعشى” كانت تُنصَبُ له منابرُ مرصّعة بالذهب والجواهر، وكان الشاعر يَخرج للناس بعد عام من ترقُّبِ أشعاره في جوٍّ مفعم بالترحيب والهتاف والتصفيق والزغاريد، وكلُّهم آذان واعية، فيحفظون ما يلقيه فورًا.
فاض الزمان بسحر البيان، فجاء القرآن يخاطب الناس جميعًا، ويتحدى الأدباء والشعراء كافّة، والإنس والجن قاطبة قائلًا:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/23-24).
أجل، إنَّه تحدٍّ لا زمان له ولا مكان، يشمل بخطابه السابقين واللاحقين، وأهل مكة ومن في الأرض جميعًا، سابقهم ولاحقهم إنسهم وجنهم، إنها دعوة مفتوحة كانت وما زالت تتحدى الخلق جميعًا.
كان القرآن وما يزال يتحدى هذه الدائرةَ الواسعة كلَّها، كأنه يقول: “إن كان بوسعكم فائتوا بكتاب من مثله”.. ولم يزل متحدّيًا هكذا، ولكن لم يستطع أحد أن يأتي بسورة من مثله، بل ولا بآية واحدة، ناهيك عن مثله، فكم من شاعر كان لقوله تأثير السحر، فلما وقف أمام القرآن انعقد لسانه ولم ينبس ببنت شفة.
إن التاريخ يشهد أنه لم يأت أحد ولو بسورة من مثله؛ لأنه لو كان لَبَلَغَنا؛ وذلك لأمرين:
الأول: أن مشركي مكة كانوا بأمسِّ الحاجة إلى الإتيان بمثله.
الثاني: أن التحدي كان علنًا عامًّا صالحًا للجميع، فأي محاولة من هذا القبيل لا بد أن يشيع خبرها، ومن حاول وجاء بمثله كما وهِم صار سخرية وباء بالخزي، لذا رَبَأَ الأصدقاء والأعداء بأنفسهم عن محاولة كهذه، ولنشرح هذين السببين بشيء من التفصيل:
مما لا شك فيه أن القرآن الكريم أكبر دليل وشاهد على نبوة سيدنا محمد ، وقد ردّه أهل مكة جميعًا بادئ الأمر وأنكروا نبوته، ولم يدخروا جهدًا في إلحاق الأذى به وبمنْ صدَّقَه، فلو صحت دعواهم أن القرآن من عند غير الله وأنه يمكن أن يؤتى بمثله لَمَا اختاروا طريقَ الحرب والصِّراع والمغامرة بالأرواح والأموال؛ فإنهم لو أتوا بشيء من مِثل القرآن لَتَبيَّن صدقهم في ردهم للنبوة، ولتخلَّى عما قاله وما سيقوله وانتهى الأمر؛ فما أيسر هذا الأمر، إلا أنهم رغم يسرِ هذا الطريق اختاروا الأصعب.
وليس اختيارهم للأصعب لأنهم حمقى لا يدركون؛ فهم من ساسوا العالم بعدئذ، وصاروا أئمة ومعلمين للحضارات الأخرى؛ إذًا ما الذي ألجأهم إلى اختيار الطريق الأشق؟ ولِماذا ضحَّوا بأنفسهم وأموالهم وأهدروها، وأيقنوا بالحاجة إلى مجابهة الرسول بالجيوش؟!
الجواب واضح قاطع؛ إنهم -كما قال الجاحظ- لمَّا انسد عليهم باب المعارضة بالحروف، اضطروا إلى المقارعة بالسيوف.
يا لَروعة نكتةِ الجاحظ هذه: “فلو أنَّ مشركي مكّة استطاعوا المعارضة بالحروف لَمَا اختاروا المقارعة بالسيوف”، والقرآن لما دعاهم إلى المعارضة لم يكن يهددهم في دنياهم، بل كان يتوعدهم بخسارة أخراهم، إن استسلامهم لتهديدٍ كهذا معناهُ العَجْز ونفاد الحِيل، وهذا يدل على أنهم لم يكن بوسعهم الإتيان بمثل القرآن أو بشيء من مثله، ولم يسجل التاريخ سوى بعض محاولات عقيمة ميتة جاءت لتعارض القرآن فصار أصحابها هُزْأَة.
وأشهرُها محاولة مسيلمة الكذاب، الذي كان أديبًا بارعًا، ذا ملَكَةٍ قويّة في التعبير والبيان، وهو ما جَعَل كثيرًا من الناس ينساقون وراءه، ولما وُضعت أقواله في ميزان القرآن؛ ما لبث السامعون أنْ سَخِروا منها، وصار مسيلمةُ ضُحْكة.
وسوَّلت له نفسُه أن يقارع سورة القارعة بأخرى مثلها، فلنقرأ سورة القارعة أوَّلًا:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ (سورة القَارِعَةِ: 101/1-11).
في هذا البيان تبيانٌ لأحوال الدنيا والآخرة معًا، يطوِّف بك من عَجبٍ إلى عُجاب، هلم فلنقارن هذا بما أتى به مسيلمة في معارضته البائسة(!):
“الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل؟ له ذنَب قصير، وخرطوم طويل”.
نعم، إن مسيلمة وهو يقول هذا كان يسخر منه حتى أقرب الناس إليه.
ويمكن تناول البلاغة القرآنية في النقاط الثلاث التالية على سبيل المثال لا الحصر:
أ. براعة التعبير القرآني
تتجلّى براعة القرآن من الناحية البيانية بخصائص منها: جزالة نظمه، وبديع بيانه، وتفرّد أسلوبه، وجلالة عبارته.. وإليك تفصيل ذلك بالأمثلة:
1- جزالة النَّظْم
من معاني الجزالةِ لغةً: الكثرة والوفرة والبركة، وتعدّد المعاني التي يحملها اللفظ، والمتانة والإحكام والقوة.
ويمكن ملاحظة هذه المعاني بجلاء في نظم القرآن الكريم؛ فإن البركة تفيض منه من كل وجه. نعم، إن نظم القرآن غنيّ بكل هذه الوجوه، فبينما ترى أنَّ للفظ دلالة واحدة إذا بها ألف.
والزمخشريُّ من الروّاد الذين اكتشفوا هذه الخصيصة في القرآن الكريم، فلطالما أشار إليها في تفسيره، ومثله الأستاذ بديع الزمان النُّورْسي، فما أكثر ما تَنَبَّه له ممّا لم يذكره غيرُه، وهذا ينمّ عن فتح رباني وعبقرية فائقة وهبها الله له؛ وإليك أمثلة على هذا من نفحاته رحمه الله لننظر في جزالة النظم دون تفصيل في التفسير:
المثال الأول:
قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/46).
في سياق ذكر العذاب تحدثت الآيةُ الكريمة عن أهونه لتجذب الأنظارَ وتحفِّزَ الخيالَ ليتصوَّرَ أَشَدَّهُ، ولتشير إلى أنَّه إذا كان أخفُّ أنواع العذاب شدةً ما لو مسَّ الإنسانَ مسًّا خفيفًا لَغَلَى منه دماغُه، فما بالك بأشدِّها؟! أجل، ما أشدّ هوله وما أفزعه وهو أخف عذاب يؤلم الإنسانَ ويفجعه ويبرِّح به!
هذه المعاني برُمّتها دلَّتْ عليها الآية، وهي بصفتها “كلام الله” تخاطبنا بأسلوب معجز اتَّشَحَتْ جزالة نظمه بدقائق معانيه.
ونسيج الآية إجمالًا منوالُهُ القلة، ومدار مفرداته على القلة أيضًا، فاعتضد الكلُّ بأجزائه في الدلالة، بل لو أمعنّا لوجدنا أن الحروف تشدّ أزره كذلك بأصواتها ومخارجها وموسيقاها ووقْعها.
ومردُّ هذا إلى الذوق، وأنى لمن لم يضرب بسهم من لغة القرآن أن يتذوّق هذا؛ وحسبُنا ذكرُ نكات من الوجه الأول:
نظرات في مفردات الآية:
“إنْ” حرف شرط يفيد الشك المفضي إلى تقليل الوقوع بخلاف “إذا”.
وأما “مَسَّ” فإنها تدل على اللمس الخفيف، ومسِّ الشيء بطرف الأصابع مسًّا لطيفًا، وهذا يعزِّزُ معنى التقليل، والسين المشددة بصوتها وجرسها توحي بالهمس واللين.
ومعنى “نفحة” رائحة خفيفة أو نسمة، والتنوين للتنكير؛ أي إنها مِن ضعفها وقلتها لا يكاد يُشعر بها، فهذا العذاب ما هو بعاصفة أو إعصار، بل كرائحة خفيفة أو نسمة
لا يكاد يُشعر بها.
“مِن” تدل على التبعيض المتضمن للتقليل أيضًا.
“عَذَابِ” هذه الكلمة أخف من “العقاب” و”النكال” ونحوهما، فلِمغزًى لطيف آثرها على ما يقتضي الهلاك أو العذاب الشديد، حتى إن بعض العلماء كالشيخ محيي الدين بن عربي لحظَ جذرها (عذب) ودلالته على العذوبة، وادعى أنه إذا طال بهم العذاب ألِفوا النار واستعذبوها، فكلمة “العذاب” مِن أخف مفردات هذا الباب إذًا؛ فهي بهذا تفيد القلة أيضًا.
“رَبِّ” هو الذي يُربِّي ويَرعَى ويُمِدُّ بالرحمة، فالكلمة توحي بالشفقة إذا قورنت بـ”القهار والجبار والمنتقم والمميت” ونحوِ ذلك، فإضافة كلمة “العذاب” إليها تخفِّف من وقْعها على النفس.
لقد اعتضد معنى الآية إجمالًا بكل كلمة منها بل بكل حرف للدلالة على معنى القلة، فأنَّى لقرائحِ البشر أن تأتي ببيان مُفلِقٍ دقيقٍ كهذا.
المثال الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/3)، المبادئ الكلية والقواعد العامة للزكاة، وهي على النحو التالي:
أ. على المنفِق أن يعطي “بعض” ماله لا كله، أما إنفاق الكل كما فعل سيدنا أبو بكر فهذا خاص بمن لديه روحانية وإيمان كأبي بكر ؛ فالرسول لم يَقبَل من الصحابة أمثالِ كعب بن مالك وسعد بن أبي وقاص أن يتصدقوا بأموالهم كلها، بل عدَّه إفراطًا، ولمَّا أصر سعد أذِنَ له رسول الله بالثلث فما دون، وأرسَى مبدأً خالدًا: “إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ” .
ب. شرط مال الزكاة أن يكون حلالًا، فلا يقبل الله ما يُنفق من الحرام؛ فلو أنفق كلَّ ما كسبَه من الحرام في سبيل الله أو حجَّ به فلن يُتَقَبَّل منه.
ج. أن لا يَمُنَّ المزكِّي على المستحق فيؤذيه، وجاء هذا تصريحًا في آية أخرى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/264).
د. لا تُدفع الزكاة إلا للمستحق.
هـ. ينبغي أن تُدفع الزكاة ابتغاء مرضاة الله تعالى، فإن شابتْها مقاصد وأغراض أخرى قتلت روحَها.
هذه الأسس كلها في الآية الكريمة، وهذا برهان آخر على جزالة القرآن الكريم في مبناه، وإسقاط هذه القواعد العامة على الآية الكريمة على النحو التالي:
أ. إنفاق بعض المال لا كلِّه أفاده التبعيض في كلمة “مِن”، فلتكن الزكاة بعضًا مما رزقه الله.
ب. أن يكون مال الزكاة حلالًا، فالضمير “نَا” في قوله تعالى: “رَزَقْنَاهُمْ” يومئُ إلى هذا، فكأن الآية تقول: ينفقون مما آتيناهم على سبيل الرزق”، فما تسلبه من زيد لتعطيه عَمرًا لا يكون من الزكاة في شيء.
ج. وأما مسألة المنّ والأذى، فضميرُ “نَا” في قوله “رَزَقْنَاهُمْ” يشير إليها، فكأنه يقول: “إنني أنا الرزاق، فليس لأحد أن يمن على غيره ويؤذيه فيما يعطيه”. نعم، إن الله هو الذي خلق التراب والماء والهواء والشمس، وهو الذي خلق البذرة التي تنمو؛ فماذا يملك الإنسانُ حتى يقف متكبرًا مغرورًا منّانًا على من يعطيه بعض ماله.
د. لا تعطَى الزكاة إلا للمحتاجين وقوله تعالى: “يُنْفِقُونَ” يشير إلى ذلك؛ أي يجب على من تُدفع إليه الزكاةُ أن يعلم أن هذا المال “نفقة” للمحتاجين.
هـ. ينبغي أن تُدفع الزكاةُ ابتغاء رضوان الله تعالى كما دلّ عليه قوله تعالى: “رَزَقْنَا”، أي “إنني أنا الرزاق، فليكن الإنفاق باسمي أنا أيضًا”.
و”الإنفاق” من “الرزق” عام يشمل أمورًا أخرى بمقتضى عموم “ما” في قوله تعالى “مِمَّا”؛ فالمال رزقٌ، والعلم رزق، والبيان رزق، ولكل من ذلك زكاته، فالتعليم والإرشاد إلى الحق والحقيقةِ مثلًا زكاة العلم، وهكذا.
إن بضعة ألفاظ في آية تشتمل على هذه المعاني كلها لهي آية بينة على أنه ما يقول هذا بشر، إنه الوحي الذي جمع فأوعى.
المثال الثالث:
قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (سورة آل عمران: 3/159).
قبل تحليل الآية يحسن التمهيد للمحاور التي سنذكرها:
هذه الآية نزلت في غزوة أحد: استشار الرسول أصحابه قبل الغزوة، ولا يخفى أن استشارة الرئيس واستطلاعه لآراء أهل الرأي والشورى أمر جلل لإشراكهم عاطفيًّا بَلْهَ عقليًّا في موضوع القرار، فيَعرض المسألةَ عليهم، ويُدْلي كلّ بدلوه، وهذا يثري الآراء ويُتَداوَل كلُّ ما ليس في مداولته حرج، إلا إذا كان ثمة ما يستأثر الأميرُ بمعرفته وهم
لا يعرفونه، أو كان في اطلاعهم عليه حرج وضررٌ ما يحول دون مداولته، وقد يجوز للأمير أن يخالف رأي أهل مشورته لعوارض معتبرة؛ فهو وإن كان بيده وحده اتخاذ القرار في حالة كهذه لكن تَظَلّ استشارته لأهل الرأي والمشورة من المبادئ الأساسية؛ ذلك أنّ “الوعي الجمعي” بهذا ينمو ويتطور، وبهذا يعرف كلٌّ مهمته إلى حدٍّ ما، ويبذل ما بوسعه وطاقته ليثبت وجوده وصواب رأيه وقوة حجته.
لهذا كان الرسول يستشير أصحابه دائمًا، وفي غزوة أحد كان صوت الأكثرية مع الخروج من المدينة للحرب، وكان للرسول رأي، لكنه اتَّخَذ القرارَ بناءً على رغبتهم ليشير إلى ما للاستشارة من قدْرٍ وقيمة.
ووقعت هزة أُحد، وإن لم نسمِّها “هزيمة”، لكن من المسلَّم به أنَّ المسلمين لم ينالوا ما أرادوا من النصر، فتألَّم الرسول وأصحابه أيّما ألم.
وعندئذ نزلت هذه الآية لتحول دون هذه الحالة. نعم، أرست الحدود وأوْصت الرسولَ بأن يستشير أصحابه رغم ما جرى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/159).
ولو تأمّلنا مفردات هذه الآية لرأينا كيف تآزرت حول المعنى والمضمون ذاته:
فكلمة: “فَظًّا” لها معان، أهمُّها:
أ. سيئ الخُلُق.
ب. غليظ الفِعال.
ج. بذيء اللسان، يَجرح المشاعر وينفِّر.
د. إذا عطش في البادية نحر الإبل، وعصر كروشها ليشرب ماءها العكر.
هـ. معسِّر يصعِّب الأمور ويُعَقِّدها.
و. مُبْهم الفعال.
وأما قوله تعالى “غَلِيظًا” فهي مشتقة من الغلظة أي الخشونة والقسوة وهي خلاف الرِّقَة والرِّفْق واللطف ولين الجانب والدماثة والظَّرْف، وحروفها بجرسها وموسيقاها الداخلية وتَناغُمها الصوتي مع السوابق واللواحق تعضد القدر المشترك فيها معنًى ومغزًى.
وأما “انفضَّ” فهي تدل على خبط شيء بآخر ليتبعثر ويتفتّت، أو تمزق شيء بالضغط عليه، أو بعثرة الأطراف بعد قطع الرأس، ونحوها من المعاني.
ومفردات الآية تدور حول المعنى ذاته، وفي موسيقاها ضربٌ من الشدة والقسوة والضغط والتمزق، وهذا ما يُراد بيانه.
أجل، لا بد أن يتولّد من الضغط والتضييق تمزُّقٌ وانفجارٌ وانشطار، فتلك أسبابٌ هذه نتائجُها، ولن تجد بيانًا فيه هذا القدر من الانسجام للتعبير عن اطّراد التفاعل بين الأسباب والنتائج.. يا له من تصوير بياني للحَدَث لا يرقى إليه سواه!
ولو تتبعتَ آيات القرآن بالتحليلِ لألفيتَ فيها هذه الخصائص كلها، ولمست هذا التضافر والجزالة في جميع القرآن من سورة “الفاتحة” الشريفة إلى سورة “الناس” الجليلة.
أول آية في الفاتحة ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، مرادها أن الحمد والثناء والشكر والمنة مستحَقٌّ لله الذي هو رب العالمين جميعًا وخالق كل شيء ومـُـــدبّــر أمره بذراته وكراته ودنياه وعقباه وأجساده وأرواحه ومادته ومعناه، فهو مستحِقّ الحمد وأداؤه واجبُ أمثالنا من المخلوقات.
هذه الحقيقة مكنونة بشكل ما في كل كلمة من الآية.
بيان ذلك أن الحمد لفظ جامع لكل ما يعبِّر عن التعظيم والمنّة مما ذكرناه أو أغفلناه، ويدل ضمنًا على المعنى المراد في الآية.
ولفظُ الجلالة: “الله” علم خاص على المعبود المطلق، فيدل -بالتضمن والالتزام- على الحمد والثناء والشكر والمنة والمدح والتبجيل، وعلى أنها مستحقة له وحده سبحانه قطعًا.
واللام في “لِله” للاستحقاق والاختصاص، فتشير بجلاء إلى أن الحمد والثناء مستحق لله وحده دون سواه.
وقوله: “رَبِّ الْعَالَمِينَ” دلَّ على أن الله هو الذي أوجد العالمين من العدم ورعاهم وحفظهم برحمته، وأودع في خلقه بديعَ صنعِه، وعمّهم بشتى أصناف الإحسان، فدلّ -بالالتزام- أنه يستحق أنواع التقدير والتعظيم والتبجيل والحمد والثناء كلها، وهذا هو فحوى قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
مثال آخر: في سورة الناس أمور عدّة، منها توحيد الربوبية، وتوجيه الأنظار إلى معاني الأسماء الإلهية الواسعة الدالة على أفعاله وتصرفاته المتنوعة في ملكوته، لتُذكِّرهم أنه لا ملجأ ولا منجى لهم في الضراء إلا إليه، وتُبين لهم سبل وقايتهم من الشرور.
وهذا يتجلى في آيات السورة وجُمَلها كلها؛ وبيان ذلك أن الإنسان عُرْضة -من حيث لا يَرى ولا يَشعر- لشياطين الإنس والجن، إذ ينفذون بدهاءٍ ومكر خبيثين إلى جوانيته من العروق التي قد يتحكمون به من خلالها إغواءً وإفسادًا؛ والإنسان أدرى بمسارب ضعفه، وحقيقة عجزه وحاجته لاتقاء شرِّ أعدائه، فلجأ إلى القدير المطلق في ظلال “رَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلٰهِ النَّاسِ”، ومما يُثري البيانَ ويزيده جزالة لا تُنال أنَّ الجملَ بجرسها وأصواتها وجناسها ترمز إلى ذلك المكر والدهاء والخداع.
والأمثلة كثيرة، وفي قليلها ما يشهد أنه تنزيل من رب العالمين كما يشهد بهذا ما في ألفاظه من جزالة وثراء لا يحيط بهما وصفٌ، فحسبنا هذا لِنَبحث مواضيع أخرى.
2- البيان البديع العجيب
من تأمَّلَ بيان القرآن وقف -بحسب المقام- على عذوبة ورقة وشدة وقوّة بأسلوب بديع لم يُعهْد مثله من قبل ولم يُرَ بعدُ، فلا مقارنة ولا تشابه بينه وبين أدب الشعراء والأدباء السابقين أو اللاحقين، فلا هي منه بنسب وما هو لها بنظير.
أجل، إنه كلام الله المتميِّز بأسلوبه وسَمْته وتفرّده، فما هو بمقلِّد، وما لأحد يدانِ بتقليده، والغرابة في الأسلوب والتفردُ في سمت الكلام قد تثير المخاطبين وتُحرِّك فيهم نزعة الرفض والإنكار، وهذا ما كان منهم، ورغم ذلك استحسنوا أسلوبه البديع وعظَّموه مذعنين لسلطانه المكين في أسلوبه؛ إنه يحلق بالمستمع في جوٍّ دافئ لطيف، ويحيط به فيأسر لبّه؛ فما أكثر من استمعوا إليه فلم يستطيعوا أن ينعتقوا من تأثيره الأخاذ، بل منهم من آمن من فوره، ومن لم يؤمنوا أذعنوا لعظمته وجلال قدره.
فهذا الوليد بن المغيرة لما استمع إليه من رسول الله رقّ، فجاءه أبو جهل منكرًا عليه، فقال: والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا.
وجمع قريشًا عند حضور الموسم، وقال: إن وفود العرب ترِد، فأجمعوا فيه رأيًا،
لا يكذب بعضكم بعضًا، فقالوا: نقول كاهن، قال: والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته
ولا سجعه.
قالوا: مجنون، قال: ما هو بمجنون، ولا بخنقه ولا وسوسته.
قالوا: فنقول: شاعر، قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه، وهزجه، وقريضه، ومبسوطه، ومقبوضه، ما هو بشاعر.
قالوا: فنقول: ساحر، قال: ما هو بساحر، ولا نفثه ولا عقده.
قالوا: فما نقول؟ قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا وأنا أعرف أنه باطل، وإن أقربَ القول أنه ساحر، فإنه سحر يُفرّق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته، فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس، فأنزل الله تعالى في الوليد:
﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ (سورة الْمُدَّثِّرِ: 74/11-24).
وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: “يا قوم، قد علمتم أني لم أترك شيئًا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، والله لقد سمعت قولًا والله ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة” .
وما كان منه بعدئذ إلا أن ترك معارضة الرسول إلى حدٍّ ما. نعم، إنه لم يؤمن ولكنه كان مبهورًا بالقرآن.
ولعل الغرابة في أسلوب القرآن على ضربين:
الأول: روائع حروفه لا سيما المقطعة.
الثاني: أنَّ القرآن عجيبٌ في جمعه وإحاطته.
أ. روائع الحروف المقطعة:
إن في حروف القرآن -لا سيما المقطعة- شيئًا عُجَابًا يأخذ بالألباب.
الحروف المقطعة تصدَّرت بعض السور نحو ﴿الٓمٓ﴾، ولم يُعهد قبل نزولها كتابة رموز من حروف كهذه.
نعم، إن أسرار القرآن أُودِعت في روحه مشفَّرةً، والحروف المقطعة من مفاتح هذه الشفرات.
ومن له علمٌ بماهية الشفرة يدرك معنى هذا جيّدًا، فخبير اللاسلكيات قد تَقرعُ سمعَه هذه الأصوات: (دي، دي، دا، ديت؛ دا، دا، ديت)، فنحن لا نفهمها، أما هو فيحوِّلها إلى حروف مثل: (أ-ب-ت)، ويكتبها (خماس-مخمس)، لقد اتّخذ من هذه الحروف أرقامًا دالّة على مجموعة أسرار، فالرسالة المشفرة تُحلَّل في ضوء هذه الأرقام، فتفيد المعنى المراد.
والغرض من التشبيه تقريب المسألة للأذهان، ووجه الشبه أن الحروف المقطعة في القرآن شفرات أيضًا على ما في القرآن من أسرار، ولعلها هي التي حملت أمثال محيي الدين بن عربي والإمام الرباني وبديع الزمان على أن يكشفوا آلاف الأسرار، ويفتحوا أبواب تلك الكنوز، ويطلعوا على الأسرار القرآنية..
وأما العلم بهذه الشفرات فمصدره الإلهام، يُلهمها سبحانه قلوب من شاء، فيكشفون الأسرار القرآنية النافعة لزمانهم، ويُبلغون مَن حولهم الأسرارَ الإلهية.
وموضوع هذه الأسرار ليس من القضايا التكليفية، بل هي ضروب من الموائد القرآنية ونافلة من الإحسانات الإلهية.
ولا يتسع هذا المقام لبيان وجوه الإعجاز كلها للحروف المقطعة، فحسبنا مسائل مهمة تقدِّم تصوُّرًا عن الموضوع:
إن للقرآن منهجه في اختيار الحروف المقطعة واستخدامها، وبيانُ ذلك أنَّ للحروف أقسامًا في علم التجويد والأصوات: فمنها المجهورة، والمهموسة، والشديدة، والرخوة، ومنها حروف القلقلة وهكذا، والحروف المقطعة -وهي نصف الحروف العربية فقط- جاءت على نسقٍ دقيق، فالحروفُ الرخوة ضِعْفَا الشديدة استخدامًا في القرآن، ومن المستحيل وجود هذا التقسيم بالصدفة، فهذا الضرب من نظام الحروف ليدلّ على أن القرآن معجزٌ بنظمه وأنه كلام الله، ولِبيان ذلك إليك مثالًا لا يخفى على أحد:
لنفرض أن على قارعة الطريق عددًا من الأعمدة، ثم هُدم العمود الثاني والرابع والسادس… إلخ، أي فرادى، فمن السفه ادّعاء المصادفة كأن يقال: إن الريح هدمتها فرادى؛ إنَّ في هدمِ بعضٍ بعينه وتَرْكِ غيره قصدًا وترجيحًا، وقل مثل هذا في الحروف المقطعة، فاختيارُها بالنمط المذكور ليس مصادفة، فمثلًا: حرف “قٓ” لم يرد إلا في موضعين: سورة “قٓ”، والشورى، وهو عند القائلين بالإعجاز العددي رمز القرآن الكريم، وهو كذلك لمن أمعن، وبيان ذلك أن حرف القاف ذُكِرَ 57 مرة في كلا السورتين، فالمجموع (114)، وهو عدد سور القرآن، ومعنى السورتين وموضوعهما هو القرآن؛ فمطلع سورة “قٓ” القَسَم بالقرآن: ﴿قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وخِتَامها: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (سورة ق: 50/45).
وأما سورة الشورى فمطلعها: ﴿حم عسق كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة الشُّورَى: 42/1-3)، وختامُها عن خصائص القرآن: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾ (سورة الشُّورَى: 42/52-53).
جاءت البداية والنهاية في السورتين عن القرآن كما أشرنا أن “ق” رمز إلى القرآن، وأن موضوع السورتين هو القرآن، وأن الحرف “ق” تكرر (114)، وهو عدد سور القرآن، أفيمكن أن ينسب هذا إلى المصادفات؟ ويزيدنا يقينًا بذلك أن هاتين السورتين ليستا من أواخر ما نزل من القرآن، فهذا التحديد لا يكون إلا ممن يعرف عدد السور القرآنية قبل إنزالها، ولا أحد يعلم هذا حتى الرسول نفسه ، فيستحيل أن يشير من تلقاء نفسه بمائة وأربعة عشر (114) قافًا إلى مائة وأربع عشرة (114) سورة.
والدلائل على أن القرآن كلام الله متنوعة، ونظام الحروف المقطعة وأعدادها فيه، وهي من الإعجاز بمكان.
ومن النكات البديعة للحروف القرآنية المقطعة أن زيادتها ونقصانها في سورها له نسق يطّرد وترتيبَ ورودها مثلًا:
سورة الرعد تبدأ بـ﴿الٓمٓرٰ﴾ فترتيبها (أ، ل، م، ر)، ثم يتناقص عددها على هذا الترتيب أيضًا: فـ”أ” تكررت (625) مرة، و”ل” (479)، و”م” (260) مرة، و”ر” (127) مرة.
وثَمَّةَ سورٌ سوى هذه يلاحظ فيها هذا التناسب الدقيق منها سورة البقرة، فالحروف المقطعة فيها هي ﴿الٓمٓ﴾، وتكرارها في السورة كالتالي: تكرر حرف “أ” (4592) و”ل” (3204)، و”م” (2195)، فالانسجام في الترتيب جليّ فيها؛ وهو كذلك في سورة آل عمران، فالحروف المقطعة فيها هي: ﴿الٓمٓ﴾، وعددها في السورة مطّرد مع ترتيبها؛ فحرف “أ” تكرر في السورة (2578) مرة، و”ل” تكرر (1885)، و”م” (1251)، على التوالي، والأمرُ جارٍ في سورتي العنكبوت والروم لو عددْتَ حروفَهما.
وأما في سورة (يس) فكان العكس؛ فالحرف الأخير عدده في السورة أكثر، لأن ترتيب الحروف المقطعة فيها على خلاف ترتيبها الهجائي، بدأت بالياء وثنَّت بالسين، فجاء عدد السين أكثر من الياء، ونكتفي في هذا الباب بما قدمناه مجملًا، ولندع تفصيله للمتخصّصين.
ب. شمول الخطاب القرآني جامعيته
للقرآن الكريم أسلوبٌ وبيانٌ فريد يرعى مستويات المخاطبين الإدراكية والفكرية في مختلف العصور، ففَهِمَهُ الناسُ زمنَ نزولِهِ بيسر، وكذا من أتوا بعدهم بعصور، إنَّ له أسلوبًا في بيان المراد، تنكشف به لجبريل الذي نزل به من العوالم العُلوية معانٍ من ذلك المقام، بينما يدرك الرسول أسراره من أُفقه هو، والناس ينهلون منه كلٌّ على قدر مداركه، حتى الراعي وهو يرعى له فيه نصيب من الفهم والإدراك، وكذا الفلاح وهو يحرث، وربة البيت في عملها والبدوي في بيئته.
فعلى مرّ العصور وتعاقُبِها تربَّتْ في كنفه قاماتٌ سامقة وعباقرة أفذاذ أمثال الفقهاء الأربعة، توجهوا إليه بأرواحهم وقلوبهم، واستَخرَجوا منه لآلئ المعاني وجواهر الحِكم، بل إن أمثالنا ممن لا يَرقَون إلى مستوى التتلمُذِ على أيدي هؤلاء حينما يرِدون مَعِينه يَستقون فيُسْقَون خيرًا كثيرًا، وهذا خير شاهد على أنه منهل فياض لا ينضب ولا يغور، فيا لَله أيُّ بيانٍ هذا؟! يرتشف من كوثره سكان الملإ الأعلى، ويقتبس منه الأميون، لا تفسير لهذا الأمر العُجاب الذي يأخذ بالألباب إلا أن ينسب إلى الله تعالى وأن نذعن أنه كلامه سبحانه.
ومن المعلوم بأنّ للبيئة وقْعًا كبيرًا على الإنسان، وأن المواهب والملكات إنما تظهر بتهيئة الظروف المناسبة لنموّها؛ فالمواهب التي تَربَّت في القصور يرعاها المؤدِّبون وتأخذ عن المعلمين الأكفاء، فتعْمُر فيها الروح والمشاعر والقلب والعقل، وهي ليست كغيرها؛ فعلى من يخاطبها أن يلحظ -على الأقل- مستواها، ويخاطبها بأرقى الأساليب؛ لكن خطاب القرآن ليس كذلك؛ فهو يخاطب من تربَّى في القصر ومن دونه في مجلس واحد، بخطاب واحد، وكلاهما يستقي منه ويغترف بقدر دلوه، ويغدو تلميذه، ويدخل في حلقة إرشاده النورانية، فنحن نسمِّي هذا الأمرَ “جامعية القرآن”، والرسولُ يصف هذه الجامعية بقوله: “لكل آية ظهر وبطن وحدٌّ ومُطَّلع… إلخ” ؛ أي إن كل شيء في جامعيته.
والمقصود بـ”الظهر” المعاني الظاهرة وبـ”البطن” المعاني الخـفـيّة التي لا تنكشف إلا لذوي بصائر اكتحلت عيونهم بقلم الفراسة، وهذا مسلَّم به.
كثير من الموجات الضوئية والصوتية لا نستطيع عادة أن نلتقطها بالعين والأذن وحدهما، وعندما نضغط زرَّ المذياع والتلفاز تغدو مرئية مسموعة، وكذلك القرآن له ضروب من المعاني غير مرئية كهذه الموجات، لا يراها ولا يدركها إلا ذوو البصائر، ولدينا مئات الكتب في التفسير الإشاري، منها تامَّة، ومنها ما تناول عددًا من السور أو سورة واحدة أو آية فقط، فهؤلاء أعربوا عما كشفه الله لهم.
ولكل آية حدّ ومُطَّلع؛ فقد تُفهَمُ وتدركُ ابتداء أو في النهاية، ولكل ظهرٍ وبطنٍ وحدٍّ ومطلعٍ أنواعٌ كثيرة من الفروعِ والغصون والأوراق والثمار، ولا تنالها سوى أيدي ذوي القامات السامقة، ولا يَطَّلع عليها أهلُ كل عصر، بل منها ما يفوت السابقين وينكشف للاحقين.
إنه كلام الله الذي لا يَخْلَق بالتقادم، بل هو ذو حُلّة قشيبة إلى يوم القيامة، فلو عُمّرتِ الدنيا مئات القرون لظلَّ القرآن كما كان غضًّا طريًّا فتيًّا، فالآلاف بل مئات آلاف التفاسير التي كتبت إلى يومنا هذا براهين ساطعة على ذلك، وما زال تلامذة القرآن يُثوِّرونه ويستقصون مضامينه كلٌّ بقدره ووفق طاقته الإدراكية، ولن يزال الأمر كذلك حتى يلفظ آخرُ المؤمنين أنفاسه، فهذا هو مقتضى جامعية القرآن.
ولعلَّ الأمثلة تجلِّي خصيصة القرآن بأنَّه الصرحُ البيانيّ الوحيد الذي يخاطب كل إنسانٍ على حِدَة في كل عصر، وتمتنع هذه “الكيفية الخارقة” على غيره، فهو فريد في هذا، ولنتناول الأمثلة على الشكل التالي:
المثال الأول: قوله تعالى في سورة النبإ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا﴾ (سورة النَّبَأِ: 78/6).
هذه الآية بضع كلمات لو أدركنا مدى ما فيها من جامعية القرآن، لأمكن قياس ما سواها عليها لتقديم تقييم دقيق في المسألة.
إن الآية تتحدث عن تهيئة الأرض على هيئة “مهاد” والمَهد -بفتح الميم وكسرها- مِنَزُّ الصبي أي فراشه، فالمعنى: أن وجه الأرض كالمهد، يسهل المشي عليه، وكل ما يحتاجه الإنسان متاح ميسور، فهذا المعنى يلحظه ويشاهده كلّ امرئ فلا يحتاج استنباطُه إلى عميق العلم والفهم والبحث.
وأما الأديب الذوّاقة فله من الآية مدارك أخرى منها:
وجه الأرض كالمهد والفراش، يَشْعُر المرء بدفئه كلَّ حين وكأنه حضن أمه، ويتنسم فيه السكينة والطمأنينة، وهو كالمهد يتحرك ويهتز باطّراد وانتظام مريح يمكن للإنسان أن يعدّه “مَهدًا” له، ولولا توازن الحركة واطّرادها لمَا استقر شيء في مكانه، ولما تذوّقنا ما نحن فيه من سكينة وطمأنينة، فالأرض في هيئتها التي هي عليها الآن تتحرك وتهتز كمهد تهزّه أم رَؤُوم بلطف وحنان حتى إننا لا نشعر بحركتها تلك، فمن جعلها كذلك ذو رحمة ولطف لا نهاية له ولا حدود.
أجل، لا خوف ولا قلق ما دامت الأرض في يده، وتتحرّك بأمره، فهذا يبث فينا روح الثقة ومشاعر الاطمئنان، ويُشعرنا بالسكينة كما الطفل في مهدٍ تهزه أمه، وإذا قيمنا الأحداث وتأملناها من هذا المنظار فستطمئن قلوبنا وتهدأ نفوسنا.
ومن معاني “المهاد” الأرض المستوية المسطحة؛ فمن اتسعت آفاقه الفكرية أدرك من الآية معنى كهذا: كلٌّ منا يرى وجهَ الأرض مستويًا مسطّحًا حين ينظر إليه من مكانه، والأرض في الحقيقة كروية، ولكن الرؤية البصرية تظهرها لنا على شكل سطح مستوٍ، لا سيما لمن سبقونا بعصور.
وهذه عدة وجوه للآية، وسنذكر ولو إجمالًا آيات تشير إلى كروية الأرض.
إن هذه آية قصيرة أَوَحَتْ لشتى المخاطبين -وهم درجات- معانيَ متفاوتة، وكلٌّ يأخذ منها حاجته.
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ (سورة النَّبَأِ: 78/6-7).
هذا الاستفهام تقريري كأنه قيل: إنا جعلنا الجبال أوتادًا، فالأمي حسبه ظاهر الآية ليرى الجبال وكأنها أوتاد، وهذا البيان مناسب له؛ فإن منظر الجبال وشكلها يشبه الأوتاد المُثبتة في الأرض.
وأما إذا سمع هذه الآيةَ شاعرٌ فمما سيستلهمه حسب روحه الشاعرية -على حد تعبير بديع الزمان النورسي -: وجه الأرض بساط، والسماء سقفه المزين بالنجوم، وسفوحُ السماءِ في الآفاق ركبت رؤوس الجبال أو إن الجبال قواعد لأطراف السماء تُمْسِك بها، فالجبال كالأعمدة التي تمسك بالسقف، والأرضُ قصر يزين سماءَه ملايينُ المصابيح السيَّارة المتلألئة الوضاءة، وقاعُه بساط سندسي أخضر بأزهاره وأفانينه، فيا له من منظر خلاّب أعمدةٌ تتراءى لك وكأنها باسقات أصلها أرض القصر وفرعها سماؤه.
وأما البدويّ الرَّحُول فيَفهم من هذه الآية من منظوره هو أنَّ الجبال كأنها خيام شامخة في شكل مخروطي، لكن الفرق أنها في روعتها ورصانتها قائمة بقدرة مطلقة تفوق كلّ شيء.
فالبدوي يرى الأمر هكذا، فهو يستنبط من الآية بقدره.
وأما الإداري فترشده الآية إلى نظام الدولة. أجل، فالدولة مؤسسة مهمتها تسيير أمورِ المجتمع وإدارته، أي هي منظومة سياسية إدارية أنشأها مجتمع خاضع لحكومة ونظامٍ مشترك، ولها بناء هرمي كالجبال، والمجتمعاتُ التي تقوم على خلاف هذا لن تقوم لها قائمة.
نعم، إن جعل الجبال أوتادًا يوحي بهذه المعاني زيادة على المعنى الحقيقي.
هذا وللجبال دور حيويّ في استمرار الحياة كالتراب والهواء والماء، وبهذا تغدو أعمدة حقيقية للحياة العامة؛ فهي مخازن للماء، والماءُ أساس الحياة، قال الله تعالى:
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/30)، وأكثرُ من 70% من الجسم مكوّن من الماء، وهذا برهان دامغ على مدى أهمية الماء لحياة الإنسان والنبات والحيوان؛ فلا مراء في أهمية الماء، وإذا كانت الجبال خزائن المياه فلا جرم أنها أعمدة للحياة.
ومهامّ الجبال تنقية الهواء العنصر الثاني للحياة، فلا حياة من دون الهواء النقي؛ وهذا يبرهن على الأهمية الكبرى للجبال في استمرار الحياة.
وثمة تبادل للغازات بين الإنسان والجبال المكلّلة بشتى أنواع النبات والأشجار، فالنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون وتُطْلِق الأكسجين، والإنسان يتنفس الأكسجين ويُطلق ثاني أكسيد الكربون، وهذا عنصر أساسٌ لحياة الإنسان.
والجبال تحفظ التربة وتحميها، وتحتضنها كالأم؛ فلولا الجبال لسَطَتْ البحار على الأرض، ولك أن تتخيل ما كان سيؤول إليه أمرها حينذئذ، فلولا الجبال لتعذر على الإنسان أن يعيش في مستنقع، فهذا التحصين لليابسة له أهمية قصوى في حياة الإنسان، لذا فإن استمرار حياة الإنسان منوطٌ بالجبال من وجوه.
والأمطار والسيول تؤدّي إلى انجراف التربة على الدوام، فلولا الجبال التي تُمِدّ التربة وتعوض ما نقص منها، لما بقي الآن على وجه الأرض حَفنة من تراب، ولَاستحالت حياة الإنسان وكثيرٍ من الكائنات الحية.
هذه بعض وظائف الجبال في تغذية التربة وحمايتها باستمرار، وبها يكون الحفاظ على البيئة المناسبة لبقاء التربة وكثير من الكائنات الحية.
وعلى هذا فالمتخصص في علم الأحياء سيفهم من قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ هذه المعاني وما شابهها من معانٍ كثيرة، وسيقف بين يدي القرآن بكل أدب وخشوع.
والمتخصّص في علوم الأرض سيضرب بسهمٍ من هذه الآية، وسيطلع من منظاره على أمور مهمة، فلطالما يعتلج داخلَ الكرة الأرضية تقلبات عدّة تتحلل منها بعض المواد، وتدخل في تركيبات جديدة، هذه التقلبات والتغيرات التي تبدو كمن يتميّز من الغيظ، وهذه الحمم المندلعة من البراكين ما هي إلا تعبير عن هذا المحتوى الداخلي، فكأن الكرة الأرضية تلفظ ما في باطنها لتفتدي بذلك ما هو أكبر وأعظم.
وتبدو الأرض -والحمم تندلع من أفواه البراكين- كحَنِقٍ يتأفّف، وأفواهها وتأففُها على قدْر حجمها، فتهتزّ وتُزَلزَل من تأففها بعض المناطق، ولو لم تتأفّف لربما تصدَّعَتْ بطريقة أخرى؛ فهي تُخرج بالبراكين ما يعاني منه باطنها من تقلبات داخلية، فترتاح وتسكن، إذًا إن الجبال التي تندلع منها البراكين والحمم ما هي إلا حصون ودروع لسلامة الكرة الأرضية أجمع.
وقد تدل هذه الآية على المعنى التالي: ووجه تشبيه الجبال بالأوتاد أن البادي من الأوتاد أو المسامير بعد دسْرها أقل من المطمور في الأرض أو السطح أو الخشب، إشارة إلى أن الجزء المركوز من الجبال في الأرض أضعاف البارز منها، وهذا ما لم يكتشفه العلماء إلا في عهد قريب، وأشار إليه القرآن منذ قرون.
وهكذا سائر القرآن له وجوه وجامعية كهذه الآية المؤلفة من بضع كلمات.
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/30).
ولعله من المناسب تحليل المفردات أولًا: كلمة “كَفَرَ” بمعنى ستر وغطَّى، وسمي الزارع “كافرًا” لستره البذر بالتراب من قولهم: كفر الحبةَ أي غطاها بالتراب وسترها، وهذا أحد أوجُه تسمية الكافر بهذا الاسم؛ لأنه ستر ما في باطنه من قابلية المعرفة الإلهية وغطى استعداده هذا، ولم يُتِح له الفرصة لينمو وينكشف، وهذا انغلاق القلب دون “الحقيقة العظمى”؛ وهذه عاقبة عناده وغيّه، وسببها الرئيس عيشه كالعُمي، وإعراضه عن الحقائق.
نعم، إن الكافر هو من يهمل قلبه وعقله ويعطلهما، بل يمسخهما، وكلمة “كافر” في الآية تصوّر نواقض العقل والمنطق من التصرفات، وتفضح من يقضُون حياتهم سامدين ويفنون أعمارهم في قضاء نزوات النفس العمياء.
“رتق” معناها الالتصاق، والشيء ضُمت أجزاؤه وجُمعت بعدما تمزقت، والمراد أن السماوات والأرض كانتا متلاصقتين كالسائل أو الغاز، أي كانتا في هذه المرحلة شيئًا واحدًا لا انفصال بينهما، وكانت بهذا المنظر الرائع عرشًا للتجليات الإلهية، فالنجوم والنُّظُم والمجرات والسّدُم نمت في هذا الحقل وترعرعت فيه، وسيأتي وجه استنباط هذه المعاني من الآية.
“الفتق” ضدّ الرتق ومعناه الفصل، والشَّق، والفصل بين المتلاصقين، فيكون معنى “الفتق” في الآية الكريمة: فصل ما تجمع من الغازات عن بعضها، ومن معاني الفتق نظم خرز السُّبحة في خيط، وحلّ اللغز والأَحْجِية، ولشمول كلمة “فتق” لهذه المعاني اختيرت على مرادفاتها؛ فهي كلمة جامعة لمعاني الموضوع كلها.
ولهذه الآية معانٍ، كلٌّ يدرك بعضها من منظوره، من أهمّها ما يدركه العامّة والخاصّة: أنه لم يكن بين الأرض والسماء نظام وتناغم؛ فلم تكن السماء ممطرة، وكانت الأرض في رحم المستقبل، ولم يكن بين أجزاء هذا الجرم المذهلة تفاعل بخاريّ ولا أيَّة علاقة أخرى، وكذا بعد خلق الأرض لا مطر من السماء ينزل، ولا بخار من الأرض يرتفع، فكانت الأرض والسماء من جملة “المجهول”، ولم ينفصل الليل والنهار عن بعض، وما تزال الأرض في الرَّحِم، ثم أسبغَ الله تعالى الانسجامَ والانتظامَ على هذه الكتلة العملاقة الخَلِيّة منهما، ونَظَمَها كما يُنظم الخرز في خيط السبحة، وظهر للناظرين أن كل شيء مسخر بأمره، فخلق الأرض والسماء، وجهَّز الأرض بالغلاف الجوي، وأعلمَ كل شيء أنه القدير المطلق، وكلما أرعدت السماء ابتسمت الحياة على الخضراء.
والمثقَّف تدلّه الآية أن السماء والأرض كانتا تبدوان للناظر بلا هيئة ولا صورة، وكأنهما عبث، وكان الله الحكيم في أفعاله كلها المنزهُ عن العبث كتب أن سيخلق السماوات والأرضين لحكمة وغاية، فخَلَقَهما، وكساهما هيئة وصورة، فجعل الأرض قصرًا، والسماء سقفه المزين بالنجوم، والإنسان سلطانَه، وسخر له كل شيء، وصيَّره خليفة في الأرض، لِيُسَيِّرَ كل ما تطوله إرادته، فحقّق كثيرًا مما أراد، وغدت الأرض مهدًا له؛ فالوجود كله رهن إشارته، فكأن كل إشارة منه دعاء وأمر، وهذه المخلوقات المُسخَّرة له لو لم تكن مأمورة، لَمَا عرفته ولَمَا سارعت إلى إطاعة أوامره، فالذي سخر له كل شيء هو الله، وهو المنعم عليه بنعم لا تعدّ ولا تُحصى.
وأما المتخصّصون ذوو التجارب فمن منظار الآية يرون أن في الفضاء عددًا كبيرًا من السُّدُم ، ولعل منظومتنا كانت إحداها، ولما تَتَالَت الأزمنة تناقصت حرارة هذه الكتلةُ الغازية بإرادة الله تعالى وتقلَّصت، وزادت سرعة دورانها، وأخضعتها هذه السرعة لِما نسميه “قانون الطرد المركزي”، وهو القانون الذي وضعه الله بإرادته ومشيئته، فانشقّت الكتلة الأساسية الحلزونية الشكلِ، فخلق الله تعالى السياراتِ من هذه القِطع المنفصلة، وجعلها تدور حول الشمس وحول نفسها بـتأثيرِ ما في المركز من جاذبية الشمس.
نعم، إنَّ هذا الفَهْمَ موافق لمغزى الآية، فإن كلمة “الرتق” تستلزم معاني مثل: المائع المتجمّع، المادة اللزجة، المادة التي تتجاذب أجزاؤها، فكأنّ المراد: لم تتمايز السماوات والأرض من قبل، بل كانتا كتلة مائع أو غاز، فالله تعالى هو من فَصَلَ بينهما، ومايَزَ بينهما، وشكَّلهما وأخضعهما لنظامٍ ما.
وبهذا أرى لزامًا أن أشير إلى ملمح لطيفٍ قبل الختام وهو أن الخطاب في قوله:
﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ليس قاصرًا على قومٍ مضوا قبل بضعة عشر قرنًا لا يرون سوى موطئ أقدامهم، ولم يفارقوا صحاريهم، ولم يحاولوا أن يدركوا أمر النجوم ولو بالباصرة، ولا يعنيهم بل لا يفقهون ما ندركه اليوم ولا يعُون معنى قولنا: “إن السماوات والأرض كانتا كلًّا غير منفصل، ونحن فتقناها أجزاءً وفصلناها عن بعض”، فالمقصود بـ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عموم الكافرين لا سيما كفار هذا العصر الذين يخاطبهم القرآن بمعانيه الخاصة المتوجهة إلى عصرنا هذا عصر العلم، لكنهم سادرون وعنه معرضون.
إنّ كلمةً في آية توحي بضروب شتّى من المعاني لأناس على مستويات متفاوتة كل بقدره؛ فمثلُ هذه الجامعية لا ولن تجدها إلا في القرآن كما سبق، فإنه لَيستحيل على كلام البشر أن يبلغ هذا الشأوَ الرفيع.
ب. تعدّد الوجوه في معاني القرآن الكريم
إن ما ذكرناه حتى الآن يرتبط على الأكثر بعمقِ وتعدّد الوجوه في المفردة القرآنية، ولمعاني القرآن أيضًا عمق وجامعية تبرهن أنه خارق معجزٌ من هذا الوجه أيضًا.
نعم، إن لمعانيه جامعية حملت الفقهاء قديمًا وحديثًا على استنباط مئات الآلاف من المجلدات، فصنّفوا قدرًا تزيغ منه الأبصار، ونال العارفون شهدهم العرفاني من رحيقها، فسقوا بمؤلفاتهم الزاخرة ملايينَ الناس كؤوسًا عذبة، وكم جاش في أعماق العشاق قبساتٌ من إلهاماتها، وتمايلوا بحالات من العشق والمحبة في موجات المد والجزر الناتج عن الجذب والانجذاب، فكل ما أُلّف إلى يومنا هذا في الفقه أو التفسير أو علم الكلام أو التصوف فالقرآن المعجزُ البيانِ أسُّه وأساسه.
في رياض القرآن ترَبَّى فُحول الفقهاء كالأئمة الأربعة، وترعرع كبار المربيّن حتى غدوا أقمار سماء الولاية وشموسها منهم الشيخ أبو الحسن الشاذلي، والسيّد أحمد الرفاعي، والإمام الرباني، والشيخ عبد القادر الجيلاني.
ولو أن الغابات أقلام والبحار مداد، وكُتِبت بها تلك المعاني التي يتضمنها لُباب القرآن؛ لنفد المداد وما نفدت، ودليل صدق هذا الادعاء أنه لو عمد قارئ إلى كتب الحنفية ناهيك عن كتب غيرهم، فقرأ كل يوم مائة صفحة، لقضى فيها سنين طويلة، وكم من كتب الحنفية أتت عليها السنون، فلم تنتشر ولم تطبع، ومنها ما لا نعرفه بل لم نسمع باسمه، ولم تذق كلماته من مِداد المطبعة طعمًا.
وإن ضُمَّت إليها كتب المذاهب الأخرى لاستغرقت أعمارَ كثيرين، وإذا أُضيفت العلوم الأخرى كالتفسير والحديث وعلم الكلام والتصوف وغيرها صارت الأرقام عجبًا عُجابًا، كل هذه العيون تتدفق وتفيض من نبع القرآن، وتنحدر هدارة إلى يوم القيامة، فجواهر خزائن القرآن لا تنفد لأن وراء ما فيه من ثراء المعنى علمًا لا ينقضي.
إن القرآن يتناول الكون كله جملةً واحدة، وهكذا يقوِّمه، ولا يُغفل منه شيء، فالقرآن يتناوله من الذرات إلى الكرات كما يندف الحلاج القطن؛ ففي القرآن لكل شيء قدر ظاهره وباطنه، وداخله وخارجه، ولُبّه وقشره وأحواله كلّها، كل بحسب درجته ومستواه.
من أمعن في القرآن ولو بنظرة عَجْلَى فسيجد أنه ذَكَرَ كل الموجودات وما عزب عنه شيء؛ فتراه يُقْسم بالذرات (Atoms) ويَعْرض للأنظار كيفيتَها المذهلة، فلهذه الجزيئات منزلتها الخاصة في القرآن الكريم، ولا يدفعها صغرُ أحجامها أن لا تكون فيه، فما من شيء من دوران الذرات الملأى بالأسرار إلى جريان الرياح المنعش للأرواح المهدِّئ للنفوس إلا وله في القرآن ذِكْر على قدْر قيمته وأهميته، ويتنزه القرآن أن يكون مطروقًا، فيرتقي إلى قيم لا تحيط بها مداركنا: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا﴾ (سورة الْمُرْسَلَاتِ: 77/1-4).
هذا هو القرآن ينتقل من هذا التطواف والجولان في هذه السورة إلى سورة أخرى موضوعُها قلب الإنسان وعالمه اللدني وجوانيته، فيقول: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ (سورة الأَنْفَالِ: 8/24)، فيَعْبُر من الظاهر إلى الباطن، ليُثير في الأرواح هزة من لونٍ آخر.
إنه وهو يطرق قلب الإنسان لا يُغفل إرادته، فهو خير من يسبر الإرادة الإنسانية سبرًا يأسر الألباب ويصعق العقول ويقرع الأسماع: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾ (سورة الإِنْسَانِ: 76/30)، فكم في الإرادة الإنسانية من أسرار محورُها هذه الآية.
ثم يلفت الأنظار إلى الخلق الأول للإنسان، ليذكّر بماهيته وجوهره، ذلك الإنسان الذي من جنسه كان آلاف الأنبياء والأولياء، وآلاف الفراعنة والنماردة: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ (سورة الْمُرْسَلَاتِ: 77/20-23).
لكن لا يستمر حُسن الهيئة والقوام هذا: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (سورة النَّحْلِ: 16/70).
وتلك عاقبة عابرة في هذه الدنيا الفانية؛ ففي الآخرة الراحة والسكينة السرمدية تنتظر الأرواح الطيبة، وهذه حقيقة دلت عليها مئات الآيات وهي تتحدث عن العالم الأخروي.
و﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/185)، وموتها هو قيامتها الصغرى.. وأما القيامة الكبرى فهي ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ (سورة التَّكْويرِ: 81/1-3)، فالقرآن لا يُغفل هذه العاقبة، ففي هذه الآيات يذكِّر بذلك الحدث الهائل إذ يذهب ضوء الشمس، وتتبعثر النجوم كأنها عقد انفرطت حباته، وهكذا تملأ الرهبة القلوب.. فكأنَّ الحق ينادي عبده: ستخرج من هذه الدنيا كما دخلت، فتزود منها بقدْر عبورك منها، واستعدَّ للآخرة دار الرحيل بقدر خلودك فيها ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (سورة القَصَصِ: 28/77).
وعندما يتكلم القرآن عن الخلق يخصّ مرحلة البدء، فيقول: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (سورة فُصِّلَتْ: 41/11)، فقد بيّن أن السماء كانت دخانًا فقط، فشاءت إرادة الله أن تكون، فسوَّاهن سبع سماوات في شكل ما، وأنَّ السماء والأرض خضعتا لأوامر الله وسُننه طائعتين راغبتَين، وأنَّ الكون كُتِب وكأنه كتاب، وعُرض على أنظار أصحاب الشعور ليقرؤوه، وهكذا يحرك القرآن قلوبنا نحو حاجتها من العلم والمعرفة لعلنا نحلّ بعض قضايانا المعضلة.
والقرآن في حديثه عن خلق الكون لا يُغفل بأسلوبه الفريد ذكرَ طيّ السماء، وهي صفحة من صفحات الكون: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/104)، ولم يغفل أيضًا ذكْرَ تبديل الأرض وتغيّرها: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ (سورة إِبْرَاهِيمَ: 14/48).
وفي ذكره ليومٍ تُكشف فيه الأسرار يقول: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ (سورة الطَّارِقِ: 86/9) يومئذ تشهد على الإنسان يدُه ولسانه ورجله، فتحرجه أيّما حرج: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورة النُّورِ: 24/24)، إنه لَيبعث في القلوب مِنْ صنوفِ الرهبة والفزع ما لا يُحصَى، ليس هذا فحسب بل إن المرء يفرّ حتى من أقرب أقاربه بحثًا عن ملجإ يؤويه، هكذا يصوِّر القرآن ذلك اليومَ: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (سورة عَبَسَ: 80/34-37).
إنه لَيوم الفزع الأكبر، فيه تَبهَر الأهوالُ الناظرين، فتزيغ الأبصار، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولا ينفع في ذلك اليوم مال ولا بنون، وكل سيُوفّى عمله غير منقوص ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (سورة الزَّلْزَلَةِ: 99/7-8)، فستنجلي هذه الحقيقة ظاهرةً جليةً، وستصطبغ الوجوه بصبغة الأعمال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/106).
ثم يصور القرآن موقف الإنسان وهو ينتظر المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، وحالَ الناس وهم يأخذون كتبهم وتتعالى صرخات الفرح أو صيحات الحزن، فتنشرح صدور المؤمنين وتبتهج وهي تشاهد تصويره لنضرة النعيم على وجوه السعداء بعدما رأوا الجمال الإلهي، وعندئذ تبدأ السعادة السرمدية، لكن لا ريب أن بلوغ مرضاة الله فوق هذا كله وهي أسمى ما يبتغون: ﴿وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (سورة التَّوْبِةِ: 9/72)، فالمتنافسون في هذه الحَلْبة هم الفائزون في الدار الآخرة.
دلّ هذا أن لمعاني القرآن شمولًا، فلم يترك شاردة ولا واردة في الوجود إلا تحدث عنها بطريق العموم، فما من حادثة وواقعة إلا عرَضَ لها بقدر أهميتها في سياق بَدْء الخلق وختامه؛ فبهذه الجامعية والشمول عمد لتشريح (Anatomy) الكائنات كلها، حتى لَكأنّ الجزيئات كُبِّرت بعدسات وجُلِّيَت للأنظار.
وخصيصة القرآن هذه أرغمت فحولَ الشعراء والأدباء يومئذ على الإذعان للقرآن، وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فكم من علماء ومفكرين عمالقة في عصرنا أذعنوا للقرآن واتخذوه منارًا فريدًا يُهتدَى به، وأقروا بجلال قدره، وهذا كلّه دالٌّ على أن القرآن أجمعُ وأشمل رسالة إلهية إلى الإنسانية.
وإليك من شعراء الجاهلية ما يُجلّي مدى تأثير القرآن الكريم فيهم، فهذان الفحلان الشقيقان كعبٌ وبُجير -وهما ابنا زهير بن أبي سلمى أحد أعلام شعراء الجاهلية- كانا من شعراء العصر الذهبي للشعر العربي، وكان بجيرٌ قد سَبق أخاه إلى وسام الشرف بالإسلام، وأما كعب فتأخر وكان يحرّض على الإسلام، ولكنه انبهر بنور الإسلام ومعاني القرآن فهداه الله للحقّ وانجذب لنور القرآن كما الفَرَاش.
وكان كعب بن مالك فريدَ عصره، شاعرًا يَفخر به قومه الخزرجُ، ولم يشارك في تبوك فتجرّع مرارة ما عوقِب به وكأنها السم، فما انثنى عن إخلاصه وصدقه مثقال ذرة؛ إذ إنَّ البيان الإلهيّ سَحَرَه وأخذ لبَّه.
وهكذا حسان بن ثابت الشاعر المُفْلِق الذي خصّه الرسول بدعائه له قائلًا: “اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ” .. ومثله عبد الله بن رواحة، الأديب والشاعر، كان له قَرِيضٌ صارمٌ كسيفه، وصارمٌ مِخذَم كبيانه، والخنساء الشاعرة المقتدرة المفوَّهة، التي أغرَقت العالمَ العربي بدموع مراثيها في مقتل أخيها صخر، فلما تشرّفت بالإسلام، لم تجزع قط بل تجلدت يوم بلغها استشهاد بنيها الأربعة في القادسية، وقالت: “الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته” .
وسوى هؤلاء كثير لا يُحصون من شعراء وأدباء، أخذ بمجامع قلوبهم سحر القرآن وحده.
ولنا أن نعمم أكثر؛ فليس بمستنكر استناد مشاهير أعلام المسلمين إلى جامعية القرآن، وعليه لنا أن نقول: إن الأئمة الأجلاء كالغزالي وأحمد السرهندي وفخر الدين الرازي، وجلال الدين الرومي، وبديع الزمان سعيد النورسي.. كلهم يحومون حول البيان الخالد للقرآن كما الفراش حول الضوء، وإن القرآن قد أَسَرَهم وأخذَ بمجامع قلوبهم بجاذبية قدسيَّة ليست لسواه.
ج. الانتظام والاتساق القرآني
من الدلائل على أن القرآن كلام الله هو ما فيه من الانتظام؛ فانتظامه المُحْكم واتساقه المتين لا تبلغ شيئًا منه لوحاتٌ فنية بديعة نقشتها أيدي الفنانين المهرة، فالتناسب في الألوان وملاءمة المادة المستعملة لمكانها المناسب يفوق الوصف، ولا نشاز ينبو عنه البصر أو يعافه الذوق السليم.
وقبل التفصيل فلنبين معنى “الانتظام القرآني”:
مواضيع القرآن تكاد تجتمع كلها في كل موضعٍ منه؛ فمن الممكن أن نَجِدَ في سورة البقرة كلَّ القرآن، ونجدَ سورةَ البقرة في سورة الفاتحة، ونجدَ سورة الفاتحة في البسملة، فليس من المبالغة أن تقول وأنت تتأمّل أيَّ سورة منه: القرآن جميعه في هذه السورة، ولو أقسمت لم تحنث؛ لأنها حقيقة، فكل سورة من سوره صورة عنه.
نعم، نزل القرآن الكريم منجّمًا، في أمكنة شتى، لأسباب متنوعة بأساليب عدّة، لكن بين آياته انسجامًا تامًّا وكأنه نزل جملة واحدة في وقت واحد ومكان واحد.
إن البسملة نواة أودعت فيها معاني القرآن، فأَخرجت شَطْأَها في الفاتحة، وانشعبت أغصانُها وأفانينها في سورة البقرة، وتفتّحت أزهارُها وآتت أُكلَها في سائر القرآن، فالنسبة التي بين النواة والثمرة هي هي لم تتغير مع باقي آيات القرآن.
ومن المتعذر تصوير الانسجام بين الآيات القرآنية كلها، فحسبنا بيان ما بين البسملة والفاتحة، وما بين آيات الفاتحة إجمالًا.
1- العلاقة بين البسملة والفاتحة
هناك بين ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾ وبين الفاتحة عُرًى متينة، حتى لكأنها آية من الفاتحة، وعدَّها كثير من الفقهاء أولى آياتها السبع، فبين البسملة والفاتحة آصرة تُحاكي الانسجام بين مصاريع الشعر الموزون، وسبق في سياق بيان المعاني المُنيفة للبسملة: أن المخلوقات دانت لجلال الله تعالى، فخَلَقَها، وألقى بذور الوجود على أرض العدم، ونمَّى الكونَ ببذرة النور المحمدي، وأودعها لُبَّه، وجَعَل الإنسانَ ثمرة لشجرة الكون.
إن البسملة تبدأ باسم الله، وكان اللهُ ولا شيء معه، ثم خلق نور سيدنا محمد ووصفه بمثلِ آخرِ البسملة بأنه “رَحْمَة للعَالَمِين” وبأنه “رَحِيم”، ثم تتالى خلقُ سائرِ الكائنات من نوره، فتسلسلت الأحداث (الكونية)، وسمِّها -إن شئتَ-: “الأدوار الأرضية (Geological Periods)”، أو الأدوار التي تلاحمت فيها الغازات، فالبذرة صارت شجرة وراحت تنمو.
قد يغرس أحدنا شجرة لتثمر، فما تزال محط نظره ورعايته، يرعاها في كل طور، وعينه على أعاليها تترقب ثمارها، وقد تخلو بذورُها من أمارات الحياة، ولا يعني لِحَاؤُها شيئًا لناظرها، ولا كذلك أغصانها وفروعها وأوراقها قبل أن تُينع، فهي إنما غُرست لغرض كبير؛ وعين ناظرها مسمّرة على الثمرة التي ستطل برأسها من بين الزهور يفترّ ثغرها مترامية في الأحضان ضمن غُلُفٍ ربانية.
وهكذا جعل الله تعالى نور محمد بذرة في أرض العدم، فأنشأ الوجود من شعاع ذلك النور، ولو كان لِعِلْمِنا وإدراكنا أن يحيط بالأمر لجاز أن نقول: إنه مادّة الإلكتروناتِ وعالمِ الذرة، ومَبْلَغ علمنا أن شجرة الكون نبتت ونَمَتْ من تلك البذرة المحمدية في أرض العدم، وامتدت تلك الشجرة من العرش الأعظم ثم أينعت، وينعُها هو هذا الإنسان، ولبابُها هو سيدنا محمد الذي سماه ربه “المصطفى” أي الصفوة والرحيق.
هذه المعاني كلُّها في “بسم الله”، والمناسبة بين البسملة والحمدلة ندركها إذا علمنا أنَّ الله بجلاله زلزل الوجود فأخرج منه تلك الشجرة، وبـ”رحيميته” منحنا الإرادة، وهدانا لإدراك ماهية الكون وسَعته.
إن في البسملة جاذبية رحيمية لا يفوتها شيء حتى سورة الفاتحة، فكل من يشرع في ختمة يبدأ بالفاتحة، وقارئ الفاتحة يستفتح بالبسملة، وهذا الاستفتاح كأنه سؤال لنا: كيف ستلقون الله تعالى الذي يتحدث عن نفسه في البسملة بالرحمانية والرحيمية؟ وبأي كلام ستقابلون تلك الرحمة الجذابة التي تتجلى في البسملة بجمالها وجلالها؟
هذه أسئلة مقدرة وجوابنا هو: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فردّنا هو: “الحمدُ والثناء لله الذي أحاطنا ورعانا برحمته”.
إن الحق تعالى يتجلى تجليًّا كليًّا عموميا بـ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم﴾، وبرحمته يمنحنا من إرادته إرادة، وها نحن أصبحنا ندرك معاني الأشياء فسيَفتح لنا بابَ الحصول على بعضها، ويمنّ علينا بالهداية، أي إن الله تعالى أتى بنا إلى عالم الوجود فالإنسانية، ثم هدانا إلى الإسلام، فجعلنا أمة من شرَّفه وسماه باسمه في ختام البسملة (الرحيم)؛ فالرحمة التي تحيط بنا بجاذبيتها تجعلنا نقول: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فالحمد لله أنْ أوجدَنا، والحمد لله أنْ خلقنا في أحسن تقويم، والحمد لله أن جعلنا مسلمين، والحمد لله أن شرَّفَنا بالإسلام الذي هو الإنسانية الكبرى وجعلَنا من أمة محمد .
وقبيل التوجه إلى الله مباشرة نطوِّف في ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾ لنبحث في آثار الله تعالى عن الأدلة عليه ، ثم إن الله “رب العالمين” يقلِّب الكون بقدرته كالسُّبحة بيد المسبِّح، ويبصّرنا بعظمته وجلاله، ثم يدعونا في الفاتحة إلى التأمُّل في اسميه: “الرحمن الرحيم”، ليرينا كيف أنه -برحمته وشفقته- جعل وجه الأرض مائدة للنعم، وأن الكون كأنه أمواج من الشفقة تَمُورُ باسم “الرحمن الرحيم”، وتتوالى هكذا، فتتكون موجات متتابعة من الرحمة، والله من وراء هذا الغطاء يبصّرنا ويعرفنا نفسه، فنقف لنخاطب من جعلَنا نعي وندرك الرحمة المطلقة قائلين بلسانِ جميع المخلوقات ومشاعرها وأحاسيسها القلبية: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فَبَيْن ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾ و﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مناسبات من هذا النوع.
ونحن إذ نقوم بهذا الاستكشاف والبحث لا نخاطب الله مباشرة، بل نستعملُ صيغة الغائب وكأننا لسنا بين يديه .
هذا “مقام الفرق”، وأما “مقام الجمع” فهو أن يدرك الإنسان الحقائق الكونية جميعًا بمنظار فلكيّ، ويَمْثُلَ بهذا المستوى من الإدراك بين يدي الله تعالى.
وإليك مثالًا يجلِّي المسألة:
إن العبد لن يعرف ربه سبحانه، ولن يتسنى له أن يتوجه إليه، ويقومَ بعبوديته كما يليق بعظمته تعالى إلا إذا أَدرك معنى الكون كله جملةً واحدة، وهذا يستلزم أن يُطلّ من منظار فلكيّ على ذلك المقام السرمديّ، وبه يمكن أن يرى شؤون الله في هذه الدائرة الواسعة، ويفهمَها، ويحيطَ بها علمًا، فيكبّر من أعماقه، أو يسبّحه وينزّهه، وما لم نَحظَ بمثل هذه الأمور على وجه كامل، فإننا سنظل في “مقام الغيب، والإيمان بالغيب” إذا لم تُكشف لنا هذه الأمور تفصيلًا.
وكلما نظر الإنسان إلى التسيير الجليل للكون وما فيه، تقرَّب إلى الله تعالى وحظي به، وهذا القرب سيكشف ما في جوانيته من حُجُب البعد، فيدرك ويستلهمُ مما كان يفهمه وعلى نحو ما أمورًا مختلفة، ثم يرقى إلى مقامِ “كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَالله بخلاف ذٰلِكَ”، وهذه ذروةٌ كلما أدرك الإنسان منها شيئًا، وجد أن الله مِن ورائه؛ فإذا نظرنا إلى زهرة، أبصرت قلوبنا أن صنعها المتقَن من فعل البديع، وإذا رأينا ثمرة على شجرة فسيغمرنا الإحساسُ بـأن مصوِّرها وبارئها بهذا الشكل والنضج والقِوام هو الله تعالى، وإذا تأملنا الخلق شاهدنا عليهم تجلياتِ الرحمن الرحيم ومحاسنها كافّة.
بهذه المشاعر والمشاهدات يكدّ الإنسان ويجدّ للخروج من “مقام الغيبة”، فإذا بقلبه ووجدانه تترعرع فيهما مشاعرُ وأحاسيس تجاه الحق تعالى تحمله على مخاطبته بـ”أنت”، وما إن يَظهر هذا الإحساس حتى يشعر بمثوله أمام حضرة المولى ، أي يشعر وكأنه لطائف مركبة من أسمائه تعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن، فيناجيه من صميم قلبه بإخلاص تام: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، فإذا به في المقام الذي يستطيع فيه أن يخاطِب اللهَ تعالى بـ”أنت”.
على زائر السلطان أن يقدم بين يديه هدية، وهديتنا التي نقدّمها هي “الغاية التي من أجلها خُلقنا”، ألا وهي “المعرفة الإلهية”؛ فعلينا أن نُقرّ له بأن غايتنا معرفته، ونعترفَ بأن نواصينا وأمْرنا بيده، ولا يجدُ وجدانُنا خطابًا لائقًا إلا ما علَّمَنَاهُ بقوله “إياك”، والحقيقة أننا مفطورون على هذا الإحساس المكنون في وجداننا وعلى هذا الشعور القائم فينا، لكن يغيّب هذا الوجدانَ بعضٌ من رانِ المعاصي، فإذا شاهد العبدُ “شؤون” ربّ العالمين، واطَّلع على تجلياته بالرحمة، فسرعان ما يزول هذا الران ويتجلّى الوجدانُ، ويصدح بـ”إياك” بنقاءٍ صِرفٍ، فينطلق اللسان بـ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾.
وإذا حظي العبد بهذا القرب قال: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ لأنه لن يستطيع النهوض بتكاليف العبودية إلا بمعونةٍ كهذه، فلا واسطة ولا وسيلة؛ فالعبد الذي ارتقى في مقام الخطاب إلى هذا المستوى لا بد أنه سيستعين بالله وحده، فإنه في مقامه هذا يكون قد تخطَّى كل شيء وشاهَد بوجدانه قدرةَ الله وعظمته، وارتقى من مقام الغَيبة إلى مقام الخطاب.
وكأن الإنسان يلُوح له وهو في هذا المقام أنها فرصة وصلاحية، فليستثمرها على أفضل وجه، إذًا عليه أن يقتنصها ويطلب أحسن ما يليق بأن يُطلب، وها هو ذا يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم قائلًا: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.
وللقرآن ثلاثة محاور: العقيدة، والعبادات، والحياة.. فالعقيدة كلُّ ما يجب اعتقاده، والعبادةُ كلُّ ما يجب فعله، والحياة هي تطبيق الأحكام القرآنية على الفرد والأسرة وشرائح المجتمع كافّة.
إن موضوع القرآن إجمالًا هو هذه المحاور الثلاثة، ولا تخلو سورة منها، فهذه سورة الفاتحة تجمع بين العقيدة والعبادة والحياة؛ فالعقيدة من قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ﴾ إلى قوله ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، إذ إن ﴿الْحَمْدُ لِلهِ﴾ تعبيرٌ عن الركن الأساسي للإيمان، فهي تُبين أن الله تعالى هو وحده المعبود الحقيقي، وهذا هو جوهر التوحيد وصفوته، وأما قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فيشير إلى صفات الله التكوينية المتصرفة في الكون، وإلى أسماءٍ من جنس هذه الصفات، ويدخل فيه كلُّ اسمٍ له في خلق العالم وتدبيره أثر؛ وفي قوله ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ توحيدُ المالك ليوم الدين يوم الحشر والآخرة والحساب والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب.
إذًا مِن مطلعِ السورة إلى قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ موضوعُها العقيدةُ والحديث عن مسائلها بأبعادها كلِّها، وقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ يتناول العبادات، وهو مطلق يصدق بالبدنية والمالية، فأشار بكلمة إلى الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد… وقوله:
﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ يشير إلى أن العناية الإلهية أُسّ الأسُس، وإلى الاستغراق في العبادة، ويأتي الحديث عن الحياة في قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.
إن الفاتحة تبدو وكأنّ محورها “الصراط المستقيم”؛ فهو صراط لا إفراط فيه ولا تفريط، فالنوازع النفسانية في توازن تام مع اللذائذ الروحية، والعقل على خط متوازٍ مع القلب وكأنهما فرسا رهان.
فاذا عوّلنا في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم على المحاور الثلاثة: (العقيدة، العبادة، الحياة) يكون المعنى: اللهم اهدنا في العقيدة الصراطَ المستقيم، وأرشدنا في عباداتنا إلى الاستقامة، وبصِّرنا بطريق الدين منهجًا لحياتنا.
هذه الأسس الثلاثة مواضيع القرآن الرئيسة هي العقدة الحياتية في الفاتحة أيضًا، ولولا الهداية الربانية، لتعذّر الوصول إلى الحق في العقيدة والعبادة والحياة، فالهداية أولًا، وبها بدأت سورةُ البقرة أيضًا، بل جوهرها ومفتاحها قوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/2)؛ ففي كلمتين أبانت بإيجاز أن القرآن فيه الهدى الذي تسألون، وأنه لا هداية في عقيدة أو عبادة أو نمط الحياة إلا باتباعكم له مطلقًا.
وبين طلب الهداية في سورة الفاتحة وقولِه تعالى في سورة البقرة: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ آصرة متينة، فلو اجتهدوا لتحقيق ما في الفاتحة من هداية بالمعنى المصدري بأن أنزلوها على الواقع، لتحقَّق نمط الحياة الذي يدعو إليه القرآن ولأثمرَ فكرًا ومنهجًا إسلاميًّا، وطلاب الهداية في الفاتحة هم من يشعرون في سورة البقرة بأن القرآن منبع للهداية، فينهلون منه، ولا يستشعر في سورة البقرة بأن القرآن مصدر للهداية، فيتَّبعُ هداه، إلا من التمسها في سورة الفاتحة.
وكليات الفاتحة في العقيدة والعبادة هي مطلع سورة البقرة، فالفاتحة من ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ في قضايا العقيدة، وقولُه تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ في العبادة، وفي مطلع سورة البقرة بعد قوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾، أوصاف المتقين: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾، وهو فحوى قوله تعالى في الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾.
والعبادة نوعان: مالية وبدنية، فقوله تعالى: ﴿يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ إشارة إلى العبادات البدنية، وقوله تعالى:﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ إلى المالية، وهكذا يظهر جليًّا التناغمُ والانسجام بين الآيات الأولى من سورتي الفاتحة والبقرة.
والصلاة والزكاة ركنان في العبادات، فذُكرتا دون غيرهما، وأيضًا بين قوله تعالى:
﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ وقولِه تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/5) تطابُق تامٌ، فما ورد في سورة الفاتحة اعتضد بالآيات الخمس الأولى من سورة البقرة، فيا له من تناسب وانسجام فريد!
وموضوع قوله تعالى في الفاتحة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ جاء في بضع عشرة آية من سورة البقرة بدءًا من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وكذا في سورة يونس بالتفصيل، فبين الفاتحة وسائر القرآن وشائج وأواصر، ولن ترى مثل هذا الانسجام إلا في القرآن، وهو كذلك من كل وجه، فأيّ إعجاز هذا!
2- التناسب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء
ونقدم ههنا ومضات لما بين هذه السور الثلاثة من التطابق والتناسق والوحدة الموضوعية قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/21-22).
مطلع الآية دعوةٌ للخلق إلى عبادة الله والإيمانِ به، وعرضٌ لتجليات علمه وإرادته في السماوات والأرض لعلهم يؤمنون عندما يشاهدون آثار التصرفات الإلهية جملةً واحدة وكأنهم يشاهدون عرضًا سينمائيًّا؛ يُنـزل الله الأمطارَ، وينبت الأزهار، فيُمد الإنسانَ بكل شيء؛ فالمراد من ذكر نعم الله في الأرض والسماء، دعوة الناس إلى عبادته، فالهدف هو العبودية لا عدّ النعم فحسب.
تذكَّرْ هذا وتأملْ ما تلاه: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي [أي في بيان الحقائق] أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا [أي ما هو أضعف منها] فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/26).
مطلعها البحث في القدرة والقرآن وأمثاله، ثم محاولة الكفار والمنافقين استهجان هذه الأمثال، ثم يذكّر الناس بما أخذوه على أنفسهم من ميثاق في عالم الأرواح أَن يؤمنوا ويتبعوا سيدنا محمدًا نبي آخر الزمان، فنقضه كثير منهم، وما زالوا يفعلون، وهذا ما تذكِّر به الآيةُ الكريمة بأسلوبها الطريف: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/27).
فحياة هؤلاء هي الخذلان، وبنيانهم الاجتماعي متداعٍ من الفوضى؛ نقضوا ما عاهدوا الله عليه، فعاد ذلك على عقدهم الاجتماعي، فتاهوا في حلقة مفرغة ودَوْرٍ فاسد، وكلُّ دائرةٍ فاسدةٍ تولِّد دائرة أخرى، وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ
أَنْ يُوصَلَ﴾ من أواصر الإيمان وصلة الأرحام ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ﴾.
ومطلع سورة البقرة فيه عناصر متنوّعةٌ تُقَدِّمَ لنا “تحليل الطبائع”، فالصورة القلمية المصوَّرة يصدِّقها الحسّ السليم والعقل السليم والقلب السليم، ففي مرآة هذه الصورة القلمية تبدو طبيعة “قوم متمردين” قَتلوا الأنبياءَ على مرّ التاريخ، ولم يألوا جهدًا
ولا وسيلة في الإساءة إلى الرسول .
وهذه الشخصيةُ المصوَّرة في عدة مواضعَ قرآنيةٍ متشبثةٌ بالحياة، مغرمةٌ بدوامها، حريصةٌ على منافعها، وتركبُ كلَّ مركبٍ في سبيل مصالحها، يداها ملطختان بدماء الأنبياء، بل إنها لتساوم الله بسفاهة.
وأبرزُ أوصافهم إثارة الفوضى، ودفعُ المجتمع نحو الأزمات والمعضلات، والصراعُ على حيازة الدنيا بأسرها، وهذا منتهى آمالهم، فيا لهم من متمردين!
وأنت على وعي بأنهم كلما سنحت لهم فرصة نشطوا -لا سيما ضدنا فلنأخذ حذرنا- وفق هذه الخصال المتجذّرة فيهم.
ومعالم هذه الشخصية وردت في بعض السور، وآيات من سورة البقرة، وبأقسى من هذا في نُسَخ الكتاب المقدس كالعهد القديم والجديد فقد ورد فيها تصريحًا وتلميحًا أن هذه الشخصية المتمردة التي باءت مرارًا بتشنيع الله لها وتقبيحه على لسان موسى وعيسى وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام؛ لتُفسِد في الأرض كثيرًا، فيا أيها المؤمنون الحيطةَ الحيطةَ والحذرَ الحذرَ من فعالها الخبيثة.
وفي بعض الأحكام قسوة، قد تبدو شديدة لكنْ فيها خير كثير، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/216).
إن أقلام القدر خطت ذلك التكليف في اللوح المحفوظ، فهذا الحكم كائنٌ لا محالة، وأنى لكم أن تخرجوا عنه وما أنتم إلا بشر؛ فهذه هي الجغرافيا الاجتماعية ما تزال تتبدل كل حين بما يجدّ من أحداث.. فلا مفر إذًا من الخصومة والنزاع، وقد يهاجُمكم قوم متغطرسون أو قوةٌ إمبريالية محتلة، فيمتنع حفظ العِرض والنفس والشرف والمال إلا بالدفاع والقتال، ومن هنا قد يكون للحرب وجه حسن من باب “الحَسَن لغيره”، فعلى الإنسان أن يتحرى الخير دائمًا ويسعى جاهدًا للوصول إلى الحسن لغيره إن تعذر عليه بلوغ “الحسن لذاته”.
والقرآن الكريم يتحدث في مواضع عدة ومناسبات مختلفة عن اضطرار المظلومين للجهاد، ومنها سورة البقرة، وفيها أيضًا قضايا اجتماعية كثيرة، وتفصيل ذلك يطول فحسبنا هذا من تطوافنا في رحاب القرآن الكريم، لنشرع في مناسبات السور الثلاث:
بَيْنَ مطلع سورتي البقرة وآل عمران تناسبٌ وثيق، وسور القرآن كلُّها بينها تناسبٌ وتناغم، إلا أن التناسب هنا أجلى وأقرب.
مطلع سورة البقرة ﴿الٓمٓ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/1-2) وكذا مستهلّ آل عمران ﴿الٓمٓ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/1-3) فالتناسب بينهما أوضح من أن يُبيّن أو يؤول.
في الآيات العشرين الأولى من سورة البقرة ذكر المتقين والكافرين والمنافقين، وفي سورة آل عمران الدعوة لجهاد الكافرين والمنافقين، وهذا إشارة لتناسب محتواهما.
وفي آل عمران ذُكِرت غزوة أحد بإطناب، فما ذُكر في سورة البقرة مقتضبًا فُصِّل في آل عمران مشخَّصًا؛ ففي غزوة أحد اجتمع المتّقون والمنافقون والكافرون، فدلّ هذا أنه روعي في عرض الأحداث التناسبُ المذكور.
وكثيرٌ مما أجمل في سورة البقرة فُصِّل في آل عمران.
وهذا كله يدفعنا إلى التأكيد على النقطة التي نريد إبرازها، وهي التناسب.
والاتساق المذكور في البقرة وآل عمران تراه كذلك في سورة النساء، بل في السور كلّها، وأدلّ دليل هو الانسجام الذي رأينا بين قوله تعالى في الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ وقوله في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/21).
قضية العبودية في سورة الفاتحة تتكرر في سورة البقرة بأسبابها الموجِبة لها يقول داعيًا إلى العبودية والتوحيد: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/22)،
وفي سورة النساء يتجدد الخطاب بالصيغة نفسها في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/1).
فمَن أمعنَ النظرَ تجلَّى له ما بينها من انسجام لا يعوزه تبيان.
وإليك وجوهًا أخرى:
أولًا: هذه السور رغم تمايزها فإن العبودية محورها.
ثانيًا: صيغة الخطاب واحدة في مستهل هذه الآيات جميعها وكأنها رمز مرور.
ثالثًا: أُجمِلت التقوى في إحدى هذه السور وفُصِّلت في أُخرى.
رابعًا: إجمال الخطاب في بعض الآيات وتفصيله في بعض، مثل قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾.
ومن أمثلة التناغم والانسجام بين السور قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/27)، وقوله في صدر سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/1)؛ والتناسب بينهما في أبهى صورة، فلا حاجة لتلمُّس الانسجام إلى أي تفسير وبيانٍ؛ فالثانية كأنها تكمل ما تناولته الأولى، فبينهما مئات الآيات لكن لا وقْصَ في الانسجام.
وبعد أمثلة عُجاب في سورة البقرة عن المنافقين، تتحدث السورة عن الخالق البديع والقدرة والإرادة المطلقة التي تدبر كل شيء: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/29)..
بدأت الآية بالضمير “هو”، وهو في سورة الأنعام أكثرُ من غيرها وإليك بيان ما فيها من اتساق مع هذه الآية من سورة البقرة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/2)، أي إنكم في أصل الخلق طين، ثم رفعكم الله تعالى ورقَّاكم إلى مقام الإنسان صورة ومعنى وماهية.
﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/60)، فبهذه الوفاة يهبكم الراحة لتقدروا على المضي في الحياة.
﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/165)، فلكم بوصفكم خلفاء التصرف في الكون بإرادة الله تعالى، فباسمه تعالى تعمرون الأرض ورياضها وبساتينها، وتؤبّرون أشجارها، وبإرادته تنظِّمون أمور الأسرة والمجتمع والدولة وتدبرونها، إنكم خلفاؤه تعالى ومحطّ عنايته.
هذه الأمور فصِّلت في سورتي البقرة والأنعام، وإن التدقيق في السورتين مع ملاحظة ما بينهما من سور ليرشدنا ويدلّنا دلالة واضحة على مدى ما بينهما من تناغمٍ وانسجام فهذا الانسجام الذي نلاحظه والتناغم الذي نشاهده إعجازٌ لا طاقةَ لبيانِ الإنسان به.
وأجلى ما يكون التناسب القرآني في آيات حقيقة الخلق، فأساليبها متنوّعة في سور متفرِّقة، لكن فيها تناغم وانسجام وكأنها جملة واحدة؛ وتناسبها محكم مع سياق السور الواردة فيها، ومع الآيات الواردة في السورة قبلها وبعدها.
نعم، إن آيات خلق الإنسان، وتكريم الله له بسجود الملائكة، تتناسب فيما بينها بانسجام عجيب؛ فقول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/34)، قد فُسِّر في الآية الحادية عشرة من سورة الأعراف بإطناب، وكأنه لجلالة هذا الحدث خُصّ بالذكر مرارًا ليُعْنَى الإنسانُ بهذه الحقيقة، ومن أمعن في القرآن جملةً لحظَ هذا الأمر؛ فهو يجذب الأنظار إلى كل أمرٍ جَلَل؛ ومنه هذا الموضوع في سورة الأعراف: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (سورة الأَعْرَافِ: 7/11) فبين الآيتين اتساقٌ وتكامل، ومن تتبعَ هذه الآيات بحذقٍ أدرك الملامح الرئيسة للانسجام والترتيب القرآني، وعقب قضية الخلق تتحدث سورة الأعراف عن أولئك المتمردين المعهودين وتشير إلى ما في السور السابقة من آيات عنهم، وهذا من ملامح الانسجام القرآني الذي طالما تَحَدَّثْنا عنه.
وهناك موضوعٌ آخر ذو قدرٍ جديرٌ بالبحث:
في سورة البقرة معلومات وبيان مفصّل عن الشخصية المتمردة والنمط المُفسِد في الأرض على مرّ التاريخ وفي عصر النبوة، وعما تتّصف به من إحداث الفتن والفساد في الأرض، المُودِي بالإنسان في اضطرابات اجتماعية، ومما عنيت به سورة البقرة الوظائف والمَهامّ التي تجب على المسلم في مواجهة الكفار والمنافقين ومن والاهم من أهل الكتاب، فعليه أن لا يتوانى عن التضحية لإعلاء كلمة الله، وهذا هو “الجهاد” اصطلاحًا.
وفي آيات من سورة البقرة أنّ الرسول سُئِل عن الجهاد تَتْرَى، ولا أدلّ على هذا من قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/217).
والصبغة هي هي في سورة الأنفال، ولكن المسؤول عنه مختلف؛ فالسؤال عن تقسيم الغنائم لا القتال.
وبين هاتين الآيتين انتظام واتسّاق أخَّاذ لم يُخِلّ به ولو يسيرًا الفصل بينهما بمئات الآيات.
ومن أمعن وعمَّق ودَقَّق النظر في القرآن كلِّه رأى فيه تناغمًا وانسجامًا يستحيل أن تأتي به قرائح البشر، فالسورة من قصاره أو طواله متّسقة، والتناسب نفسه تراه بين السور، فكل سورة كأنها صورة مصغّرة للقرآن، فيها كل ما فيه؛ فالانسجام مكينٌ فيه وأصلٌ.
لقد اتفق المفسرون والعلماء جميعًا على هذا، وذكروا أن القرآن كلّه في سورة البقرة، وسورة البقرة في الفاتحة، والفاتحة في البسملة؛ إذًا القرآن من مبدئه إلى منتهاه في انسجام تام وكأنه جملة واحدة.