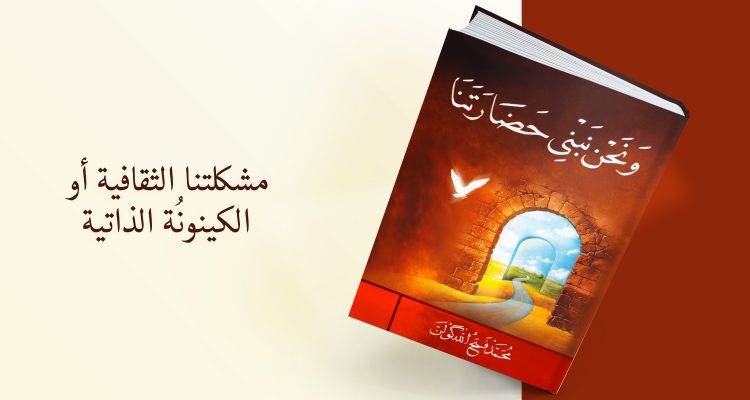لا شك أن المعنى الذي نقصده من “الكينونة الذاتية” هو إبراز هويتنا الداخلية المنسوجة من ميراث حضارتنا الذاتية وثقافتِنا الذاتية، وجعلُها “المحورَ” الذي ندور حوله. فلربما يَفهم بعضُ الأوساط في أيامنا هذه كلمةَ “الذاتية” على أنها العروض الفلكلورية التي لا علاقة لها بالجذور “المعنوية” لأمتنا، و”الغرائزُ” التي تطفح حينما تحس الكتل البشرية بالحاجة إلى إشباع نزواتها “الجسمانية”، والمراسيمُ التي تقام في مناسبات الأكل والشرب والأعياد والأعراس… لكننا نحن نفهم من تعبير “الذات” معنى أوسع وأشمل وأعمق؛ فهي ظاهرة أجرت فاعليتها في كل شرائح المجتمع، وتغذت من ذاكرة الأمة وشعورها ووجدانها على مر الزمان إلى أن وصلت إلى عصرنا هذا، وانعكست على مشاعر الأمة وأفكارها ولسانها وتصوراتها الفنية وتمثلت فيها، وعشناها في أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا باعتبارها أهم عمق من أعماق الحياة في كل أوان.. فنحن نحس ونشعر بها في كل وحدة من وحدات الحياة، وفي كل صفحة من صفحاتها وكل مرحلة من مراحلها، وفي كل محطة من محطاتها؛ من الرعاية التي نلقاها في أحضان أمهاتنا إلى سلوكيات أجدادنا المشبعة بروح الأبوة الحانية التي تعكس طبيعتنا الذاتية.. ومن طبع برامجنا التربوية ومضامينها بروحنا الذاتية إلى نفخ المربي لهذه الروح بأكمل وجه.. ومن أشكال الطهي في مطابخنا إلى تصرفاتنا في حقولنا ومزارعنا.. ومن قيامنا وقعودنا في مكاتبنا إلى أخلاقياتنا المهنية.. ومن أساليب كلامنا وكتابتنا إلى علاقاتنا بالآخرين.
قد لا يُدرِك البعضُ على المدى القريب الفوائدَ العملية أو الاجتماعية للعيش في أجواء “محور الذات”. لكن من الطبيعي والبدهي أنه على المدى البعيد وبالإصرار عليه سوف تبدو الأهمية الحيوية له في مراحل التقدم كلها. وعلينا في هذا السياق أن نواصل السير في إطار ديننا وتراثنا وأعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا، مع أخذ ما يستجد من تفسيرات الزمان بعين الاعتبار. وبمرور الزمان ستكون قيمنا الذاتية جزءًا لا يتجزأ من طباعنا. وما نقتبسه من الخارج سيصطبغ بصبغتنا وسنتبناه فيكون لونا مهما من ألوان الخطوط في نسيج أطلسنا الذاتي؛ الفكري والثقافي.
إن تلك الحضارات التي كانت تُذهِل العقولَ وتَبهر العيونَ بغناها الثقافي لم تَظهر في روما وأثينا ومصر أو بابل فجاءةً من غير مقدمات؛ إن الثقافة في كل مكان إنما وُلِدت بعد حضانة طويلة في عالم المشاعر والأفكار للأفراد، وفي السفوح الخصبة للوجدان العام، واستقت من المناهل الداخلية بشكل مباشر، ومن الخارجية بعد الترشيح والتصفية، فترعرعت حتى صارت بعد زمان عمقا مهما لطبائع الشعوب ولونًا ظاهرًا لحياتها، ثم أحاطت بأرجاء الحياة كلها وإن لم تَجْرِ الألسنُ بالكلام عنها دائمًا، فهيمنت على حياتها في المعبد والمدرسة والشارع والبيت والمقاهي وغرف النوم… حتى إنَّ الناس لو لم ينصاعوا لها بإرادتهم ووعيهم، فقد كانت تطوِّعهم بقوة سرية عفوية تأسر إرادتهم.
فأية أمة أرسيت قواعدُها بهذه المثابة على أساس ثقافي بهذه الرصانة فإنها بمرور الوقت ستصل إلى مستوى من النضج بحيث يكون من الطبيعي لها أن تتخطى كل العقبات التي تعترض طريقها كالجهل والفقر والتشرزم والتسيب والضغوط الخارجية. فكل من حضارة روما وأثينا ومصر والعثمانيين تُعتبر -باعتبارها من حضارات العهد الوسيط- من الأمثلة الجيدة على هذا.. وبالنسبة للتاريخ القريب تُعتبر ألمانيا نموذجا لابأس به لولا أنها أنهكت نفسها بخوض مغامرات من نوع الحرب العالمية الثانية. فبعد الحرب العالمية الثانية، انقلبت ألمانيا عاليها سافلها، وصار اقتصادها ركامًا، وتسلط الأجانب على سيادتها الوطنية، وتفرَّق المجتمعُ إلى معسكرات متنازعةٍ في الجو النفسي الذي ولَّدته الهزيمة والبؤس، وصارت تلك البلاد من أدناها إلى أقصاها معسكرًا للأسر… لكن قلوبهم كانت-في الوقت ذاته- تنبض بالهمة، ورؤاهم تفوح بحب ألمانيا الكبرى، وكانوا على ثقة تامة بأن قوتهم العضلية وفكرَهم كافيان لتحقيق ذلك. وكانوا على يقين بأن ألمانيا إذا كانت لا بد وأن تنجو من ميدان الموت هذا، فإنما تنجو بطاقتها الحيوية وثقافتها المستقرة الراسخة. وهذا ما حصل فعلا. نعم، إن الشعب الألماني ولَّى وجهه شطر جذوره المعنوية، واستفاد بعقلانية من الظروف الاجتماعية، والنفسية-الاجتماعية، والاجتماعية- الثقافية، وأصبح من الذين قرؤوا وفسروا أوضاع النصف الأخير من القرن الماضي في سبيل مصالحهم، بشكل لم يسبق له مثيل.
نستنبط من هذا الأنموذج: أن اختزال أسباب المعضلات السياسية والاقتصادية والإدارية لأي بلد وحصرَها في السياسة والاقتصاد والإدارة وإن صح من وجه معين، لكنه معلول بنواقصَ من أوجه كثيرة ؛ فما من شك في فائدة الجهد والهمة والعلم وابتكار البرامج البديلة في كل ساحة وميدان، لكن هنا أمر آخر ينبغي صرف الهمة إليه بالضرورة، وهو -على ما أعتقد- ثقافةُ الأمة وجذورها المعنوية؛ إذ ينبغي على الأمة ألا تغض البصر عن جذورها المعنوية في جميع فعالياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وألا تنسى البتة الرسالةَ الهادفة المميِّزة لثقافتها الذاتية، ما دامت قد قررت أن تتقاضى وتتحاسب مع عصرها.
صحيح أنه كلما دار الحديث حول التغير والتطور في بلادنا حصل التركيز على ثقافتنا الذاتية، ولكننا لا يمكننا الحديث عن مبادرة تتصف بالديمومة والمنهجية في هذا المجال؛ فالمدارس (التقليدية) والزوايا والتكايا التي كانت تربي مهندسِي فكرِنا وعمالَ روحنا في الماضي، لم تنتج مشاريعَ تأخذ بأيدينا إلى المستقبل. وإذ لم تنجح في ذلك، انسحقت تحت ركام أنقاضها. وإذ نقول هذا القول، نواجه مبدًا يكاد يسكتنا ويضرب على أفواهنا، هو: “اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم”،( ) ويمنعُنا من أن نتفوه بشيء غيرِ هذا. ونحن بدورنا نقول: “إن حوادث التاريخ لا تعيد نفسها مهما تشابهت فيما بينها. فاللازم أن نعتبر بعبرها، لا أن نتلقى دروسًا منها”. ومن ثم نوجه الأسئلة عن الماضي إلى أنفسنا في الحاضر، فنقول: إن الذين سبقونا قد انقرضوا لما انحرفوا عن الغاية والهدف من وجودهم. ونحن اليوم في الموقف عينه. فالأصوب إذن أن نقاضي أخطاءنا بدلاً عن الانشغال بأخطائهم، وإن سلّمنا بوقوعها.
لنسلِّم بأنهم لم يأبهوا بالمنابع التي ينهلون منها، فصاروا وسيلة لجدب أمتنا. لكن قولوا لي -أرجوكم- ما الذي صنعناه نحن؟ هل نستطيع أن ندَّعي بأننا -كشعوب- وفَّيْنَا بمسؤولياتنا كلها؟ أو هل نزعم بأننا قمنا بإدارةِ مؤسسات الدولة كما يتطلبه العصر؟ رجاءً أفيدوني! من يستطيع أن يقول: إن المدارس في كل هذه المدة المديدة قد أثمرت المرتجى؟ صحيح أن كثيرا من الشباب حصّلوا تعليمًا عاليا في باريس ولندن وميونيخ ونيويورك… لكن هل صاروا أعضاء نافعين لمجتمعهم؟ بل على العكس؛ فدع عنك كونهم أعضاء نافعين، رجع أكثرهم إلى بلادهم بأحلام (فانتازيات) مختلفة، وجلبوا للوطن معضلات عويصة بتأثيرِ تياراتٍ مثل الأنكلوسكسونية والنازية والسلافية، أو الرأسمالية والليبرالية والشيوعية؟ فزادوا الاضطراب اضطرابا، وزادوا القطيعة مع الذات شدة… ولا زلنا نرجو ونأمل ألا يدوم الحال على هذا المنوال.
والحقيقة أن ثمة أسبابا كثيرة تبعث على الرجاء والتفاؤل؛ فقبل كل شيء، قد أصبحنا نعي إبان هذه المدة ما أصابنا من الغدر والظلم. ويمكن لألبوم الصور المريرة هذه أن تلهمنا صورا مختلفة منذ الآن.. إنَّ تَعَلُّقَنا بمد جسور الصداقة مع فرنسا وألمانيا وإنكلترا وأمريكا، وخيبةَ آمالنا، وقلةَ حيلتنا، والتجاربَ التي اكتسبناها في خضم محاربة المئات من السلبيات، قد تحولت إلى توتر روحي جاد يمكن أن يولد انفتاحًا على غرار “قوة الطرد المركزي”. لكن استثمار هذا التوتر استثمارًا جيدًا واجب يقع على عاتقنا نحن. المدرسة أعطت ثمارها بمقدار أهميتها. والآن جاء أوان ترويض ما ألهمته المدارسُ من العلوم والتجارب بعجنها في معجنة أرواحنا نحن، وتغذيتها بأسس ثقافتنا نحن. ذلك بأننا إن كنا عازمين على المضي قدما نحو المستقبل، فلا مناص من أن نكون ذاتيين في المنطق والمحاكمة العقلية والأسلوب، باستثمار تراكمنا العلمي والتجريبي في مواقعه المناسِبة. فقد تُكسب المدرسةُ الإنسانَ تراكمات وتجارب علميةً واجتماعية واقتصادية وسياسية؛ لكنَّ تقبُّلها من قِبل فئات المجتمع كافة ودوامَها مرتبط بامتزاجها وتكاملها مع الجذور المعنوية للمجتمع وبنيانه الفكري. ولهذا فإن معضلة أمثالنا من الدول المتخلفة إنما هي عجزها عن اكتشاف حقيقة المدرسة بروحها ومعناها، بل -وبالأحرى- إنها معضلة ثقافية في أصلها. ومن الضروري واللازم أن تُحَلَّ هذه المشكلة في أرضيتها هي.
نعم، هناك أمور كثيرة نحصل عليها وتتشربها أرواحنا ونحن على مقاعد المدرسة، ولكن ثمة أمر أشد وَقْعًا وتأثيرا، ألا وهو الثقافة.. ومما لا مرية فيه أن الثقافة من الأمور التي تنتجها البيئة والمحيط.
يمكن القول بأن البيئة ظلَّت مصدر القيم الثقافية في كل الحضارات سابقها وحاضرها. ويمكن أن نسميها “البيئة العامة” التي تتكون من الأحاسيس والأفكار والسلوكيات والأصوات والألوان والأساليب والأداء والخصوصيات الأخرى الحاوية على أعماق متنوعة من طبيعة الأمة. ولا يتعسر علينا التدليل على صحة هذا المقترب بأدلة كثيرة، لكننا نريد الآن أن نركز على أقوى حركيةٍ، وهي “شمولية” الثقافة التي تتنفسها جميع شرائح المجتمع كالهواء، وترتشفها كالماء، وتشمها كالزهور، وتصغي إليها كالطبيعة. فالثقافة إنما تتسع وتحوز على قدرة التأثير الدائم بهذه “الشمولية”. وهذا ما ينبغي أن يتبادر إلى الذهن حينما تُذكر “الثقافة”. نعم، إنها مؤثرة في راعٍ بعين المقياس الذي تؤثر به على مثقف أو علاّمة. فما يعنيه التقاء الماء والتراب والهواء والشمس في نقطة واحدة بالنسبة لوجود أي كائنٍ حيٍ ومواصلتِه لحياته، هو الذي تعنيه الثقافة بالنسبة لحاضرِ أيِّ مجتمع ومستقبلِه. نعم، إنها من أهم المقومات التي تُوصِل الفردَ والمجتمع إلى درجة النضج من الجهة النفسية والأخلاقية.
إن المدرسة بقدر ما تكون متوجهة نحو الهدف ومتسمة بالعمق تصبح ميناء أو مطارا أو منطلقا للأمة، بشرط أن تُصْهَر مكتسباتها في بوتقة الثقافة الذاتية. وإلا فمن البدهي أن المدرسة لن تستطيع حل المشاكل الفردية والاجتماعية. إن المدرسة، باعتبارها دائرةَ تخطيطٍ ومركزَ مشروعٍ، من الممكن أن تعني شيئا بقدر ما يستمع الوجدانُ الاجتماعي إلى صوتِ شيء من برامجها المنسجمة مع الأخلاق العامة وثقافة الأمة… ولكن من العسير جدًا -بل من المحال- أن نستدل على أنموذج واحد أنجزته المدرسة بوحدها. لذلك، علينا أن نتقبل المدرسة بواقعها وحقيقتها، ولا نأملَ منها إلا ما يمكن أن تمنحنا إياه. ومع حفظِ ورعايةِ حق العلم، إنَّ تعليق الآمال كلها بالمدرسة منطلَقٌ مبالَغٌ فيه وتفكيرٌ سطحي وبسيط يَجعل إيضاحَ كثير من البديهيات مستعصيًا، كتحميل الأرض على قرن الثور!
إن المجتمع السليم الواعدَ بمستقبل مشرق، يتكون من أفراد سليمين هم منه كالجزء من الكل، ولكن -من جانب آخر- وجودُ أفراد منضبطين وممتازين وتطورُهم لا يتم إلا في مجتمع سليم كهذا، وإن كان هذا المقترب يؤدي بنا إلى نوع من “الدَّوْر المحال”. فإن بيئة عامرة بتراثنا الثري ستؤثر في كل وقت؛ في العالِم والجاهل، والشاب والكهل، والبدوي والحضري، والمفكر والسارب في هواه.. وما إن يفتح هؤلاء أعينهم ويرتبطون بما حولهم حتى يوحي المحيطُ والجو العام إليهم دائمًا بأمورٍ ويحاسبهم ويحاورهم… وبوارداتها وغناها، أو بفقرها، أو بوسطها النفسي والمادي، قد تغذيهم وتربيهم وتعمرهم، أو تقوض عواطفهم وأفكارهم وتحيل كل شيء إلى خراب.
وقد لا يتسنى للإنسان أن يحس على وجه تام بمدى التأثير الذي يحدثه جو “روح الأمة” على أي مجتمع وعلى أفراده من كل النواحي، ولكن ينبغي أن نستحضر دائمًا أن هناك أمورا جزئية في العالم النفسي أو المادي تبدو لأول وهلة وكأنها تافهة وعادية ولكنها في كثير من الأحيان لفتت الأنظار وفتحت الأذهان نحو اكتشافاتٍ أو محاولاتٍ أو إجراآتٍ علميةٍ غايةٍ في الأهمية؛ فكما أن ترقُّب قطة لجحر فأر ألهب مشاعر بعض النابهين، فهناك عقول انكشفت أمامها آفاق واسعة حينما فَكَّرت في التناغم البديع لمجتمعات النمل والنحل، تلك المجتمعات التي لا يضاهِي كمالَها أكملُ الجمهوريات.. فَكَّرت في التناغم البديع لمجتمع النمل والنحل الذي لا يضاهِي كمالَه أعظمُ الجمهوريات كمالاً.. وكم من أمر مستصغر في عالم المادة أذكى نارَ أذهان وقَّادة. وكم من أمر يبدو للآخرين هينا ولكنه فتح الأبوابَ لاستلهام عظائم؛ مثل طاس الحمّام لـ”أرخميدس”، وتفاحةِ “نيوتن”، والتناغم العام لـ”جِين”، والقِدْرِ المتدحرج على سطح الدار لنصير الدين الطوسي، وأنغامِ الموسيقى التي تهدِّئ المجانين لابن الهيثم، وبزوغِ شمسِ صباحٍ آسرٍ لـ”ميخائيل إنجيليو” وماءِ جَرّةٍ لـ”دنيس بابن”!
ومن الحقيقة أن لبنيان المجتمع من حيث صحته أو عطبه، وجوانبه الإيجابية أوالسلبية تأثيرا بَيّنا على الأفراد، وإن لم يتمكن العقل -دائمًا- بالنظر الظاهري السطحي من إدراكه والشعور به. فالأفراد هم أبناء المجتمع الذي يوجَدون فيه، و يحسون بكل شيء ويعيشونه ويتقبلونه في بيئة مجتمعهم. فالواجب على أهل العلم والمعرفة عمومًا، وعلى المسؤولين خاصة، أن ينقُّوا ويغربلوا الأفكار الغريبة والضارة والمنكَرة التي تؤثر على المجتمع سلبا وتُضادُّ العقل والمشاهدة والتجربة والفكر الديني. إن أعظم الأبطال الذين قاموا بهذه الغربلة في التاريخ هم الأنبياء. ثم مِن بعدهم الأصفياءُ المتحفِّزون بالإلهام، ورجالُ الفكر الذين تكاملت قلوبهم وعقولهم، ورجال العلم الموقِّرون لعالم الغيب مع عالم الشهادة، وللحس الوجداني مع التفكير العقلاني، وللوحي السماوي مع التجربة.
فحينما فتح سيدنا نوح u النقاش حول وَدٍّ وسُواع ويغوثَ ويعوقَ ونسر؛ وثار إبراهيم u تجاه الأصنام والفكر الوثني المحيط ببيئته؛ ونافح موسى u الظلم والاستبداد والطغيان واستغلال الإنسان؛ وأذل المسيح u الماديةَ المؤلَّهة؛ وحارب مفخرةُ الإنسانية r العللَ الاجتماعية التي ما فتئت تمسك بتلابيب البشر كالجهل والفقر والتنازع والتفرق، إلى جانب جميع الأخطاء الأخرى التي جاهد الأنبياء السابقون ضدها… ومن بعده إلى يومنا فَسَّر جميعُ المجددين والمرشدين الكمّل الحياةَ تفسيرا جديدا في إطار أوامر الله تعالى وإرادته ورضائه… هؤلاء كلهم سعوا جاهدين لتحقيق تلك الغربلة والتنقية.
فمن أجل إنشاء الثقافة وإدامتها، ينبغي تحفيز رد الفعل المشترك ضد الأفكار الماسخة والغريبة المنكرة، إلى جانب استشعارها والإحساس بها بكامل عناصرها من قبل كل فئات المجتمع… حتى نبقى وندوم بذواتنا وبخصالنا الذاتية من جهة، وحتى نسير إلى المستقبل من غير السقوط في دوامة الباطل والخرافة والتغرب من جهة أخرى.
إن التأثير المتبادل ما بين الثقافات حقيقة لا مراء فيها. لكن نقل الثقافة من مكان إلى آخر مع المحافظة على أصالتها غير ممكن؛ فالثقافة ليست لباسًا يُنـزع عن بدن ويُلقى على بدن آخر. وكما تحافِظ الكائنات الحية على أصالتها باعتبار خصوصياتها البيولوجية، كذلك الثقافة إنما تحافظ على نفسها وتصير بُعدا حيويا للمجتع الذي وُلدت وترعرعت فيه إذا صارت كالهواء الذي يتنفسونه والماء الذي يرتشفونه، حتى تصيرَ عمقًا حيويا لذلك المجتمع، فتُحمَى وتُصانَ.
إن الثقافة تموت إذا ما نقلت من مكان إلى آخر ما لم تتجهز البيئة الجديدة بما يصلح لوجودها ونمائها، أو –في الأقل- تفقد خصوصياتها الذاتية، فتتهجن ويُعدم معناها وتنقلب إلى حقل ثقافي آخر. وكما يَعجز الآخرون عن التمثيل التام لصوتنا ونغمنا وخطنا ورسمنا ونمطنا وأسلوبنا بأصالته الذاتية، كذلك يتعذر علينا التمثل العيني لخصوصيات ثقافة الآخرين. ومع ثراء الألوان في ثقافتنا، فإن الآخرين لن يستفيدوا منها معاني كالتي نفهمها نحن، ولن تهيج فيهم المشاعر كما تهيج فينا نحن، ولئن أحدثتْ فيهم تأثيرًا معيَّنا فلن تُحْدثه فيهم بطبيعتها وفطريتها الذاتية. والعكس صحيح إذا أخذنا ثقافة الأمم الأخرى قبل استيعابها وهضمها. ذلك لأن الثقافة ليست بضاعة تشترى من الباعة المتجولين فتؤخذُ إلى البيت كلوحة أو صورة أو أسطوانة أو شريط؛ إنها من حيث كونها ملتقى كل العناصر الزمانية والمكانية للمحيط الذي نشأت وترعرعت فيه “كلٌّ” لايتجزأ وخاصةٌ ببيئتها التي تربت هي فيها، ولابد من تناولها مع كل العناصر التي تقف وراءها حتى يمكن وضع كل الوحدات التي تُكوِّنها وتُغذِّيها في إطار يربط فيما بينها… وأول ما يخطر بالبال أثناء نظرتنا هذه أنها صيغةُ حياةٍ معينة ذات نمط خاص لأمة معينة ومنظومةُ سلوكياتٍ خاصة فريدة من نوعها لأفراد تلك الأمة. ولا شبهة في أن أول ما يلفت النظر في هذا التحليل هو التأثير والتأثر بين فلسفة الحياة لأي مجتمع ونمط سلوكيته. وكلما توطدت فلسفة الحياة وتبناها كل أفراد المجتمع، تكون سلوكياتهم وأنماطُ حياتِهم باقيةً وواعدة للمستقبل. وكما في الأحياء البيولوجية؛ “الكلُّ” -أي الجسم بمجموعه- يعيِّن حركاتِ الخلايا في خط معين، وتقوم الخلايا المتوجهة باتجاه معيَّن بوظيفةِ عواملَ تنقل الهيأة العمومية “للكل” إلى المستقبل.
منظومة الحركات هذه، التي تجري وكأنها في إطار المسؤوليات المتبادلة، توجِد -من جهةٍ- تنظيمًا من التدرج الوظيفي عندما يتعلق الموضوع بالموجودات الإرادية، ومن جهة أخرى، تفجِّر سيلاً من التمحيص والاختبار من قِبَل العقل السليم والمشاهدة الصحيحة والتشخيص بالحس الوجداني.
إن هذه هي الطريقة المثلى لتوحُّد المجتمع وتَطابُقه مع فلسفة حياته وأسلوبه الذاتي وطبيعته التاريخية، حتى يصبح مجتمعا مستقرا بماضيه وحاضره ومنفتحا على العقل والفكر والوحي.. وإلا فإن الأمور الفلكلورية التي لم يكتمل سياقُ تطورها، والتي تم نسجها من العادات والتقاليد واللهويات وما يُشبِع الغرائزَ والأذواق.. حتى المؤلَّهة منها.. ما هي إلا نماذجُ خادعةٌ من العدْم والعوز الثقافي.
نعم، ثَمَّ أخذ وعطاء، وتأثير وتأثر دائم بين فئات المجتمع المتنوعة في الأمم والحضارات الوطيدة التي سكن تموجُها الاجتماعي. وفي الأوساط التي يوجد فيها جو ديمقراطي خاصة، يوجد تأثير وتأثر، وتفاعل مهم ودائم بين قمة هرم المجتمع وعناصر قاعدته. فالمعلم في المدرسة، والواعظُ على الكرسي، والكاتبُ في الجريدة والمجلةِ، والمحللُ على شاشة التلفزيون، والأديبُ بشعره ونثره، والرسامُ الناقل للموجودات بالمعنى الواسع ولمحيطه بالمعنى الضيق إلى لوحات للعرض… هؤلاء جميعًا يتحركون دائمًا في سياق التأثير والتأثر مع جماهيرهم. فالذين في الأعلى، بصفتهم معطِين ومنتجين، يرسلون الإشارات إلى من حولهم باستمرار، يحفّزون بها المعنيين بالخطاب، ويجهزونهم للتحرك، ويزيدون من عدد المعطِين والمنتجين بتوجيه قابلياتهم واستعداداتهم نحو آفاق “تصوراتهم” المهنية والفنية. فيحوِّلون كل واحد من المستقبِلين الذين قلَّت أعدادهم بمرور الأيام، إلى أناس ذوي آفاق واسعة.
وإذ ينتج الصانعون للأفكار ويقدمونها، يتعاطى المتلقون مع كل ما يقدَّم لهم من رأس الهرم بنظرة ماحصة متفحصة ونقدية، ويعترضون على أخطاءِ أولئك أو ما يعتقدون أنه خطأ حسب نظرهم.. ويضغطون على من في الأعلى فيُلجئونهم إلى حلول بديلة. فبذلك يُؤكَّد على كل ما يخص هويتهم، وتتم مراجعة أي فساد في الأساليب بإمرارها من المرشِّحات، وتُنَقَّى السلوكياتُ الخاطئة بالتقاضي والمحاسبة. ولا يمكن تبادلٌ وتفاعل من هذا النوع بين طبقات المجتمع إلا بفضلِ مشاركتهم جيمعا وتقاسُمِهم لموروث ثقافي مشترك.
فإذا تكاتفت أمة بفئاتها المختلفة وأصبحت كـ”البنيان المرصوص” كما وصَفَها مفخرة الإنسانية r، وسَخَّرت قوتَها وطاقتها في سبيل تكوين البناء الداخلي وتناغمه، فإن الْحَزن سيصير سهلاً، وسيكون من الطبيعي أن تَأخذ تلك الأمة طريقها لتكون عنصرا فاعلا في التوازن الدولي. لكنَّ تواجُدَ رابطة اجتماعية مؤثرةٍ على هذا المستوى من القوة منوطةٌ بثقافة ذاتية قد استقرت أركانها وعايَشَتْها شرائحُ المجتمع كافة حتى غدت جزءًا من طبعها وجِبِلّتها… ثقافةٍ مبنية على قيم أخلاقية تتغذى وتتنفس بها، مستندةٍ بقوة الدين القاهرةِ ومتخطيةٍ بالاستناد إليها كلَّ أشكال “التغريب”، ساندةٍ لتصوارتنا الفنية بحيث تكُون ملجًا ومأوى آمنًا لها في كل مكان. وإلا فأي ثقافة لم يتوضح إطارها ومعالمها بشكل جيد، ولم تحظ بالقبول لدى كل المجتمع، فلا مناص من أنها في حالة كهذه ستصبح دائما مدعاةً للتنازع والتناحر بين معماريي الثقافة وتلاميذهم، ناهيك عن غناء تلك الثقافة وثرائها واحتضانها! وقد يَفتح أحيانا تشاجرٌ كهذا -وبخاصة إذا كان في موضوع الفن والأخلاق- جروحا يستعصي دواؤها.. وقد يورِث الإفراط والتدقيقُ الشديد في مسألة أخلاقية هيمنةً وتسلطًا على المشاعر والأفكار حتى يُوقِع الفردَ والمجتمع في الْمَحْلِ والفقر أحيانا، وأحيانا يفتح الباب لتضييع القواعد والأخلاق في البديعيات، فيتلوث كل شيء بالفوضوية والمستهجنات.
ونحن إذ نتناول قضية الثقافة فبدلا من تهيئة الأجواء والمناخ لإشباع الغرائز باللذائذ واللهويات لمن لم تنضبط قدراتهم الروحية بعدُ.. علينا أن نزيد من نشاطاتٍ تُكسبهم القوة والمناعة لمواجهة المعضلات التي قد تواجههم في الحاضر والمستقبل، ونضعَ في الأساس توجيههم نحو التفكير الشمولي الذي ينمي لديهم موهبة اختيار الخير والجميل والصحيح.. وبذلك تتهيأ الأجواء لإمكانية ترجيح الأفراد للخيار الأفضل والأنفعِ بفضل التوجيه الإجباري-الاختياري للجو العام، والانسياقِ وراء التيار الجماهيري، إلى جانب مساندة العلوم والمعارف…
وهكذا، بفضل التمسك بالقواعد نوعا ما، وبفضل التوجيه الاختياري أو الجبري للبنيان الاجتماعي سيصبح مركزُ التقاء “الأخلاقية” و”العلمية” و”الذوق الفني” مغذيا لأسلوب حياتنا، وماكنةً ساحبةً لتحركاتنا وانطلاقاتنا، فتجعلنا ننهل على التوالى لذائذَ نشوات الظفر في ميدان الخير والجمال والصحيح… ومن المهم هنا أيضا، كيفية التفسير والتعقل لـ”تصور” الأخلاق والإيمان والفن ومفهوم الجمال. إن حصر الأخلاق في تطبيق بعضِ قواعدَ صارمةٍ.. وفهمَ الإيمان على أنه تصديقٌ أعمى لا يحسب حسابًا للعقل والمشاهدة والحس والوجدان.. وتفسيرَ الجمال بأنه التقاط لمحة من منظر الأشياء وصبُّها في لوحات عارية وتماثيل جامدة.. وحبسَ الفن في أطر محددة كالشعر والموسيقى والمسرح.. كل ذلك لا يعني إلا حبس الجمال وثقافةِ الجمال في مساحة ضيقة وجعْلَها ضحلة وترفا لبعضهم.
إن انبعاثنا مجددًا بثقافتنا الذاتية يتطلب رجالَ قلوبٍ متحفزين بالإيمان، ومهندسي فكرٍ سائحين في الغد بأفقهم الفكري، وعباقرةً يحتضنون الوجود والأحداث بتصوراتهم الفنية، ويتعرفون بتحسساتهم وتفحصاتهم الدقيقة على آفاق جديدة أبعدَ من الآفاق التي نحن فيها.
إن انفتاح العديد من عشاق الجمال نحو آفاق جمالية جديدة وتفسيراتِهم الجديدةَ لها.. والهممَ العالية التي تستحق التقدير للفنانين المهرة في الفنون وتلاميذِهم المجدين.. وألحانَ ذوي الأصوات الذين يبذلون قصارى جهودهم لترجع موسيقانا إلى روحها الأصلية، ومخزونَهم الثري.. والجهود التي يبذلها الشعراء الفطاحل والناثرون عشاق اللسان في سبيل تخطي مرحلة التقليد حيث بدؤوا يتشممون الذوق الأدبي.. كل ذلك تبدو لنا وكأنها أمارات بزوغ فجر صادق في طريق عودتنا إلى الذات. فإن يكن شعاعاتِ فجرٍ كاذبٍ، فلا ريب أن ما يعقبه هو الفجرُ الصادق!
فإذا سرنا على هذا الخط فلسوف تكون ثقافتنا الرصينة، وجذورُنا المعنوية والروحية، وشخصيتنا ومحتوانا، جزءًا لا يُستغنى عنه من الثقافة العالمية حينما يأتي الوقت المناسب. أما إذا بقينا على تخبطنا الذي عرفناه أمس واليومَ في التزود والتغذي من مصادرِ ثقافةِ الآخرين، وانغرزنا في التقليد كلما فكرنا في الإنشاء، فلن تنجو الأمة من ذلة التبعية، ولن نتحرر من الوصاية في الشعر والموسيقى والرسم وفروع الفنون الأخرى، ولن نتمكن من إدامة وجودنا بذاتيتنا الخاصة، ولن نفلح في الوصول إلى درجة الإنتاج والعطاء.
نعم، إن لم نبدأ من فورنا بشحن أجيالنا الناشئة بشعائرِ ثقافتنا الذاتية، ولم نبادر بإحياء ما شحنَّاه في النفوس، فسوف نَحكم على الآتين مِن بعدنا بأن يكابدوا حظنا العاثر في الحياة. فينبغي أن يُستنفَر كلُّ مَن له قول في الموضوع، ومهندسو عالمنا الفكري خاصة، بروحية النفير العام إزاء خَطب داهِمٍ، ويحوِّلوا البلاد من أدناها إلى أقصاها إلى مشاغل لثقافتنا الذاتية، ومدارسَ لفلسفة حياتنا الذاتية، ومختبراتِ تركيبٍ وتحليل لمنطقنا ومحاكمتنا العقلية الذاتيتين؛ فإن بقاءنا بذاتيتنا يمر عبر انبعاثنا بذاتيتنا.
المصدر: مجلة “يَنِي أميد” التركية، يوليو 1998؛ الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغْلو.