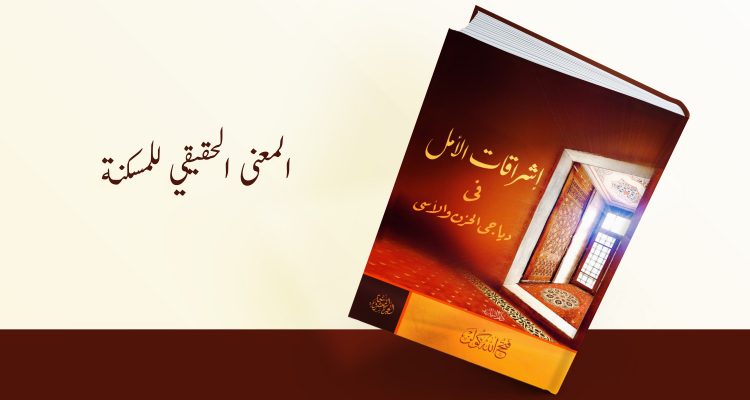سؤال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: “اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ”[1]، فكيف نفهم هذا الدعاء النبويّ؟ وما الدروس المستفادة منه؟
الجواب: المسكين كلمةٌ مشتقّةٌ من الجذرِ “سَكَنَ”، وتعني لغةً: الإنسان الذي استسلم للراحة والخمول، وتوقّفت حركتُه، فلم يعدْ يكسب أو ينتج، وشرعًا: ذاك الذي لا مالَ له، يفترش الأرض ويلتحف السماء؛ ومن ثمّ فالمسكينُ من الناحية المادّيّة أسوأُ حالًا من الفقير؛ لأن الفقير هو الذي لا يملك من المال ما يبلغ نصابَ الزكاة (المقدر بحوالي ثمانين غرامًا من الذهب)، بمعنى أن لديه من المال قدرًا قليلًا، أما المسكين فهو لا يملك حتى هذا القدر القليل، وعلى ذلك فالمسكين هو الذي يقبل الزكاة والصدقة، ولا دخلَ له سوى المعونات من الآخرين.
المسكنة المذمومة الواجبُ اجتنابها
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى أبدًا بالركود والخمول، وإهمال العمل، أو أن يكون عالةً على أحد، وكيف لا وهو الذي شنّ حربًا ضروسًا على التسوّل، وذمّه في أحاديث كثيرة، وحذّر أمته منه!؟ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: “أَمَا فِي بَيتِكَ شَيءٌ؟” قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: “ائْتِنِي بِهِمَا”، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: “مَنْ يَشْتَرِي هَذَينِ؟” قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: “مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ” مرّتين أو ثلاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَينِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَينِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: “اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ”، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: “اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا”، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: “هَذَا خَيرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَومَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَو لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَو لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ”[2].
وفي هذا الصدد يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أيضًا: “اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى”[3].
وهنا استخدم عليه الصلاة والسلام أسلوب الكناية، مشيرًا إلى أن اليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذ، وكأنه يقول محفّزًا المؤمنين على أن تكون أيديهم هي العليا:
“لا تقلّلوا من كرامتكم وعزّتكم الإنسانية بالتزلُّف والتودُّد إلى الآخرين، وما دمتم تمتلكون يدًا تعمل ورِجلًا تمشي فاعملوا على تأمين معيشتكم بأنفسكم، ولا تكونوا عالةً على أحد”، ومع هذا فقد أجاز الإسلام التسوّل عند الضرورة، ويزولُ الجوازُ بزوالِ الضرورة؛ مثل الجوع والعطش، فيجوز التكفّفُ بالقدرِ الذي يدفع عن الإنسانِ الضررَ والهلاك، وما سوى ذلك فلا، كما أن القرآن الكريم أباح أكلَ لحم الخنزير لِمَنْ وقع في خطر محقّق، ولكن بالقدر الذي يحفظ به حياته ليس إلّا، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سُورَةُ البَقَرَةِ: 2/173)، فانتفى الإثمُ عن المضطرّ على قدرِ ضرورته فقط.
وقد استوعب السلف رحمهم الله هذا السرّ الوارد في الحديث الشريف، فأوصوا بصيانة كرامة الفقير، بأن يجعل المعطي يده أسفلَ يدِ الفقير عند إعطائه الصدقة أو الزكاة، ولقد لعبت “أحجار الصدقة” التي ظهرت في عهد الدولة العثمانية دورًا مهمًّا في الحفاظ على عزّةِ وكرامة الفقراء؛ حيث كان الأغنياء يضعون صدقاتهم في هذه الأحجار، ثم يأتي الفقير ويأخذ قدرَ احتياجِه منها فقط؛ مما يُدلّل على نقاءِ السريرة وصفاءِ القلب، وشعورِ التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع العثمانيّ آنذاك، بل يمكن أن يقال إن ذلك المجتمعَ كان يشبه الملائكة في السماء، فها نحن الآن رغم وجود كمٍّ هائلٍ من رجال الشرطة والأمن فإننا لم نلمس -مع الأسف- مثل هذا الجوّ من الأمان الذي كان متوفّرًا في تلك الأيام؛ حيث لم يعد هناك رادعٌ قلبيّ، ولم تعد الآخرةُ محورَ اهتمام الناس، كما أن الشعور بالمحاسبة قد قُتل في نفوس الناس، والحقُّ أنّ الذي مات هو قلبُ الإنسان وضميرُه.
المسكنة الممدوحة، ورغبة الرسول في أن يكون عبدًا رسولًا
في ضوء ما سبق يتبيّن لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل الله تعالى المسكنةَ التي تعني سؤال الناس ومدَّ اليد إليهم، وإنما المقصود بالمسكنة هنا هو العيش المتواضع، أو الشعور بالعجز والفقر إلى الله، ولقد عرّف الأستاذ النورسي رحمه الله رحمة واسعة ذلك الفقر الذي جعله أساسًا لدعوته بأنه إدراك الإنسان أنه لا يملك شيئًا في الحقيقة، والشعور بالحاجة إلى الله تعالى، وصاحب هذا الشعور العظيم يلوذ إلى حماية الله تعالى وحفظه وكلاءته قائلًا: “يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَينٍ”[4].
لقد كان سيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه يرجو أن يحيا بهذه المشاعر، ويرحل بها إلى أفق روحه، وأن يُحشر مع هؤلاء المساكين الذين يلجؤون إلى الله دائمًا، ويحلّقون في الآخرة بجناحي العجز والفقر، وبعبارةٍ أخرى: إن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مرشدًا ورائدًا لأصحاب هذا الشعور في الآخرة أيضًا؛ لأنه عاش طوال حياته كواحدٍ من الناس، ولم يتخلَّ قطُّ عن مَحْوِهِ وتواضعه، فعن أمِّنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “كَانَ يَأْتِي عَلَينَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالمَاءُ، إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللُّحَيمِ”[5]، ومن يدري ربما النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساوره -في وقتٍ ما- بعضُ الأفكار حول مسؤوليّته تجاه أهله.
لقد جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ونَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيكَ رَبُّكَ أَمَلكًا جَعَلَكَ لَهُمْ أَمْ عَبْدًا رَسُولًا؟ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: “لَا بَلْ عَبْدًا رَسُولًا”[6].
لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم فقيرًا، وعندما رحل إلى أفق روحه لم يخلّف مالًا يُحاسب عليه في الآخرة؛ فقد أعطى نعم الله حقها، وأنفق كل ماله في سبيل الحقّ جل وعلا، فسار إلى الديوان المقدس أبيضَ الوجه ناصعَ الجبين طاهرًا نقيًّا.
صرحُ العفة وأبطالُها
ومع هذا لم يركن النبي صلى الله عليه وسلم للدعة والخمول، ولم يَشْكُ لغيرِ خالقِه ما تعرّض له من أزمات، ولم يكن عالةً على غيره، وما استعطى أحدًا، ولم يكن يقبل الصدقة والزكاة أبدًا؛ حتى إنه قد حرّم الصدقة على نفسِه وآلِ بيته[7]، وإذا ما جاءته هديّة وزعها على الآخرين[8]، حتى إنه قبل أن يرتحل الى أفق روحه اشترى طعامًا بأجلٍ من يهوديّ؛ حتى يفي بحاجيّات أهله، ورهن درعه المبارك عوضًا عنه، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: “تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ”[9]، ومن المحتمل أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن لديهم علم بذلك، فلو علموا لفعلوا ما استوجبه هذا الأمر.
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجودَ من الريح المرسلة، يُعطي عطاءَ من لا يخشى الفقر، أنفق كلّ مالهِ في سبيل الله، وعاش -بمحضِ إرادته- حياةً أقلّ من درجة أيّ فقير من أمّته، ومع ذلك لم يمدّ يده إلى أحدٍ مستجديًا، بل لم يقم بأي إشارةٍ تدلّ على ذلك؛ إذ كانت المسكنة التي ينشدها هي تفضيل الحياة البسيطة العادية مع إظهار مزيدٍ من الكرم والمروءة، ولأنّه صلوات ربي وسلامه عليه صرحُ العِفّةِ الشامخ لم يكن يتشوّف لأيِّ شيءٍ من الآخرين.
وكما أنَّه صلى الله عليه وسلم كان رمزًا فريدًا في العفّة؛ فقد عاش ساداتُنا الصحابةُ الكرام الذين اقتفوا أثَرَه خطوةً بخطوة حيواتهم أبطالًا للعفّة، ولقد بجَّلَ القرآن الكريم وامتدح أبطالَ الإسلام الأُوَلِ الذين لم يتكفّفوا الناس ولم يسألوهم شيئًا، ولم ينظروا إلى ما في أيدي غيرهم ولم يُسلِموا أنفسهم للتسول رغم ما عانَوه من خصاصةٍ وحاجةٍ وشظفٍ في العيش فقال: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ (سُورَةُ البَقَرَةِ: 2/273).
أجل، إننا حينما ننظر إلى حياة الصحابة الكرام نجدهم قد استنكفوا بحساسية مرهفة وحقيقية عن شتى صور الاستعطاء والتكفّف، وسدُّوا احتياجاتهم ودبروا أمورَ معيشتهم من كدِّ أيمانهم وعَرَقِ جباههِمْ، فمثلًا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحدُ العشرة المبشرين بالجنَّة اضطرّ إلى تركِ كُلِّ ثروته في مكة مهاجرًا إلى المدينة، إلا أنّه ما إنْ وَصَلَ إلى المدينة حتى سأل عن السوق وبدأ العمل، ولم يقبل معونةً من أحد، وهو القائل: لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينِي وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَينُقَاعٍ، فَغَدَا إِلَيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ الغُدُوَّ… [10]، لكنه ما لبثَ أن أصبح -بعون الله وعنايته- من أثرى أثرياء المدينة فعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: بَينَمَا عَائِشَةُ فِي بَيتِهَا إِذْ سَمِعَتْ صَوتًا فِي الْمَدِينَةِ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: عِيرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوفٍ قَدِمَتْ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ -وكَانَتْ سَبْعَ مِائَةِ بَعِيرٍ- فَارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ مِنَ الصَّوْتِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: “قَدْ رَأَيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا”، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوفٍ، فَقَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتُ لَأَدْخُلَنَّهَا قَائِمًا، فَجَعَلَهَا بِأَقْتَابِهَا، وَأَحْمَالِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ[11]. أجل، إنَّ ساداتنا الصحابة الكرام الذين خبروا شَينَ سلوك التسوّل بحثوا عن سبل الكسب والعيش الحلال دائمًا مما تكسبه أيديهم رغم ما كابدوه من حاجةٍ وفقرٍ حقيقيّين، ومن ثمَّ فإنَّني أرى أنَّه لا يليق بمن يُنفقون أوقاتهم ويخدمون في سبيل الله تعالى أنْ يتشوّفوا للحصول على منحة أو عطية من الآخرين، فالأفضلُ دائمًا الأكلُ من عرق الجبين ولو حتى بالعمل في قطع الأحجار، أو تنظيف المباني والعمائر، غير أنّ ثمة بعض المواضع والخدمات التي يشتغل بها الإنسان لا تسمح له أن يمارس عملًا آخر غيرها، وفي مثل هذه الظروف فحسب قد يُرخَّصُ لهذا الإنسان باستعمال قدرٍ مما يمنح له بحيث يستطيع توفير احتياجاته الضرورية فحسب.
وإنني شخصيًّا أشعُرُ دائمًا بضرورة التفتيش في حياتي عن هذا الشأن وتَحَرِّيه، فمثًلا عملتُ بالإمامة مدّة ثلاثِ سنوات قبل الْتِحاقي بالجيش لأداء الخدمة العسكرية، والحقيقة أنني كنت أستطيع أن أُشبع نفسي بوجبةٍ واحدةٍ فحسب يوميًّا من راتبي الذي كنت أنفق معظمه على الكتب والخدمات، فلَمَّا عُرِضت عليّ وظيفة العمل بالوعظ شعرت بحاجةٍ إلى أن أستفتي أحدًا: هل يجوز القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقابل ماديٍّ؟ فسألت أحدَ أقربِ طلاب الأستاذ بديع الزمان عن هذه المسألة فنَقَلَ إليَّ أن السؤالَ نفسَه طُرحَ على الأستاذ بديع الزمان وأنّه أجاب عنه بقوله: “إنْ لم يسمحوا لك بالوعظ والإرشاد حين لا يوظفونك في هذا المجال فاقبل هذه الوظيفة، وإن لم تكن لديك حاجة إلى هذه الأموال فادفعها إلى من يحتاجها، غير أنَّكَ إنْ كنت محتاجًا فخُذْ من راتبها بقدر حاجتك فحسب”، وعليه فقد انتسبتُ أنا كذلك لمهمة الوعظ؛ فأخذتُ من الراتب الذي خُصِّص لي من الوعظ بقدرِ ما يسُدُّ احتياجاتي الضرورية، وتركتُ الباقي منه لذوي الحاجة طلبًا لرضا الله تعالى، فلما أصبح هناك أجرٌ يأتي من تأليف الكتب لم تمسّ يدي هذا الراتب، وطلبت أن يُمنح للمحتاجين.
ورجال الخدمة في يومنا هذا أيضًا ينبغي لهم ألا يسألوا الآخرين شيئًا، بل إنّه ليجب على الآخرين أن يُهرولوا وراءهم من أجل توفير احتياجاتهم الضرورية، قائلين: “ثمة حاجة وضرورة لهذا كي تخدموا وتنتجوا في مجالاتٍ أخرى فتنفعوا المجتمع أكثر”، وفي مثل هذه الأحوال فقد تقبلون كارهين لا راغبين ما يخصّصونه من مبلغٍ بسيط، أما خلاف ذلك من أن يربط الإنسانُ حياتَه بما يأتي من الآخرين فإن هذا يدخل -في رأيي- في إطار المسكنة والذلة التي عابَهَا وذمَّها القرآن الكريم والسنة المطهرة.
الإنسان ليس مخلوقًا حقيرًا يُشترى ويُباع بالمال
يجب أنْ تكون القلوب المؤمنة في عصرنا أكثر حساسية في هذا الموضوع، وتهتمّ وتنتبه لأن تعيش طيلة حياتها شريفةً عزيزةً، وعليها ألا تتشوَّفَ إلى أيِّ شيءٍ في أيدي الآخرين مهما كان بسيطًا، وألا تضطرّ لدفع بدل ومقابل لأيِّ إنسانٍ. أجل، ينبغي لهم باعتبارهم أبطال العفة ألّا يتذلّلوا لأحدٍ ولا يَهِنوا، وإلَّا فإنَّ شباك المنفعة والمصلحة المتعددة تُخضعُ إليها هؤلاء الساعين في سبيل الدين وتستَعبِدُهم، ثم يأتي يوم تجبرهم فيه على التنازل عن شيءٍ من دينهم والعياذُ بالله.
ومن المؤسف جدًّا أننا نرى كثيرًا من الأمثلة المؤلمة لهذا في عصرنا. أجل، نرى ونحن نتقطع ألماً ومرارةً أن البعضَ يتمّ شراؤهم ثم استغلالهم بمختلف الطرق وشتى الوسائل، في حين أن الإنسان ليس مخلوقًا يُشترى ويُباع بالمال، ولا ينبغي أن يكون كذلك، فقيمته وثمنه هو نيل الجنة، وذروته الفوز برضا الله والنظر إلى جماله، وما عدا ذلك فلا قيمةَ له. أجل، حتى وإن قُدّر أن يكون فتح إسطنبول بدًلا ومقابلًا للإنسان فيستحيل أن يكون هذا أيضًا ثمنًا يبيع الإنسان به نفسه، أي إنّه حتى وإن كانت إسطنبول ستُفتحُ إذا بيع الإنسان فعليه ألّا يرضى بهذا أيضًا، لأن عزة الإنسان وشرفه أسمى وأعلى بكثيرٍ من هذا كلِّه.
وإن لم نعترف أنّ البعضَ ممن في هذه الدائرة القدسية قد وصل إلى صفاء الروح بهذا القدر لكان هذا جحدًا ونكرانًا للحقيقة، غير أنه يجب علينا أن نسعى من أجلِ إيصال الجميع إلى هذه الحالة الروحية، ونُبَيّنَ للناس قيمة الكسب من عمل اليد، وحماية السمعة، وقيمة العيش في عزّةٍ وكرامة؛ لأن اختيار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدًا رسولًا يُظهرُ أنّه يُمكنُ دائمًا تمثيلُ منهج الخدمة -التي تعتبر امتدادًا لمنهج ومهمة الرسالة- وأداؤه بنفس الحالة الروحية.
لقد رأيت في الفترة التالية عقب رحيل فضيلة الأستاذ بديع الزمان إلى دار البقاء معظمَ الطلاب الذين كانوا يُجالسونه، وقد كان في عموم تركيا آنذاك بضعةُ بيوتٍ للخدمةِ تسودها البساطة، ولا طعامَ فيها سوى الحساءِ اليتيمِ الخالي من الدسم، وكان يُكتفى بقطعة خبز وجُبنٍ إلى جوار كوب من الشاي إدامًا، غير أنهم كانوا يعيشون شوقًا ونشوةً حقيقيةً في خدمة الحقّ؛ فشبُّوا وانتشوا كالجَوَادِ عشقًا للخدمة، ومن ثمَّ يمكن القول إنَّهم هم من اضطلعوا بالخدمة الأساسية، وهيّؤوا لكم الأرضية الحالية؛ فحرثوا الأرض، وبذروا الحبوب، ثم تعهدوها بالرعاية والعناية، فكان العملُ في موسم الحصاد من نصيبكم أنتم.
وقد يَثقُلُ على البعض العَيشُ في عفةٍ واستغناء بهذا القدر، إلا أن مهاجري الغاية المثالية الذين عشقوا فكرة علوية سامية يجب عليهم أن يسعوا ويجتهدوا دائمًا لبلوغ هذا الأفق.
وينبغي ألا ننسى أبدًا أنّ استمرارَ هذه الغاية السامية مرهونٌ ببقاء هذه الأخلاق والخصال الحميدة فحسب، لأنكم إن عشتم حياة مبهرجةً طنّانة اهتزت -لا قدر الله- ثقتهم بكم اهتزازًا يجعلهم يتخلّون عنكم، وحينها تتوقف -لا قدر الله- الأنشطة المنتشرة في بقعة جغرافيّةٍ مترامية الأطراف من العالم. أجل، إنّ مثل هذه الخدمات تُقدَّم للإنسانية جمعاء؛ ولو لم يكن هناك تضحياتٌ جمّة وغفيرةٌ من متطوّعين لا معدودين لما كان من الوارد استمرارُ هذه الأنشطة والفعاليات، وقد يسألُ البعضُ في يومنا الحاضر أسئلة تشكيكيّةً واتّهامية؛ إما غَيرَةً منه أو حَسدًا رغم علمه جيدًا حقيقة الأمر: “من أين يأتي ماء هذا الطاحون؟”، والمؤكد أنّ دواليبَ هذا الطاحون لا تدور بالماء أو بالرياح، بل بالمروءة والبسالة والتضحية التي أبداها إنسان الأناضول من قبلُ في حرب الاستقلال على نحو حيَّر العقولَ والأذهان؛ وعليه فينبغي النأيُ عن ارتكاب أيِّ خطإ -حتى ولو كان صغيرًا تافهًا- يشتت أذهان هؤلاء الداعمين الكرماء ويدفعهم إلى إساءة الظن، فهذا -إنْ حَدثَ- وبالٌ لا قِبلَ لنا بتحمله، والله مُحاسبٌ عليه.
لا شك أنَّ أيَّ رجلٍ من رجال الأعمال والتجار يخوض غمار الحياة التجارية سيعمل ويربح، فليبارك الله تعالى لهم في تجارتهم، وعليهم أن يواصلوا العمل والربح، إلا أنّ الأرواح التي نذرت نفسها للحقّ المهاجرةَ إلى غايةٍ سامية المضطرّةَ إلى أنْ تعيش حياةً بسيطة بالنظر إلى وضعها، عليها أن تفضِّل حياة زاهدة متواضعة حتى آخر أنفاسها، وتستغني عن الدنيا وتهب أحاسيسها ومشاعرها وأذهانها وقلوبها بل وأنفسها بشكل كاملٍ لخدمة الإيمان والقرآن الكريم.
[1] سنن الترمذي، الزهد، 37؛ سنن ابن ماجه، الزهد، 7.
[2] سنن أبي داود، الزكاة، 26؛ سنن ابن ماجه، التجارات، 25.
[3] صحيح البخاري، الزكاة، 18؛ صحيح مسلم، الزكاة، 94، 97.
[4] النسائي: السنن الكبرى، 9/212؛ الحاكم: المستدرك، 1/730؛ البيهقي: شعب الإيمان، 2/212.
[5] صحيح البخاري، الهبة، 1، الرقاق، 17؛ صحيح مسلم، الزهد، 26-28.
[6] أبو يعلى: المسند، 10/491؛ مسند الإمام أحمد، 12/77، صحيح ابن حبّان، 14/280.
[7] صحيح البخاري، الزكاة، 60، الجهاد، 188، صحيح مسلم، الزكاة، 161.
[8] صحيح البخاري، الزكاة، 50، الرقاق، 20، صحيح مسلم، الزكاة، 124، الفضائل، 50.
[9] صحيح البخاري، الجهاد، 89، سنن الترمذي، البيوع، 7، سنن ابن ماجه، الرهون،1.
[10] صحيح البخاري، مناقب الأنصار، 3.
[11] مسند الإمام أحمد، 41/337.