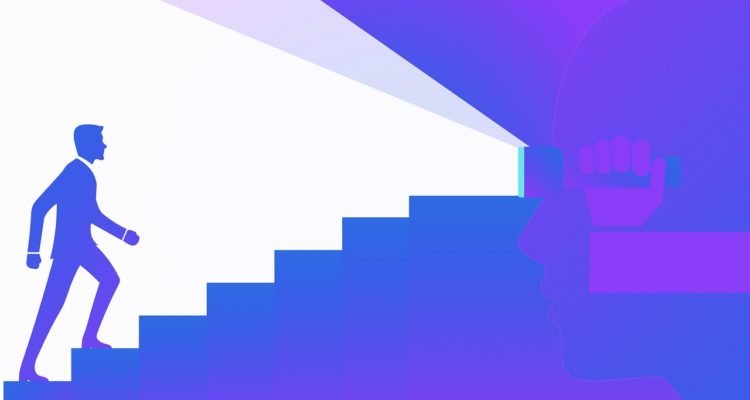السؤال: ما “القلب السليم”؟
الجواب: كلمة “سليم” مصدرها الفعل “سلم”، أي لها الجذر نفسه مع كلمة “الإسلام” والمعنى اللغوي للقلب السليم هو القلب الخالي من المرض ومن أي عارض. أما المعنى الخاص له فهو القلب الذي لا يعرف سوى الإسلام.
ولكي يكون الإنسان صاحب قلب سليم، عليه تطبيق أخلاق المؤمن الواردة في القرآن الكريم. وهذا تعريف عام ويتضمن كل شيء. فقد ورد في الحدي «عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن.. أَمَا تقرأ في القرآن قول الله عز وجل ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم:4)»[1]. وقد نـزل القرآن لكي ينظم الرسول صلى الله عليه وسلم حياته على ضوئه أولاً ومن ثم تقوم الأمة باتباع إمامها وتنظم حياتها وفكرها وتصوراتها حسب ما ترى من نبيها. ثم إننا نرى أن القلب السليم هو القلب السالم عن كل ما يضر الناس، ذلك لأنه ورد في الحديث الشريف: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»[2] وهذا تعريف خاص، ولكنه تعريف ممتاز. فيجب على المسلم ألا يمد لسانه ولا يده لإيذاء أي شخص.
وقد ورد تعبير “القلب السليم” في القرآن الكريم في موضعين وكلاهما متعلقان بإبراهيم عليه السلام. كان إبراهيم عليه السلام متألماً جدّاً من وضع قومه وانحرافهم وضلالهم ولاسيما من وضع أبيه “آزر” وكان اهتمامه بوالده شيئاً طبيعياً وفطرياً. ذلك لأن كل إنسان يحمل في فطرته حبّاً واهتماماً بعائلته وأقربائه، ويزداد حبه كلما كان الشخص قريباً إليه. ولا يوجد هناك ابن صالح يرضى الضلالة والانحراف لوالده، بل يتألم من ذلك ألماً كبيراً، ولاسيما إن كان يحمل روحاً شفّافاً وحساساً كروح نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي كان من كبار الأنبياء. لذا كان إبراهيم عليه السلام يتلوى من الألم بسبب أبيه.
كان إبراهيم عليه السلام يدعو قومه وأباه إلى دين التوحيد، ولكن قومه -وأباه كذلك- كانوا يعاندون ولا يستجيبون له بحجة أنهم رأوا آباءهم للأصنام عابدين. وكان هذا العذر يرِد على الدوام على لسان كل قوم وفي كل عهد عندما يريدون التهرب من الحقيقة ومن الحق. أمام هذا العناد رفع إبراهيم عليه السلام يديه إلى ربه متضرعاً: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدقٍ فِي الآخرِين * وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيم * وَاغْفِر لأَبِي إنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ * وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ * إِلاََّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء:83-89).
كان إبراهيم عليه السلام صاحب قلب سليم، والآية الكريمة ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الصافات:83-84) تُؤكّد هذا المعنى. وكان يؤكد -كما جاء في الآية السابقة- أنه لا ينفع في الآخرة إلاّ من أتى الله بقلب سليم. أي أن القلب الكافر لا يمكن أن يصل إلى شاطئ الأمن والسلامة في ذلك اليوم، فلو كان ابن الكافر نبيّاً في مقام إبراهيم عليه السلام فلن ينفع ذلك الكافر هذا. مع أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله وأب لأنبياء عديدين، حتى أن سيد الرسل صلى الله عليه وسلم كان يفخر بأنه يشبهه. أجل، كان والد مثل هذا النبي الكريم كافراً، ومع أن مقامه كبير عند الله إلاّ أنه ما كان بإمكانه أن ينفع أباه الكافر.
فإذا نظرنا إلى موضوع “القلب السليم” من هذه الزاوية نكون قد فهمنا معناه بشكل أفضل. فالقلب السليم يجب أن يكون سالماً من الكفر ومن الشرك ومن الشك والريبة والتردد. وإن القلب المملوء كفراً مَهْما تصرف صاحبه بشكل إنساني لن يكون قلباً سليماً. يقول كثير من الناس اليوم: “إن قلبي نظيف لأنني أحب الناس كثيراً وأسعى إلى مساعدتهم”، ولكن هذا ادعاء فارغ؛ ذلك إن كان القلب قد سكنه الإلحاد والإنكار فلن يعد قلباً سالماً ولا سليماً، لأنه يُنكر صاحبَ الكون ومالكه عز وجل، وقلبه مملوء بهذا الانكار. إن حب الناس وحب الإنسانية شيء جميل ومهم، إلاّ أنه يجب فهم الوجه الحقيقي للإنسانية أولاً، ثم يجب أن يكون هذا الإدراك دائميّاً وغير منقطع، ومثل هذا الإدراك مرتبط بالإيمان. فبِدون الإيمان تكون كل صور الخير والجمال والفضيلة إما كذباً أو شيئاً مؤقَّتاً؛ لذا فهي دون قيمة.
إن قام شخص بأداء خدمات جليلة إلى وطنه، بل حتى إلى الإنسانية ولكنه إن ادعى أنه لا يعترف بقوانين البلد ولا بنظمه فإنه سرعان ما يتعرض إلى العقاب دون الأخذ بنظر الاعتبار خدماته السابقة. وهكذا فالإنسان الذي ينكر مالك الكون وصاحبه ولا يعترف به فإنه يؤخذ بالنواصي والأقدام ويعاقب، ولا يفيده أي عمل أو خدمة قام بها.
فقد قام أبو طالب برعاية رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم حمايته مدة 48 سنة تقريباً، ولكنه -مع كل هذا- عندما لم يؤمن لم يحصل على الأمان الإلهي.. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه عندما أتى بوالده “أبي قحافة” الذي اشتعل رأسه شيباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أسلم ونطق بالشهادتَين، بكى أبو بكر رضي الله عنه.. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عما يُبكيه بعد أن أسلم أبوه واهتدى، قال أبو بكر رضي الله عنه إنه كان أقر لعينيه لو أن أبا طالب كان قد أسلم، لأنه كان يعرف مدى رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، إذ لم ينس موقفه معه وحمايته من المشركين، وقوله له: “اذهبْ يا ابن أخي! فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا”.[3]
ثم إن أبا طالب كان قد سلم عليّاً الكرار رضي الله عنه وجعفر الطيار رضي الله عنه “بطل مؤته” إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أي سلّمهما إلى أفضل يد وأكثرها أمانا. ولكن هل أفادت كل هذه الخدمات أبا طالب؟ إن كان مات على الإيمان فسيفيده هذا وإلا فلا.
والقلب السليم بهذا المعنى مهم جدّاً. فقد يؤدي الإنسان أعمال بر كثيرة وقد يتصرف بشهامة ويعطي ويبذل بكرم. ولكن يجب أولاً التأكد من سلامة القلب وخلوه من الكفر ومن الشرك.
ويجب ثانيا أن يكون القلب عامراً بالإسلام ومتزيناً بخلق القرآن. فإن لم يكن القلب عامراً بالخلق الذي أمر به القرآن لم يكن ذلك القلب سليماً.. وقلب الإنسان يكون سليماً بدرجة اتباعه لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان الإنسان الذي تجلى فيه خلق القرآن وجميع تجليات القلب السليم، وإلا فلا يخدع أحد نفسَه. ندعو الله تعالى أن يوفقنا اتباع خلق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه.
إننا نأمل ألا يحصر المؤمنون الذين يؤدون اليوم خدماتهم للإسلام في موضوع العبادة والطاعة، وأن يغنوا قلوبهم بها فقط. بل أن يكونوا في الوقت نفسه مستعدين للتضحية بفيوضاتهم المادية والمعنوية من أجل السعادة الدنيوية والأخروية للآخرين ويضحّوا بلذّة العَيش الرغيد من أجل أسعاد الآخرين وإنقاذ حياتهم الأخروية. وإن اجتمعوا في مجلس واحد فلكي يقووا من عزيمتهم لأداء خدمة أفضل. وعندما تنصت لكلامهم ترى أن قلوبهم تنبض بغاية واحدة وهي “إعلاء كلمة الله”.. وعند ذلك تتأكد بأنهم هم الأشخاص الذين جاءت البشائر حولهم؛ لأنهم مؤمنون حقيقيون وهم ضمان انبعاث أجيالنا في المستقبل، وهم أصحاب القلوب السالمة والسليمة.
وإن موضوع القلب السالم والسليم موضوع مهم، ذلك لأن عدة آيات من القرآن وضعت القلب السليم في مقابل المال والبنين ﴿يَومَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيم﴾ (الشعراء: 88-89). إن وضعك في الآخرة متوقف على الأجوبة المعطاة لكثير من الأسئلة:
هل عشت بشكل مرضي؟ هل مت بشكل مرضي؟ هل تبعث بشكل مرضي؟ أتستطيع أن تجد طريقك إلى “لواء الحمد”؟ أتستطيع الوصول إلى “حوض الكوثر”؟ هل يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراك من بعيد ويعرفك؟ ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بأنه سيتعرف يوم القيامة على أمته ويميزها من بين سائر الأمم، وعندما سئل كيف يستطيع ذلك أجاب صلى الله عليه وسلم: لكم سيما ليستْ لأحد غيركم، تردون عليّ غُرًّا مُحَجَّلين من آثار الوضوء. ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من ﴿سِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ (الفتح:29). عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ رضي الله عنه؛ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثر الوضوء. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل».[4]
وهذا من تجليات ومن مظاهر أصحاب القلوب السليمة.
الهوامش
[1] المسند للإمام أحمد، 6/91.
[2] البخاري، الايمان 4؛ مسلم، الإيمان 24.
[3] البداية والنهاية لابن كثير، 3/48.
[4] البخاري، الوضوء 3؛ مسلم، الطهارة 35.
الترجمة عن التركية: اورخان محمد علي.