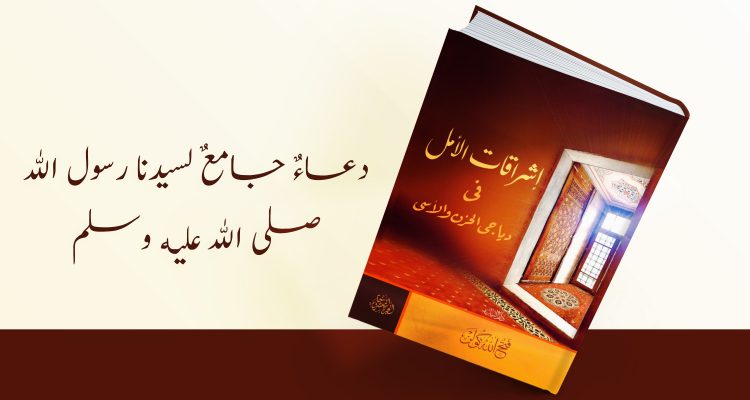سؤال: بعد نزول أوائل سورة “المؤمنون” دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه سبحانه قائلًا: “اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا”[1]، فما الرسائل التي يبثّها هذا الدعاء في رُوع القلوب المؤمنة في الوقت الحاليّ خاصّةً؟
الجواب: ننوّه بدايةً بأنّ الله سبحانه وتعالى قد خصّ نبيه صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي؛ ولذا فليس لأحدٍ أن يَصِلَ إلى شعور أو إدراك كُنْه هذه الحقائق الجليلة بقدر أُفقه هو صلى الله عليه وسلم، لهذا السبب يجب أن نعلم بدايةً أنّ ما قيل في معنى ومحتوى هذا الدعاء قاصرٌ عن بيان العمق والبُعد الحقيقي له.
وكما جاء في السؤال لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء بعد نزول أوائل سورة “المؤمنون” التي يقول فيها الحقّ سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ $ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ $ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ $ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ $ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ $ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ $ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ $ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ $ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ $ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ: 23/1-11).
بعد نزول هذه الآيات المباركات التي تُعتبر هديّةً من الله تعالى لنبيّه وأمّته أدرك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمقَ بشرى الفلاحِ التي زفّها الله تعالى للمؤمنين الذين حازوا على هذه الخصال المذكورة في الآية؛ فكان صلوات ربي وسلامه عليه يرفع أكفّ الضراعة إلى ربه جلّ وعلا في أوقاتٍ مختلفة، ويدعو بهذا الدعاء شعورًا بالامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى.
الطلب الأول: “اَللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا”
كان أول ما استهلّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم دعاءه هنا قوله: “اَللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا”، وأوّلُ احتمالٍ يتبادر إلى الأذهان هنا: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سألَ ربَّه زيادة عدد الأمّة المحمّديّة؛ لأن كثرةَ الأمة المحمديّة كانت على الدوام من أسمى أمانيه صلى الله عليه وسلم، ويدلّ على ذلك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الأُفُقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ”[2]، فأَدخلَ هذا المنظرُ الحبورَ والسرورَ على قلبِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن خلال الأحاديث النبوية التي تشجّع وتحضّ على الزواج يمكننا أن ندرك مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده بل ومجاهدته في سبيل إكثار عدد أمته، فعلى سبيل المثال يقول عليه الصلاة والسلام في حديث شريف: “تَنَاكَحُوا، تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”[3].
والواقع أن مسألة الزواج -من حيث إنها مسألة فرديّة وأسريّة- قد تبدو بسيطةً بالنسبة للقضايا الدينيّة الكبيرة، وإن لها قيمةً نسبيّةً مقارنةً بهذه القضايا الكبيرة، ومع هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمّته بالزواج والتكاثر، وذكر أن هذه الكثرة ستكون موضع مباهاةٍ وافتخارٍ بالنسبة له صلوات الله وسلامه عليه، والمباهاة هنا تعني الشعورَ بالامتنان تجاه الألطاف الربّانيّة.
الكثرة العدديّة ليست هي الهدف الأساس
وقد يُراد من قوله صلى الله عليه وسلم: “اَللَّهُمَّ زِدْنَا ولَا تَنْقُصْنَا” الكثرةَ والزيادةَ من حيث الكيفيّة لا من حيثُ الكَمّيّة فقط؛ لأن الكيفيّةَ هي التي تُكسب قيمةً للكمّية، فلا أهمّيّة للكثرة العدديّة وحدها دون الكيفيّة، فكم من فئةٍ كثيرةٍ لم تستطع أن تقوم بما قام به عشرة أو عشرون ألفًا من الصحابة رضوان الله عليهم، لقد أحبط هؤلاء الأبطالُ الأوائلُ الأفذاذُ في الإسلام مؤامراتِ أكبرِ إمبرطوريّتين عملاقتين في ذلك الوقت، الساسانيّة والبيزنطية، وأخضعوهما لسلطانهم، وبذلك غيّروا مصير العالم.
ورغم أن عدد المسلمين اليوم يبلغ حوالي مليار ونصف المليار نسمة فليس بوسعنا أن نقول إن هؤلاء المسلمين قد أدّوا المهمة التي تتناسب مع هذه النسبة العدديّة الكبيرة؛ لأنهم اليوم ليسوا على المستوى الذي يريده القرآن الكريم، فهم في نزاعٍ وخلافٍ دائم، حتى إنهم أنهكوا بعضَهم بسبب عدم خروجهم من دائرة التصارع والتنازع الفاسدة.
أجل، لـما لم يستطع المسلمون أن يحقّقوا الوفاقَ والاتّفاقَ فيما بينهم أخذ الخلاف والنزاع يُهدر طاقاتـِهم، فلم يحظوا بالعناية الإلهيّة، ولم يتقدّموا ليتبوّؤوا مكانتهم في مصافّ التوازن الدولي، ولم تكف الكثرة العدديّة لأداء هذه المهمة العظيمة التي لا بدّ من القيام بها حتى تتبوّأ الأمة مكانها في التوازن الدولي.
والواقع أننا إذا ما نظرنا إلى التاريخ بهذه النظرة لألفينا أمثلةً باهرةً على ذلك، فمثلًا كم من أناسٍ مخلصين هجروا أوطانَهم في فترةٍ ما من أجل غايةٍ سامية، وصرفوا كلّ جهودهم لتحقيق غاياتهم، فحقّقوا أعمالًا عظيمةً، وأحرزوا نجاحاتٍ مباركةً مثمرة، ولكن لــمّا أخذ هؤلاء الناس يتدنّون في الروح والمعنى والفكر والشعور والحياة القلبيّة والروحية لم يتمكّنوا من الحفاظ على الموقع الذي أحرزوه، بلهَ التقدم والازدهار؛ رغم أنهم أكثر عددًا مقارنةً بالماضي.
أجل، لقد استكانوا للدعة والخمول والكسل، واستسلموا للخوف وحبّ المنصب، ونسوا فكرة الهجرة من أجل إعلاء كلمة الله، فلم تُغن عنهم كثرتُهم العدديّة؛ حيث فقدوا قوّتهم وتأثيرَهم ونفوذَهم، ولذا يمكن القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتضرّع إلى ربّه قائلًا “زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا” كان يقصد علوّ الدرجة والمكانة والقدر، وألّا يعترينا نقصٌ في هذه المسألة، أي إنه كان يقصد زيادة الكيف إلى جانب الكمّ.
أعظم النعم أن تعرف النعمة على أنها نعمة
ثم يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: “وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا”، وهنا نجده صلى الله عليه وسلم يسأل ربّه أن يكون هو وأمته مظهرًا للإكرام الإلهيّ، لا الإمكانيات المادية والقوّة والكشف والكرامة؛ وهذا يعني أن الإكرامَ الإلهيّ هو لطفٌ كبيرٌ من الله تعالى لا بدّ من الحرص عليه، والإكرام من باب “إفْعال”، لذا فقد يكون المعنى: اللهم أكرمنا، وأشعرنا على الدوام بأن هذه الألطاف هي من محض كرمك.
والحقّ أن إدراكَ هذا الإكرام الإلهيّ والشعورَ به هو وسيلةٌ لحفظ الإنسان من الانزلاق والتردّي؛ لأن من هو على وعيٍ بهذا الإكرام يدرك أن كلَّ الجماليّات التي يتمتّع بها إنما هي مِنه سبحانه وتعالى، فلو نسب الإنسانُ هذه الجماليّات إلى قدراته ومواهبه الشخصيّة كما فعل “قارون” وقال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (سُورَةُ القَصَصِ: 28/78)، فقد استصدر لنفسه دعوةً للذلّة والمهانة، ومن ثمّ يجب على الإنسان أن يرفع أكفّ الضراعة إلى ربّه، ويدعوه قائلًا: “اللهمّ لَا تُهِنّي ولَا تُذِلَّني بما اقترفَتْه يدايَ من ذنوبٍ وآثامٍ أو بما ابتليتني به”.
اللهم لا تعاقبنا بالحرمان!
ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: “وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا”؛ على الإنسان أن يسأل ربّه النعم الدنيويّة التي لا تُغويه ولا تضلّه، بل من الأهمّيّة بمكانٍ أن يسأل الحقَّ جلّ وعلا كلّ ما يريد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ (أي أَحدَ سيوره) إِذَا انْقَطَعَ”[4]، ومن ثم على الإنسان أن يسأل ربّه سبحانه وتعالى ما شاء؛ عشًّا دافئًا يشبه روضةً من رياض الجنة، أو ولدًا صالحًا أو غير ذلك.
ومن هنا تَتَحدّد قيمة ما يطلبه الإنسان بمستوى أفقه ومنزلته وغايته المثلى، فلا جرم أنّ الأسرة المطمئنّة والأبناء الصالحين والإمكانيّات المادّيّة التي لا تُلجئه إلى مدّ يديه إلى أحدٍ من الخلق هي نعمٌ كبيرة يجب طلبُها من الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يشغله الإحياء عن الحياة، والذي نذر نفسه لفكرة الإحياء، وفاضت عيناه بمشاعر الشفقة تجاه جميع الإنسانية؛ قد يغضّ الطرف عن هذه المتع الدنيويّة جميعها؛ لأن كلّ ما يملأ أفقَه هو: “اللهم إني لا أرغب أن أرى -وأنا على قيد الحياة- أيّ فتوحات أو نجاحات كنتُ سببًا فيها أو يُظنّ أنني سببٌ فيها، لكني أرجوك يا ربي أن تمنّ عليّ بأن أرى من قبري بعد الممات انتشارَ دين الإسلام المبين في كلّ بقاع الأرض، ورفرفةَ الروح المحمّدية في كل الأرجاء، وتردّدَ الأذان في كلّ أنحاء العالم، وخفقانَ القلوب باسمك جلّ جلالك في كلّ الآفاق”.
ومن ثمّ يمكن أن نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم “وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا” أن كلًّا يسأل ربّه على قدر هِمّته، فقد يطلب هذا خمسةَ قروش، ويطلب ذاك ملايين، وقد لا يكتفي آخر بهذا، ويطلب من الله تعالى السرمديّة والخلودَ، فعلى حين كان البعض يسأل ربّه بعضَ النعم الدنيويّة كان أصحاب الأفق الواسع من أمثال الإمام الغزالي، والإمام الرباني السرهندي، والأستاذ بديع الزمان سعيد النُّورسي رحمهم الله جميعًا يسألون ويبتغون مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويسألون فتح طريق الجنة للإنسانية جمعاء. أجل، إن أمثالهم يقومون ويقعدون قائلين: اللهم أزهق روحي خمسين مرّةً في اليوم، ولكن أتوسّل إليك أن تُنقذَ أمّة محمدٍ من هذا البؤس والشقاء، وأن تَنْتَشِلَها من هذا الترديّ الذي لم يُسبق لها أن انحدرت إليه منذُ خلقتَها.
وعلى ذلك فإن الذين يرفعون أكفَّ الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء يستدعون الأفكار التي ألهمتهم بها درجاتهم.
من أعظم الآفات دخولُ المسلمين تحت وصاية غيرهم
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه أيضًا: “وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا” وهذا يعني: “اللهم إن كان ثمّة ترجيحٌ واختيارٌ فاخترنا وآثِرنا!”، وبتعبيرٍ أشمل نقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الحقّ تعالى ألّا يأذن للآخرين والأغيار بالسيادة على أمّته، ولا أن يسوسوها ويضعوها تحت وصياتهم وأمرهم.
ويمكن أن تتعدد صُوَرُ إيثار الله تعالى غيرنا علينا؛ فمثلًا إن لم نؤدّ العبوديّة حقّها، ولم نرعَ الأمانة حقّ رعايتها، ونَكَصْنا على أعقابنا في الدين فسوف يُذهبُنَا الله تعالى ويأتي بقوم آخرين يستخلفهم بدلًا منّا في التوازنات الدولية، ولهذا السبب فإنه ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نطلب من الله تعالى أن يُحَلّيَنا بأوصاف عباده المقبولين عنده، ونقول: “اللهم لا تستبدلنا بغيرنا! اللهم استعمِلْنا واستخدمنا نحن في كلّ ما تريد وتشاء!” لأنّ تَخَلِّي الله عنّا كالأشياء الرثّة واستخلافَ غيرنا يعني تركنا إلى تَفَاهتنا وخِسَّتنا الذاتية.
نوعٌ آخر من الامتحان: المحاباة
وقد لفتَ سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتباهَنا إلى حقيقة أخرى تتعلق بالموضوع: “إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ”[5].
وقد ظهرت هذه الحقيقة التي عبر عنها هذا الحديث بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى أفق روحه، ولقد خصّ القرآنُ الكريمُ الصحابةَ الكرام السابقين الأوّلين لهذه الأمة بالتقدير والإجلال لدرجة تكاد تحيرنا وتدهشنا إلّا أن بعض اللاحقين من الناس لم يستطيعوا فهمَ ذلك، فقاموا بظُلْمِ الرعيل الأوّل في الإسلام من ذوي القَدر العظيم عند الله وعند رسوله وجاروا عليهم؛ فالخوارج مثلًا عجزوا عن إدراك قيمة سيدنا علي كرّم الله وجهه الذي حظي بألقاب سلطان الأولياء والحيدر الكرار وصهر النبي عليه الصلاة والسلام، وبالشكل نفسه لم يتسنَّ لكثيرين من الناس ممّن عاشوا في عصر سيدَينا الحسن والحسين أن يَقْدُروهما قَدرَهُما ويعترفوا بقيمتهما اللائقةِ بهما.
كما أن بعضَ الحكّام الذين جاؤوا من بعدُ عجزوا عن الحفاظ على العدالة التي سادت في عهد الخلفاء الراشدين ولجؤوا إلى سبيل المحاباة؛ فكانوا -على سبيل المثال- إذا ما أرادوا إرسال أحدٍ حاكمًا أو واليًا على مكان ما أو تقسيمَ غنيمةٍ ما اختاروه من بين أقاربهم، في حين أنه ليس هناك أحدٌ قطّ من الخلفاء الراشدين وضع واحدًا من أقاربه في أيّ منصبٍ لمجرّد صِلة القرابة، ولم يميزوهم عمن حولهم ولا عن الآخرين، ولم يحابوا أو يُجامِلوا أحدًا؛ لأن الأمةَ التي يُشرع فيها أو يقع فيها أن تُوسَّد الأمانة لغير أهلها، ويُعهَدُ في مسؤوليّاتها إلى الأقاربِ أمةٌ قد انتهى أمرها.
أجل، لقد أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ستكون من بعده أثرةٌ ومحاباة، وأوصى الأمة أن تصبر حتى تلقاه؛ لأن الصبر نهايته السلامة، ومثل هذه التوصية رسالة مهمّة جدًّا للمؤمنين في عصرنا لأن من بيدهم زمام الأمور ومقاليدها اليوم ربما يظلمون ويجورون على أصحاب الكفاءات عبر وضع عراقيل مختلفة في سبيلهم، فليظلموا وليعتدوا؛ المهمُّ أن تُواصلوا أنتم مسيركم وخدمتَكم في سبيل الله تعالى في الاتجاه الذي تحسبون أنه الحقّ. أجل، ينبغي للأرواح التي نذرت نفسها في سبيل الله تعالى أن تتعامل بفلسفة الاستغناء في مواجهة هذه النوعية من المحاباة والمحسوبيّات، وتنتظر تقديرَ الحقّ تعالى في هذا الشأن؛ لأنه تعالى فعل وقدّر كلّ الأشياء الجميلة حتى اليوم، وما فعله الله تعالى مسبقًا يُعدّ أصدق برهانٍ على ما سيفعله من بعد، وهذا يعني أنه سيقدر كلّ الأشياء الجميلة مستقبلًا كما قدّرها في السابق؛ يكفي لذلك أن نكون صادقين مخلصين له سبحانه وتعالى وألا نُقصّر في الارتباط به جلّ شأنه.
سنام العبودية: أفق الرضا
وفي نهاية الحديث يطلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله أن يجعلَنا راضين وأن يرضى هو عنّا أيضًا بقوله: “وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنا”، وهذان الأمران متلازِمان لا ينفصلان عن بعضهما؛ لأن الله تعالى إن كان راضيًا عن إنسانٍ ما أرضاه، وبالشكل نفسه فإن رضا العبد عمّا يقدّره ربّه يعني رضا ربّه عنه، ولأهل الله آراء مختلفةٌ فيما يتعلّق ببيان أيّهما سببٌ للآخر، أو مسبَّبٌ عنه؛ إذ يقول بعضهم إن إعطاء الإنسان إرادته حقَّها، وطلبَه سبيل الرضا يؤدّي إلى نيل الرضا الإلهيّ، وقد ربطوا هذا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرْ مَا مَنْزِلَةُ اللهِ عِنْدَهُ”[6]، أي إن قيمتكم عند الذات الإلهية تكون موزونةً بحسب تقديركم الله تعالى وإجلالكم إيّاه؛ فإن كنتم تحبّونه أكثر من كلّ شيءٍ وتقدرونه وتجلّونه أكثر من الدنيا وما فيها فستجدون هذا التقدير والإجلال عند الله ولدى ساكني الملإ الأعلى، أما البعض الآخر من أهل الله فقد قالوا: إن الله إِنْ لم يرضَ لم يُرْضِ العبادَ عنه، وقد علّلوا ذلك بتقديم ذكرِ رضا الله تعالى أوّلًا في الآية الكريمة: ﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (سُورَةُ التَّوْبِةِ: 9/100)، بينما قسمٌ آخر من العلماء من بينهم الإمام القشيري قال: “إن الأمر بالنظر إلى بدايته هو كسبيٌّ مرتبطٌ بالإرادة والعمل، وأما باعتبار نهايته فهو عن تجلٍّ وحال”.
وإذا نظرنا إلى المسألة وفقًا للعقيدة الماتريديّة فيجب على الإنسان -كشرطٍ عاديٍّ- كي يحظى برضا الله سبحانه وتعالى أن يبذل جهدَه بشكل إراديٍّ في سبيل هذا الرضا، وهذا أيضًا مرتبطٌ بأن يتدبّر الإنسان في ذاته والوجود من حوله، ويحلّل حقائق الحقيقة الإسلامية ويفهمها على نحو صحيح. أجل، إن الإنسان حين يرضى عن الله فإن الله جل جلاله يتوجّه إليه برضوانه، ورضوانُه هو الأكبر.
وختامًا: إن كلّ أمر من الأمور التي طلبها رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم في دعائه المبارك هذا له تأثيراته المهمّة في حياة المؤمنين، ولذلك فإنه ينبغي لنا نحن أيضًا أن نطلبها دائمًا من الحقّ سبحانه وتعالى.
[1] سنن الترمذي، تفسير القرآن، 24.
[2] صحيح البخاري، الطب، 17؛ صحيح مسلم، الإيمان، 374.
[3] مصنف عبد الرزاق، 6/173.
[4] سنن الترمذي، الدعوات، 155.
[5] صحيح البخاري، المغازي، 58؛ صحيح مسلم، الإمارة، 48.
[6] مسند البزار، 17/307؛ أبو نعيم: حلية الأولياء، 6/176؛ البيهقي: شعب الإيمان، 10/109 (واللفظ للبيهقي).