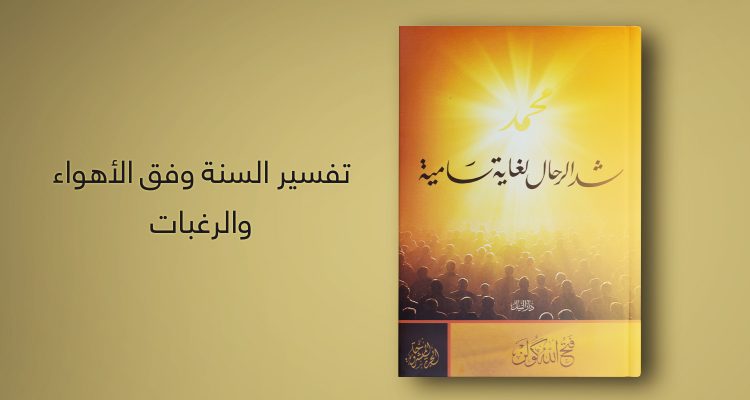سؤال: نرى أناسًا إن استهواهم شيءٌ قالوا فيه: “لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لفعل كذا”، وإن لم يستهوهم أصدروا حكمهم على الفور قائلين: “لا يقول نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا”، فكيف تقيّمون هذا؟ وما الشروط التي يجب توافرها فيمن له حق الكلام في مثل هذا الموقف؟
الجواب: يختلف تقييم هذه الأقوال على حسب “مَن قالها؟” و”لماذا قالها؟”، فنبينا صلى الله عليه وسلم رسولٌ يبلِّغ رسالة ربه ويبيّن المسائل ويوضحها بسنّته القولية والفعلية والتقريرية، وكان مجتهدًا في مسائل الدين أيضًا، فإن التعرّضَ إلى حلّ مشاكل معينة وفقًا للظروف والأزمنة قائلًا: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا اليوم لفعل كذا في هذا الموضوع أو ملأ هذه الثغرة بهذا الشكل” قد يكون أمرًا لا حرج فيه؛ ولربما يكون لهذا القول محملٌ حسن؛ أي إن الزمان هو أبلغ مفسر للحوادث والأشياء؛ حيث يقوم بوظيفة المؤشر في تفسير بعض الأمور وتأويلها بحسب الظروف والأوضاع.
وبتعبيرٍ آخر ثمة مسائل دينية تخضع للاجتهاد والاستنباط، وقد تُرك تفسيرُها وتأويلها إلى الزمان ليفتي فيها، لكن يجب على من يقوم بتأويل هذه المسائل وفقًا للأزمنة والظروف التي يعيش فيها أن يدققوا ويحققوا أولًا ويعلموا هل في الكتاب أو السنة نصّ صريح متعلق بالمسألة التي يتناولها أم لا؛ لأنه لا مَساغَ للاجتهاد في مَورِد النص، أيضًا إن وقع إجماعٌ من المجتهدين العظام على مسألة فمن غير المقبول مخالفة ذلك.
أجل، فالإجماع حجة، ومن أدلة حجّيّته هذه الأحاديث:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي (أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ”[1].
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ”[2].
وعن أبي بَصْرة الغفاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا”[3].
فإن أجمع أناسٌ سلمت قلوبهم وأرواحهم وعقولهم ووجدانهم وحواسهم الظاهرية والباطنية على حكم مسألة ما دون غرضٍ أو انتظار أجرٍ، فالعقل لا ينكر صحة ما قرروا عليه، فكما لا تجوز معارضة الكتاب والسنة بالاجتهاد فكذلك لا تجوز معارضةُ الإجماع.
ومن ثم فإن إظهار الرأي اتباعًا للهوى دون النظر إلى المصادر الأساسية يختلف كثيرًا عن إظهاره بالرجوع إلى المُحكمات والمصادر الأصلية، ولذا لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة والإجماع عند البحث عن حل أي مشكلة فرديةً كانت أم أسرية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، فإن لم يوجد فيها حلٌّ لما نبحث عنه فعند ذلك لا بد أن نراعي ألا تخالف الآراءُ المطروحةُ المبادئَ الأساسيةَ.
لا بد أن ترتجف القلوب عند تقريرها لأي حكم
ويُشترط للاجتهاد فيما يتعلق بأيّ ناحية من نواحي الحياة أن يشعر المرءُ بالخوف والخشية من مخالفة المراد الإلهي وأن يرتجف قلبُه ويقشعر منها كما يُشترط أن يكون متخصصًا في العلوم الشرعية، وإلا فليس للذين يتساهلون في أمور الدين دائمًا ولا يسعون إلا ليقدره الناسُ قدره وليكون “مشارًا إليه بالبنان” أن يقولوا فيما تهوى أنفسُهم: “لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا لقال أو لفعل كذا”، وفيما لا تهوى: “لو كان رسول الله بيننا لما قال أو فعل هكذا”، فكأنهم بذلك قد قدّروا -حاشا وكلا- نبيًّا فرضيًّا من تلقاء أنفسهم، وجعلوه يتكلم وفقًا لرغباتهم ويفتي حسب أهوائهم؛ أجل، ليس لأحد الاستهتار بأحكام الدين الذي يضمن لهم السعادة في الدنيا والآخرة.
كان السلف الصالحون رضوان الله عليهم يتحرون الدقة البالغة في مسألة الاجتهاد، فمنهم من إذا سُئل عن مسألة من المسائل الدينية ختم القرآن الكريم من أوله إلى آخره عدة مرات حتى يتمكن من الإجابة الصحيحة، وها هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان يناقش طلابه ويناظرهم بضعة أيام ليفتي في مسألة واحدة، وكان الطلاب قد يقتنعون بعد المناقشة برأيه فيقولون: “الرأي ما قلتَ في هذه المسألة”، ورغم ذلك كان الإمام يعيد النظر كرة أخرى في المسألة ويطالعها ويُجهد نفسه بالليل كثيرًا، ثم ينهض صباحًا، ويذهب إلى طلابه ويقول لهم: “لقد وافقتموني الرأي أمس في هذه المسألة، لكنني أخطأتُ حيث لم تخطر ببالي هذه النصوصُ”، ويُعرض عن رأيه من باب إحقاق الحق، ويؤثر رأي طلابه.
وثمة مثال آخر على إحقاق الحق وهو الإمام أبو الحسن الأشعري: كان رحمه الله عليمًا خبيرًا بالكتاب والسنة، أوتي قوة البيان ومهارة الخطابة وبلغ في ذلك الوقت الذروة في العلم وارتقى أعلى الدرجات وذاعت شهرته في أرجاء المعمورة؛ وكان قد تبنَّى أفكار المعتزلة فترة، ثم ترك مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة والجماعة، فقال للناس: “كل ما قلتُه لكم في مسائل كذا وكذا خاطئ بالجملة، أما الصحيح فهو هكذا”.
مَن اتّخذ إلهَه هواه
وللأسف الشديد ظهرت في هذه الأيام محاولاتٌ تفتقر إلى الجدّية فيما يتعلق بهذه المسالة، حتى إننا قد نجد أناسًا ينكرون أحكامًا بدعوى أنها لم ترد في القرآن الكريم، رغم أن القرآن الكريم نصّ عليها صراحة وجرى العمل بها في عهد الصحابة والتابعين.
وإنّنا وإن سكتنا حتى اليوم على هذه الترّهات تحفظًا منّا وحذرًا وعقدنا ألسنتنا إزاء ما يفعله من ينكرون هذه المسائل التي أجمع عليها السلف الصالحون، فإنّ حكم إنكار ما ورد نص صريح بشأنه معلومٌ لا يخفى على أحد.
وعلى ذلك فإن انعقد الاجتهاد على حلِّ مشكلة من المشاكل الفردية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية فلا بد من الاطلاع بدايةً وبشكلٍ جيدٍ على القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ومراجعةِ الآراء والأفكار النيّرة للسلف الصالحين فيما يتعلق بهذه المسألة، ثم البحثِ عما إذا كان لهذه المسألة نظيرٌ في المصادر الأصلية أم لا، وبعد ذلك نضع حلًّا للمشكلة، مع مراعاة الأزمنة والظروف التي جرت فيها.
فمثلًا يقول القرآن الكريم في زوجين فسدت العلاقة بينهما:
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: 4/35)، ويقول: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: 4/128)، فيلفت الأنظار إلى مبدأ مهم وهو الصلح بين الزوجين.
وعلى نفس الشاكلة يقول تعالى في سورة الحجرات: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (سُورَةُ الْحُجُرَاتِ: 49/9).
وانطلاقًا من هذه النصوص نجد أنه من الممكن تطبيق هذا المبدأ بين الجماعات الكبيرة، بل وعلى مستوى العلاقات الدولية، لأنه إن كان الصلح خيرًا في الأسرة التي تشكّل أصغر جزيء في المجتمع فهو بين مختلف الشرائح والثقافات والتيارات والأمم أولى وأعظم خيرًا، فبقدر حجم المسألة تزداد أهمية الصلح؛ لأن فساد العلاقة بين الزوجين، واتجاه كل منهما إلى ناحية مختلفة يجعل الأولاد يعانون نوعًا من اليُتم والحرمان، أمّا إن اقتتلت طائفتان ولم نستطع أن نصلح بينهما فلكم أن تتصوروا حجم الخراب والدمار الذي يحلّ بالبلاد على مستويات مختلفة.
وعلى القلوب المؤمنة التي تنشد اليوم حلَّ المشاكل الاجتماعية على كل المستويات أن تتحرى سبلًا للصلح، وتمهِّد أرضيات للحوار، وتقيم منابر للسلم والتفاهم والتسامح، وتشكِّل –إن اقتضى الأمر- لجانًا للتحكيم، كل ذلك مع مراعاة متطلبات الظروف التي تعيش فيها وإمكانياتها.
عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ”[4].
أجل، فإن اجتهد الإنسان في سبيل الدين وإحقاق الحق نال ثواب اجتهاده حتى وإن أخطأ، لأنه أجهد نفسه في هذا؛ وإن أصاب فله أجران على الأقل، وقد يتضاعف الأجر وفقًا لأهمية المسألة وصدق النية.
أما من يتناولون المسائل حسب أهوائهم ورغباتهم فيقول الله عنهم:
﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ (سُورَةُ الْجَاثِيَةِ: 45/23).
والحاصل أن القولَ الفصلَ لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم في حلِّ كل القضايا الفردية والأسرية والاجتماعية، فليس للإنسان في مورد النص إلا السكوت، وإلا فليعلم أنه قد اتخذ إلهه هواه.
[1] سنن الترمذي، الفتن، 7.
[2] سنن ابن ماجة، الفتن، 8.
[3] مسند أحمد بن حنبل، 45/200.
[4] صحيح البخاري، الاعتصام، 21؛ صحيح مسلم، الأقضية، 15.