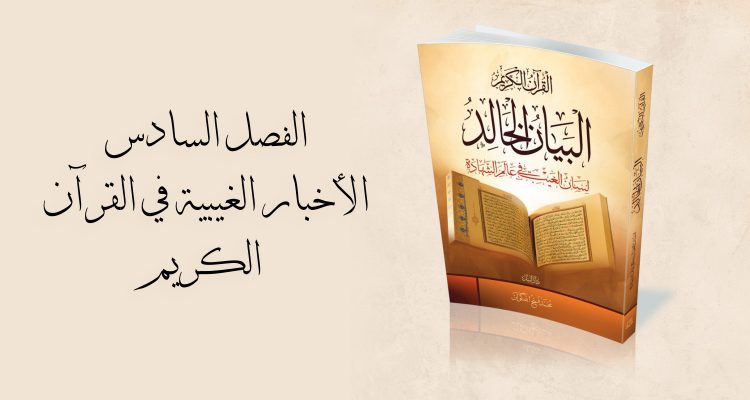أ. تعبير “الأخبار الغيبية في القرآن الكريم”
لقد نزل القرآن في مجتمع كان يعيش قبل أربعة عشر قرنًا من الزمن.. وقد استغرب ذلك المجتمع الأسس التي جاء بها القرآن، والقواعد التي وضعها، وحقائقه المتعلقة بالدنيا والآخرة، وفلسفته في الاعتقاد والعبادة والأخلاقِ.. أجل، فمعظم هذه الأسس الجديدة كانت أمورًا مختلفة، فقد كان القرآن يربط هذه الدنيا بحياة أبدية ويجعلها مزرعة للآخرة، ويجتث العصبية القبلية والقومية من جذورها ويضع مكانها أسسًا اجتماعية جديدة كل الجدة، ويُنزِل ضربات قاضية على الوثنية التي كانت منتشرة بشتى أشكالها في كل نواحي الحياة الفردية والاجتماعية.. ويزيل كل رواسب الجاهلية المتعمقة في النفوس ويقتلع كل الأفكار الضالة الراسخة في الأذهان، وكان يتحدث عن عوالم لم يَسبق لأهل ذلك العصر أن علموها أو سمعوا عنها، ويقدم لهم لوحات عن مئات من الأحداث والشخصيات التي لم يسجلها التاريخ القديم، ويفتح لهم نوافذ غيبية مذهلة تطل على المستقبل، وبهذا كان يتحدى كل من له ادعاء فيما يتعلق بهذه المجالات، بل إنه يكشف عما كان يخالج أعماق أرواحهم من الأفكار والنوايا والخطط، ويتتبع كل أحاسيسهم وحماساتهم وضربات قلوبهم وأنفاسهم خطوة فخطوة.
ولقد انقلبت جميع أفكار المخاطَبين بهذا الكتاب رأسًا على عقب، وتَغير عالَمُهم، وتبدلت آفاقهم وانفتحت أمامهم من هذه الآفاق الجديدة منافذُ إلى عوالم مختلفة؛ لذلك لم يكن أمام السامعين له خيار إلا الاستسلام له، وهذا ما وقع منهم فِعلًا، فقد كان القرآن ينزل منجمًا وكانت تتشرّبه أرواحهم، فتركوا ما دأبوا عليه من عاداتهم، وحلّت مكانها عادات قرآنية وتجذّرت، وأصبحوا بمرور الزمن يفكرون ويتحدثون وفق ما يأتي به من الرسائل الإلهية، وتعوّدوا من خلال ذلك على الإحساس بنوع مختلف من الحماس، وقد تحقّق هذا كله في زمن قصير أي في ثلاثة وعشرين عامًا.. وهذا أيضًا واحدٌ من جوانب الإعجاز القرآني.
كما هو الحال في القوانين التي تضبط الحياة الاجتماعية والفردية وتنظمها تقابَل بألفِ لونٍ من الاستغراب حينما تُعرض على الناس، وكثيرًا ما تتصادم معها العادات والتقاليد التي تطورت في المجتمعات في جوِّ تركيبتِها النفسية والثقافية والعقدية والتقليدية ونضجت في قلب الأحداث التي مرّت بها على مر العصور، فالأفراد الذين تخاطبهم هذه القوانين هم الذين تشكّلت مشاعرهم وعواطفهم وأطوارهم وأفكارهم ونظرتهم للحياة في ظلّ هذا المجتمع؛ لهذا فإن القوانين التي تُملى عليهم، بآلية إدارية وبأسلوب فوقي وبعقوبات قانونية؛ لن تكون مؤثرة على المدى البعيد، ولا يمكن جعلها مقبولة لدى ذلك المجتمع لمدة طويلة؛ لأنه لا بد، قبل كل شيء، من أن يتقبلها المجتمع من صميم قلبه؛ فإذا لم يتم النفوذ إلى عالَمهم القلبي والروحي، فإن الشعور المجتمعي لن يستمرئ القوانين والقواعد المفروضة عليه من فوقُ، بل سيرفضها يوما ما، وبالأخص إذا كان الذين يضعون القوانين لم يتربوا في تلك البلاد وفي أحضان ذلك المجتمع فإن الأمور ستزداد تعقيدًا، ولن يتكوّن توافق بين القوانين والحياةِ التي يعيشها الناس.
أجل، فهاكم نتيجة القوانين والمراسيم التي تنطوي على ثغرات معينة، فالتاريخ يشهد أن الحضارات التي انهارت والمجتمعاتِ التي تحطّمت وتفكّكت ما هي إلا ضحايا لمثل هذه التناقضات، ولم يستطع الذين يسُوسُون المجتمع ويوجهون مختلف شرائحه، أن يُوجِدوا فيهم شوقًا واشتياقًا وإيمانًا، لم يستطع هؤلاء -ولن يستطيعوا- أن يبنوا حضارةً وأمة قوية لا تتزعزع، ما لم ينفذوا إلى أرواح الناس وقلوبهم، ولم يأخذوا بعين الاعتبار أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم وعواطفهم.
إلا أن هذه القوانين والقواعد إذا عجنت بالإيمان بالله فستكون أكثر تأثيرًا في الأفراد والمجتمعات؛ فإن الله الذي خلق الإنسان يعرفه حق المعرفة، بكل تفاصيله حتى أنفاسه التي يلتقطها ودمه الذي يجري في عروقه.. فهو الذي أودع في فطرته كل الأجهزة، وهو أعلم كيف سيعيش الناس في هذه الدنيا وكيف يؤسسون فيما بينهم علاقة اجتماعية، وعلى حسب أيّ القواعد والأصول سيقضون حياتهم تلك في مزيد من الراحة والسعادة.. وبالتالي فإن الإنسانية بمقدار ما تستطيع أن تطبق هذه القواعد والأصول الإلهية في واقعها ستشعر بمزيد من الراحة والأمان، وحينذاك سترى أن القرآن مهيمن على كل مشاعرها وعواطفها، وجميعِ علاقاتها الروحية والاجتماعية، وعلى كل عباداتها وطاعاتها بكل تفاصيلها وفرعياتها، وأنه يُشَكِّله من الداخل شيئًا فشيئًا؛ لذلك فإن القرآن منذ أول يوم نزل فيه إلى اليوم الذي انقطع فيه الوحي لم يُقابَل بنفور أو ردة فعل إلا مِن قِبَل شرذمة قليلة من المعاندين؛ فقد تسرب إلى أرواح كل من استمع إليه، وفتح قلوبهم، وأما الذين عاندوه وتمردوا عليه ولم يستسلموا له فقد سُحروا به وبهتوا.
ومن هذا المنظور نقول: إن الأخبار الغيبية في القرآن تفُوقُ حدود مدارك البشر بكثير؛ فتراه يتناول الأخبار المتعلقة بالماضي، ويتحدث عن الأقوام التي عاشت قبل التاريخ بأدق خصائصها، ويرسمها بحيث إنه من المستحيل على أي بشر أن يعرفها كما فصلها القرآن مهما كان واسعَ المدارك كثيرَ المعارف، وفي الوقت نفسه تراه قد أخبر عن أمور مستقبلية وأشار إليها، وقد ظهر كثير منها بعد ذلك، فكأنه يَعرض لأنظار الناس الزمانَ الماضيَ مع الزمان المستقبل مثل شريط سينمائي، وكأنهما على خطّ واحد أو هما نقطة واحدة، وسنبيّن لاحقًا كل هذه الأمور بأمثلتها، ولكن من المفيد لفت الأنظار إلى بعض النقاط:
أ. كما هو ملحوظ من بعض الأمثلة التي يأتي بها القرآن فإن الأخبار الغيبية التي يتحدث عنها القرآن ترِد فيه بأسلوب صريح وواضح، حتى إن العقول العامية البسيطة تستطيع أن تفهم منها الهدف القرآني وتطلّ من خلالها على آفاق جديدة من العلم والتفكّر.
ب. وكما أن القرآن يستخدم العبارات الصريحة في الأخبار الغيبية نراه يستخدم أحيانًا تعبيرات كنائية لا يستطيع كل شخص أن يفهم هذه الكنايات، حيث تكون هذه العبارات محمّلة بإشارات ورموز لا يرقى إلى فهمها إلا أهل الاختصاص.
ج. ويتحدث القرآن عن أقوام وجماعات لم يسجلها التاريخ، ولأن المخاطبين ليس لهم طريق إلى التعرف على هذه الأقوام والجماعات فإنها تكون من قبيل الغيبيات، فالأخبار المتعلقة بتاريخ قدماء روما والصين وبابل والفراعنة وحضاراتها التي لم يسجلها التاريخ المكتوب أو الشفهي هي من هذا القبيل؛ فإننا نحن أهلَ هذا العصر نمتلك معلومات تاريخية ترجع إلى أَلْفَي أو ثلاثة آلاف سنة، في حين أن المجتمع الذي نزل فيه القرآن كان أميًّا، وبهذا الاعتبار فإن الأحداث التي أصبحت مطوية هنا وهناك في ثنايا التاريخ تُعتبر بالنسبة لهم غيبية.
د. إن معظم الأخبار القرآنية تتعلق بالمستقبل، وقد يكون من المفيد أن نتناول هذا الأمر بشيءٍ من التفصيل.
قد يكون هناك من يعترض على غيبية الأخبار المتعلقة بالماضي، لاعتبارات مختلفة.. كما أن الأخبار المتعلقة بالزمان الحالي لا تعتبر من قبيل الخوارق والمعجزات.. وأما الأخبار والإشارات المتعلقة بالمستقبل التي تتحقق حينما يحين الأوان، فليس هناك مجال لأي اعتراض على كونها من الغيبيات، ومن الممكن على كل حال التحدي بمثل هذه الأخبار، وبالتالي فإن الأخبار التي من هذا القبيل ظلت جالبة لأنظار بني البشر، وكانت مصادرها تحظى بالاحترام أكثر من غيرها.
وبالمناسبة فإني أود أن أتطرق لحقيقة تاريخية، وهي أن “ماركس” الذي يعتبر من المؤسّسين للفلسفة المادية ومن المحسوبين في عداد أحجار الزوايا فيها؛ كان قد تكهن بأمر في بداية تأسيسه لنظريته، وهو أن بريطانيا ستكون أول الأمكنة التي ستطبق فيها هذه النظرية، فروح فلسفته كانت تقتضي هذا؛ حيث كان يَربط نظامه هذا في معظمه بإفلاس الفلسفة الرأسمالية، فكان لا مفرّ -حسب تكهنه- من حلول هذه الفلسفة المادية محل الرأسمالية التي هي على مشارف الإفلاس.
ويبدو أن ماركس كان يفكر كما يلي: إن أوروبا كانت منذ العصور الوسطى في وضع تتصادم فيه شرائح المجتمع وطبقاته، وكان الصراع الطبقي مُسْتَعِرًا إلى حدّ كبير، مما يعني أن هذا الصراع القائم سينتهي في إنكلترا بالاشتراكية والشيوعية، وكان هذا -على حد زعمه- أمرًا مثل قانون طبيعي لا مفر منه وغيرَ منوط بإرادة الإنسان، إلا أن هذا التكهن والتوقّع لم يتحقق، بل تأسس هذا النظام المادي بعد خمسين عامًا في روسيا التي كانت في جغرافيا لم تكن بالحسبان، وهكذا أصبح هذا النظام مجروحًا منذ أول تأسيسه وسرعان ما ظهر للناس أنه بني على أسس خاطئة.
ولا ريب أن أفكاره التي طرحها في هذا الباب كانت عبارة عن توقعات وادعاءات، وكان لزامًا أن تبوء بالفشل الذريع قبل أن يمر عليها سبعون عامًا، وهذا ما وقع فعلًا، إلا أن الملايين من الشبان قد سفكوا الدماء جراء توقُّعٍ وكذبة، وارتكبوا جرائم الظلم والاضطهاد، ولا يزال إلى يومنا هذا من بني الإنسان من يئنّ جرّاء بقايا هذا النظام الطاغي، فهناك في جميع أنحاء العالم من كان يتابعهم بأفكار سطحية، ويرتكب أشكالًا وألوانًا من عمليات الاحتيال والفساد من رشوة وغيرها.
أجل، قد يكون من الممكن لمن يتابع سير بعض الأحداث عن كثب أن يتنبّأ ببعض الأمور حول المستقبل القريب، فتلبُّد الغيوم وإبراق البرق من الأمارات الدالة على نزول المطر، وتوقع مثل هذا الأمر لا يُعَدّ من الغيبيات، إلا أن هناك بعض الأحداث لا يوجد أثناء التنبؤ بها أيُّ أمر يتعلق بها بحيث يساعد على التخمين حولها وكيفية جريانها، حيث إنه بدلًا من وجود أمارات حولها قد تحدث هناك أمور من شأنها أن تدحض هذا التنبُّؤ وتسيرَ في عكسه، والأنباء التي أخبر عنها القرآن من هذا القبيل.
هـ. وقد اخترنا مما يتعلق بالموضوع بعض الأمثلة من الماضي وبعضها من المستقبل حتى نقارن بين هذين الزمانين.
وفي هذا الموضوع الذي نتطرق فيه إلى الجوانب الإعجازية للقرآن الكريم أردنا أن نشير إلى ما يؤيد هذا الطرح، وإلا فإنه كان من الأنسب أن يتم تناول هذا الموضوع في بحث مستقل، وكما ذكرنا من قبل: إن هدفنا الرئيس في هذا التحليل هو لفت نظر مسلم القرن الحالي إلى القرآن وتوجيهُ الأنظار إلى كون القرآن كلامًا معجزًا؛ فإنه إن لم تتوجه القلوب إليه مرة أخرى، ولم تتشبع الأذهان ولم تنشغل به، فلن يكون -حسب اعتقادنا- خلاص كلي للإنسانية.
ب. الأنباء المتعلقة بالماضي
إن القرآن الكريم يتحدث بين الحين والآخر عن أقوام ومجتمعات سابقة لم يكن إلى ذلك الوقت في تاريخ الإنسانية أي معلومات حولها، فلو رجعت إلى ما تناوله الأدباء والمؤرخون العرب وتفحصْتَه علمتَ أنه لا توجد فيها معلومات حول هذه القضايا التي تناولها القرآن الكريم.
ومع أن الرسول نشأ أمّيًّا في بيئة أمّيّة، فقد كان يتحدث عن موضوعات وردت في التوراة والإنجيل وكأنه اطلع عليها بتفسيرها وشروحها، فكان يقول أشياء تعتبر تأسيسًا لهذه المواضيع وأحيانًا أخرى بمثابة التوضيح، أو بمثابة التصحيح.
أجل، إن سيد الأنبياء كان بمنزلة الحَكم، فكان يُقرّ الأمور الصحيحة المتفق فيها، كما أنه كان يؤسس للأمور التي تدعو الحاجة إلى تأسيسها، وكان يقدم الحلول البديلة للقضايا الخلافية، فمثلًا كان هناك من يرمي السيد المسيح بأنه -حاشاه- لا نسب له، وكانوا يزعمون أن لديهم أدلة تصدق دعواهم هذه، ففي المقابل كان الرسول يقول: “إنه رسول الله”، وبذلك كان -من جانبٍ- يدحض دعواهم بأنه لا نسب له، ومن جانب آخر، يرد على أولئك الذين ينسبون إليه الألوهية.
كان هناك إسرائيليات على هذا النحو، تحتوي على العديد من الافتراءات والمغالطات في حق الأنبياء الذين أُرسلوا منابعَ للهداية بكل ما للكلمة من معنى، ففي هذا المجال أيضًا تَناول القرآن الكريم كل الأنبياء بأدب يناسب شأنهم العظيم، وأَثبت أن كل واحد منهم مرشد هاد للإنسانية نحو الترقي المادي والمعنوي، فمع أن مفخرة الإنسانية كان أمّيًّا ولكن نداءه بهذه الحقائق بأسلوب القرآن الرائع النفيس يدل على مدى صفاء منبعه وصحته.
أجل، إنه على الرغم من أنه كان نبيًّا أميًّا ولم يسافر في حياته إلا مرتين نحو الشام مع قوافل التجارة ولم يتسنّ له التعرف على غيرها من المناطق.. نجد أنه تَحدَّث عن الأزمان الغابرة وكَأنَّ أمامه جميعَ الكتب المقدسة، ويقوم بدور الحَكَم فيعالج الاختلافات التي ظهرت بين بني إسرائيل ويأتي بحلول عادلة من مشكاة النبوة بتركيب سحري يأخذ بالألباب.
وقد سبق لنا أن أوردنا في الفصول السابقة معلومات مفصلة عن الأمم السابقة فلا داعي لتكرارها إلا أننا سنكتفي هنا بإيراد مثال صغير:
يتحدث القرآن في مواضع عديدة عن كثير من الأقوام مثل عاد وثمود، مع أنه لم يكن هناك من يتحدث عن هؤلاء قبل أن ينتشر في أوروبا علم الآثار والتاريخ، فالمعلومات التي كتبها العلماء المتخصصون في الكوزموغرافيا والجغرافيا وعلم الفلك حول عاد وثمود وإرم قربيةٌ جدًّا من المعلومات التي وردت في القرآن حولهم منذ زمن بعيد، اللهم إلا بفارق بسيط في النطق ببعض الكلمات.. فقد جاء في القرآن الكريم قبل قرون قولُه تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (سورة الفَجْرِ: 89/6-14)، وذلك له مغزى كبير.
فلما سمع الكُتَّاب والعلماء في أوروبا مثل هذه الآيات بادروا بالاعتراض فقالوا: إن القرآن يتحدث عن أقوام مثل عاد وثمود ما سبق لنا أن سمعنا أو علمنا عنهم شيئًا، وليس لدينا معلومات عن وجود مثل هذه الأقوام منذ اكتشاف الكتابة، فمن المحتمل أن القرآن يتحدث عن أمور خيالية، إلا أنه لما انتشر تاريخ العلوم في أوروبا بدأت الحيرة والدهشة تأخذ هؤلاء الناس أنفسهم بسبب مثل هذه الإخبارات الغيبية القرآنية؛ لأنهم كانوا يحتاجون لدعم من علم الآثار والأنثروبولوجيا ونحوهما للحصول على معلومات عن الأقوام التي تحدث عنها القرآن قبل قرون، وبالفعل فقد أسفرت البحوث التاريخية والتنقيبات الأثرية التي أجريت في الفترات اللاحقة عن تصديق علم التاريخ أيضًا للقرآن وتأييده لأنه كلام الله.
إن القرآن الكريم يصور الأقوام الماضية بروحها ومشاعرها وحماساتها، ونواياها ومعتقداتها ويحللها وكأنه عاش بينهم، بحيث إنه يُشعر قارئ الآيات القرآنية أن أولئك الأقوام ماثلون أمام عينيه، إلى مدى أن القرآن حينما يذكر بتعبيراته المذهلة جنان إرم وبساتينها يخيل إلى الإنسان أنه يتنزه بين تلك المناظر الجميلة اللطيفة .
ففي الآية السابقة يتحدث القرآن عن فرعون، صحيح أن كتب التاريخ ترد فيه معلومات مختلفة عن فرعون، وبالتالي قد لا يكون حديث القرآن عن قصته معجزًا من هذه الناحية، إلا أن تناول القرآن للأحداث بشكل موجز، وتعرضه لأدقّ خصائصهم بأسلوب بالغ في الوقع والتأثير، ومعالجته للوقائع بما اكتنفها من واقع ومشاعر لهو أمر يقرب من حد الإعجاز، لكن المستشرقين ومن يحذون حذوهم ويقلدونهم قد أغمضوا أعينهم عن حقائق القرآن ولا يزالون يتغاضون عن هذه الأمور المهمة.
ففي حين أن القرآن الكريم يذكر في قوله تعالى: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ (سورة يُونُسَ: 10/90-92) أن فرعون قد غرق، نرى أن بعضًا من المستشرقين ينكر غرق فرعون قائلًا: “إنه مات وحُنِّط جسده، وظل موجودًا هكذا إلى يومنا هذا”.. في حين أن القرآن قد ذكر بقاء بدنه حتى تراه الأجيال القادمة ويكون عبرة لهم، وأخيرًا لما جاء اليوم الذي ظهر فيه جسد فرعون لم يبلَ رغم عدم تحنيطه تمامًا كما ذكره القرآن الكريم؛ تحير الكل أمام هذا الخبر الغيبي القرآني، وانتصر الضمير والوجدان على مشاعر الجحود والإنكار.
وكان بعض الأوروبيين يهاجم الآيات القرآنية التي تتحدّث عن طوفان نوح، ولكن بعد حين من الدهر أظهرت بعض البحوث حقيقةَ أنه قد حصل طوفان رهيب غمرَ جميع الأرض أو قسمًا منها، حتى إن الوثائق التي حصلوا عليها أحدثت لديهم قناعة قوية أدت بهم إلى أن أتوا إلى جبل الجودي مرات متعاقبة للبحث في القضية، مع أن القرآن كان يتحدث عن هذا الأمر منذ زمن بعيد بكل تفاصيله وبدرجة من القطعية بحيث لا يبقى في القلب أدنى تردد حوله، ولكن للأسف كان لا بد من مرور عصور حتى يفهموا القرآن ويَقبلوا الحقيقة غير معاندين.
وبعد سرد القرآن الأمثلة حول هذا الموضوع وإتيانه بتلميحاته عن الأمم السابقة يقول: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ (سورة هُودٍ: 11/49).
أجل، فكما قال القرآن الكريم، لم يكن بإمكان النبي ولا قومه أن يكونوا عالمين بهذه الأخبار؛ إذ كما أنه لم يكن في جزيرة العرب من يتحدث عنها؛ فكذلك لا يوجد أي معلومات صغيرة حولها في كتب التاريخ ولا في أشعار العرب، فأرسل الزمان أطيافه النيرة وقدم تفسيراته، وطلعت شمس القرآن على آفاق مدارك البشرية.
ج. الأخبار القرآنية المتعلقة بالمستقبل
إن الأخبار القرآنية المتعلقة بالمستقبل تختلف عما يتعلق بالماضي، فهي أكثر إثارة للتفكير؛ لأن الإخبار عن واقعة قبل حدوثها أمر يتجاوز حدود آفاق الإدراك البشري؛ فالحديث عن أمر سيحدث في المستقبل من دون أية أمارة حوله لهو ادّعاء كبير وتحدٍّ عظيم في الوقت نفسه، ومن ثمّ فإن القرآن الكريم بمثل هذه الإخبارات المعجزة يتحدى المنكرين له في عصر نزوله والعصور اللاحقة ولنأتِ ببعض الأمثلة حول هذا الموضوع:
يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/67).
فهذا البيان الإلهيّ يُخبر الرسول بأمر غيبيّ بأنه لن يصل إليه أيّ ضرر من أيّ إنسان، وقد كان الرسول جاء برسالة عالمية تشمل كل البشرية، وكان من المتوقّع أن تعارَض قضيةٌ بهذا الحجم من قِبل بعض المنكرين، وأن تكون هناك ردّات فعلٍ من المشركين تجاهها، وهذا ما وقع فعلًا؛ فقد وقف كثير من المنكرين والمشركين في طريق هذه القضية المقدّسة عازمين على عدم إعطاء الفرصة لتطوُّرها وانتشارها، فحين بدأ الإسلامُ ينتشر في مكة لم يدع المشركون طريقًا للمجادلة إلا وجربوها، وحاولوا محاصرته من كل الجوانب، ولما علموا أنهم لن يُوَفَّقوا لذلك؛ قرروا اغتيال سيد الأنبياء الذي هو صاحب القضية.
إلا أن الله تعالى أَطْلع رسولَه على خططهم السرية، وأخبره من خلال الآية الآنفِ ذكرها أنه سيحميه مهما كانت الأوضاع، وأنه لن يتسنّى للمشركين أن يضروه بشيءٍ أبدًا، لأن قضية مفخرة الإنسانية كانت قضية فوق كل القضايا باعتبارها تتعلق بالفلاح الأبدي لكل الإنسانية، وكان الممثّلُ لهذه القضية هو سيدنا محمد الذي أُرسل رحمة للعالمين، وما كان للبشرية أن تحظى بالسعادة إلا بإرشاده، مما يعني أن القضاء على حياته سيؤدي إلى انغماس كل شيء مرة أخرى في غياهب الظلمات.
وقد تكفل الله مباشرة بحفظ حياة هذا الشخص الذي أنيط وجود الكون بوجوده إلى هذه الدرجة، لأنه كان على شمس الهداية صلوات ربي وسلامه عليه أن يطوف بالشوارع، ويمر على كل البيوت ليدعو الناس إلى الهداية والنور، وهذا يعني أنه سيكون معرّضًا كل حين للأخطار المتنوّعة، فقد كان هناك من يبصق في وجهه المبارك ويذرُّ التراب والحصا على رأسه، كما أن خصومه إذا رأوه يرتاح في مكان ما لوحده فإنهم سرعان ما كانوا يحيطون به جاهدين لحياكة مؤامرة ضدّه ومحاولين قتله.
ففي بدر وأُحد والخندق استهدفوا شخصه للقضاء عليه وتصفيته تمامًا، وأما هو فقد كان حيال كل هذه المؤامرات يعيشُ حالة من الثقة المطلقة والاطمئنان العميق تجاه ربه، بحيث جعل الكفارَ يندهشون ويحتارون من توكّله وجسارته التي تفوق حدود الطاقة البشرية؛ لأنه كان يعلم أنه تحت الحماية الربانية مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/67).
أجل، إن الله تعالى قد عصم الرسول الذي أرسله لينور البشرية مثل الشمس، وحماه من أيدي أعدائه فلم يبلغوا منه أملهم وأفشل كل الأفخاخ التي نصبوها ضده.
وقد كان قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (سورة الأَنْفَالِ: 8/30) وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ (سورة الطَّارِقِ: 86/15-16)، من المبشرات التي تصب في هذا الاتجاه.
وإلى جانب الآيات التي تدور في إطار قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/67)، والتي تدل على أن الله تعالى قد تكفل بحفظ سيدنا محمد مباشرة، هناك أحاديث وردت في كتب الحديث تتحدث عن واقعة جرت قبل نزول هذه الآيات، منها:
يروى أنّ عائشة كانت تحدّث، أنّ رسول الله سهر ذات ليلة [ولعله كان في السنة الثانية للهجرة النبوية إلى المدينة] وَهِيَ إِلَى جَنْبِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : “لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ”، [وهذا لأن غير المسلمين في المدينة كانوا عازمين دائمًا على أن ينصبوا له أنواعًا من المصائد والأفخاخ] قَالَتْ: فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُ خَشْخَشَةَ سِلاحٍ، فَقَالَ: “مَنْ هَذَا؟”، فَقَالَ: سَعْدُ بْنُ أبي وقاص، قَالَ: “مَا جَاءَ بِكَ؟” قَالَ: وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه .
وبعد مدة لما نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/67)، قال النبي لهم: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللهُ” وهذا ما وقع فعلًا، فقد التحق الرسول بالرفيق الأعلى وهو على فراشه تحت حماية الله تعالى، ولم يسمح الله لهم بأن يصيبوه بسوء.
فقد أخبرَ القرآن بهذا الخبر قبل وفاته بعشر سنوات تقريبًا وأعلن أنه لن تصل إليه أيَّة يد منحوسة، وبالفعل فقد لاقى بعد ذلك مئات المخاطر، وشارك في عديد من المعارك، وشارف على الموت في ساحات الوغى، ولكن هذا الحرز الإلهي بدا للعيان في كل مرة منها.
فمثلًا في مرة من المرات بينما كان يستظل بظل شجرة انتهز أعرابيٌّ يسمى غَوْرَث ابن الحارث تلك الفرصة فجاء وأخذ سيفه المعلق بالشجرة وقال بأسلوب السخرية: من يمنعك مني اليوم يا محمّد؟! فأجابه الرسول بأسلوب بالغ في التوكل والثقة بربه وصرخ في وجهه قائلًا: “الله”، فأرعبت هذه الصرخةُ المدوّية منه الكافر، فوقف واجمًا ثم ارتجف وارتعدَ وخارت قواه فسقط السيفُ من يده، فإذا بالرسول يأخذ السيف ويقول له: “فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي الْآنَ؟” فأخذ الرجل يرتعد كالمحموم قائلًا: كُنْ خَيْرَ آخِذٍ، فقَالَ له النبيّ: “وَأَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟” قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ
لَا أُقَاتِلَكَ، وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ .
وفي بداية غزوة حنين أيضًا بدا نوع من الهزة في صفوف الجيش الإسلامي؛ بحيث إن جميع الصحابة تقريبًا عاشوا هذا الهزة، وقد سادت في صفوف الصحابة قناعةٌ بأن الأمر قد يؤول إلى مغلوبية وانهزام؛ حيث لم يصمد شباب المهاجرين والأنصار أمام النبال التي يرشقها مهرة الرماة من مشركي هوازن وبني نصر في بداية المعركة، وتحولت بوادر النصر إلى تقهقرٍ وبقي شخص واحد معه قِلّةٌ من صحبه أحدق بهم الخطر وأحاط بهم الأعداء.. ألا وهو الرسول.
ففي هذه اللحظة الحرجة بالذات حَدَث أمرٌ لم يكن في الحسبان؛ ففي حين أن العباس كان يمسك براحلة الرسول إذا بالنبي يتقدم نحو صفوف الأعداء ويصرخ بصوته الجهوري المهيب قائلًا بملءِ فيه: “أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ”، فهو الذي لا يمكن أن يدير ظهره للأعداء، كما أن جدّه أيضًا لم يهرب مِن أمامِ أبرهة، بل وقف صابرًا صامدًا.
وكان من الصمود والمهابة والجسارة بحيث إن الذين كانوا يدخلون في محيطه المغناطيسي ينبهرون بكل شيء منه، بل إن الذين كانوا يحتَمون به كانوا يعتبرون أنفسهم في أمان.
أجل، إنهم كانوا يرون بأن آمَن الأمكنة هو ما كان بقربه، وهكذا كانوا يفعلون فيلتفون حوله؛ لأن الله تعالى كان يكلؤه ويرعاه، تصديقًا لقوله الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/67).
وقد روي عن الحيدر الكرار وملكِ الفُتوَّة، صهر سيد الأنام، سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: “كنا إذا حمي الوطيس (أي اشتدت المعركة) احتمينا برسول الله” . فقد حَدَثَ مثل هذا في أحرج مراحلِ حنين، وأدى إلى انتصار جيش الإسلام، وانقلبت الهزيمة إلى النصر.
وكما نفهم من الأمثلة التي أوردناها إلى الآن فإن القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/67) قد أخبر عن حدثٍ غيبي يتعلق بحفظ الله تعالى لرسوله، وقد أكدت الأحداث التي وقعت خلال المدة الزمنية التي مرت بعد نزولها صِدْقَ هذا الخبر الغيبي، حيث إنه على الرغم من نزول هذه الآية في فترة لم تكن فيها حماية للرسول بل كان الأعداء محدِقين به من كل جانب، ظهر صدق هذا الخبر القرآني والتحق سيد الرسل بالرفيق الأعلى وهو على فراشه آمنا مطمئنًّا.
وأود أن آتي بمثال آخر له علاقة بالموضوع:
فلقد أخبر القرآن الكريم في قوله: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾ (سورة القَمَرِ: 54/45-46) بأن المسلمين سيَهزمون الكفار في المستقبل، وأن المشركين سينهزمون، وقد روى البخاري عن أمنا عائشة أن هذه الآية مكية ، وقد كان المسلمون في مكة في غاية الضعف مما جعلهم يغادرون مكة مهاجرين إلى الحبشة، ولما لم يجد الرسول من المكيين استجابةً توجه إلى الطائف لعله يجد من يسانده في قضيته.. إلا أنه بدلًا من أن يلقى من أهلها القبول الحسن رشقوه بالحجارة وعرّضوه لشتى أنواع الإهانات وسوء الاحترام، وحين لم يعد جو مكة مناسبًا للعيش بالنسبة له ولمن حوله من المسلمين، أجابوا دعوة أهل المدينة الذين احتضنوهم، فهاجروا إليها.
ففي هذه الفترة التي كان المسلمون فيها في غاية الضعف، وكان الكفار -بالمقابل- أقوياء من كل الوجوه وفي منتهى التهوّر والطغيان نزل قوله تعالى: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (سورة القَمَرِ: 54/45) مبشِّرًا رسوله بأن الكفار عما قريب سينهزمون وسينقلبون على أعقابهم.
وقد كان من الصعب جدًّا أن يؤمن الإنسان بتحقق مثل هذا الأمر في تلك الظروف التي لم تكن موازين القوى بين المؤمنين والكفار متكافئة قط، وكان الكفار يزيدون من ضغوطهم، وبالتالي فقد كان من العسير جدًّا التنبّؤ بمثل هذه النتيجة، حتى إن سيدنا عمر الذي كان رمزًا للشجاعة تعجّب حينما نزلت هذه الآية قائلًا: أيُّ جمع يهزم؟! أيّ جمع يغلب؟! فهذه الحيرة من سيدنا عمر تجاه هذه البشارة لها مغزى كبير في التعبير عن مدى صعوبة تحقّقها في واقع الأمر، صحيح أن سيدنا أبا بكر بحكم كونه رمزًا للصّدّيقية بادرَ بتصديق هذه البشارة، أما سيدنا عمر فقد عبر عن الأجواء السائدة على الشعور العام لدى الصحابة، فسأل عن وقت تحقُّقها، وأراد أن يؤكد أنه إذا كان لها أن تتحقّق فإنها ستتحقق ولكن في وقت ليس بقريب.
فلما كانت السنة الثانية من الهجرة النبوية المباركة، التقى المسلمون يوم بدر بالكفار، وكان الرسول يتضرع إلى ربه ويرفع يديه ويقول في سياق دعائه الطويل: “اللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ”، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْه، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ .
وفي هذه الأثناء تغيّر الجو فجأة، وغطّت السحبُ كلَّ الأفق، فتبسم الرسول أمام هذا المشهد الذي اعتبره تصديقًا للبشارة التي جاءت بها الآيات من قبل، فأخذ حفنة من الرمل ورماها في وجوه العدوّ وخرج وهو يَثِب في الدرع وهو يقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾ (سورة القَمَرِ: 54/45-46). وفي رواية ابن أبي حاتم: قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يثب في الدرع، وهو يقول: “سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ”، فعرفت تأويلها يومئذ.
فهذه الحادثة هي مصداق ذلك الخبر الغيبيّ الذي أخبر به القرآن قبل عشرة أعوام، مع أنه حينما نزلت الآية التي تُبشّر بهذا النصر لم يكن كثيرٌ من حديثي العهد بالإسلام يتوقّعون تحقُّق هذه الغلبة، ولكن الله أنجز وعده ببدر وهزم جمع الكفار هزيمةً نكراء، بحيث إن أبا سفيان رأسَ العصابة حينذاك هرب مع العير إلى مكة حتى ينجو بنفسه من الموت، وقد سأل أبو لهب -ولم يشهد بدرًا- أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: يا ابن أخي! أخبرني كيف كان أمر الناس؟ فقال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم، فمنحناهم أكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاؤوا، وايمُ الله مع ذلك ما لُمْتُ الناس، لقينا رجالًا بيضًا، على خيل بُلْقٍ (لونها بياض وسواد) بين السماء والأرض.. فقال رافع مولى العباس بن عبد المطلب -وكان مسلمًا يكتم إسلامه-: تلك -واللهِ- الملائكةُ .
أجل، إن الكافرين أيضًا قد شاهدوا الملائكة وهي تقاتل وتكافح في صفوف المسلمين، مما أدى إلى ضعف معنويات المشركين بالكلية.
والآيات التالية تتحدّث عن تلك التأييدات الإلهية المادية والمعنوية التي قدمها الله للمسلمين يوم بدر، يقول الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (سورة الأَنْفَالِ: 8/9-12)، ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ﴾ (سورة الأَنْفَالِ: 8/43-44).
ومن هذا الباب تلك البشارات التي أتى بها القرآن الكريم في العهد المكي الذي عانى فيه المسلمون من صنوف الضغط الشديد التي تمارَس عليهم، حيث إن القرآن نزل في هذا الجوّ بما يثلج صدورهم ويروِّحهم قائلًا: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ (سورة النُّورِ: 24/55). والحال إن التنبُّؤَ بتحقق مثل هذا في تلك الأحوال وفي ظروف ذلك اليوم كان من العسير جدًّا بل من باب المستحيل، إلا أنه لما حان الموسم تَحقَّق كل ذلك، وصار الأمر كما قال الشاعر محمد عاكف: “رسخت الأقدام التي كانت تحلق في الفضاء”، وذهب الممثلون للقرآن ينصبون خيامهم في كل بقاع المعمورة.
وفي حين كان المسلمون يرزحون تحت الضغوط، كان الروم والفرس في صراع وحرب دائبة، واستطاع الفرس أن يهزموا الروم حتى احتموا بأسوار القسطنطينية (إسطنبول)، وفرضوا عليهم ضرائب باهظة، ففي تلك الأيام كان المشركون أيضًا يشتمون المسلمين، ويقذفون بالكلام قائلين: “إِنَّكُمْ أَهل كتاب والنَّصَارى أهل كِتَاب وَنَحْنُ أُمِّيُّونَ وَقَدْ ظَهَرَ إِخْوَاننَا مِنْ أَهْل فَارِس عَلَى إِخْوَانكُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَإِنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُونَا لَنَظْهَرَنَّ عَلَيْكُمْ” [فكانوا على الدوام يهددون هذه الثلة من المؤمنين، ولكن الله تعالى في هذا الوقت بالذات أراد أن يفرح المؤمنين ويقوي عزائمهم بهذه البشارة الربانية] فَأَنْزَلَ تَعَالَى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ (سورة الرُّومِ: 30/2-5). فلما حان الموعد وقع كل شيء مطابقًا لما أخبر به القرآن، فقد التمَّ شمل الروم بعد فترة من الزمن فغلبوا الساسانيين في اليوم الذي كان المسلمون يعيشون أجواء الفرح بالنصر على المشركين في بدر.
وهناك خبر غيبيٌّ آخر حول فتح مكة.. حيث كان بعض المسلمين يعيشون حالة من انكسار الأمل جراء ما جرى في الحديبية من بعض بنود المعاهدة مما أدى إلى نوع من الضيق في صدور بعضهم، فكانت العيون ترنو إلى وجه الرسول على أمل بشارة تأتي منه، وأخيرًا وقع ما توقعوه حيث نزلت سورة الفتح وفيها قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ (سورة الفَتْحِ: 48/27)، وقد تحقّق ذلك على أرض الواقع.. وفي غضون مدة قصيرة دخل المسلمون مكة في الإطار الذي رسمه القرآن وطافوا بالكعبة.
وفي الآية التي تليها يبشر القرآن المسلمين بنبإٍ مستقبليٍّ أيضًا؛ حيث تبشرهم بالانفتاح على آفاق أوسع فيقول: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (سورة الفَتْحِ: 48/28).. وبمرور الزمن تحققت هذه الحادثة الكبرى أيضًا، فصارت البشرية في شتى بقاع المعمورة تسمع الأنفاس المحيِيَة التي تنبعث من المسلمين.
وعلى غرار ما ذكرنا من الأمثلة فهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم أخبرت عن أمور ستحدُث في المستقبل، ففرح بها المسلمون وقويت عزائمهم، ولما حان الوقت تَحققت هذه الأمور طبقًا لما أخبر به.
ويفهم مما سردناه إلى الآن من الأمثلة أن القرآن بما أخبر به من الأنباء الغيبية يلفت الأنظار إلى أفقٍ إعجازي مختلف، صحيحٌ أن بعض هذه الأخبار قد تحققَ في عهد سابق إلا أنه من المقرر أن القرآن يخاطب الناس في كل الأزمنة والأمكنة؛ لذلك فإننا على يقين بأنه كما وقع هذا في السابق فإن الإخبارات القرآنية الغيبية ستحقق في عصرنا الحاضر وفي المستقبل أيضًا، وستتنور الدنيا التي تئن في دوامة الاضطرابات والأزمات مرة أخرى.
فستنقشع في القريب العاجل -بإذن الله تعالى- السحب المظلمة، وفي ذلك اليوم سيتجدد إيمان الذين تعلقت قلوبهم بالقرآن وسيصدقون آياته وأخباره الغيبية مرة أخرى وسيقولون ليس القرآن إلا كلام الله المعجز.
د. الأخبار الغيبية التي وردت على وجه الإطلاق
لقد سردنا فيما سبق -ولو على سبيل الإجمال- أمثلة من القرآن الكريم حول الأخبار الغيبية القرآنية تحت عنوان: “الأنباء المتعلقة بالماضي” و”الأخبار القرآنية المتعلقة بالمستقبل”، وكان من الممكن أن ندرج ما سنذكره في هذا الفصل أيضًا تحت عنوان: “الأخبار القرآنية المتعلّقة بالمستقبل”.. إلا أن ما سنذكره في هذا الفصل يختلف عنها نوعًا ما، فالأمثلة التي سنذكرها لها علاقة بالماضي وبالمستقبل، بمعنى أنها أمور تحمل في طبيعتها تحدي القرآن للعصور، فأردنا أن نركز على هذه الناحية من الموضوع، ونعتقد بأنه كما لم يكن في الماضي من يستطيع أن يتصدى لتحدي القرآن، فلن يكون في المستقبل أيضًا من يتصدى له وسترفرف راية القرآن في سماء المستقبل إلى أبد الآبدين بوصفه معجزة إلهية.
وكما سبق لنا أن قلنا: إنه ليس من الممكن لإنسيٍّ أو جني أو أي مخلوق آخر أن يطلع على الغيب؛ لأن هذا الأمر يفوق بكثيرٍ حدودَ فهمِ المخلوقات وإدراكِهم؛ حيث إن مساحة علم الإنسان وإدراكه محدودةٌ وضيّقة جدًّا، فليس له أن يفهم بعلمه المحدود هذا الأمور المتعلقة بعالم الغيب، ولا أن يقوم بتركيب أو تحليل في مثل هذا الموضوع، ويستثنى من ذلك أولئك الذين اختارهم الله تعالى من بني الإنسان وأطلَعَهم على الغيب .
أجل، إن الله يصطفي هؤلاء ويوظّفهم بأن يشرحوا ما في قصر الكون أو ما في هذه الدنيا التي هي جزءٌ مهمّ من الكون، ويعرِّفوا بالآثار المعروضة على مشهر الكون، كما أنه يوظفهم بأن يدْعوا كلّ المخلوقات وبخاصة الإنسان إلى مشاهدة هذه المظاهر، ثم إنه يخصّ هؤلاء العظماء المصطفَينَ الأخيار ببعض المعجزات حتى تتوجه أنظار الناس إليهم ويسترشدوا بهم، ويأتي على رأس هؤلاء الذين حباهم الله ببعض المعجزات سيدنا محمد؛ فقد أطلعه الله تعالى على الغيب أيضًا ورفعه إلى مستوى عال جدًّا.
أجل، إن سيدنا محمّدًا لهو المرشد الأكمل والمبلِّغ الفريد الذي يدعو إلى الله.. والقرآنُ المعجز البيان الذي نزل على قلبه بوحيٍ إلهيٍّ لهو كتاب سماويّ مقدّس يحوي كثيرًا من الأخبار الغيبية، ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأن الرسول أكبر معجزات القرآن، كما أن القرآن أكبر معجزات ذلك المرشد الأكمل والأكبر.
ونعود لنُذكِّر مرة أخرى بأن القرآن المعجز البيان يفوق بكثير الكلامَ البشري وتعابير البشر وبيانه، وهو كتاب معجزٌ من كلّ الوجوه، وليس إخباره عن الغيب إلا وجهًا واحدًا من هذه الوجوه الإعجازية، ومن هذا المنطلق نقول: إنه لا بد أن يأتي يوم ستعترف البشرية فيه بأن القرآن حوى جل أنواع الإعجاز، إن لم يكن اليوم فغدًا.
والآن نود أن نقف ولو قليلًا، عند آية تعلن في معرض الحديث عن أن القرآن معجز، وأنه قد تحدى البشرية في كل القرون أن يأتوا بمثله، فتذكر بطريقة غيبية لأهل كل العصور أنه لن يتأتى لأحد أن يأتي بمثله، منذ أول يوم نزل فيه إلى يوم القيامة، فتقولُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/23-24).
وقد كان الأدب في عصر ظهور الإسلام قد تطوَّر جدًّا وكان يعيش عصره الذهبي، إلى درجةِ أن الكلمة غدت أكثر الأمتعة رواجًا بينهم، وبها كانوا يعبِّرون عن مستواهم في كثير من الأحيان، فكانوا يتعاركون من أجلها وبها يتقاتلون وكما كانت الكلمة الواحدة تؤدّي بهم إلى المحاربة، فكذلك كانت الكلمة سببًا للوئام؛ حيث ترى القبائل المتناحرة تتصالح جرّاء كلمة تلقى عليهم.
وكما أن المادة في عصرنا الحالي أصبحت قيمة فوق القيم، وصار كلُّ شيء يقاس بالمادة وبها تعتبر قيمته، وغدت المادة أساس كل شيء وغايته وأمرًا لا بد منه، فكذلك في تلك الحقبة في الجزيرة العربية كانت الكلمة، وبالأخص الشعر، قيمةً تَسبِقُ كل القيم وتَفُوقُها.
ولقد جهز الله تعالى كل نبي بالقيم الرائجة في قومه وأيدهم بمعجزات تفوق مستوى إدراك أهل عصرهم حتى يثبتوا بها دعواهم، فمثلًا:
كان السحر رائجًا في عهد سيدنا موسى، وفي عهد سيدنا عيسى كان الأمر الرائج هو الطب؛ لذلك منح الله تعالى سيدنا موسى من المعجزات ما يبطل به عمل السحرة، وأعطى سيدنا عيسى معجزات تتعلق بالطب لأنه كان في عهدٍ تطوَّر فيه الطبُّ إلى مدى أن الأطباء حينذاك كانوا يقُومون بإجراء بعض العمليات الجراحية، وهذا الأمر كان من الأمور التي يُثبت بها هؤلاء الأنبياءُ نبوتهم.. على نبينا وعليهم الصلاة والسلام.
وفي الفترة التي بُعث فيها الرسول كان الشعر والأدب يعيشان عصرهما الذهبي، ومن هنا فقد حباه الله تعالى القرآن المعجز الذي كان أساتذةُ البيان عاجزين عن الكلام أمامه كأنهم بُكْمٌ، بل خرُّوا سُجّدًا أمام بلاغته.
أجل، إن القرآن بهذه الآيات دعا كل الشعراء والأدباء إلى أن يعارضوه وتحداهم قائلًا: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (سورة الإِسْرَاءِ: 17/88).
﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (سورة هُودٍ: 11/13).
﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (سورة يُونُسَ: 10/38).
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/23-24).
فـ﴿إنْ﴾ في هذه الآية تفيد الشكَّ، ويُفهم منه أن المخاطَبين بهذه الآية يظلون يتخبطون في شُبَهٍ ضعيفة، ويرزحون تحت وطأة الشكوك والشبهات.
وكأن قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ يقول لهم: ادعوا غيرَ الله من شهدائكم وشعرائكم وأدبائكم وكلِّ مَن تظنون أنه سيساعدكم في يومكم هذا وفي غدكم من أهل العلم والمعرفة، وأجمِعوا فيما بينكم على فكر واحد، واطرحوا أفكاركم البديلة، حتى تأتوا بنظير لسورة واحدة فقط من بين سور القرآن.
وإن التاريخ لَيشهد أنه لم يستطع أن يأتي أحدٌ بنظير لآية واحدة من آي القرآن ناهيك عن السورة، فإن ما في كلمات القرآن من حسن الاختيار الخارق، وما في تراكيبه من السلاسة والتناغم البديع، وما في معناه وأسلوبه من شاعرية -رغم أنه ليس بشعر- وموسيقى وانتظام يأخذ بالألباب وما في ألفاظه من نغم يطرب القلوب، وما بين ألفاظه ومعانية من التناسب والتطابق، وكذا ما في إخباراته الغيبية من النوافذ الباهرة؛ لَمن الأمور الخارقة التي لا يستطيع أن يحقِّقها إلا الله، كما أنه ليس لأحد أن يأتي بسورة أو آية تحتوي على كل ما ذكرنا إلا الله.
أجل، إن الإنسان حينما يأخذ بعين الاعتبار كلَّ هذه النقاط، فستأخذه الحيرة، وسيملأ الانبهار عقله، وسيرى أن الإتيان بسورة أو آية مثل سور القرآن أو آياته أمر يفوق أضعاف أضعاف طاقة البشر.
إن القرآن رغم تَحدِّيه الجميع بكل هذه الجوانب الخارقة فيه، لم يتصد للإتيان بنظير له سوى ثلاثة أو أربعة من التافهين الذين أصبحوا بمحاولاتهم الفاشلة موضع السخرية لدى الآخرين، وقد كان في تلك الأيام كثير من الفصحاء وأساطين البلاغة الذين كانوا يتربعون على عروش الأدب في مهرجانات مثل عكاظ وقينقاع بمن فيهم من الشعراء الفحول أمثال الأعشى ولبيد والخنساء، ولكنهم بدلًا من الإتيان بنظير للقرآن استسلموا واستكانوا له، وقد كان من بين هؤلاء الشعراء أمثال لبيد ممن كانوا قبل إسلامهم يُنظَر إليهم على أنهم من الملهَمين، فيتحلق حولهم الناس متلهفين لسماعهم، ولكن هؤلاء الشعراء لما سمعوا القرآن استسلموا له وتركوا الاشتغال بقَرْض الشعر.
أجل، إن هؤلاء لم يكتبوا الشعر بعدما دخل القرآن عالَمهم الفكري، فشعراء تلك الفترة وأدباؤها سُحِروا من تعابير القرآن التي تأخذ بالألباب، وقد كانوا عارفين باللغة وبكل دقائقها، فقد بلغوا من العاطفة الشعرية إلى مستوى كان أحدهم يخر ساجدًا أمام بلاغة جملة واحدة، وبعدما نزل القرآن وفَهِمَ بعض من كان لا يزال على قيد الحياة من شعراء المعلقات السبع أن شعره لم يعد يعني شيئًا؛ أخذ يتولى بنفسه نزع شعره المعلق بالكعبة، حيث إن المعلقات السبع هي التي كانت تُكتب بماء الذهب وتعلق بالكعبة.
أجل، إن كل من كان يسمع ولو بضع آيات من القرآن في تلك الأيام كان يضطر للاعتراف بأنه لا يمكن معارضة القرآن بنظيره ولا الإتيان بمثله.
وتحدي القرآن لم يكن منحصرًا بذلك الوقت بالذات، فقد نشأ بعد ذلك العصر أيضًا شعراء عباقرة، وكان منهم من يعظّم أمرَ الشعر إلى درجة التأليه، ولكن إذا أمعن الإنسان النظر، ولو قليلًا، فيما قالوه فسيلاحظ ما فيه من التكلّف وسيرى أن بعضَ قطعهم الأدبية عبارة عن ألفاظ وتعابير مضخّمة، فهذا أبو العلاء المعري الذي ترك بصمات واضحة في حقبةٍ من تاريخ الشعر، وكذا المتنبي الذي ذهب به كبره وغروره إلى أن قال: أنا نبيُّ الشعر، تراهما قد حاولا أن يأتيا بما قالاه من الشعر المزخرف الذي يفوح كبرًا وغرورًا، بما قد يقترب من القرآن الكريم، ولكنك حينما تنظر إلى ديوانهما فسترى محتواه في مجمله عبارة عن الهجاء واليأس والتشاؤم والادعاءات الفارغة، فما بالك بالإتيان بما يعارض القرآن.. فهؤلاء التعساء، شأنهم شأن بعض العدميّين في القرن العشرين، لم يهتموا نهائيًّا بالسبب والحكمة من وراء وجودهم، وبكيفية هذا النظام الهائل الجاري في كتاب الكون الكبير بدءًا من الذرات وانتهاء بالمجرات، ولم يعيروا بالًا للعلة الغائية للوجود، بل إنهم لم يأتوا بشيء يُذكر سوى التعبير عن أمور تافهة بكلمات مزخرفة.
وليس المعري بأقل حظًّا من المتنبي في باب الإتيان بالادعاءات الفارغة والتشدق بالكلام والتشاؤم والقنوط، فهذا الرجل التعيس الذي تذخر أشعاره من أولها إلى آخرها بلوحات من المداهنة والمديح والهجاء قد دأب على الحديث عن الليالي المظلمة، وليس من المتوقع من أمثال أصحاب الأرواح المظلمة هؤلاء أن يُعبّروا عن أحاسيس الإنسانية وأفكارها وتصوراتها ونواياها وأهدافها، وليس من الممكن قطعًا لهؤلاء البؤساء الذي انغلق عالمهم الروحي تجاه النسمات الإلهية الغيبية أن يقولوا شيئًا حول التكوين الروحي والقلبي واللدني لبني الإنسان، وأن يسردوا أفكارهم حول هذه الأمور في تناغم وانتظام وانضباط، وأن يضعوا أمام الأفراد والمجتمعات أهدافًا وغايات سامية، في حين أن هذه قضايا مهمة وهي من الأمور الأساسية التي تناوَلها القرآن الكريم، فشرح بها الصدور.
ومن حيث إن هذا الموضوع ليس مما نحنُ بصدد الحديث عنه فإننا لن نخوض فيه بل سنتطرق إلى نقطة وننهي الموضوع.
فلو تم استعراض كل الكتب والمؤلفات نظمًا ونثرًا، واجتمعَ كلُّ أساتذة اللغة على أن يأتوا بمثل القرآن، لن يستطيعوا أن يأتوا بما يضاهي سورة واحدة بل آية واحدة منه، فكما أن هذه الحقيقة كانت ثابتة في الماضي والحاضر، فكذلك ستكون في المستقبل أيضًا، فإن القرآن رغم أنه تحدى بذلك قبل أربعة عشر قرنًا، لم يكن هناك من تصدّى لمجاراة هذا التحدّي: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/23-24).
ولا بد لي أن أنبه هنا إلى أن أمثال المتنبي والمعري ممن حاولوا أن يأتوا بما يشبه القرآن لم يقولوا يومًا ما بأن ما قالوه يُشْبه الوحي، بل غاية ما فعلوه أنهم حاولوا أن يقولوا أشياء عَجَزَ عنها غيرُهم.
وهناك أمر آخر وهو أن مئات الآلاف من الأصدقاء والأعداء لم يزالوا يقتبسون من القرآن ويستفيدون منه في نظمهم ونثرهم حتى يزيدوا من جمال قولهم وتأثير كلامهم، وهذا يدل على أنه لا يمكن الاستغناء عن تعابير القرآن وأسلوب بيانه الآخذ بالألباب.
والآن دعونا نرجع مرة أخرى إلى تفسير الآية الكريمة فنقول: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ أي بما أنكم لن تستطيعوا بالفعل أن تأتوا بكلام يماثل سورة بل آية منه، فلا أقل أن تعرفوا حدكم وتُفكروا في عاقبتكم ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/24).
وكما يُفهم من الآية تحديها لكل أحد، يفهم منها أيضًا الإيماء إلى ما يلي:
إنكم لستم حجارةً أو حطبًا، بل أنتم “بشر” ذوو شعور وإدراك وإحساس وقلب، وبالتالي فعليكم أن ترجعوا إلى صوابكم، وتُفكّروا جيدًا، تفكروا حتى لا تتحولوا بسيرتكم إلى حجارة أو حطب فتصيروا وقودًا لنار جهنم، وحاوِلوا أن ترتقوا في إطار مواهبكم إلى سماء الكمالات الإنسانية، واعلموا أيضًا أنه لن يكون للقرآن مماثل ولن يمكن الإتيان بنظيره؛ فلا تُتعبوا أنفسكم من دون جدوى في سبيل الإتيان بمثله، وإن الله منحكم العقل وحباكم بوصف الإنسانية حتى تُطوِّروا شعوركم ومواهبكم، فلا تلقوا بأنفسكم في مهاوي أسفل السافلين.
ومن جانب آخر، ينبغي التنبه لما يلي:
1- لا بد للتعرف على [إمكانيةِ أو عدم إمكانية] الإتيان بنظير للقرآن من الوقوف -ولو قليلًا- على اللغة العربية إضافة إلى التمتع بالذوق الأدبي والمعرفة بدقائق التعابير، ومعرفةِ الفصاحة والبلاغة والإعجاز ونحوها، فمن ليس له باع في دقائق هذا الباب وليس له تراكمٌ معرفي، فلن يَفهم ما يقال حوله بمجرد الاكتفاء بالسماع عن أصحاب الشأن في هذا الموضوع، فمن لا يثق بما يقوله العلماء في هذا الباب فعليه أن يتولى أمر البحث فيه بنفسه، والذين يُدْلون بدلوهم في الموضوع ويجازفون بالقول في القرآن من دون التمتع بتلك الآليات ومن دون إدراك كنه القضية فليس لقولهم أية قيمة علمية، وليس لهم حق وصلاحية في الحديث حول هذا المضمار.
2- وهناك في الآيتين (23-24) من سورة البقرة نقطتان تستدعيان التوقف عندهما والنظر فيهما.
أُولاهما: قوله تعالى: “نَزَّلْنَا” حيث أسند الله تعالى الإنزال إلى ذاته مبيّنًا أن هذا القرآن إنما هو منه.
وثانيتهما: قوله تعالى: “عَلَى عَبْدِنَا” حيث ركز على عبودية النبي لله تعالى.
أجل، إن كل شيء منسوبٌ إليه فإذا قُطِعَتْ نسبة القرآن وصاحبِه عن الله فقد ضاعت عنهما ما يتمتعان به من ذلك الموقع السامي، فمثلًا: إذا قال أحد الباحثين “لنعتبر هذا القرآن من كلام البشر وبعد ذلك لنبحث فيه وكأنه من كلام البشر” أو قال: “لنتاولْ الموضوع بموضوعية وحيادية”، فهذه وغيرها إنما هو من هراء الكلام وليست إلا من باب خداع المرء لنفسه؛ فكيف يمكن له تفسير القرآن إذا لم يسند إلى الله؟! وكذا الرسول إذا لم يُعتَبر على أنه عبد الله ورسوله فكيف تُفسَّرُ شجاعته الفائقة وصبرُه الخارق، وحلمُه وعرفانُه، وجوامع كلِمه وبيانه، وأطواره وحركاته الآخذة بالألباب، وفتحه للقلوب من أول نظرة، وإرادته الصامدة وفراسته المذهلة، وعصمته وفطنته.
وموجزُ القول: كما سبقَ وأسلفنا؛ إن كل شيء له تعالى، ولا بد أن يُنسَب إليه؛ لأن كتاب الكون الكبير هذا الذي هو ميدانٌ لأنواع الجمال لا يظهر بمحض الصدفة، وإنما هو من صنعِ ذي الجلال الذي هو قادر على كل شيء، وبالتالي ينبغي لنا أن لا نتورّط في الخطإ الذي سقطت فيه مقاربات الفلسفة الوضعية والعقلانية التي قَطعت نسبة الأشياء عن الله وسلكت سبيلَ الإلحاد في عصرنا، بل إننا إذا تناولنا القرآن وصاحبَ القرآن بالبحث فعلينا أن لا ننسى أنه “كلام الله” وأن سيدنا محمدًا هو رسوله.
وهناك أخبار غيبية غير مقيدة بزمان بعينه هو ما تشير إليه هذه الآية الكريمة: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (سورة غَافِرٍ: 40/77).
ففي هذه الآية الكريمة نوعُ تسليةٍ من الله تعالى للرسول من جانبٍ، ومن جانب آخر يخبره تعالى بأن ما يعانيه من المصائب لن يذهب سدًى، ويوصيه بالصبر على ما أصابه ويخبره بقوله ﴿إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ﴾ بأن مقصوده سيتحقق لا محالة.
والآن تعالوا بنا نتصور في عالم خيالنا إنسانًا، ظهر في جماعة مشتّتة قد انفرط عِقدها، ويكاد يتحدّى جميع البشرية وحده، وجاء بأفكارٍ جديدةٍ تمامًا وطرحها في هذه الحقبة المليئة بالفساد والتخبّط، ثم جعلَ يتحدث عن التخطيط لبعض التحولات الحيوية على مستوى العالم، ويحاول أن يقنعهم بجدوى مبادئ هذه التحولات، ولكن عدد المقتنعين به قليل جدًّا، بل إن طائفة من أفراد هذا المجتمع بينما تسُودهم السفاهة والانحطاط الأخلاقي، هناك طائفة أخرى منهم يذبحون قرابين للأصنام ويستمدون منها العون، ولقد سادت الرزائل والمنكرات إلى درجةِ أن الناس كانوا يطوفون بالكعبة عرايا… فما أعمى أولئك الذين لا يأبهون بجهود هذا الإنسان الذي كان يواصل مسيرته في خضم آلاف من تلك الخرافات المرتكبة باسم الدين!
ففي تلك البيئة المظلمة التي رسمناها وصورناها بزغ الرسول مثل الشمس، وأخذ يقدم لهم أرقى دساتيرِ حياةٍ لا يستطيع أن يتمثلها إلا أناس من أهل الجنة، وفي هذه الحقبة لم يكن من المتوقع أن تتقبّل الإنسانية الغارقة في السفاهة هذه المبادئَ بقبول حسن، ولكن عناية الله كانت خلف سيد الأنبياء، فبها استطاع أن يبين الحق والحقيقة لهؤلاء المُوغِلين في السفاهة في زمن قصير جدًّا، وأن ينجح في هدايتهم إلى الله تعالى، ولم يكن بيده إلا القرآن الكريم.
أجل، إن خطّة شمس الهداية هو القرآن، ولم تكن له تسلية وحل للمعضلات إلا في القرآن، وكلما كان يتعرّض لشتى ألوان الأذى والاضطهاد في سبيل بيان طرق الخلاص لبني البشر، وكلما كان ينكسر قلبه ويحزن، كان يلتجئ إلى الله، وبفضل ذلك كان يصمد ويحافظ على الأمل، وفي ذلك خاطبه الله تعالى واعدًا إيّاه بالتأييد والنصر قائلًا: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (سورة غَافِرٍ: 40/77).
فقوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ﴾ يشير بطريقة غيبية ضمن ما يشير إليه إلى أن رسالة النبي ستصل إلى شتى بقاع المعمورة خفاقةَ الراية، وأنها ستكون حاكمة على الناس بفضل الله وعنايته، وأنّ أنفاسَ الأمة المحمدية ستصلُ إلى كل مكان من شرقي الأرض وغربيها، وأن أسسَ الدين الإسلامي المبين ستُستقبَل بالاحترام في كل مكان، وأن القرآن الكريم ستلهج به الألسنة وتأخذ به الأيدي وتحتضنه القلوب وسيحترمه الجميع وسيتسابق الناس في فهمه واستيعابه، وغير ذلك من الأمور.
وقد بشر الله تعالى رسوله بهذه البشارة في الظروف التي كان فيها محاطًا بألف لونٍ ولونٍ من المخاطر والمهالك، ولم يكن حاصلًا على دعم أحد من الناس، وما كان لأحد أن يصدِّق حتى بمجرّدِ احتمال تحقُّق هذه الوعود في تلك الأيام، ولكن الله قال لرسوله: ﴿فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (سورة غَافِرٍ: 40/77)، فهذا يحتمل أمرين: أحدهما: هو ما يتبادر إلى الذهن من كون “أو” لأحد الشيئين، وثانيهما: أن تكون “أو” بمعنى الواو فيكون المعنى: سنريك بعضًا من الأمور التي نعدهم بها وسنتوفاك من قبل أن ترى كل الذي نعدهم.
وبالفعل فقد ظهرت بعض هذه الأمور التي وعد الله بها رسوله وهو لا يزال على قيد الحياة، في حين أن البعض الآخر قد تحقق بعد التحاقه بالرفيق الأعلى، فقد رأى في عهده فتح مكة، ومحاربة المسلمين للروم، ودخول مختلف القبائل في دين الله أفواجًا، لكنه لم يشاهد وقائع العهد الأموي والعباسي والسلجوقي والعثماني، إلا أنّه اطّلَع عليها بروحانيته.
وكان سيدُ الأنبياء يحمل على عاتقه مهمة كبرى، ألا وهي الرسالة، وكان مرتبطًا من كل قلبه بقضيّته الكبرى هذه، ولقد وعده الله بصورة غيبية بأن يطلعه على بعض الأمور، وقد كان الله يريه كل ما وعده به في أوانه، وبهذا كان يبعث الانشراح في صدره، وقد خرج المسلمون مع الرسول قبل الحديبية بنيّة أداء العمرة، ولكن قريشًا لم تكن تنوي إعطاءهم هذه الفرصة، ولما سمع مفخرةُ الإنسانية أن الكافرين لن يسمحوا لهم حتى بطواف الكعبة الذي هو من حقوقهم ومَطالبهم الطبيعية، بل وأنهم قد يستخدمون السيف للحيلولة دون ذلك، قال: “يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ، لَقَدْ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ، مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ، فَإِنْ هُمْ أَصَابُونِي كَانَ ذَلِكَ الَّذِي أَرَادُوا، وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَافِرِينَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ، فَمَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ، فَوَاللهِ لَا أَزَالُ أُجَاهِدُ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللهُ بِهِ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَة”، (يقصد: الموت) .
ففي هذه النقطة بالذات إذا نظرنا إلى موضوع الحديبية من منظور قوله تعالى:
﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (سورة غَافِرٍ: 40/77)، فسيتبين لنا أن من بعض الأمور التي وعد الله بها رسوله في هذه الآية هو فتح مكة الذي تَحقَّق بعد الحديبية بعامين.
وأريد أن أختم حديثي حول ما ورد في القرآن من الإخبار عن الأمور الغيبية المطلقة التي لم تقيّد بزمان، بما ورد في سورة النور، وهو قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورة النُّورِ: 24/55).
فقد وعد الله تعالى في هذه الآية المؤمنين بوعود ستُحَقَّق قطعًا، بشرط الإيمان والعمل الصالح، وهذا الوعد باقٍ من لدن عصر الرسول إلى قيام الساعة، إلا أن الإيمان والعمل الصالح على مستوى الفرد أو المجتمع لا يكفيان لتحقق هذه الوعود بل هناك تأكيدٌ أيضًا على أساسيات أخرى كالقيام بالعبودية من دون الإشراك بالله، وعدم الكفران تجاه الحقّ.
فالله بقوله: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ قد وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأنه سيجعلهم حكامًا على وجه الأرض مثل ما يسَّر ذلك لسيدنا داود وسليمان.
فإذا رجعنا إلى الوراء ولاحظْنا الظروف التي نزلت فيها الآية لوجدنا أنه لم يكن يبُلُّ تلك القلة المؤمنة قطرة من المطر، ولم يكن ينبت على وجه الأرض نبتة، وكانت القلوب قاسية جامدة وكأنها صخور صماء، وتتابعت ردات الفعل ضد القرآن، وكان النبي وأمته يعانون شتى ألوان الظلم والضيم، مما يعني أن نزول الآية -بمثل هذا الوعد في ذلك المناخ الذي لم تكن فيه أيّةُ أمارة- يبعث على الأمل.. وبنفسِ الملاحظةِ ندركُ أنَّ تحقق مثل هذه الوعود كان -حتى- في نظر بعض المؤمنين من باب المستحيلات؛ لأنه لم يكن هناك أي بصيص من نور الأمل.
فهذه الوعود في مثل هذه الظروف كانت بالنسبة للمؤمنين الحقيقيين بمثابة خبر غيبي يبشّر بالفوز والفلاح، فالله سيُحقق وعده هذا للمحظوظين الذين سيَخلُفونهم
في المستقبل، وسيُعلن على الملإ كيف أن القرآن يتحدى الزمان والعصور.
ومن جانب آخر تُواصل الآية وعودها بقوله تعالى: ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ (سورة النُّورِ: 24/55)، وهذا يعني أنه سيحقق الثبات لهذه المبادئ التي ارتضاها للمؤمنين وسيحفظها من كل أنواع التغير والفساد والانحطاط، وسيَترسخ الدين ويضرب بجذوره في القلوب المؤمنة ويتحكّم في سير حياتهم.
وفي الحقبة التي أخبر القرآن بهذا الأمر بصورة غيبية لم يكن الدين قد تمكن واستقر في حياة الأفراد والمجتمع، فلو كان المؤمنون يسمعون هذه الوعود في تلك الأيام التي كانوا يعيشون أضعف الأحوال فيها من غير القرآن؛ لكان من الصعب على كثير منهم
أن يصدِّق بها.
ويخبر الله بقوله ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ بطريقة غيبية أنه إذا استقرّت المشاعر الدينية على وجه تام في قلوب أي مجتمع فإن الأمن سيستقر في ذلك المجتمع بشكل تلقائي، ولن يَبقى أي خوف في قلوب ورؤوس أولئك الذين تفيض قلوبهم بالإيمان، وسيقوم الجميع بالعبودية لله من صميم القلب.
أجل، إن الآية الكريمة تعِد المؤمنين على وجه صريح بوراثة الأرض.. ولكن لن يكون من الصواب قطعًا فهمُ هذه الحاكمية التي وعد الله بها على أنها مجرد حاكمية وسلطنة مادية يتحكّمون بها في الناس ويعاملونهم معاملة العبيد والخَوَل، كيف والحاكمية الموعود بها في الآية الكريمة تستتبع مسؤوليات كبيرة جدًّا؛ فإنها تقتضي من المسلمين أن يكونوا عنصر توازن على وجه الأرض بحيث إن حاكميتهم هذه تضمن لكل الناس السكينة والطمأنينة في ظلها، ويرقى المسلمون إلى مستوى الحَكَم بين سائر الأمم والدول، وبذلك يستقر الصلح والسكون على وجه المعمورة، بكبح المجموعات التي تتسبب بالبلبلة والإرهاب، وإنذار البغاة وتأديبهم، والقضاء على كل ما يخل بسعادة بني الإنسان.
فنلاحظ أن القرآن الكريم قد وعد بهذا في حقبة لم تتشكل بعدُ فيها دولة إسلامية بكل وحداتها، ولكن الله تعالى قد حقق وعده هذا ابتداءً من زمنِ رحيل سيد الأنبياء مباشرة ووفَّقَ المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين ليتمَثّلوا تلك الحاكمية في بقاعٍ مهمة من الأرض على المستوى المطلوب وعلى الوجه المذكور في القرآن.
فالأمر المهم الذي ينبغي التركيز عليه في هذا الباب هو حاكمية الحق، ولو نظرنا إلى تلك الفترة التي نزلت فيها هذه الآية الكريمة لوجدنا أن تحقُّق هذه الأمور ما هو إلا من الأمور المستبعدة التي تدخل ضمن المستحيلات، ولكن في الفترات اللاحقة بل و-حتى- في أيامنا هذه قد تأصل الدين واستقر في القلوب بحيث لا يمضي يوم إلا ويهتدي أناس إلى الإسلام، وهذا يجعل المسلمين يعيشون فرحة كتلك الفرحة التي كان يعيشها المسلمون في عصر الرسول.. بل إنك لتلاحظ أن القلوب المؤمنة في أيامنا هذه تُحاول أن تتبع خُطَى الرسول بكل عشق وشوق وتتحرى سننه في تفاصيلها ودقائقها، حتى في الأمور التي ليست هي من قبيل الفرائض والواجبات كأكله وشربه ومشيته وتعامله مع الناس.
والحق أن الدين كما كان في السابق؛ قد أخذ -بفضل الله وكرمه- يترسخ في القلوب في عصرنا أيضًا، ونحمد الله تعالى حمدًا لا نهاية له على أن جذوة الشوق والحماس التي كانت تشتعل في نفوس المؤمنين في العصر النبوي السعيد بدأت تتّقد في عصرنا هذا مرة أخرى، وأصبح هذا المشهد الذي يبشر بالأمل يثلج الصدور التي تعاني من حر نار الهجران والحرمان، وأخذ الخبر الغيبي الذي جاء به قوله تعالى: ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ (سورة النُّورِ: 24/55) يتكرر مرة أخرى على مراحل.
روى الخباب بن الأرت أن المسلمين لم يكن لهم في مكة مأوى يلجؤون إليه واضطروا للهجرة إلى المدينة المنورة. أجل، إنهم قد هاجروا ولكنهم كانوا لمدة طويلة يحملون في المدينة أيضًا بين جوانحهم نفس المخاوف، فالكفرة الفجرة الذين يحيطون بهم، والمنافقون الذين يعيشون بين أظهرهم كانوا من بواعث القلق لهم، وكان جل المسلمين لا يبيتون إلا في السلاح، ولا يصبحون إلا فيه، فلما بلغت الضغوط والشدة أقصى حدود التحمل جاء الصحابة يومًا إلى الرسول فقالوا له: يا رسول الله، أليس لهذه المخاوف نهاية؟ فقال لهم رسول الله: “اِصْبِرُوا فَإِنَّ اللهَ سَيُذْهِبُ هَذَا الْخَوْفَ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِه” .
ولست أدري كيف كان رد فعل الناس تجاه هذا الخبر الغيبي الذي كان من الصعب التصديقُ به في جو تلك الفترة التي طغت فيها الوحشية واستفحلت، ولكن الواقع أنه تحقق هذا الأمن في عهد سيدنا أبي بكر وعمر، ونعتقد أن الله تعالى كما رزق مسلمي ذلك العهد الأمنَ فسيرزقه هذه الأمة بمشيئته مرة أخرى، فالمفهوم من هذه الآية الكريمة هو أن هذا الأمر باق بالنسبة لكل المسلمين إلى قيام الساعة، ويدلّ قوله تعالى في سياق الآية: ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ (سورة النُّورِ: 24/55) على أن الأكثرية على وجه الأرض ستعبد الله تعالى.
فإذا استطعنا أن نذهب بخيالنا -ونحن نتدبر هذه الآية الكريمة- إلى العهد المكي، فسنلاحظ أنه كان يوجد في الساحة عددٌ كبير من الأصنام، وكل قبيلة كانت تعبدُ أصنامها، وأصبح المجتمع ضحية الفوضى، وتحكمت الوثنية في القلوب والعقول، فقدَّم الناس للأوثان القرابين واستمدوا منها العون والمدد، وراجت العقائد الباطلة في كل مكان.
كما أننا إذا تناولنا هذه الآية الكريمة من منظور عصرنا هذا فسنرى الجانب الإعجازي الفريد للقرآن الكريم؛ فإن هناك، على الرغم من كل شيء، الملايينَ من الناس يعبدون الله، ويطيعونه بالمعنى الحقيقي ويجتنبون الشرك ويتوجهون إليه تعالى بخالص النية، مصداقًا لهذه الآية الكريمة.
فكما أن المسلمين الأوائل تحفزوا عندما طرقت هذه البشارة الكريمة سمعهم؛ فإن الذين جاؤوا من بعدهم في عهد عمر وفي العهد الأموي والعباسي توسعوا في الفتوحات وامتد انتشارهم من الجزيرة العربية إلى القارة الإفريقية وربوع آسيا وحققوا تلك البشارات التي أخبرت بها -بشكل غيبي- هذه الآيةُ الكريمة وكذلك آياتٌ أخرى غيرها، فأصبحوا عنصرًا مهمًّا في التوازن الدولي.
فكل هذه الآمور تدل على أن القرآن الكريم كتاب غيبي فريد لا يدانيه أو ينافسه أي كتاب آخر.
أجل، إنه يجعل كل الأدوار والعصور تصدقه فيثير الإعجاب في العقول، ونأمل أن يتوجه العالَم مرة أخرى إلى هذا الكلام المعجز الذي يلبي كل آماله وتطلعاته، حتى تصل الإنسانية مرة أخرى بطريق مباشر إلى منبع السعادة الأبدية هذه، فالإنسانية في وضعها الحرج هذا لهي في أمس الحاجة إلى روحانيته ونسماته التي تبث الحياة.
هـ. الأخبار الغيبية المتعلقة بالأشخاص
لقد تحدث القرآن الكريم -ولو بالتعريض- عن عاقبة بعض الأشخاص، وحينما حان الموعد تحقّق ما أخبر به في حق هؤلاء الأشخاص تمامًا كما أخبر.
أجل، إذا كان القرآن قد حكم على شخص بأنه “كافر”، فمعنى ذلك أن هذا الشخص قد قضى عمره كلّه في الضلال، وإذا كان قال في حقِّ شخص: “إنه من أهل النار” فهذا يُبيّن أنه قد واصل حياته كلها على ذلك الخطّ وسار نحو عاقبته المشؤومة، فمن هؤلاء من لم يبقَ بينه وبين الإيمان من المسافة إلا مقدار خطوة واحدة ولكنه انجرف بكبره وغروره وحبِّ المنصب وما أشبه ذلك، فاختار طريق الكفر والضلال ورحل عن هذه الدنيا على الشكل الذي أخبر به القرآن.
ويجدر أن نزيد الموضوع وضوحًا عن طريق بعض الأمثلة:
يذكر المفسرون أن من الأشخاص الذين تحدث عنهم القرآن الكريم الوليد بن المغيرة، فقد كان له عدد كبير من الأولاد بالإضافة إلى ما يملكه من المال والثروة، وكان قد تربى في طبقة أرستقراطية، وكان له نصيب من الأدب والمعرفة التي تتمتع بها تلك الطبقة؛ لذلك فقد كان يجيد فنّ الخطابة، ويَلقَى قبولًا في كل الأوساط.
وقد لقي الوليد بن المغيرة الرسول في بدايات نزول الوحي وسمع منه القرآن، ولأنه كان ذا ذوق أدبي فقد تأثر بالقرآن تأثُّرًا كبيرًا أدرك من خلاله أنه ليس بكلام بشر.
نعم، إنه أدرك ذلك ولكنَّ كبره وغروره حَالَا بينه وبين الإسلام، ورغم أن هذا التعيسَ غُلب أمام كبره وغروره فقد أنصف القرآنَ في أول وهلة، حيث روي أنه قال:
“والله لقد سمعت من محمد آنفًا كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى عليه”.
ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: صبأ والله الوليدُ، وهو ريحانة قريش والله لتصبأن قريش كلهم، فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه، فانطلق فقعد إلى جنب عمه الوليد حزينًا، فقال له الوليد: ما لي أراك حزينًا يا ابن أخي؟ فقال: وما يمنعني أن أحزن؟ وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد وأنك تدخل على ابن أبي كبشة وابن قحافة لتنال من فضل طعامهم، فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أني مِن أكثرها مالًا وولدًا؟ وهل شبع محمد وأصحابه ليكون لهم فضل؟ قال أبو جهل: فقل فيه قولًا يبلُغ قومَك أنك منكر له أو أنك كاره له، فقام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم: تزعمون أن محمدًا مجنون، فهل رأيتموه يحنق قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كاهن، فهل رأيتموه تكهَّن قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئًا من الكذب؟ قالوا: لا، فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو إلا ساحر: أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، فهو ساحر، وما يقوله سحر يؤثر، فذلك قول الله في سورة المدثر: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ (سورة الْمُدَّثِّرِ: 74/18-19) .
إن إصرارَ الإنسان وعنادَه في الكفر على الرغم من قربه من القرآن بهذه الدرجة وإدراكِه لمعناه ومحتواه وشعورِه بأنه كلام مقدس، يُعتبَر انحرافًا وكبرًا وظلمًا تجاه الحقيقة، مما جَعل القرآن يَعتبره في عِداد المحكوم عليهم بالإعدام الأبدي، فَرَسَم تصرفاتِه الكافرة والظالمةَ، وسوءَ عاقبته قائلًا:
﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ (سورة الْمُدَّثِّرِ: 74/18-26).
ويمكن أن نفهم من هذه التعبيرات ما يلي:
1- إن هذا نوعٌ مختلف من السحر، يفوق تأثيره كافة أشكال السحر.
2- إن لسحر القرآن تأثيرًا على الإنسان لا تُدرَك ماهيته.
فيمكن أن يُفهم من هذه التعبيرات القابلة لتفسيرات مختلفة ما يلي: إن الوليد بن المغيرة رغم أنه يقول لمن حوله بأن القرآن سحرٌ، إلا أنه يعلم جيّدًا أنه ليس بسحر، ومن المحتمَل أنه بهذه التعبيرات أراد أن يقول، في معرض الحديث عن تأثير القرآن، إنه يؤثر في الناس مثل السحر، وليس هذا إلا إخبارًا عن واقع الأمر.
وهذا يشبه صنيع بعض الملحدين في عصرنا هذا، حيث إنهم يتغاضون عن تصرفات الله تعالى المذهلة في الكون، ويحاولون أن يسموا الكائنات والأحداث بأسماء فنية من منطلق علمي، وكأنهم يقومون بتفسير كل شيء عن طريق هذه التعريفات والتسميات. فمثلًا: إن كل ما في الكون من الكُتَل تتجاذب فيما بينها، وهذه الجاذبية تتناسب طرديًّا مع مقدار حجم الأجسام، وعكسيًّا مع مربع ما بينها من المسافة، وبالتالي فإن الكتلة الأرضية والشمس تتجاذبان فيما بينهما، وبسبب هذه الجاذبية تدور الأرض حول الشمس وكأنها مقلاع، وتسمى هذه الظاهرة في لغة الفيزياء بـ”قانون جاذبية نيوتن”.
فمثل هذه المقاربات لا تتعدى أن تكون تسمية لهذه الظاهرة، ومن البين أنه لا يمكن فهم هذه الظاهرة التي لم يتحقق الكشف عن ماهيّتها بحقّ، ولا يمكن إدراكها بمجرد وضع اسم لها، ولم يزل هناك من الظاهريين من انخدع بهذا الصنيع.
ولكن ما ينبغي فعله هو الإتيان بجواب معقول حول ذلك الخالق الذي أوجد قوة الجاذبية هذه من العدم، وإذا كانت هذه الجاذبية موجودة قبل أن يُخلق الإنسان بمليارات السنين، فهذا يعني أن الخالق لها ليس هو نيوتن أو أي إنسان آخر، إذًا الذي خلق الكون بما فيه قانون الجاذبية هو الله سلطان الأزل والأبد، وليست مهمة الإنسان إلا أن يكتشف هذا القانون ويفهمه ويستفيد منه.
أجل، إن الجاذبية هي أيضًا من ضمن القوانين التي خلقها الله وأودعها في الكون وإن الذي يجعل هذه الكرة الأرضية الجسيمة تدور حول الشمس وكأنها حجرٌ في مقلاع، هو أيضًا الذي ربط كل ما في الكون من أشياء وأحداث ببعض القوانين والمقررات والمبادئ حتى تجري الأمور في نظام وتناغم، فمثلًا: إن الكرة الأرضية، شأنها شأن سائر الكواكب، تدور حول الشمس مثل عقارب الساعة بل أدق منها، بشكل بيضاوي، فلو تخيّلنا أن هناك خيطًا يربط بين الأرض والشمس لوجدنا أنه يمسح مساحات متساوية أثناء حركتها بفواصل زمنية متساوية، وهذا هو قانون “كبلر”.
وأيضًا فإننا حينما ننظر إلى الشمس في إطار هذه القوانين العامة نلاحظ أن الشمس كتلةٌ ناريّة هائلة درجة حرارة سطحها حوالي (6000) درجة بمقياس الحرارة على وجه الأرض، وأما أقسامها الداخلية فتفوق حرارتها خمسة عشر مليون درجة.. وهي تعمل بشكل دؤوب كمُفاعِل “هيدروجين-هليوم” عملاقٍ، فتجتمع فيها أربع ذرات من الهيدروجين لتتحول إلى ذرة هليوم واحدة، إلا أن أربع ذرات من الهيدروجين أثقل من ذرة هليوم واحدة ولذلك فيتحول ما زاد من المادة إلى طاقة، وهكذا ففي كل ثانية يتحوّل 564 طنًّا من الهيدروجين إلى 560 طنًّا من الهليوم، وما زاد من 4 أطنان من المادة فهي تنتشر في الفضاء على شكل حرارة وَضَوء، وفي أثناء هذه العملية لا تلتقط الكرة الأرضية من هذه الطاقة المنتشرة إلا مقدار اثنين من المليار، علمًا بأنها لو التقطت ثلاثة بالمليار مثلًا لانقلبت الحياة على وجه الأرض رأسًا على عقب.
وإذا كان من الأمور المهمة اكتشافُ قانون الجاذبية العامة، ودورانِ الكرة الأرضية بشكل بيضاوي، وكونِ الشمس مُفاعل هيدروجين وهليوم، وربْط هذه الأمور بقواعد ومبادئ فيجب التركيز على أمر آخر وهو التعرف على الخالق الذي أوجد هذه القوانين من العدم، وجَعَلها ملائِمة لحياة الإنسان، وقدَّمها لخدمته، وإذا لم يُعرف ذلك فلن يكون الكون إلا عبارة عن الفوضى.
فقول الوليد بن المغيرة: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ (سورة الْمُدَّثِّرِ: 74/24) هو إخبار عن واقع أكثر من كونه تفسيرًا للحقيقة، وإلا فلا مجال لتفسير ظاهرة القرآن بالسحر، وعلى الرغم من اقتراب الوليد من الحقيقة بشكل كبير، وإدراكه بأن القرآن ليس من كلام البشر؛ إلا أن كبره وغروره غلباه، شأنُه في ذلك شأن الذين يُسنِدون النواميس الجارية في الكون إلى الأسباب على الرغم من إدراكهم بأن الذي خلقها هو الله، فادعى أنه كلام البشر، فنكص على عقبه بعد أن لم يكن بينه وبين ساحل السلامة إلا خطوة واحدة، ولذلك قال الله فيه: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ (سورة الْمُدَّثِّرِ: 74/26).
وإخبار القرآن في هذه الآية وأمثالها عن دخول أشخاص معينين النار يدل على أنهم بإرادتهم لن يؤمنوا.
وأود أن ألفت الأنظار هنا إلى أمر آخر: وهو أن كثيرًا من أمثال الوليد من الكفار المعاندين، عارضوا القرآن بل أعلنوا عليه الحرب، إلا أن القرآن لم يخبر بأن هؤلاء الكفار سيدخلون النار، فدخلوا في الإسلام واحدًا تلو الآخر، منهم أبو سفيان الذي كان في بدايات أمره من ألد أعداء الرسول، ومنهم أيضًا خالد بن الوليد بن المغيرة، كما أن منهم أيضًا عمرو بن العاص الذي كان كثيرًا ما يُحرج المسلمين بما يتمتع به من الدهاء السياسي والدراية والخبرة والذكاء، أما الوليد بن المغيرة الذي أخبر عنه القرآن بأنه سيصلَى سقر، فلم يؤمن وظلَّ على كفره وضلاله إلى آخر لحظة من أيام عمره، وبذلك أصبح مصداقًا لما أنبأ به القرآن من الخبر الغيبي.
والسورة المتعلقة بأبي لهب وأم جميل هي أيضًا تحمل رسالة تنبئ عن سوء عاقبةٍ على غرار حال الوليد بن المغيرة، وتَعْرِض للأنظار وضْعَ هذين التعيسين، وقولُه تعالى: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ (سورة الْمَسَدِ: 111/3-5) هو شهادة غيبية بشكل صريح في حق أبي لهب وأم جميل أنهما أيضًا لن يؤمنا طوال حياتهما وأنهما في نهاية المطاف سيدخلان النار.
وعلى الرغم من أن أبا لهب وزوجه كانا من أسرة قريبة من الجو النبوي الذي يبعث الحياة في النفوس، إلا أنهما كانا من الشقاء بحيث إنهما لم يستفيدا من مفخرة الإنسانية، علاوة على أن ابنيهما عتبة وعتيبة اللذين كانا متزوجين بابنتيه تأثرا بوالديهما، وظلا يحملان تجاهه مشاعر عدائية، بل وصل الأمر إلى أن بلغت الوقاحة وقلة الأدب بعتيبة إلى أنه كلما اتسعت دائرة الذين يدخلون في الإسلام، -وبالأخص لما شعر بأن زوجه أسلمت- زاد وقاحة وسُعارًا، وأخيرًا أخذ بيد زوجه يجرّها إلى أن أتى إلى مجلس سيد الأنبياء قائلًا له: ها هي ابنتُك، أنا أطلقها.. فقال له النبي -برخصة من الله-: “سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكَ كَلْبًا مِنْ كِلَابِهِ”، وبذلك أشار إلى عاقبته الدنيوية، ولما سافر بعد مدة إلى اليمن ضمن قافلة، أقبل أسدٌ إلى القافلة وافترسَ عتبةَ من بين سائر الموجودين في الرَّكْب أثناء الاستراحة، وبذلك تحقّق ما أخبر به الرسول، وأما عتبة فإنه قد نال سعادة الدخول في الإسلام بعد فتح مكة .
أجل، إن القرابة الجِبِلِّيَّة، حتى مع الرسول لا تكفي للخلاص من العذاب الإلهي؛ إذ لو كانت كافية لنجا أبو لهب وزوجه، فأبو لهب كان عم الرسول، وما يدريكم فقد يكون احتضن النبيَّ في صغره، كما أن أم جميل كانت زوج أبي لهب هذا، وهؤلاء رغم قرابتهم للرسول، لم يستفيدوا من تلك القرابة، لأنهم كانوا بعيدين عن الله فلم يهتدوا ولم يسلكوا سبيله الذي يؤدي بهم إلى النجاة.
وأظن أن الأمر الملفت للنظر هنا هو أنه كان في ذلك الوقت كثير من الكافرين والظالمين الذين لم يألوا جهدًا في إيذاء الرسول، إلا أن أبا لهب صار هو المقصود بالآية فلا بد أن يصيبه وعيد القرآن.
ويمكن أن نورد في تفصيل هذه الأفكار النقاط التالية:
1- إن عدم تفلُّت عم الرسول بالذات من وعيد القرآن كان تأثيره أكبر لدى الرأي العام؛ لأن ذلك من شأنه أن يسد الباب أمام من يظن أن الرسول يحابي أقرباءه، فيكونُ ذلك من باب التأكيد على أن جميع الكفار سواسية، وهذا يدل على أن سيد الأنبياء قد عُصم مما يؤدي إلى إثارة الشبهة حول الرسالة والوحي.
2- إن الله بيّن في سورة المسد بشكل صريح أن أبا لهب وزوجه سيدخلان النار، وهذا تحدِّ من القرآن لهم، ففي تلك الفترة التي كان المسلمون ضعفاء من حيث الكمية وكان الكفار يمارسون الضغوط على المسلمين بكل ما يملكون من قوة، تحداهم القرآن على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفة غيظ الأعداء وكراهيتهم، إلا أن القرآن بارزهم وتحداهم بهذا الشكل، وذلك خير دليل على أنه ليس من كلام البشر، وأن الذي جاء ليُبَلِّغه واثقٌ من نفسه بأقصى درجة، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتلك الفترة الحرجة.
3- إنّ تعرُّض أقرباء الرسول للوعيد، وتهديدهم بالعذاب الإلهي، والتصريحَ بأسمائهم يضاعف أهميةَ هذا الموضوع؛ لأن الرسول كان قد بدأ بأقربائه امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/214)، ذلك لأنهم كانوا أعرف الناس بطبائعه الأساسية وبتكوينه الروحي والقلبي، فقد نشأ بين أظهُرهم وترعرع على مرأى ومسمع منهم، فكانوا هم الذين أذاعوا للعالم مدى سموِّ أخلاقه، وفطرته المنفتحة على المعالي، وشخصيته البارزة في شجاعته وسماحته.
أجل، إنهم كانوا يعرفون جيّدًا سيدَ الأنبياء الذي لم يكذب قط في حياته، ولم يلتفت أبدًا إلى اللهو ولم يُعرف عنه سفاسف الأمور، واجتَنَبَ التصرفات التي تجرح مشاعر الآخرين، بل إنهم كانوا يفتخرون به.
فهذا الوضع كان يتطلب منهم أن يسارعوا إلى تلبية دعوته قبل سائر الناس، إلا أن أبا لهب وأبا جهل وأم جميل وكثيرًا من سائر أقربائه بذلوا كل ما يملكون من طاقة في سبيل الحيلولة دون خدمته للدين، وأيضًا كان مقابلَ هؤلاء من أقربائه من أمثال حمزة والعباس مَن عرفوا قدره ولم يتخلّوا عنه ولو قليلًا.
فالقرآن الكريم بالحديث عن أبي لهب في سورة “المسد” كأنه يقول لأبي لهب: “على الرغم من وجود نور إلهي يشع ويتلألأ بالقرب منك، إلا أنك تُغمضُ عينيك عنه بل تحاول إطفاءه، وتدير ظهرك لذلك المنبع الذي من شأنه أن يكون وسيلةَ هدايةٍ لكل الورى”، وبذلك يقدم القرآن لنا لوحة حية من شأنها أن تعلّم العالمين درسًا مفيدًا.
نعم، إن القرآن الكريم بقوله: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ (سورة الْمَسَدِ: 111/3)؛ قد أخبر عن أبي لهب -وهو لا يزال على قيد الحياة- بأنه لن يؤمن، وفي نهاية المطاف سيدخل النار بسبب كفره وعدم إيمانه، وحينما حان الموعد وقع الأمر كما أخبر به القرآن تمامًا، ومات أبو لهب على الكفر والضلال.. وفي بعض الروايات أنه مات كمدًا؛ لما سمع بانهزام المشركين يوم بدر، وفي رواية أخرى: أنه كان هو وأبو سفيان على رأس بئر، وكان أبو سفيان يتحدث له عن بدر وكيف انهارت قوتهم المعنوية أمام المسلمين وتزلزلت أقدامهم، ويذكر له ما أبدى المسلمون أمامهم من البسالة والبطولة، وإذ هما يتحدثان فيما بينهما كان هناك مولى للعباس قد آمن من قبلُ، فإذا به يتحدث عن دعم الملائكة لجيش المسلمين ويقول: “والله إنها الملائكة تقاتل مع المؤمنين”، فاغتاظ لذلك أبو لهب فصفعه صفعة أسقطته على الأرض.
ولكن زوجة العباس لم تتحمل ذلك، فأخذت عصا كبيرة ثم ضربت به أبا لهب فشجت رأسه وقالت: “أتفعل هذا لمّا غاب سيده”، فمن المحتمل أنه لقي حتفه بما أصابه من نزيف في الدماغ من جراء تلك الضربة الشديدة، وقد أنتن جسده وتفسخ وفاحت منه رائحة كريهة فلم يستطع الناس الاقتراب منه، حتى إن أولاده لم يهتموا به مما جعل الناس يربطون رجله بحبل ويسحبونه ليرموه في حفرة .
وحينما كان القرآن يتحدّث عن هذه العاقبة الوخيمة لأبي لهب لم تكن تبدو في الأفق أية علامات تدل على ذلك؛ فقد مات أبو لهب بعد نزول هذه الآية بحوالي عشر سنوات وقلبُه ممتلِئٌ بالكفر والحنق والغيظ والحسد تجاه انتصار المسلمين وهزيمة المشركين في بدر، فصار موتُه كما أخبر به القرآن من العلامات التي تؤيد أنه كلام الله.
وهناك أناس يحسب الناظر إلى واقع حالهم أنهم سيموتون على الكفر، ولكنهم في أواخر أعمارهم يصبحون من خُلَّص المؤمنين.
أجل، إنه ليس للإنسان أن يطّلع على الغيب، وليس لأحد أن يخبر عن شيء إلا أن يشاء الله إخباره بذلك، وبالأخص الأخبار التي يلقيها ويجازف بها أصحابها رجمًا بالغيب ثم لا تأتي لهم إلا بالخزي والعار في نهاية المطاف، أما النبي فإن الله تعالى أحسن إليه فأيد رسالته بمثل هذه الأخبار الغيبية، بحيث إنه كلما تحققت الأمور التي أخبر بها أصبح الناس -وعلى رأسهم الذين كانوا يسخرون منه- ينبهرون واجمين أمام صدقها.
و. أنواع متفرقة من المعجزات والأخبار
1- إن الله تعالى هو الذي خلق كل شيء
والأخبار الغيبية هي من الأمور التي تفوق طاقة البشر وقدرته، ومن غير المتصور أن يصل الإنسان إليها بعلمه ومعرفته، وبعقله ومنطقه وإدراكه؛ لأن هذه الأمور من المعجزات، والمعجز مشتق من العجز، فهو بمعنى: الأمر الذي يُعجز الآخرين.
والمعجزة في الاصطلاح الإسلامي: هي أمر خارق للعادة يعجز عنها الناس، يخلقها الله تعالى ويجريها على أيدي الأنبياء لتكون دليلًا على صدق نبوتهم وهذا الأمر الذي يعجز عنه كلّ أحد سوى الله هو في الوقت نفسه يقوي إيمان المؤمنين ويُفحم الكافرين.
ولا يستطيع الإنسان أن يخلق شيئًا من العدم، وليس له إلا أن يقوم باكتشاف العناصر الموجودة ويُجري عليها بحوثًا وتراكيب ويحصلَ على معلومات حولها، فلن يرقى شيء مما يحدثه الإنسان ويكشفه إلى مستوى المعجزة مهما كان أمرًا بديعًا، فالمعجزة أمر خارق يخص اللهَ تعالى، ومن ميزاتها أنها تقترن بدعوى النبوة.
فالقرآن الكريم يشير إلى هذا بقوله: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (سورة الشُّورَى: 42/31).. فإذا تناولنا الآية بالمعنى اللازمي تَبَدّتْ لنا الإشارة التالية:
إنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمعجزة على وجه الأرض، ولن تطيقوا أن تعملوا شيئًا خارج إرادة الله، فقد تتقدّمون في العلوم، وتنجحون في شتى مجالات التكنولوجيا، وتكتشفون معلومات مهمّة للغاية، فمثلًا:
تقومون بتحليلات وتركيبات مختلفة في مجال الكيمياء، وقد تعالجون العناصر الموجودة وتُنشِئون منها أشياء مختلفة، فتصنعون في المختبرات عناصر مركّبة جديدة، وقد تكتشفون أصغر اللبنات الأساسية للمادة من الذرة وما تحتوي عليها من الجزيئات من أمثال الإلكترونات والبروتونات والنترونات، وتكتشفون أن الإلكترونات تدور حول نواة الذرة التي تتشكل من البروتون والنترون بسرعة 100-1500 كم في الثانية، وتكتشفون الكواركات التي يتشكّل ويتكون منها البروتون والنترون.
كما أنكم قد تَشْطُرون الذرّة فتصنعون القنابل الذرّية، لتحصلوا من انشطار كيلوجرام من نواة اليورانيوم على طاقة تعادل ما ينتجه 2500 طن من فحم الكوك من الطاقة، وقد تكتشفون تركيبات جديدة للهيدروجين فتصنعون القنبلة الهيدروجينية ذات التدمير الهائل، ولكن لن يكون كل ما تفعلونه من هذا القبيل معجزة قطعًا؛ فكما
أن المكتشف لقارة أمريكا لن يَعدُوَ أن يكون مكتشفًا فحسب، فكذلك أنتم.
فالخالق للذرة في حقيقة الأمر هو الله، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وانفتاحُ كل شيء وانقباضُه وتشكُّله بشتى الأشكال إنما هو بمشيئته وإرادته، وهو الذي يأخذه، بيده كلُّ شيءٍ بدءًا من قلب الإنسان وانتهاء بأقصى الأجرام السماوية، ويؤسّس دائمًا بين هذين العالمين شتى أنواع العلاقات، والذي يتحكّم بالذرات والجزيئات إنما هو برنامجه الذي وضعه فيها، وهو الذي يكتب الديمومة لذلك البرنامج أيضًا، وبالتالي فإن ما تقومون به لا يعدو أن يكون مجرّد اكتشاف لما هو موجود حقيقةً، فليس من الوارد الحديثُ عن إتيانكم بأمر معجز، والله هو الذي يأتي بالمعجزات، وإذا كان الأمر متعلّقًا بدعوى النبوة فالوسائل فيها هم الأنبياء.
ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (سورة الشُّورَى: 42/31)، ورد ذكر “الأرض” فقط، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (سورة العَنْكَبوتِ: 29/22) يذكر السماء أيضًا مما يعني أن الإعجاز لن يكون لا في الأرض ولا في السماء.
وقد ورد في بعض آيات القرآن الكريم ما يشير إلى الصعود -ولو نوعًا ما- إلى السماوات، وفي ذلك إيماءٌ إلى أن بني البشر سيصعدون يومًا ما -ولو في حدود معينة- إلى بعض طبقات السماء، ولكن هذا النوع من الإنجاز ليس من الأمور الخارقة للعادة؛ فإن من يريد الصعود إلى السماوات فعليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما وضعه الله من قوانين الكتلة والوزن والسرعة والجاذبية الأرضية، ولن يكون ما يحققه الإنسان في هذا من باب الإعجاز بل غاية ما يقوم به هو الاستفادة مما خلقه الله من الغلاف الجوي وعلم الرياضيات وتقليد بعض الأجسام والنماذج.
وأيضًا يمكن أن نستفيد من الآيتين ما يلي:
أ- كل شيء يعتمد على بعض النواميس، ولكن ليس للانسان في هذه النقطة مجال للتدخّل، وليس له أن يضع بعض النواميس التي يتدخل من خلالها في جوهر الأشياء وأساسها وماهيتها؛ فإن الله هو -وحده- الذي يمتلك حقَّ وضعِ القواعد والمبادئ الأساسية في هذا الباب.
ب- وعلاوة على ذلك فهاتان الآيتان تخاطبان إنسان عصرنا قائلتين: “إنكم بما حقّقتم في هذا العصر من النجاحات المتعاقبة أصبحتم تعتقدون بأنكم تستطيعون أن تعملوا كل شيء، وقد تُوغِلون في الوقاحة وتعلنون كفركم وضلالكم إذا نجحتم غدًا في السماوات، ولكن مهما عملتم فإن عليكم أن تعلموا جيدًا أنكم لن تبلغوا أي مدى تُعجزون الله فيه، بل على العكس ستظلّون عاجزين أمام إجراءاته الإعجازية، ومصنوعاته الخارقة، وترجعون إليه طوعًا أو كرهًا”، وهذا يشير إلى أن طريق العلم سيظلّ مفتوحًا أمام البشر، وفي الوقت نفسه ستكون هناك وقاحات أيضًا.
إن العلم قد تقدَّم وسيتقدّم، والإنجازات التكنولوجية تعاقبت وستتعاقب، ولكن كل الأمور ظلت تجري منذ البداية في إطار القوانين التي وضعها الله، فليس هناك أيُّ تَخَطٍّ للنواميس الإلهية ولا إعجازٌ بشريٌّ، صحيحٌ أن رجال العلم قدموا للإنسانية كثيرًا من الأمور البديعة، ولكن لا شيء منها من قبيل المعجزات، بل إن كلّ الأمور جرت في إطار القوانين التي أودعها الله في الكون، ولم يحصل أي تخطٍّ لمشيئتِه وإرادته.
ولم تكن في الفترة التي نزل فيها القرآن دراسات حول الفضاء على غرار ما في وقتنا الحاضر، ولكن القرآن في سياق حديثه عن المقاصد العامة كان يشير بلفتات إلى الصعود إلى الفضاء، ولكن بمرور الأيام تطوّرت الأوضاع وتقدم العلم في تكنولوجيا الفضاء بشكل مطابق للبيان القرآني، وعلى الأقل كان في ثنايا تلك التعبيرات القرآنية إيماءات إلى ما في أيامنا من التطورات.
والقرآن الكريم، حين يُذكِّر الإنسان بضعفه وعجزه في الأرض والسماء، ويلفت النظر إلى أن ما يكتشفه ويحققه من الأمور إنما هي أمور عادية في حقيقتها وإن كانت تبدو في ظاهرها خارقة.. نلاحظ أنه يومئ إلى أنه سيصعد يومًا ما إلى السماوات ولو بشقّ الأنفس، ولو لم يكن هناك مثل هذه الإيماءات لما كان لذكر السماوات في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ (سورة العَنْكَبوتِ: 29/22) وجهٌ، وقوله “معجزين”
أي لن تعجزوا الله، أو لن تأتوا بمعجزة.
ولكن الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه من آفاق السماء لن يتأتى إلا في إطار القوانين التي وضعها الله، وبقوته وضمن حاكميته.. فقوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (سورة الرَّحْمَنِ: 55/33) يشير إلى أن هناك عقباتٍ عديدة تحول دون الوصول إلى هذا الهدف من انعدام الأوكسجين، والجاذبية الأرضية، والاحتكاك وسائر الأحداث الكونية، وليس من الممكن تخطي هذه العقبات إلا بمقدار معرفة القوانين التي وضعها الله والاستفادة منها، وإذا كان النجاح عن طريق هذه القوانين فلا معنى لتسميته معجزة، ومن الممكن التركيز هنا على بعض التفاصيل التي أدلى بها المؤولون المحدثون ولكننا سنكتفي بما قلناه.
2- وسائل المواصلات
وفي هذا المجال يقدم القرآن الكريم بشكل معجز بطريق الإشارة أو الإيماء لكل الأجيال المتعاقبة من لدن العهد النبوي إلى قيام الساعة أخبارًا تتخطّى حدود آفاق علوم الإنسان من كل العصور، ومن تلك الآيات التي تحتوي على هذا النوع من الأخبار قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي من وسائط النقل والركوب.
وبالنظر إلى الفترة التي أنزل فيها القرآن فإن ما كان يركبه الناس آنذاك إنما كان عبارة عن الخيل والبغال والحمير والإبل ونحو ذلك كما ورد في الآية.. وكذلك كان الوضع في سائر أنحاء العالم، وكان الناسُ يسافرون عليها وعليها تسير القوافل وتُنقَل السلع التجارية، كما أنها كانت من الأمور البارزة في باب الزينة، فقد كان الناس يستخدمونها وسائل للترفيه والمتعة.
فالآية الكريمة بعد تعداد وسائل الركوب والزينة هذه، تقول: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ إشارة إلى ما سيخلقه في المستقبل من وسائط النقل والركوب، و”الخلق” من الأمور التي تختص بالباري، وإن كان هناك من يستعمله في عصرنا في الإسناد إلى الإنسان، ولكن الخلق هو الإيجاد من العدم ولا يستطيع تحقيق ذلك إلا الله، فما يصنعه الإنسان ليس من قبيل الأمور التي توجد من العدم، وإنما هو إنشاء مما هو موجود، وحتى ذلك لن يتحقق إلا بإذن من الله.. ولنرجع إلى ما كنا بصدد الحديث عنه في قوله تعالى:
﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فهو إشارة إلى ما تم تحقيقه وإنشاؤُه عن طريق ما يتمتع به الإنسان من العلوم والمعارف وما حباه الله تعالى من القدرات والإمكانات، ومن الوسائط العديدة التي تم إنشاؤها للركوب والنقل في البر والبحر والجو، بل إن هذا الأمر لن ينحصر فيما تم تحقيقه في أيامنا هذه، فمن يدري لعل الله تعالى يرزق الأجيال القادمة أنواعًا شتى من وسائل السياحة والتنقل في قابل الأيام.
وأيضًا فهذه الآيةُ الكريمة تثير همم العلماء وتحفّز عزائمهم وتُوجّه عشاق العلم نحو البحث العلمي، كما أنها تشير وتنبه إلى اكتشاف وسائط غير معلومة في هذا المجال انطلاقًا مما هو متاح وموجود، وهذه وأمثالها من الآيات تشجع المسلمين دائمًا على العمل وتُوجّههم إلى الانطلاق نحو آفاق جديدة، ولكن الواقع المرير هو أن المسلمين يعيشون في القرون الأخيرة حالةً خطيرةً من الكسل والجمود الفكري، فبدلًا من أن تَهيج أشواقُهم بسبب الإشارات القرآنية الصريحة، وتنهضَ عزائمُهم تجاه ذلك الكم الهائل من الأبواب التي انفتحت عبر الأشياء والحوادث، ويزيدَ ذلك فيهم احترامًا للقرآن والحقيقةِ، بدلًا من ذلك إذا هم يعيشون هذا الحال من الخمول الروحي والقلبي والعقلي.
ونأمل أن يتحقّق رجاؤنا في قابل الأيام، وأن ينشأ جيلٌ جديدٌ يهتمّ بالقرآن، ويؤمنُ بضرورة تحقيق هذا الأمر، حتى ينقذَنا مما وقعنا فيه من الكسل الفكري والعمى عن الحقيقة، ويدلَّنا على سبل تحقيق ذواتنا.
ومن المعلوم أنه يتم الصعود في عصرنا نحو السماء بوسائل معينة، ويمكن أن يكون في الآية ما يدل -ربما بطريق الإشارة- إلى أن الصعود كما يكون بالواسطة فقد يكون بدون وسيلة، ومن المحتمل أنه إذا تقدّم العِلم والتقنيّات يوفَّق العلماء لإنجاز ذلك، ويتأكد لهم أن لله نعمًا أخرى من هذا النوع، وأيضًا فالآية الكريمة تخاطب على وجه الخصوص أولئك الذين يجتهدون ويُعملون عقولهم لتبعث فيهم الأمل والفضول.
والآية التالية التي سنعرضها -مع العلم بأن الله تعالى أعلم بمراده- تشير إلى أن هناك وسائط أخرى ستصنَّع، وتضع أمام عشاق البحث أهدافًا جديدة وتعطيهم إحداثياتٍ جديدةً للوصول إلى تلك الأهداف: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ (سورة يس: 36/41-42).
أجل، إنه لا شك في أن من نعم الله تعالى التي حباها الإنسان هي السفن التي يسافر عليها في البحر، ولم تكن أثناء نزول الآية من أنواع السفن إلا سفن بدائيّة للغاية تَشقّ طريقَها حسب هبوب الريح أو تُحرَّك بالمجاديف، ومع أن سياق الآية هو تعداد النعم، إلا أن ذلك لا يمنع بتاتًا من أن نستنبط من قوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ (سورة يس: 36/42) ما سيُصنَّع في المستقبل من الباخرات والسفن العابرة للقارات والعبّارات والغواصات والسفنِ التي تعمل بالكهرباء أو الطاقة النووية والشمسية.
وكان جُلُّ ما عسى أن يتصوره المسلمون في ذلك الوقت هو السفن ذات الأشرعة، ولكنهم ما كان لهم بتاتًا أن يتصوّروا السفن التي تعمل بالبخار أو بالمحركات أو يتخيلوا السفن العابرة للقارات.. فقوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ (سورة يس: 36/42) أرشد رجالَ العلم ووجههم وفتح آفاقًا جديدة أمام ذوي الاستعداد الذين يريدون اختراع وسائط جديدة، وحينما حان الأوان إذا بنا أمام وسائل جديدة في مجال النقل تأخذ مكان القديمة ويتحقق ما تشير الآية إليه، واحدًا تلو الآخر.
ولسنا ندري ماذا سيخترع بنو الإنسان في قابل الزمان من وسائل النقل، ولكن هناك حقيقة ندركها وهي أن المجال ما يزال مفتوحًا أمامهم، حسب ما يشير إليه القرآن الكريم، وهناك الكثير مما يتخيله الإنسان ويعمل عليه سيتم تحقيقه إذا آن الأوان، وذلك على حسب ما تسمح به الظروف، ولعله سيكون لمفسّري عصرنا الحديث في هذا المجال تفسيرات جديدة.
3- سيتحقق في المستقبل الدخول في دين الله أفواجًا
ومن الأخبار الغيبية القرآنية بشارته بأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجًا.
أجل، إن القرآن الكريم قد ذكر في قوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (سورة النَّصْرِ: 110/1-3) بأن هذه البشارة العظيمة ستتحقّق في وقت قريب، ولم تكن وقتَ نزول هذه البشارة التي بثّت الفرح في نفوس المؤمنين أيَّة أمارات تبعث الأمل في النصر، ولكن حينما آن الأوان تحقّقت هذه البشارة بفتح مكة، وتتابعَ الناسُ من أهل حنين وقبائلِ هوازن والطائف ونجد يدخلون في الإسلام مصداقًا لهذه البشارة.
وكانت مكة أمَّ القرى، وكان الناس قبل الفتح أيضًا يأتون إلى الكعبة من كل فجّ ويعظّمون الأصنام التي حول الكعبة، ولما أسلم أهل أم القرى بعد الفتح أخذت القبائل تَفِدُ إلى الرسول معلنة الإسلام في مجلسه المبارك، فكان هذا الفتح، في الوقت نفسه، فتحًا للقلوب أجمع، بحيث إنه لما أخذ طريقه إلى حجّة الوداع كان محاطًا بآلاف من صحابته المخلصين، وكان هذا تحقيقًا لتلك البشارة التي وردت قبل سنين.
ومن جانب آخر كانت هذه الآيات، بالنسبة لمن فَهِمَ مغزاها إلى جانب إخبارها عن انتشار الإسلام وشيوعه؛ إخبارًا بوفاة الرسول الأكرم، حيث روي في هذه الشأن عن ابن عباس أنه قال:
“كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وَجد في نفسه فقال: لِمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات ليلة فأدخلني معهم، فما رئيتُ أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ فقال بعضهم: أُمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نُصرنا وفُتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجلُ رسول الله أَعْلمَه له قال: ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ وذلك علامة أجَلك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول . أجل، إن هذه الآية تقول للرسول: إذا جاء نصر الله والفتح فهذا يعني أن مهمتك قد انتهت، فلذا عليك أن تسبّح بحمد ربك وتستغفرَه إنه كان توابًا.
فبعد صدور هذا الجواب من ابن عباس فهِمَ الحاضرون هناك السببَ من وراء اهتمام سيدنا عمر بابن عباس، وسكتوا.
أجل، فقد تحقق هذا الخبر الغيبي الذي أخبر به القرآن المعجزُ البيانِ طبقًا لما أخبر به، والتحقَ سيّد الأنبياء بالرفيق الأعلى ولسانُه يلهج بطلب العفو والمغفرة ليفتح بذلك الطرقَ المؤدية إليهما.
4- فتح بيت المقدس
إن هذه الآيات التي مرّت بنا والتي تَعرَّضْنا لمعناها سريعًا كانت في مجملها متعلقة بالأخبار المستقبلية التي تُعتبَر جانبًا من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم، والمقام لا يتّسع لسرد جميع الآيات المتعلقة بالأخبار الغيبية؛ فلذا لن نوردها جميعها؛ لأن الآيات التي تتعلق بالأخبار الغيبية أكثر من مائة وخمسين آية، إضافة إلى أننا ذكرنا الآيات التي تدل على ذلك صراحة فقط، ولم نتطرق إلى الآيات التي تدل على تلك الأمور بطريق الإشارة، وقد وقف المفسّرون طويلًا في تفسيراتهم الإشارية عند هذه الآيات واستخرجوا منها كمًّا هائلًا من جواهر الحقائق، وألّفوا فيها عددًا كبيرًا من الكتب.
واستنبطوا بهذه الطريقة من القرآن فَتْحَ القسطنطنية وإعادةَ فتحِ المسلمين لبيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي بعد احتلالها واستباحتها من طرف الصليبيين، بل ذهبوا إلى أبعدَ من ذلك فذكروا تواريخ هذه الأحداث، ولتوضيح ذلك لا بد من مثال حول الموضوع:
إن احتلال القدس الشريف واستباحته من قبل الصليبيين قد جرح مشاعر المسلمين جرحًا غائرًا.. ففي هذه الحالة التي كان المسلمون في جميع أنحاء العالم الإسلامي يُعانون من غمٍّ شديد كان من بين أَتَابِكَةِ السلجوقيين الذين يعتز بهم المسلمون شخصٌ يُدْعى “نور الدين زنكي”، وكان المسلمون قد عقدوا فيه الأمل، وهو بدوره لم يخيّب رجاءهم فيه فحقق عديدًا من الإنجازات، فهذا الرجل صاحبُ الأفق الواسع كان قد استصنع قبل إعادة فتح بيت المقدس بخمسة وعشرين عامًا منبرًا على حسب مقاسات المسجد الأقصى، وكان كلما مرّ بالمنبر يمتلئ ويفيض بمشاعر ممزوجة من الغم والفرح على أمل أنه سيضع هذا المنبر في مكانه بالأقصى المبارك.
وكلما سأله الناس عن سبب استصناعه لهذا المنبر كان يردُّ قائلًا: “إنما استصنعته للأقصى”.. وحينما قالوا له: فكيف سيتحقّق هذا والأقصى بيد الصليبيين؟ ردّ قائلًا: إنني رأيت في بعضِ الحواشي والتعليقات الفرعية على تفسير “ابن برجان اللخمي الإشبيلي” أثناء تفسيره لسورة الروم ما مفاده: أن الصليبيين سينهزمون وسيعود القدسُ مرة أخرى للمسلمين، فقد رأيتُ هذا مضبوطًا بتاريخٍ محدّد، وأَمامنا خمسة وعشرون عامًا لحلول ذلك التاريخ، فإن عشتُ خمسة وعشرين عامًا أخرى فسأضع هذا المنبر في موضعه هناك ، لكن نور الدين زنكي توفي قبل ذلك الموعد، وحقق الله شرفَ فتح بيت المقدس لصلاح الدين الأيوبي الذي تربى على يد نور الدين، ووضعِ المنبر في المسجد الأقصى.
أجل، إن ابن برجان قد استنبط من معاني القرآن الإشارية فتْحَ القدس وبشَّر به قبل أن يقع بيد صلاح الدين بسنين عديدة.
وهناك خبر آخر يورده ابن جرير الطبري عند تفسيره لسورة الشورى، ومعلوم أن تفسيره “جامع البيان” من التفاسير التي جَمعت بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية، وإلى جانب ذلك يهتم كثيرًا بالمعاني الإشارية، فيَروي ابن جرير في هذا التفسير الذي حرّره قبل أيامنا هذه بحوالي ألف ومائة عام عند تفسيره لـ﴿حم عسق﴾ (سورة الشُّورَى: 42/1-2) بسنده إلى أرطاة بن المنذر قال:
جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حُذيفة بن اليمان: أخبِرني عن تفسير قول الله: ﴿حم عسق﴾، قال: فأطرق ثم أعرض عنه، ثم كرّر مقالته فأعرض فلم يجبه بشيء وكره مقالته، ثم كرّرها الثالثة فلم يجبه شيئًا، فقال له حُذيفة: أنا أنبئك بها، قد عرفتُ بم كرهها؛ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله، ينزل على نهر من أنهار المشرق، تُبنَى عليه مدينتان يَشقّ النهرُ بينهما شقًا، فإذا أذن الله في زوال مُلكهم وانقطاع دولتهم ومدّتهم بعث الله على إحداهما نارًا في ظلمة الليل فتصبح سوداء مظلمة
قد احترقت كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحبتها متعجبة، كيف أفلتت، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كلّ جبار عنيد منهم، ثم يخسف الله بها وبهم جميعًا، فذلك قوله: ﴿حم عسق﴾ يعني: عزيمة من الله وفتنة وقضاء، حم، عين: يعني عدلًا منه، سين: يعني سيكون، وقاف: يعني واقعًا بهاتين المدينتين .
ومن الغريب أنه لما حصل الانقلاب في سنة (1958م) بالعراق قُتل عبد الإله الذي كان من أحفاد ابن عباس من قِبل البغاة، وتَحقَّق ما أخبر به القرآن بطريق إشاريٍ قبل ذلك بقرون.. فتحقّق مصداق هذا الخبر الذي جاء قبل ألفٍ وثلاثمائة عام لهو من الأمور التي تَفُوق حدود آفاق علم البشر.
والعلماء من أمثال محيي الدين بن عربي والقشيري ممن لهم بعض الإلمام بعلم الحروف قد اهتموا بهذا الجانب من القرآن، فتحدثوا عن أمور كثيرة بدت لهم عن طريق الرمز والإشارة، ولا ننكر أن هناك من بالغوا في الأمر وأخرجوه عن حدوده الطبيعية فأغرقوا في رمزية الحروف، لكن هناك بالمقابل من جانبوا الإفراط والتفريط واتخذوا طريقًا وسطًا فاستخدموا هذه المعطيات ليتوصلوا عبرها إلى أسرارٍ تُلقي الضوء على أمور ربما ستتحقق بعد عصور، وحقًّا حينما آن الأوان إذا بتلك التنبؤات تتحقّق وتظهر للوجود، فمثل هذه الأمور إما هي من قبيل الرموز والإشارات التي أتى بها القرآن أو هي عبارة عن أطياف نورانية وإشعاعات قرآنية تجلت وانعكست في الآفاق المعنوية لتلاميذ القرآن هؤلاء.
والأمثلة كثيرة في هذا الباب ولكن المقام يضيق عن ذكرها.
وكما يُفهم من الأمثلة المذكورة بشكل صريح فإن القرآن الكريم ليس من كلام البشر بتاتًا، بل هو بيان معجز جاء من الله الذي يعلم الماضي والمستقبل بكلّ تفاصيلهما.