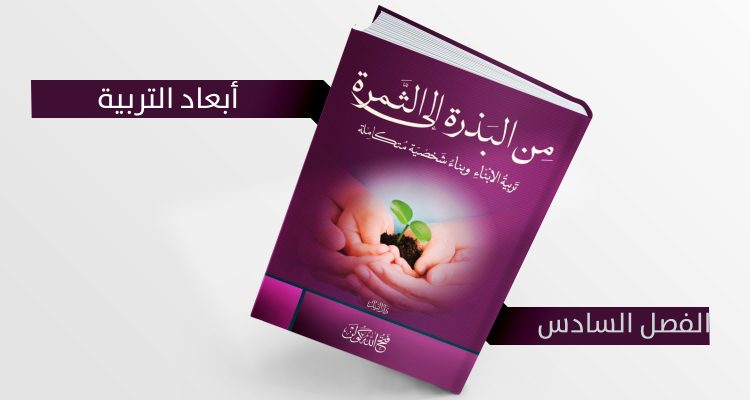تطرّقنا في الفصل السابق إلى المسائل التي لا بدّ من تلقينها للطفل بما يتوافق مع عمره ومستواه، إلى جانب الأمور التي يجب على الأبوين والمعلمين والمربّين مراعاة الدقة فيها عند القيام بعملية التربية.
وننوّه هنا مجدّدًا على أنّ مَن لم يراعِ الدقّة في هذه العمليّة ولم يحفل بالعمر والمستوى والأفق الفكري ولا البيئة والمستوى العلمي، ولم يُحسن تغذية طفله وسدّ جوعه ونَهَمِهِ على أكمل وجهٍ؛ فلا تأخذه الحيرة عندما يرى ابنَه ذئبًا جائعًا في المرحلة المستقبليّة.
1- الاستعانة بذكر الصالحين في التعريف بالعمل الصالح
إن التعريف بالعمل الصالح عن طريق الاستعانةِ بأبطاله من الصالحين منهجٌ يهمّ المعلّمين والمربّين فضلًا عن الأبوين، ومن ثمّ سنعرض فيما يلي لبعض الأفكار المتعلّقة بالسلوك الواجب اتّباعه في هذه المسألة:
أجل، ينبغي للأطفال والشباب أن يتعرّفوا على العمل الصالح، وحتى لا يبقى هذا الأمر مجرّدَ معلوماتٍ نظريّة فمِن الأهمّية بمكان تعريفُهم بالصالحين وبتعبيرٍ آخر تعريفُهم على الأعمال الصالحة عن طريق تعريفهم على أبطالها، فلا بدّ للطفلِ أن يتعرّف على الشخصيات العظيمة المشهورة بتديّنها وورعها حتى يدرك أن الطريق الذي يسير فيه قد سارَ فيه أفذاذٌ وعُظماء من قبله، وبذلك يشعر بلذّة السير في هذا الطريق، فإذا ما وصل الطفل إلى سنٍّ معيّنةٍ أدرك أن هذه الشخصيات العظيمة التي كانت تصلي كلَّ يوم كذا وكذا ركعة وتصوم كذا وكذا يومًا في السنة دون اعتبارٍ لحرٍّ أو بردٍ إنّما هي شخصيّاتٌ فاضلةٌ عند ربّها ولا نزكّي على الله أحدًا فإننا نحكم بالظاهر، فإذا ما أدرك الطفلُ هذا أدّى ما عليه في سبيل دينه وتديّنه بما يتناسب مع روح الدين ومعناه، فلا يهتزّ -ألبتة- أمام أيّ رياح معاكسة.
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَخْفِي الْمُؤْمِنُ فِيهِمْ كَمَا يَسْتَخْفِي الْمُنَافِقُ فِيكُمُ الْيَوْمَ”[1].
وهكذا يجب تعريف الأجيالِ الشابّة -وهم ما يزالون في سنّ الطفولة- على سبل التغلّبِ على هذا المرض الذي يظهر في بعض الأحيان، والأحرى أن نلقّنهم أن الدين هو سبيل العزة والكرامة؛ حتى تنشأ لديهم حالةٌ روحيّة تسعى بإخلاصٍ إلى التمسّك بأوامر الدين.
وهنا أريد أن أعرض عليكم هذا المثال الحيّ:
حدث أن جارية حديثة السنّ نشأت في عائلةٍ أحسنت التخطيط لتربية أبنائها وكانت تتابعهم باستمرار، إلى أن أصبحت هذه الفتاةُ ذات يومٍ مرشدةً لمعلّمتها في الفصل الدراسي، فرغم ما كانت تتحلّى به المعلّمة من ظُرفٍ ورقّة كبيرة مع الجميع فإن الإلحاد أخذ مع الزمن يُنهكها، حتى كاد أن يفتك بها، وذات يوم سُمع صوت البنت وهي تجهش بالبكاء في أحد الصفوف الخلفية واقعةً تحت تأثير حقيقة الدين المتعمّقة في روحها، وعند ذلك جاءتها معلّمتُها الحنون، وسألتها: ما يبكيك يا عزيزتي؟ فقالت البنت: أبكي عليكِ، وأردفت قائلةً: إنني أخشى أن يصيبك عذاب الله لأنك لم تؤمني، فتجمّدت المعلّمة في مكانها عند سماعها لهذه الكلمات وتراجعت إلى الخلف دون أن تنبِس ببنت شفه، وبعد بضعة أيّام جاءت المعلمة إلى الطالبة المرشدة ووجهُها يُنبئ عن جماليّات إيمانها الذي أنار قلبها، فتقاسمَتا معًا فرحةَ الإيمان وسروره.
فهذه الفتاةُ قد شربَت من معين العزة كما الإيمانِ، يقول تعالى: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: 4/139)، ومن الحقائق الدينية: أنّ مَن يعايش مبادئ الدين يعزّه الله، ومَن يُعرض عنها يُذلّه الله.
أجل، على الطفل أن يتيقّن من صحة وسلامة الحقائق التي يؤمن بها والطريقِ الذي يسلكه حتى لا يقع فيما بعد أسيرًا لعقدةِ الدونيّة وينسحق إزاء تيّارات الإلحاد الجارفة، والأحرى: عليه أن يدرك عظمةَ الصلاة والصوم، حتى إذا ما حانت الصلاةُ هرعَ إليها وشرع في التكبير دون تردّد، معلِنًا خضوعَه التام لله تعالى.
إنّ القرآن الكريم -وهو يحدّثنا عمّا يجب أن نفعله ولا نفعله- يدعونا إلى أن نعلن عن رغبتنا وأملنا في الهداية إلى سبيل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من خلال قوله تعالى: ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ $ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (سورةُ الفَاتِحَةِ: 1/6-7) الذي نكرّره كلّ يوم أربعين مرّة على الأقل، ومن جانبٍ آخر يلفت انتباهنا إلى السلبيات دون تفصيلٍ أو تصويرٍ للباطل بقوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ (سورةُ الفَاتِحَةِ: 1/7)، بل إنه عندما يثير رغبتنا نحو طريقِ الرضا؛ طريقِ الجنة، يشير إلى ضرورة التصدي لسبل الكفر والجحود والضلال.
وهذا الأسلوب يشكّل نموذجًا لهؤلاء الذي نُعنى بتربيتهم، فلا بدّ أن نضع في اعتبارهم المنهجَ والسبيلَ الموصّل لرضا الحقّ سبحانه وتعالى، وأن نكوِّن في أرواحهم ردّ فعلٍ فوريّ إزاء ما لا يحبّه الله تعالى ولا يرضاه، وهذه وظيفةٌ منوطةٌ بنا.
لقد خاب وخسر مَن لا يعرف الله ولا يعترف بأنه سبحانه وتعالى واحدٌ أحدٌ في ألوهيته وربوبيته، وهو المتحكّم الأوحدُ في حياته؛ لأنه لا خلاص ولا فلاحَ في الدنيا والآخرة لمَن لا يعرف وظيفة الفطرة ولا يستوعب حكمةَ الخلق ولا يدرك العلاقة بين السبب والمسبّب في الكون، وبالأحرى لا يُذعن ولا يؤمن بالله الذي يُشعرنا بوجوده وراء كلّ هذه الحجب من الأسرار، فهؤلاء والذين يخالطونهم ويعاملونهم لا نجاة لهم من الله، يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (سُورَةُ هُودٍ: 11/113).
2- الإفادة من العلوم التجريبية في التربية الدينية
ثمّة ضرورةٌ ملحّةٌ في أن يكون الحديث عن العقيدة الإسلامية الحقّة متوازيًا مع ثقافات الأطفال الذين يدرسون الفيزياء والكيمياء والفلك وفيزياء الذرّة وما شابه ذلك من العلوم الطبيعية، فالمادّيّون اعتمدوا على المادّة وربطوا كلّ شيء بها، فكان حريًّا بالمؤمن أن يستغلّ المادّة واضعًا إيّاها في موضعها عند حديثه عن الله تعالى والآخرة والقرآن والإيمان.
أجل، لا بدّ أن يعرف المؤمنون طريقة تحويل مستنقع المادة الذي انغمس فيه جميع المادّيّين التاريخيّين إلى حدائق ذات بهجة، وأن يعتبروا جميع الأشياء والحوادث شواهد على وجود الله تعالى.
فإن لم تكن التربية الدينيّة في البيت والأسرة على قدر ما حصّله الطفل من علومٍ تجريبيّة في تعليمه الأساسي والثانوية والجامعة فلا محالة من انزلاقه وانحرافه، وإنَّ عدمَ المتابعة الحثيثة للمستوى العلمي والثقافي الذي حصّله الطفل في المدرسة أو في بيئته وعدمَ التدخّل في الوقت المناسب للحدّ من الأفكار الضالة المحتملة يؤدّي إلى احتماليّة تحويل العلوم التي حصّلها الطفل إلى أسباب للكفر، مع أنه من الواجب أن تكون هذه العلوم أنصعَ أدلةٍ على وجود الله تعالى ووحدانيّته.
أجل، قد يقع الطفل في شكوكٍ وشبهاتٍ بسبب تحصيله للفلسفة، فإن لم نساعده بالعقل والمنطق والاستغلال الإيجابيّ للعلوم لَوَقع في أزماتٍ خطيرة فيما بعد، فمن الضروري تزويده بالأدلة العقلية والمنطقية والبديهية بقدر ما حصّله من علومٍ تجريبية وعقلانية.
لقد نسب المادّيّون ذلك النظامَ الذي يهيمن على الكون إلى الطبيعة، واعتمدوا في ديماغوجيتهم على نظريّاتٍ فلسفيّة، وهذا أمرٌ يحتّم علينا أن نحدّث الطفل عن بعض المسائل مثل: الإبداع في خلق الكون، والتناغم بين الموجودات، وما نشاهده في الكون من قوانين تتحكّم في كلّ شيء، وأن ننقشَ في ذهنه حقيقة أن كلَّ هذا يجري بحكم الله وتصرّفه، وبذلك فقد يمكننا أن نحول بينه وبين الشبهات والشكوك التي تورِثها النظرياتُ المختلفة.
أجل، يجب أن نزوّد ذهنَ الطفل بالمعلومات السليمة بدلًا من المعلومات السقيمة التي يُشحنُ بها ذهنه من خلال تحريفاتٍ غير منطقيّة، وبذلك نكفل عدم وقوعه في أية حيرةٍ مستقبليّة.
إن كلَّ شيءٍ باعتبار ماهيّته مرتبطٌ بالعلم، والجهل هو ألدّ عدوٍّ للدين والمتديّن، ومن ثمّ يجب على المؤمنين تنشئة جيلٍ ينفتحُ على الدين والعلوم والفنون، وأن يُعمّقوا انتماءَه لتاريخه ووطنه؛ وهذا كفيلٌ بدحضِ محاولات الجهلاء إفسادَ النشء بِحِيَلٍ لا تخطر على بال.
3- إعداد البيئة الصالحة
والآن نريد أن نقف عند مسألة إعداد البيئة الصالحة للطفل، فالعالم المتحضّر يولي أهمّيّةً كبيرةً لحدائق الطفل الموجودة بالقرب من المدارس أو في أماكن أخرى مناسبة، وللحضانات والمؤسسات الاجتماعيّة المختلفة، والحقّ أنّ انقضاءَ الحياة المادّيّة للطفل وعالمه الفيزيائي في بيئةٍ آمنةٍ صحّيةٍ سليمةٍ له أهمّيّةٌ كبيرةٌ في راحةِ بال الأسرة، وتنشئةِ طفلٍ مجهّزٍ ومنفتح على ما حوله
قد تُدرس احتياجات الطفل إلى هذه الناحية الماديّة فتتمّ مراعاة كلِّ المنافع والأضرار التي قد تتأتّى من هذا الإجراء، ولكن كما يحتاج هذا الصغير إلى بيئةٍ مادّيّة هكذا فهو في حاجة أمسّ إلى بيئةٍ سليمة يعيش فيها حياتَه المعنويّة ويطوّرها ويشعر فيها بإنسانيّته ويؤسّس علاقةً روحيّةً مع ربّه سبحانه وتعالى، لا بدّ أن نفكّر في هذا الأمر عند الحديث عن بيئة الطفل.
والآن سأعرض عليكم ما يجب مراعاته فيما يتعلّق بهذا الأمر:
أ. اختيار الصديق
من الأهمية بمكان أن نساعد الطفل في اختياره أصدقاءً يراعون حقّ ربّهم ودينهم، ولا يقتصر الأمر على المساعدة فقط، بل يتعدّاه إلى المتابعة الدائمة للطفل عن طريق الإرشاد والتوجيه لا الضغط والإكراه؛ حتى ينشأ جيلٌ محترِمٌ لدينه وأمّته ووطنه وقِيَمِه الذاتية.
لا ينبغي لنا أن نستأمن أحدًا على قرّة أعيننا وفلذات أكبادنا وأعزّ المخلوقات لدينا، فمثلًا لو جاءك أحدٌ لا تعرفه وقال لك: “أخي، انتبه فقد تُسرق محفظتك، فثمّة كثير من المجرمين في بلدتنا، فأعطني هذه المحفظة أو الحقيبة أحفظها لك…”، فهل ستثق به؟ كلا… فإذا كان الأمر كذلك فكيف لكم أن تستأمنوا شخصًا لا تعرفونه في الشارع أو السوق على ولدكم أو تتهاونوا في متابعته ومراقبته؟ لا بدّ -في رأيي- من عدم التردّي في هذا التناقض.
أجل، إن مسألة اختيار الصديق الحسن تقع على عاتق الأم والأب، وكما يقول الشاعر سعدي[2]: الصديق الطالح هو أسوأ من الأفعى والحية الرقطاء، فإن حدث واتّخذتم صديقًا كهذا بثّ فيكم سمومه وشغلكم بأشياء لا طائل منها، أما الصديق الصالح فهو أفضل من الملَك، وإذا ما كنتم معه تجوّلتم دائمًا في آفاق الملائكة.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ”[3]، ولذا يجب على الأبوين أن يتخيّرا أصدقاء ولدهما؛ فالصديق له دورٌ كبير في تشكيل عقل الطفل وفكره، فإن كانت البيئة التي يعيش فيها الطفل بيئةً سيّئة فعلينا أن ننتزعه منها على وجه السرعة، ونرسله إلى مكانٍ آخر نطمئن له، بل لو قُدِّرَ وأُحيطَ الطفلُ بأصدقاء السوء في المكان الذي ينشأ فيه فلا بدّ من عزلِهِ وفصله عنهم بشتى الطرق والوسائل، فإن لم نستطع ذلك أرسلناه إلى بلدٍ آخر، غير أنه لا بدّ من تأكّدِنا واطمئناننا إلى أن الأصدقاء الذين سيتعرّف عليهم الولد في ذلك المكان من المتديّنين الشرفاء الأعفّاء.
فالطفل -أيًّا كان- لا بدّ أن يشعر بالمناخ الدينيّ في البيئة التي يعيش فيها، وأن يجتمع مع الآخرين على الأفكار العالية، قد يحرِم هذا الأمرُ الأمَّ من ابنها ويتكلّف الأبُ الكثيرَ من المصاريف والنفقات، ولكنه يفعل ذلك خشية أن يأتي يوم يعذّبه الله فيه هو وولده، ولذا فهما يحاولان اليوم وغدًا ألا يكونا أبوين لحيّةٍ أو عقرب.
أحيانًا يذهب الطفل إلى أحدهم لمذاكرة دروسه أو عمل واجبه، وهنا أيضًا يجب ألا يغيبَ نظرُنا عنه مطلقًا.
أجل، من حقّ الطفل أن يذهب إلى بيت أصدقائه، ولكن يجب أن يكون كلّ ما تحتويه هذه البيوت من حجرٍ ومدرٍ وجدران يراعي اللهَ ويترنّم باسم الله، فإن نودي للصلاة فُرشت السجاجيد، واصطفّ أفراد الأسرة في جماعة لأداء الصلاة.
أجل، علينا ألا نمنع الطفل من إقامة صداقةٍ مع أبناءِ مثلِ هذه البيوت والغدوّ والرواح إليهم والمذاكرة معهم، بل علينا أن نشجّعه على ذلك، وإلا فإن كان البيتُ الذي يغدو إليه ويروح منفتحًا على الذنوب التي تُثيرها الأهواء النفسيّة فقد خسرنا فلذة كبدنا وضيّعناه.
ب. تنسّم الجوّ الدينيّ الصادق والبعد عن الرياء
ومن الضروري اصطحاب الأولاد إلى المسجد للصلاة في جماعة وحضور المناسبات الدينيّة التي يُتلى فيها القرآن وتتردّد فيها الابتهالات والمدائح النبوية، وبذلك نكون قد أتحنا لهم فرصة التعرّف على أصول وفروع الحياة الدينيّة؛ حيث ينبغي أن يتشبّعوا بما تقتضيه فطرتهم من مثل هذه الأمور؛ حتى لا يتطلّعوا إلى أي أمور أخرى.
أجل، لا بدّ للموسيقى التي يسمعها الطفل أن تترنّم بدينه ومقدّساته، وأن تعمل على انبساط مشاعره الرفيعة، وأن تأذن بتطوّر شعوره بالله سبحانه وتعالى.
غير أننا نؤكّد هنا على أن قرّاء القرآن والمبتهلين والمدّاحين في مثل هذه المناسبات الدينيّة إن لم يتجاوز ما يتلفّظون به حدودَ حناجرهم وجرحَ الرياءُ حسَّ الوقار الدينيّ لدى الطفل؛ ففي رأيي أنه من الأولى صرفه عن مثل هذه المناسبات.
الابتهالات والمدائح النبوية هي بمثابة حوضٍ لغسل القلب وتطهيره وتصفية الوجدان وتنقيته، ولكن إن جاء شخص -على سبيل المثال- لا تتحدّر الدمعة من عينه وقال: “كلّما ذكرتك يا ربّي انهمرت دموعي” فهذا القول هو كذبٌ على الله تعالى، وسماعُ الأطفال لمثل هذا الكذب وقاحةٌ كبيرة إزاء مشاعرهم.
لقد كتبتُ في صغري جملةً معناها: “كلّما ذكرتك يا ربي اقشعرّ جسدي”، ولمّا شعَرْتُ بأنّ هذه الكلمات لا تلامس شغافَ قلبي ارتعدَ جسمي وتركتُ القلم، واعتراني الحياء لأنني أقول: يا رب إنّ جسدي يقشعرّ والحال ليست هكذا، وإنّني ما زلت أحتفظُ بهذه الجملة في دفتري إلى الآن.
أجل، إن رؤية الطفل للمرائي الذي لا يتجاوز قوله حنجرتَه ولا تدمع عيناه، ومع ذلك يرفع يديه إلى السماء قائلًا: “لقد جئناك ربّنا بدموعنا”؛ يتسبّب في انبعاثِ تساؤلاتٍ كثيرةٍ لديه.
إننا نعتبر الابتهالات والمدائح النبويّة عرفًا إسلاميًّا ومصدرًا مهمًّا لرقيّ الحياة الروحيّة لدى الطفل، ومع ذلك فإننا نرى من مقتضى العقل والمنطق والفراسة الدينيّة أن يبتعد الطفل عن السلبيّات التي تعوّده على الكذب والرياء وحبّ الظهور؛ إذ علينا أن نجعله يشعر بنفورٍ واستياءٍ من الرياء قدر نفوره وامتعاضه من الكفر، ويتحرّى الإخلاص لدى مَن يمثّل الدين ويدعو إليه، ويُنصت إلى مَن يترنّم بانفعالات قلبه ونغماتِه لا مَن يصيح بما لا يؤمن به.
هذا هو مقتضى فهمنا الدينيّ الذي نراه في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل هو ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلّم، حيثُ لا يُتصوّر أن يُخالفَ الصحابةُ النبيَّ صلوات الله وسلامه عليه، فإن تقبّلنا هذا المبدأ نكون قد سلّمنا أيضًا بمبدإٍ من مبادئ الدين، وإلا فإن أخطأنا الفهم نكون قد أفسحنا المجال لضلال أبنائنا وأحفادنا.
إنني أحذّر من اصطحاب الأبناء إلى مجالس المرائين واستماعهم للمنشدين منهم، وأوصي بدلًا من ذلك بحضور مجلس مَن يتحدّث عن الدين في جدّيّةٍ ووقار.
إن النقد هنا ليس موجّهًا إلى مسألة السماع أو عدم السماع للابتهالات والمدائح النبويّة، وإنما هو موجّهٌ إلى مَن يشوّهون كيفيّة هذا الأمر. أجل، إنْ أردنا صيانة جيلنا فنحن مضطرّون إلى إبعادهم عن مجالس المرائين.
ج. اختيار الأماكن والشخصيات في علاقات الأطفال
توقّفنا في فصولٍ سابقةٍ عند الأمور التي لا بدّ من مراعاتها لصحّة الأسرة وسلامتها، والواقع أن حسنَ تربية الأبناء وتغذيتهم روحيًّا يحميهم بشكلٍ كبير من الرضوخ تحت التأثيرات السلبية للبيئة التي يعيشون فيها، فالمتابعة الحثيثة لهم مهمّةٌ للغاية، فلا بدّ -مثلًا- أن نوجّههم ونرشدهم حتى عند شراء القلم والدفتر وما شابه ذلك؛ حتى لا يتعرّضوا للكلمات النابية والتأثيرات السلبية.
أجل، ينبغي أن يبتعد الطفل عن الأماكن التي تُعرض وتُباع فيها الكتب المحظورة، حتى لا يتكدّر -ولو بقدرٍ يسير- نظرُه ولا يتعكّر صفوُ عالمه الشعوري؛ إذ إنه من الضروري أن تقع عينه في كلّ مكان يمرّ به على إشارات تشير إلى الله والدين والغايات السامية، وأذكِّر مرّةً أخرى بأن الأب أو وليّ الأمر عليه أن يتخيّر لولده حتى الأماكن التي يشتري منها قلمه ودفتره وكتابه، ولا يسمح بأن ينساق ولدُه -ولو بقدرٍ يسير- إلى الضلال.
فإذا ما توجه مثلًا إلى الخيّاط لحياكة ملابسه فلا بدّ أن يتنسّم نسائم عالمنا الخاص بنا ويسمع أصداء ذاتيّتنا، بل يجب أن يكون مدار الحديث طوال الفترة التي يمكثها عند الخياط عن الدين والتديّن ورفعة الوطن ورقيّه، فإذا ما أعمل الخيّاط إبرته في القماش الذي بين يديه صبغ روحَ المُرْتادين إليه بروحه الدينيّة، وعبّر بمشاعره ولسانه عن الحق والحقيقة، وأن تكون أحاسيسه ترجمانًا للحقيقة، وأن يحلجَ عالمنا الفكريّ وهو يقلّب الألبسة التي بين يديه، وهذه كلّها نماذج لتصوير المتابعة الحثيثة، غير أن ما يجب فعله يفوق ذلك بمراحل.
ولا يُفهم من هذه الدقة العالية عزل الطفل عن الناس، بل إن هذه الدقّة ضرورية لرقيّه في مدارج الكمال، وإذا أردنا تفصيل المسألة أكثر نقول: علينا أن ننتخبَ لابننا حلّاقًا يربط كلّ شيءٍ يفعله باسم الله، فإذا ما حرّك ذراع ماكينته أو فتح الصنبور واغترف منه الماء وقام وقعد سمّى الله تعالى، وعدمُ وجود مثل هذا الحلّاق يعدّ قصورًا تربويًّا يظهر لدى الطفل فيما بعد بشكل مختلفٍ.
وأستميحكم عذرًا في الانتباه إلى هذه النقطة المهمّة:
إن الذهاب إلى الوليمة مسؤوليّة ومهمة دينيّة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا”[4]، ولا يجوز مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كلّ مؤمن أن يقول: سمعنا وأطعنا، ويذعن للأمر النبويّ، غير أن عدم الذهاب إلى العرس الذي يشيع فيه اللهو وتنتشر فيه المعصية وتُرتكب فيه الموبقات والذنوب هو مبدأٌ دينيٌّ آخر؛ لأنّ ما يراه الطفل هناك إذا كان سيبعث على إفساده وتكدير أفكاره فمن المؤكّد أنه لا يجوز لأحدٍ حضور مثل هذا العرس.
د. اختيار البرامج التلفزيونيّة التي يشاهدُها الطفل
إنّ ممّا يجب على ربّ الأسرة الذي يحتوي بيته على تلفازٍ أن يراعي الدقّة البالغة في انتقاء البرامج التي يشاهدُها أبناؤه، ونحن لا نقول بتحريم التلفاز أو تجريم متابعته، ولا ينبغي أن يُحمل كلامنا على أننا خصومٌ له، ولكن من الضروري في مسألة التربية أن نُحسن انتقاء الأفضل والنافع لأبنائنا من قنوات التلفاز وبرامجه، فضلًا عن ذلك فقد عالجت بعض الدول هذه المسألة على النحو الذي ذكرناه، واتخذت شتّى التدابير؛ للحفاظ على عقليّة الطفل وفكره وأخلاقه على وجه الخصوص.
أجل، لقد فكّرتْ هذه الدول في الفساد الذي يشوب أخلاق الشباب جرّاء بثِّ بعض البرامج والأفلام، بَلْه السياسات الإعلامية المنحرفة، فلا يخفى أن بعضَ ما يُبثّ يهزّ الفكر العقدي والأخلاقي للشباب ويروّج للفسق والفجور؛ ومِن ثمّ فإن الإصرار على مشاهدة قناةٍ بعينها في البيت رغم إعلانها الحرب على الأخلاق والقيم من شأنه أن يعمل لا محالة على تفسخ وتشوّه شخصيّة أفراد البيت وخاصة الأطفال.
ولا ينبغي أن يُحمل كلامنا على أننا نعادي العلم والتطوّر والتقنية والفنّ؛ فنحن نؤيد دائمًا كلّ تقنيةٍ تعمل على تحقيق الطمأنينة والسعادة للإنسانية وتُسهم في تطوّرها، كما أن علينا أن نستفيد من هذه النعم التي منّ الله علينا بها في المجال الفكري والثقافي والصناعي والصحّي والطبّي… إلــخ، إذن لا يُوصف مثلُ هذا الفكر بالرجعية؛ بل ما يوصف بها هو غضُّ الطرفِ عن كلِّ ما تبثه بعضُ القنوات التلفزيونية من شناعاتٍ ودناءاتٍ وأمورٍ غيرِ أخلاقية، والسكوتُ عن تفسّخ الأجيالِ وانحلالها.
هـ. التربية القرآنيّة
معلومٌ أن الطفل سرعان ما ينسجم مع كلّ وسطٍ يعيش فيه؛ ولذا يجب على الأبوين والمعلّمين والمربّين أن يحولوا بينه وبين المعاصي حتى لا يألفها قلبُه وعقلُه وأذنه وعينه وسائر أحاسيسه، وأن يكفلوا له بيئةً صالحةً نقيّةً ينشأ ويترعرع فيها، فإن حدث ذلك بالفعل انعكسَ الجوّ الديني الذي يشعر به الطفل في أسرته على البيئة الخارجية، فتتوافق البيئة الخارجية مع البيئة الداخليّة.
ومن الأهمّيّة بمكانٍ أن يحافظ الإنسانُ على كرامته وشرفه واستقامة فكره ومشاعره في هذا العصر الذي استُخدِمت فيه كلُّ القوى كعناصرَ للضغط والاضطهاد، وإنني على قناعة بأن تربية النشء تربيةً قرآنيّةً وتخلُّقه بأخلاق القرآن ومناصرته الحقّ دائمًا، ووصوله إلى مستوى وقوّة لا تقوى على مواجهتها القوى التي لا تُقهر هو أهمّ السبل الناجعة بالنسبة لنا كأمّة للحفاظ على وجودنا وبقائنا؛ لأن أنموذج المجتمع المثالي في عالم الحسّ والوجدان أو في عالم الواقع لا يتحقّق إلا في ظلّ القرآن الكريم وقد تحقّق.
لقد نشأ في المناخ النورانيّ للقرآن الكريم هذا المجتمعُ الإسلاميّ الرائع الذي أضاء حقبةً من الزمن تتجاوز الألف سنة، وأبهر الأبصار دائمًا بتجسيد الأيادي الأمينة له، وكان ظهور هذا المجتمع وتغييره لمجرى التاريخ هو أكثر الحوادث إثارة للدهشة والإعجاب في عالم الإنسانية، ولقد استطاع أفراد هذا المجتمع الرائع الذين لم تتكدّر عقولهم بأي تيّار فلسفيّ أن يصِلوا إلى مثل هذا المستوى بفضل ما استقَوْه من المنبع الصافي وما ارتشفوه من معين القرآن النقي.
كان صلى الله عليه وسلم خُلُقه القرآن، فمن اقتدى به شعر بالقرآن وعاشه ونما وانتعش به، أما مَن عجزوا عن إدراك مثل هذه الجماليات والروعة -وإن تراءى ارتباطهم بالقرآن- فهم ذَوُو أرواحٍ وأفكارٍ سطحيّة لم ينفذوا إلى روح القرآن.
إنّ فهمَ القرآن والانبعاث به مرتبطٌ بالتعمّق في لبه وجوهره ومكنوناته، ولذا فإن مَن يتسلّون بترديد عبارات القرآن وألفاظه -بألسنتهم دون قلوبهم- وإن كانوا ينالون الثواب بقراءته إلا أنهم لا قبل لهم أن يكوِّنوا مجتمعًا صالحًا والله أعلم، فالأصل في علاقتنا بالقرآن هو التوجّه إليه بقلبنا وقالبنا وشعورنا وأحاسيسنا وإرادتنا وإدراكنا والشعور به بكل أبعاد ذاتيّتنا، وبفضل هذا التوجّه والشعور نُحِسُّ بمخاطبة الله تعالى لنا فننمو وننتعش كالبراعم التي وصلها الضوء والماء، ونبلغ أعماقًا مختلفةً في كلّ جملةٍ وكلمةٍ من آياته، بل ونصل إلى أفق المشاهدة لخريطة السماوات في نفس اللحظة التي نشاهد فيها أطلسَ روحنا.
وأعتقد أنه من الممكن أن يتشكّل جيلٌ جديد في جوٍّ ملائم كهذا، وعند ذلك تبدأ وتيرة الدائرة الصالحة، ويكشف لنا القرآن عن كلّ أسراره، وكلّما ارتقينا بسبب هذا الثراء المعرفيّ من العلم إلى الإيمان ومن الإيمان إلى المعرفة وصلنا مع اختلاف مستوى الخطاب الموجَّه إلينا إلى أعماقٍ داخليّةٍ أخرى، وأدركنا بشكلٍ آخر أبعادَ كلمات الله تعالى.
أجل، علينا أن نتّخذَ القرآن الكريم أستاذًا ومربّيًا نَتَتَلْمَذُ بين يديه، وإن هذه التلمذة -التي تعطي أولويّة للحركيّة وتعتمد على التطبيق- هي السبيل الأمثل لكشف القرآن عن أسراره لنا، وإلا فإن كان احترامُنا للقرآن وارتباطنا به مقصورًا على الشكل ولم نقدِر على سبر أغواره عشنا بعيدين عنه رغم قربنا منه والتصاقنا به، إن البؤسَ والحرمان الحقيقيّ هو الحرمان من روح القرآن ومن الثراء الناتج عن جعل القرآن روحًا للحياة، فالأصل في علاقتنا بالقرآن الكريم هو تحريك الآلية الإنسانية بعد المعرفة، فعلى الإنسان أن يجعل من معارفه قوّةً محرّكةً ليُحقّق ما فهمه من القرآن مراعيًا الظروف والأحوال والأجواء، فإن تيسّر ذلك تسنّم الإنسانُ مكانَه المتوائم مع غاية خلقه، ونجا من الضياع.
4- مواصلة الدقّة في التربية
إن إقامةَ فكرةٍ أو حقيقة ما وترسيخها شيءٌ، والحفاظ على ديمومتها شيءٌ آخر، فكم من مؤسّسةٍ وفكرة أُنشئت ببالغ الدقة والاهتمام غير أنها تردّت بعد ذلك وتعرّضتْ للركود والتخلّف بسبب عدم مراعاتها للدقة اللازمة لبقائها حتى وإن لم يعتر أيُّ قصورٍ عملّيةَ تأسيسِها وظروفَ تشغيلها، بل إن مرحلة الانهيار قد بدأت مباشرةً بعد التأسيس بسبب سوء إدارة البعض من شرِّ الخَلَفِ.
أجل، إن إقامة وبناءَ أي شيءٍ أمرٌ مهّمّ، غير أن الأهمّ منه الحفاظ على ديمومة هذا الشيء وتطوّره، لقد راعى المسلمون الأوائل والذين اتبعوهم بإحسانٍ الدقّةَ والعنايةَ في مسألة تبنّي المجتمع للمقوّمات التي تحافظ على وجوده ورعايته وحمايته، وسدّوا أيَّ خللٍ عقليٍّ أو منطقيٍّ أو حسّيٍّ، ولم يقصّروا ألبتة في تطبيق ما يعرفونه ويؤمنون به، ولا شك أنني لا أقصد القصور الفرديّ، بل الأسس اللازمة لسلامة المجتمع والإبقاء عليه في المستقبل، أما بعد ذلك فقد أصبح بعض الورثة أمثالنا الذين لا يدركون روح المسألة ويتناولون القضايا الإسلامية من منظورٍ واحدٍ فقط قد أصبحوا يُفسدون الأمر من الأساس، ولم يُطوّروا الميراث التاريخيّ الذي استُودِعوا إياه، بل واستنزفوه إلى أن جفَّ.
أ. لئلّا نكون شرّ الخلف
وقد وردت آيات كثيرةٌ في القرآن الكريم تصف أحوال العديد من الأنبياء وتعدّدهم لنا تِباعًا: “وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ… وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ… وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى… وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ… وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ…” (سُورَةُ مَرْيَمَ: 19/16، 41، 51، 54، 56)، وبعد أن تكلّم القرآن عن هؤلاء الأنبياء المصطَفَين وخصائصِهم في سورة مريم قال: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (سُورَةُ مَرْيَمَ: 19/59).
قد يكون سيدنا نوح وآدم وموسى وعيسى وحتى محمد عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام هم الأوائل في هذا الطريق، ولكن من غير الممكن أن يستفيد من عظمة هؤلاء الأوائل شرُّ الخلف الذين جاؤوا من بعدهم وأضاعوا الصلاة، ونلاحظ أنه قال “أضاعوا” ولم يقل “تركوا” لأنه لا فائدة من صلاتهم رغم أنهم يصلون، فهم قد اتخذوا من وسائل القرب إلى الله أُسُسًا للبعد عنه، وكأنهم لم يكتفوا بذلك بل اتبعوا شهواتهم ورغباتهم الجسمانيّة، وطبّقوا دينهم على حسب أهوائهم.
إننا اليوم على خطر الوقوع في ذات الخسارة التي مُنِيَ بها السابقون من قبل؛ مسلمون لا يصلون لأن الصلاة تثقل عليهم! ولا يصومون لأن الصوم يشقّ عليهم! ولا يعرفون حدًّا في اتّباع الشهوات… وهذا هو الحال المشين الذي لوّث ماضينا وحاضرنا أيّما تلويث
بيد أن المؤمن هو المُجَسِّدُ بكلِّ أحواله للإيمان والأمن والاستسلام للحقّ، إنه هو الخاضع المتذلّل بين يدي الله تكتنفه القشعريرة من المحرّمات التي نهى ربّه عن إتيانها.
ب. أهمّيّة الصلاة
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: “مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ[5].
ويمكن أن نستنتج من مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن مَن ران على قلوبهم فلم يصلّوا وأصبحوا لا يوقّرون الناس ويُثيرون القلاقل ويعادون الدولة ويرهبونها بحِرابتهم ويُثيرون الفتن والاضطرابات هم أبناء الأهواء والرغبات، ومن ثَمَّ فهم ليسوا منا ولسنا منهم، ولكن إن لم نعدّهم منّا فمِمّن؟ أطلقوا لخواطركم العنان واعتقدوا فيهم ما تشاؤون، فلا مكان لهؤلاء في الدائرة القدسيّة التي حدّدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة مسألةٌ مهمّة للغاية، علينا أن نحتاط لها ونراعي الدقة فيها، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة حين حضرته الوفاةُ فقال: “اتَّقُوا اللهَ فِي الصَّلَاةِ، اتَّقُوا اللهَ فِي الصَّلَاةِ، اتَّقُوا اللهَ فِي الصَّلَاةِ (ثلاثًا)”[6]، وقال في حديث آخر: “بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ”[7]، وقال: “مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ”[8].
أجل، الصلاة مسألة مهمة جدًّا، ولكن إن كانت المشكلة في الإيمان فالمسألة أعظم أهمّيّةً وأكثر دقةً، فعنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ، وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟” قَالَ: لَا، قَالَ: “فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ”، قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: “فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ”، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيدَاءِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: “تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟” قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فَانْطَلِقْ”[9].
أجل، إن الإيمان هو السفينة التي تنقل المؤمنين إلى شاطئ السلامة، والصلاة هي أهمّ عنصر فيه، وكما يقول الشيخ محمد لطفي أفندي:
الـــــصـــــــلاة عـــــمــــاد الـــديــــــــــــن
وهي التــي تسيِّر سفينة الدين
فـــــهـــي رأس كُـــــــــــــلِّ عـــبــــــــــادةٍ
لــــــــذا فلا إسلامَ بــــلا صــــــلاةٍ
ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: “لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ”[10]، والآن يا تُرى! هل نحن نؤدي هذه الصلوات بشوقٍ واشتياقٍ أم لا؟ إنّني أرى أن الشوق والاشتياق للصلاة هما السبيل الأمثل للوقاية من النفاق.
[1] الطبراني: مسند الشاميين، 1/148.
[2] سعدي شرازي (606-690 أو 694 هـ): هو مشرف الدين بن مصلح الدين من شعراء الصوفية الكبار، ومن أرقّهم تعبيرًا، ولد في مدينة “شيراز” قدم بغداد استكمالًا لدراساته في علوم الدين في المدرسة النظامية، وكان من مريدي الشيخ عبد القادر الكيلاني، قضى ثلاثين سنة من عمره في الأسفار ونظم الشعر، وكِتابه “كلستان (روضة الورد)” مشهور، ترجمه الشاعر “محمد الفراتي” إلى اللغة العربية. (مترجم)
[3] صحيح البخاري، الأدب، 96؛ صحيح مسلم، البر، 165.
[4] صحيح البخاري، الحج، 15.
[5] صحيح البخاري، الصلاة، 28؛ سنن النسائي، الإيمان، 9.
[6] البيهقي: شعب الإيمان، 13/404.
[7] صحيح مسلم، الإيمان، 82؛ سنن أبي داود، السُّنّة، 15.
[8] مسند الإمام أحمد، 45/357.
[9] صحيح مسلم، الجهاد، 150؛ سنن الترمذي، السير، 10.
[10] صحيح البخاري، الأذان،24؛ صحيح مسلم، المساجد، 252.