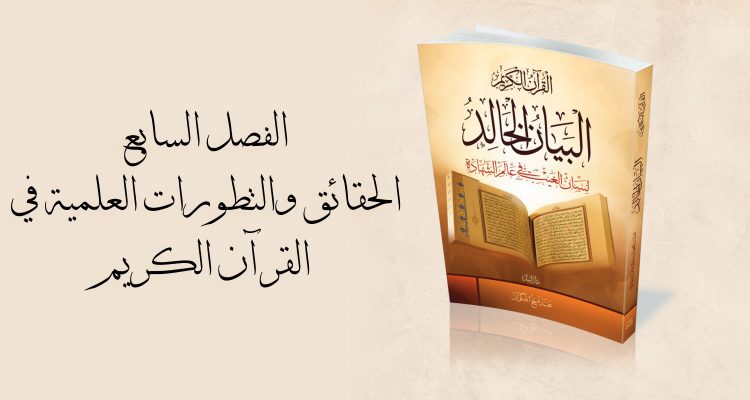أ. النظرة القرآنية الواسعة
إن الإنسان إذا تتبع القرآن آيةً آيةً فسيرى أن فيه إشارة إلى العديد من الحقائق العلمية على نطاق واسعٍ بدءًا من أعمق الأفكار والأحاسيس في الإنسان، مرورًا بأعظم الأنظمة والمجرات الكونية، وصولًا إلى عالم المثال والعوالم الغيبية.
فكما أن هذا الكتاب يتناول الإنسان ويفسره بميوله القلبية والروحية ومشاعره الظاهرة والخفية، فهو في الوقت ذاته يتحدث عن أوسع دوائر الكون وأبعد زواياها؛ فيلفت الأنظار في آن واحد من الكون إلى الإنسان، ومن الإنسان إلى طبقات الكون، فتارة يَفتح ذلك الكتاب الكبير أمام أنظار من يقرؤونه، وتارة أخرى يكثِّف الأنظار بتجلٍّ أَحَدِيٍّ على الإنسان.
ففي حين نراه يتحدث من خلال بعض آياته عن لدنيات الإنسان، إذا بنا نراه يشرع في الحديث عن السُّدُم والمنظومة الشمسية، فيتجول بنا في آفاق عالم المجرات، فهذا أسلوب يخصه هو، وهو بأسلوبه هذا يَلفت النظر إلى الكون جملة واحدة، فيُرينا كيف تتجلى الإرادة الكلية والقدرة الإلهية في الدائرة الواسعة والضيقة في آن واحد، وإليك مثالًا على ذلك من القرآن الكريم:
يقول الحق: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (سورة فُصِّلَتْ: 41/53).
إن الحق تعالى سيُري آياته للناس في الآفاق والأنفس واحدةً تلو الأخرى وعلى هيئة مجموعات متتالية حتى يذعن السوادُ الأعظم ويقر: بـ”أنه الحق”؛ وهذا القرآن “حقٌّ” جاء من “الحقِّ” ونشَرَ الحقيقة وصار ترجمانًا للكون والوجود.
إن هذه الآية تشمل كثيرًا من الحقائق المتعلّقة بالإنسان والكون، وتُبشّر بأن الأعوام القادمة ستكون أعوام القرآن، كما أنها تشير إلى حقيقةِ أن أعماق الكون سيتمّ سبرها إلى حدٍّ ما بفضل الأدوات التقنية التي يصنعها البشر، كما أنها تؤكد في الوقت نفسه على
أن الإنسان سيقطع شوطًا كبيرًا في سبر أعماقه الداخلية.
أجل، بفضل الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا المستمرة في التطوّر، تَوجَّه الإنسانُ إلى ذاته مرة أخرى، ووضَعَ نفسه على منصة التشريح ليعيد تفسير جوهره ويكتشفه، وبدأ بتفسير ذاته وتقويمها مرة أخرى في ضوء العلوم الحديثة؛ كالفيزياء والكيمياء والفلك والطب والهندسة بل وعلمِ النفس والتربية، وبذلك يكون قد بدأ بالدخول في تلك المرحلة التي أشار إليها القرآن الكريم.. ونستطيع القول: إن الجميع سيتفق على أنه الحق في النهاية.
والقرآن هو وحده الذي يعرِّف الإنسان بما يبث في قارئه من عشق الحقيقة والشوق إلى العلم والتوق إلى البحث، من دون أن يقطع علاقته بالكون، ومن دون أن يقطع صلة الكون بالله، ومع المحافظة على موقع الإنسان في الكون، ففي القرآن يجري الحديث عن الكون بالتزامن مع الحديث عن الإنسان، ويتم تحليل القلب في الموضع الذي يرِد فيه شرحُ الأوضاع العامة للمنظومة الشمسية والمجموعاتِ النجمية، ويدور القول حول لدنيات الإنسان بالتوازي مع لفت النظر إلى أعماق الكون.. وبذلك تتجلى فكرة التوحيد.
وستُواصل العلومُ سيرَها نحو التقدم بعد يومنا هذا أيضًا، وعلى قدر انكشاف العلوم سيتعمق فكر الإنسان؛ فمن جانبٍ ستنكشف المجاهيل في العالم المجهري تحت أضواء المجهر الإلكتروني وشعاعاتِ إكس، في حين أنه ستتم محاولة الاطلاع بأنواع المناظير العملاقة على كل صغيرة وكبيرة في أوسع دوائر الكون الكبير إلى أبعد حدّ يمكن التوصل إليه.. وهكذا فسيتم وضع كثير من الموجودات الأخرى غير الإنسان في دائرة البحث والدراسة، بحيث يَخضع كل شيء للتجربة والمشاهدة.. فحيثما تصل البشرية في نهاية المطاف فستسمع كلَّ شيء ينادي بلسان الحال أو المقال أنْ: “لَا إِلَهَ إِلَّا الله”.
فالقرآن يتحدث عن هذه الحقيقة على أنها بيان لـ”صاحب القرآن” الذي أوجد الكونَ بقدرته وإرادته، وهو القائل في كلامه العزيز: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (سورة فُصِّلَتْ: 41/53)، أي إن القرآن يحملُ دلالات وبشائر ووعود ربانيّة عديدة.
وقد كان الخطاب في الآية وقتَ نزولها موجّهًا للصحابة، ولا ندري ما فهمه ذلك الجيل الطاهر البريء، ولم تكن في ذلك الحين أدواتٌ تَرْصُد الآفاق، كما كان من غير الممكن التعرّف على كلّ جوانب النفس.. وأيضًا فلم تكن أشعّة “إكس (X)” قد اكتُشفت بعدُ، كما أنه لم يكن حينذاك المجهر الإلكتروني، ولكن القرآن كان يقول لهم: إننا سنجعل كلّ واحد في المستقبل يقول: “إنه الحق”، وهذا يعني أن هذه الآية كما كانت تفيد بالنسبة لهم أمورًا، فكذلك تهمس في أُذُن إنسان هذا القرن أيضًا بعديد من الأمور.
أجل، إن إنسان هذا العصر بفضل التكنولوجيا المتقدمة يُعتبَر مُدركًا -إلى حد ما- لهذه البشارة الإلهية، فلقد اكتُشفت أسرارٌ كثيرة حول تشريح جسم الإنسان، وتم تمشيطه بواسطة المجاهر الإلكترونية، وأجريت العديد من الأبحاث العميقة الأخرى في الآفاق والأنفس، وأصبح الوضع كأن فيه انفتاحًا على أبواب الغيب.
ومن جانب آخر يمكن الحديث في هذا السياق عن ملمح لطيف وهو: أن القرآن الكريم يَعرض الإنسانَ والكون للأنظار في آن واحد وفي نفس المستوى من الأهمية وبنفس الدقة، ويريد منا فهمَ كل الوجود في تكامل تام، وفي الخطّ الممتد من أعماق الإنسان الداخلية إلى زوايا الكون الشاسعة يؤكد على ضرورة البحث في كل الوجود، ولزومِ بذل الجهد في اكتشاف الآيات الربانية، بأن يصرِف الباحثون كلَّ ملكاتهم في هذا المجال، ويوجهُ إليهم أوامره الربانية وكأنه قائد يقول لجيشه: “انطلقوا”.
فهذه النكتة الدقيقة تدل على أنه إذا كان لا بد من البحث عن الاستقامة الفكرية حتى في العلوم البحتة فإنما يمكن ذلك بفضل إجراء البحوث بمقاربة كلية، من دون التغاضي عن المناسبة بين (الإنسان-الكون-الله)، وبالانفتاح على الآفاق والأنفس معًا.
والحاصل أن القرآن الكريم حينما يقدم معلومات عن السماوات والأرضين وكلِّ الوجود يستخدم أسلوبًا يتمتع بمستوى عال من قوة الإقناع بحيث يؤكد للإنسان أنه كلما قطع شوطًا في الاكتشافات والاطلاعات والاختراعات الجديدة، فإنه سيتقاطع طريقه في مرحلة من المراحل مع حقيقة من الحقائق القرآنية، ويُذكِّره بالأيام القادمة التي سيتّضح فيها تعلُّق كل شيء بالله.
وليس من المعقول أن يكون كلامُ خالق جميع الكائنات متناقضًا مع الكون والطبيعة والعلوم؛ لذلك ليس من الممكن بتاتًا أن تكون المعلومات التي استقيناها من القرآن متناقضةً مع المعارف التي أخذناها من الكون بأي وجه من الوجوه، طبعًا إذا أخذناها بطريقة صحيحة.
وإذا رأينا تناقضًا بين العلوم وبين القرآن، فإما أننا فهمنا القرآن فهمًا خاطئًا، أو أننا ظننا بعض الفرضيات المطروحة على بساط البحث “حقيقة علمية”.
ب. النظريات البشرية والحقائقُ القرآنية
إن العلوم الطبيعية على عكس العلوم العقلية والنظرية، ونقصد بالعلوم الطبيعية “العلوم المثبتة” التي تستند إلى التجربة والمشاهدة، وتبيّن صدقها بشتى طرق الإثبات.. فما تم إثباته من المسائل المتعلقة بعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء والفلك والطب وما شابهها إنما هو من هذا القبيل، ونحن نسميها “العلوم الطبيعية” باعتبار أنها من العلوم التي تم إثباتها.
والعلوم الطبيعية حسب العقلية السائدة في عصرنا هي مجموعات المعلومات المتشكلة من الفرضيات التي من الممكن تخطئتها في كل حين، ومنهم من يعتبرها: الأدوات والوسائل التي تمنحنا إمكانية التكهن حول ما في الكون من كائنات..
إلا أنه ليس من الصحيح أن نستخرج من مفهوم المخالفة لهذا التعريف أن العلوم التي
لا تدخل في مجالِ التجربة والمشاهدة هي من “العلوم المنفية”.
فعلينا أن لا نفسح المجال أمام بعض الفهوم الخاطئة على غرار ما وقع في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث تمكّنت (الجدلية) من عقل البشرية بقدر ما وعكَّرت صفو بعض الأذهان، فمن المعلوم أن بعض العلوم لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريق العقل وليس بالأدوات والوسائل المَخْبَرية. فكم من الحقائق لا تدخل في نطاق التجربة ولكن لها قواعد تخصها ولا يمكن التوصل إليها إلا عبر تلك القواعد، فمثلًا لا يمكن إدراك الله الواجب الوجود، بل ولا الملائكة الكرام والجنِّ والشيطان وما شابه ذلك من كائناتِ ما وراء الطبيعة بالعلوم الطبيعية، بل بالوحي والعقل والمنطق والوجدان والقلب والحس؛ لأن هذه المواضيع ليست من النوع الذي يُعالَج عبر المختبرات، ولا هي موضوعه أصلًا، ولا يمكن مشاهدةُ ذات النوع بالتلسكوب (المقراب) أو الميكروسكوب (المجهر).. وبالتالي يلزم توسيع مفهوم “العلم” بحيث يشمل جميع الأمور التي يتم إثباتها عن طريق الوحي والعقل والمنطق والحس والوجدان.
ولا بد لي من أن أُنبّه هنا إلى أن أكثر موجود تم التركيز على إثباته هو “واجب الوجود”.. صحيحٌ أن تعبير “إثبات” لا يُستخدَم كثيرًا في حق واجب الوجود، إلا أن صفات الله وأسماءه وشؤونَه الذاتية والملائكةَ الكرام والحشرَ وحقيقةَ النبوة لهي أكثر المفاهيم والمضامين التي يحاول العلماء إثباتها حتى الآن.
فهذه الأمور ظلّت إلى يومنا هذا تُتناوَل بالبحث، بمقاييس عقلية بلغت مستوى رفيعًا بحيث تبقى ما يسمونها “التجربة” باهتةً للغاية أمام تلك المقاييس، فقد ظهر على مرّ العصور كثيرٌ من القوانين والمبادئ والكشوفات المتعلقة بالساحة التجريبية وأصبحت اليوم طيَّ النسيان حتى بأسمائها.
أجل، كم من نظريات وفرضيات وأفكار كانت تفرض نفسها على الأوساط التاريخية والعلمية، ولكنها بدأت تهترئ وتتآكل ولا يؤبه لها رغم أنها لم يمض عليها قرن أو قرنان من الزمن، فمثلًا إنَّ “كانْط” و”لابلاس” اللذين شَغَلا بالَ أهل الفيزياء الفلكية بكل ما يملكان من أبهة وعظَمَة كان لهما أفكار أصبحت بالمقارنة مع تفسيرات عصرنا الراهن بمثابة أوراق الخريف تذروها الرياح.. حتى إن قانون الجاذبية المنسوب لنيوتن الذي لم يكن ليتزعزع، أصبح اليوم عرضة للنقاش من حيث بعض تفاصيله وجزئياته.
صحيح أن كل النظريات بحكم أنها تُعتبر من باب السُّلَّم المُوصل إلى الحقيقة، قد تهتز وتتزعزع، ولكن قد يأتي يوم يتم الوصول فيه إلى قوانينَ وحقائقَ راسخة -ولو نسبيًّا- لا تتزعزع ولا تهتز.. فنحن نعتقد بأن كلّ الحقائق ستأتي يومًا ما وتلتقي في جوهرٍ وخلاصةٍ قرآنية ، فمن المؤكد أنه ستتحقق في كل مرحلة زمنية بعض التطورات، وإذا لم تتعثر العلوم المتطورة والمعارف النظرية بعصرها الذي تعيشه، فإنها ستأخذ طريقها نحو التجدّد المستمر.
إن أرباب العلم الحقيقي يدركون جيدًا كيف أن نظريات لا حقيقة لها شغلت بالَ التاريخ ومختلفِ المحافل العلمية، وجعلتْها تتعثّر في طريقها نحو الحقيقة.
أجل، إن بعض المحافل العلمية لهي من أكثر المسارح لمثل هذا النوع من معارك العميان، ولكن هناك حقيقة وهي أن العلم دخل مرحلة جديدة تتّسمُ بأنها ستجعله يتجاوز نفسه ويسبقها محطِّمًا أرقامه القياسيّة ومتحرّرًا من أطره التقليدية التي لا تخرج عن عالم المادة، فإذا عاشَ العلم هذه المرحلة فسيهتفُ يومها قائلًا: “ربي الله”.
وحينذاك سيصل كلُّ عِلم واصلٍ ومُوصِل إلى الله إلى مستوى لا نهائي، ولن يتعرض بعد ذلك لانسداد الطريق أو للتعثر بأمور أخرى، ولن يتعرض للتعارضات والتساقطات كسائر الفرضيات الأخرى.
ففي هذه النقطة بالذات يضع القرآن لأرباب العلم هدفًا لا نهائيًّا، فيخلصهم من التعثّر بنظريات ذات أحكام مسبقة تعترض طريقهم، ويرشدُهم إلى أن يُوَلُّوا وجوههم شطر النقطة النهائية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بتطورات جديدة. فالقرآن هو جوهر الحقيقة وأساسها وخلاصتها، ولا مجال فيه للأخطاء والتصدعات والانكسارات،
وهو كتاب الله العزيز الذي أنزله مَنْ يدبر الكون بقدرته وإرادته، لا يأتيه الباطل من بين يديه (أي في المستقبل) ولا من خلفه (أي من الماضي).
حيث يقول الله فيه: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (سورة فُصِّلَتْ: 41/41-42).
أجل، إن هذا القرآن كلام الله العزيز الحكيم، ولا مجال لتسرّب الباطل إلى ما يتحدث عنه من الأخبار أو بما يتعلق بالماضي أو المستقبل، وقد مضى على نزوله قرابة ألف وخمسمائة عام، ولو مضى على ذلك عشرات الآلاف من السنين فلن تتبدل الحقائق التي أقرها.
أجل، فهناك من جانبٍ نظرياتٌ في طريقها نحو الانتهاء والسقوط، وبالمقابل هناك الآياتُ القرآنية التي تُنبئ عن حقائق لا تنطفئ، بل تُنادي صارخةً بالحقائق بصوتها الجهوري المدوي في سائر الأنحاء، وكم من نظريات شهيرة ستسقط وينتهي أمرها، في حين أن القرآن وما أخبر به من الحقائق سيبقى كما هو وسيحافِظ على جدّته ونضارته كأول يوم نزل فيه، لأنه كلام الله صاحبِ العلم المطلق، وهو ذو أنفاس أزلية وأبدية، معجزُ البيانِ وخارقٌ للعادة.
ليس من الصحيح المقارنة بين ما طرحتْه الفرضيات العلمية على بساط البحث وبين ما جاء به القرآن من الحقائق حتى ولو كان بينهما تشابه أو توافق بل وتطابق تام؛ لأن العلوم رغم ما حققتْه من تطورات كبيرة لا يمكن اعتبارها قد وصلت إلى منتصف الطريق، ولذلك فمن الخطإ ربطُ القرآن بالنظريات العلمية وأن يقال: “إن القرآن يقول: كذا وكذا كما تقول النظريات الفلانية”.
صحيح أن العلوم كلها ما هي إلا نتائجُ إلهاماتٍ من الله لبني البشر، فحتى لو كان الشخص ملحدًا فإن ما يقوله في الموضوع الذي يبحث فيه يُعَدُّ هو أيضًا نوعًا من الإلهام الرباني، وهناك حكمة إلهية في إيجاد التفكر والبحث العلمي، فالتفكر المجرّد والبحث العلمي البحت وإن لم يكونا في حد ذاتهما كافيين في الوصول إلى الحقيقة المطلقة، لكنهما من الوسائل الموصلة إليها، فلقد ربط الله تعالى العلمَ والبحوث العلمية بحقيقة وقيمة، بحيث إنه من سنة الله تعالى في من يبذل الجهد والطاقة لتحصيل المعرفة أن ييسر له طريق الوصول إليها، ويحقق له ذلك بقدْر مراعاته للأسباب الموصلة إليها سواء كان هذا الباحث ملحدًا أو مؤمنًا.
إن العلم والقرآن بمثابة عينين تنظران إلى نقطة واحدة، أو هما بمنزلة مقرابين ومنظارين متوجهين إلى شيء واحد، فهما وإن كانا في البداية شيئين مختلفين لكنهما وجهان لحقيقة واحدة، فالله تعالى الذي قدَّم أمام أنظارنا الكونَ وكأنه كتاب أو معرض أو قصر أو حديقة حتى نتأمل فيه، هو الذي أنزل القرآن أيضًا وكأنه كتاب إرشاديٌّ، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحقيقة إلا من خلال هذه الظاهرة ذات الجانبين.
وإذا نظرنا إلى ما وصل إليه الأمر في زماننا، فقد نلاحظ عدم انسجام بين بعض فروع العلم وبين الحقائق القرآنية، لكن هذا الأمر إما ينبع من عدم الإجادة في استخدام العلم، أو من فهمنا الخاطئ للقرآن الكريم؛ فكما أن العلم في يد غير المؤهلين له يكون بمثابة شخص أعمى، فكذلك الدين في نظر الجهال فإنه سيظل عرضة للتفسيرات الخاطئة.. وإنني أعتقد أن المختبر الذي يُجري بحوثًا صناعية وزراعية وكيميائية وفيزيائية إذا كان في يد رجال الحق الذين ارتبطت قلوبهم بالله فستكون له صبغة مختلفة تمامًا.
وخلاصة القول أن بني الإنسان إذا أصبحوا ذوي صلاحية في الكلام حول العلوم فسيُلاحَظ أن العلم والقرآن يتقاطعان في نقطة واحدة، وحينذاك سنجد إمكانية رؤية الأشياء وتفسيرها على حقيقتها، ولكن الواقع الحالي هو أن الكثير منا يعاني من ضعف في الرؤية أو عَمَى الألوان ويحتاجُ إلى إجراء عملية جراحية روحية، وما لم تنفتح القلوب على الإيمان فلا مجال لأن يكون هناك تفكير متوازن لدى العلم أو الإنسان
أو المجتمعات الإنسانية.
ولا يُتوهَّمْ أننا حينما نتحدث عن بعض الحقائق العلمية ننوي بذلك وضع القرآن تحت وصاية العلم، فالقرآن مُنزّه ومُبرّأٌ عن أمثال هذه الوصايات، بل الأمر على العكس تمامًا بالنسبة لنا؛ فغاية ما نريد أن نبينه هو أنه كلما تم تفسير العلم تفسيرًا صائبًا اقترب من القرآن؛ وما نحاول فعله هو أن نجمع في نظرتنا إلى القضايا العلمية بين الفكر الأبستمولوجي وبين ما يقدمه القرآن من الحقائق في قضية الخلق الأول، وخلقِ السماوات والأرض، وخلقِ الكائن الحي الأول والإنسانِ الأول بعد تهيئة كل الظروف اللازمة لاستمرار الحياة على وجه الكرة الأرضية، ونتحدثَ عن كروية الأرض ودورانها، ومنافع الجبال وغيرها، فننظرَ إلى هذه القضايا من كلا المنظورين، وهذا يعني معالجة القضايا وتناوُلها في خطّ مناسب لنظريّة المعرفة.
ج. تعبير عن تحسُّر يحزّ في النفس
هناك بعض الغافلين الذين خضعوا لتنشئةٍ أحادية الجانب تحت تأثير بعض الأوساط، يحاولون أن يُلقوا باللائمة على الإسلام في قضية خمولنا وتدهوُرنا الذي دام قرنين أو ثلاثة قرون، وبالمقابل هناك شريحة أخرى تظنّ كيل المسبات للجبهات الأخرى نوعًا من البراعة، وبهذا يحوِّلون نقاط الالتقاء إلى مسرح للتناحر والنزاع، كما أن هناك مجموعة أخرى ترى من البراعة أن تتعامى عما أهملتْه وقصرت فيه في هذا الباب وتتحيّن كل الفرص لانتقاد أجدادنا في كل ما فعلوه.. صحيح أن هناك في الماضي نوعًا من الخرافات تسربت إلى ما كان يمارسه المسلمون من التدين، وقد ألقت هذه الخرافات بظلالها على القرآن والإسلام، وإلى جانب كل هذه السلبيات فقد بُذلت في تلك الحقبة جهود كبيرة وأُنجزت أعمال جادة كثيرة، كما يوجد في عصرنا أعمال قد أُنجزت، وتم التغاضي عنها؛ وهذا من باب كفران النعمة.
إننا -كأمة- استطعنا على مرّ تاريخنا، أن نُنَشِّئ عباقرة حافَظوا أثناء تفسيرهم للقرآن على صفاء العصر النبوي والخلافة الراشدة، وقاموا من قبلِ ألف سنة بتفسيرات لبعض آيات متعلقةٍ بالعلوم والتكنولوجيا لم يتبين مغزاها إلا في هذه الحقبة، وقد أشَرْنا فيما سبق لهذا الموضوع، ولكن ما يحزّ في النفس هو أن هناك بعض النفوس المريضة التي اعتادت
أن تسبّ أمتها وماضيها لا تريد أن تتقبّل هذه الأمور بل تتغافل عن رؤية بعض الحقائق.
ففي حين أن العثمانيين حينما كانوا يبنون تلك الصروح المعمارية ومختلفَ الآثار الثقافية والمستوصفات ودُورَ العَجَزة والمحتاجين، كانت أوروبا لا تزال تتخبط في جهلها ووحشيتها، ولم يكن لدى أوروبا أيُّ دراية بألف باء المدنية.. ولكن المؤسف أن يكون هناك مثقفون مصابون بالدوار زائغو الأبصار لا يزالون متمادين في عنادهم ولا يريدون أن يلاحظوا ذلك بوجه من الوجوه، بل يواصلون -بكل وقاحةٍ- تشويهَ سمعة دولة كان لها وزنها على المستوى العالمي، ومهما كان الأمر فنحن من ثمرات تلك الجذور، ونحن أحفادهم بصالحهم وطالحهم، ومن الخطإ أن ننكر جذورنا ونسبَّ أجدادنا، كما أنه
من الخطإ أيضًا أن نفتخر بما صنعوه على عِلّاته.
وبعبارة أوضح نقول: إنه من اللازم علينا أن نتصرّف في إطار من المعقولية والوعي والإنصاف، فإن كنا لم نستطع أن نُطوِّر ما ورِثناه منهم من التراث الثقافي والحضاري، وصبَبنا الكبريت على جذورنا وجفَّفناها بالانبهار بالغرب، فإننا سنُعتبر منكرين لفضل الأجداد رافضين لإرثهم. أجل، لقد أتى علينا حينٌ من الدهر لم نتناول فيه القرآن بعمقه، بل حاولنا تقييم كلام الله تعالى بما استورَدْناه من أفكار وتصورات غربية، فبطبيعة الحال لم يتسنّ لنا أن نفهمه على حقيقته، ولم يكن لنا ذلك؛ لأننا حاولنا تصميم عالم يخصّنا نحن بمعاييرَ تنتمي لغيرنا، ولا بدّ لأمرٍ كهذا أن يبوءَ بالخيبة والخسران، وما كان لنا أن نقطع المسافات والأشواط بهذه الطريقة بتاتًا، بل كدنا نَفقد مصادر طاقتنا ونجفف قُدُراتنا بهذه الطريقة.
ولقد عشنا أيّامًا، كلّما دار الحديث حول التطوّر التقني والتكنولوجي كنا على الفور نشكك بأصولنا وأنسابنا، ونَكيل وابلَ الشتائم لأجدادنا بلا إنصاف، وعكرْنا صفوَ العقول بإثارة أسئلة من مثل: لماذا تَخلَّف العالم الإسلامي على الرغم من تناول القرآن لهذا الكم من المسائل العلمية والتقنية والحضارية؟ وحاولنا نِسبة التخلف للإسلام، والأدهى والأمرُّ من ذلك أننا لم نُتِح للقرآن فرصةً ليعبر عن نفسه، وحاولْنا تسلية أنفسنا بإلقاء اللائمة على سلفنا وأجدادنا الذين عاشوا قبل ثلاثة أو أربعة قرون بل الذين عاشوا قبل أربعة عشر قرنًا.. حتى ولو افترضنا جدلًا أنهم قصروا في هذا المجال فالذي يجب علينا أن نستفيده من ذلك الوضع الدروسَ والعبرَ بدلًا من اللومِ وملحقاته.
وأيضًا فإن مقتضى الأدب الإسلامي والإنساني أن يكون موقفنا منهم في إطار المبدإ الأساسي الذي يقول فيه الرسول : “اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ” ؛ لأنهم لم يترددوا في التضحية في سبيل فهم القرآن بكل ما يملكون، حتى بأرواحهم، ولهذا يترتب علينا قبل كل شيء أن نقوم بإصلاح عيوبنا نحن، وأن نوجِّه على الأقل كلَّ ما نملك من قوانا الفكرية وقدراتنا الذهنية وكل طاقاتنا وجهودنا نحو القرآن، وأن نحاول فهمه بحق، وأن نجعل ذلك هدفًا أساسًا في حياتنا.
د. المنظومة الشمسية في القرآن الكريم
إن نظرة القرآن إلى العلوم الطبيعية الكونية إجمالية، ولكن لا بد من التنبيه إلى حقيقة جلية وهي أن اختيار بعض الجمل والكلمات والحروف في الآيات المتعلقة بالعلوم يشير بشكل ملفت للأنظار إلى بعض الحقائق صراحة أو ضمنًا؛ لأن القرآن الحكيم نابع من العلم الإلهي الشامل، ولذلك فإن ما يشير إليه من المعلومات حتى ولو كانت إجماليةً، فإن لها تفوُّقًا على العلوم والتكنولوجيا مهما بلغت من التقدّم والرقي. أجل، فكما أن القرآن معجزٌ في تعبيراته وألفاظه فهو محيطٌ وعالٍ في محتواه ومضامينه أيضًا، صحيح أن هذا البيان الإلهي لا يتطرق إلى التفاصيل في المسائل المتعلقة بالعلوم، إلا أنه قد يُقدم لنا أحيانًا مفاتيحَ تؤدي بنا إلى أفكار واكتشافات جديدة كل الجِدَّة، فهناك بعض الحقائق لا يسهل شرحها إلا بصياغة عبارات مُسْهِبة، إلا أن القرآن كثيرًا ما يعبر عنها فيختصر الطريقَ بجملة واحدة أو بنصف جملة بل ببضع كلمات، ويختار في تعبيراته كلمات تشير إلى معظم القواعد والقوانين المقررة في العلوم بأسلوب لا يدع مجالًا لحدوث أيِّ شكٍّ وريبة في النفوس.
فمثلًا: حينما يصوِّر القرآنُ الشمسَ والمنظومةَ الشمسية ببضع كلمات، فإنه يبين خط سيرها من المبدإ إلى المنتهى بأسلوب رصين لا فراغ فيه من حيث المشاهدة والعقل والمنطق والحس، فلو نظرنا إليها من منظور علم الفلك لوجدنا أن كثيرًا من الأحداث المتداخلة قد تمّ اختصارها في بضع كلمات.
لنتأملْ قول الله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (سورة يس: 36/38). فالآية بمبانيها ومعانيها تُبيّن أن الشمس تجري وتسير نحو نقطة ستستقر عندها، وهذا المعنى واضح جلي يستطيع كل واحد أن يفهمه ويدركه، بحيث إن من له أدنى حظّ من اللغة العربية لن يجد صعوبة في فهم المعنى بتاتًا، وإذا تم التوجه نحو الكلمات والحروف فستنجلي منها معلومات حول تفاصيل الموضوع، كما أننا إذا رجعنا إلى التفاسير التي أُلِّفَتْ قبل خمسمائة عام فسنرى أن المفسرين كلهم فهموا من الآية المعنى نفسَه، وفي ذلك أوضح دليل على صحة هذا الفهم، فمثلًا إذا رجعنا إلى التفسير الكبير لفخر الدين الرازي الذي ألفه في أواخر القَرن السادس وبدايات القَرن السابع الهجري نراه قال بمثل ما قاله ابن جرير الطبري في تفسيره الذي ألفه قبل الرازي بما يُقارب ثلاثة قرون.
أجل، إن الإنسان ليحتار حينما يلاحظ أن هؤلاء حينما يتحدثون عن الشمس يُدْلُون بمعلومات قريبة من معلومات عصرنا، قائلين بأن الشمس جسم من العالَم المادي وهي جزء من منظومة معينة، بل إننا نرى أنهم حينما يأتون بهذه التفسيرات يُسندون آراءهم إلى ابن عمر أو ابن عباس أو ابن مسعود، وذلك علم لم يُسبَق إليه.
وأكثر ما يلفت النظر في الآية هو اللام في كلمة “لِمُسْتَقَرٍّ” حيث إنه يحتمل أكثر من معنى، وكل ذلك يؤيد المعلومات الفلكية المعتبرَة في هذا العصر، وقد ذكروا لـ”اللّام” ثلاثة معانٍ:
1- أن تكون بالمعنى الطبيعي والعادي لحرف اللَّام.
2- أن تكون بمعنى “في”.
3- أن تكون بمعنى “إلى”.
فعلى حسب المعنى الأول، يكون المعنى أن الشمس تدور حول نفسها وهذا الدوران يتم في مدة شهر تقريبًا، إلا أن كل قسم من أقسام الشمس لا يدور بالسرعة نفسها بالنسبة لغيرها، حيث إن سرعة الدوران في خط الاستواء تكون حوالي خمسة وعشرين يومًا، بينما يختلف هذا الأمر في المناطق القطبية فيتم الدوران في ستة وثلاثين يومًا.. أما في المناطق الأكثر عمقًا وفي الأجزاء التحتية لمنطقة البلازما يتم دوران كل شيء في سبعة وعشرين يومًا، ولو كانت الشمس كتلة جامدة لاقتضى أن يتمّ دوران كل جزء منها في نفس المدة على غرار كرتنا الأرضية، حيث إنه من المعلوم أن الكرة الأرضية تُكمل دورانها حول نفسها في غضون أربع وعشرين ساعة.
وتتحرك الشمس بسرعة هائلة تصل إلى 20 كم في الثانية صوب نجمِ “النسر الواقعِ (Vega)”، ويسمى المحور الذي تسير فيه في مصطلح علم الفلك “قبة الشمس (Solar Apex)”، وتصِلُ هذه السرعة في الساعة إلى 72 ألف كم، ويعني هذا أن للشمس طريقًا يخصّها، فتسير فيه على الدوام وتقطع طريقها نحو نقطة معينة.. فالقرآن الكريم حينما يقول: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (سورة يس: 36/38) يعني -والله أعلم- أن الشمس تسير وتجري وتدور في محور معين لها، فيشير إلى هذه المعاني كلها دون أن يدخل في التفاصيل.
وأهم شيء بالنسبة لحركة الشمس هو ارتباطُها بمدة محددة وسيرُها وجريانها إلى نهاية مقدرة لها، فهذه المعاني الثلاثة التي قدّرناها لحرفِ اللَّام تدل إجمالًا على أن الشمس تجري وتسبَح في مسار معين، بحركتها المقدرة إلى نهايتها المعلومة عند خالقها.
وقد ورد في تفسير كلمة “مُسْتَقَرّ” قولان: الزمان، والمكان.. فبناءً على أنه اسم مكان نقول: إن الشمس تجري نحو نقطة معينة، وهذه النقطة من الناحية المعنوية -والله أعلم- هي العرشُ الأعظم، ومن الناحية المادية فهي تشير إلى نجم “النسرِ الواقعِ” ومركزه، كما يشير البيت الحرام إلى حقيقة الكعبة.. وإذا اعتبرناه اسم زمان يكون المراد أن حركة الشمس وفعاليتها محددة بوقت معين، فإذا انتهت تلك المدة يكون دَورُها الحاليُّ منتهيًا أيضًا.
وتقول بعض المعلومات الفلكية: إن سياحة الشمس الحاليةَ هي التاسعة عشرة من عمر الشمس الذي قُدر بـ 4.6 مليار سنة، وأيضًا تقول التخمينات العلمية: إن الشمس قد حَققت هذا المقدارَ من الجريان في غضون 250 مليون سنة، إلا أنه من غير الممكن التنبؤ بما ستحققه وتكرره في المستقبل، والحقيقة أنه يمكن للشمس ألا تتجاوز حدود سياحتها التاسعة عشرة وهي تجري اليوم في الساعة الواحدة بسرعة 72 ألف كم نحو آفاقها التي تتحول وتتبدل فيها، كما أننا نحن أيضًا نسير نحو نقطة سنتعرض عندها للتحول والاستحالة، إلا أن هناك حركة دائرية للشمس وهي مهمة وجديرة بالتوقف عندها طويلًا، تتوقف على تفسير اللام في “لِمُسْتَقَرٍّ”: بمعنى “في”.
وتسمى حركة الشمس أو أيِّ نجم آخر حول محورها أو حول أي جسم آخر بـ”الحركة الدائرية” -ويمكن أن نسميها بـ”الحركة المغلقة” أيضًا-، وبناء على هذا فإن الجسم الذي يتحرك وهو يدور يكون دائرًا حول نفسه في الوقت الذي يجري فيه ضمن محور معين، إلا أن النقطة المشتركة بين الآية المتعلقة بهذا الموضوع وبين الآيات الأخرى المشابهة هي كون جريان الشمس “في فَلَك” وبشكل دائري، وليس حركة في خط مستقيم، قال تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (سورة يس: 36/40)، ويمكننا أن نعمم الآية أكثر فنقول إن كل الأجرام السماوية تتحرّك بالطريقة التي تُشْبه حركات الشمس.
و”مُسْتَقَر” في قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (سورة يس: 36/38) تهمس في ذهن الإنسان بمعان من هذا النوع.. وبينما تدور الشمس وتجري نحو نهاية مقدرة لها، يكون بطبيعة الحال لهذا تأثير وتغيير على حركة الكرة الأرضية أيضًا، فحينما تسير الشمس وتقطع طريقها تتحرك الكرة الأرضية معها في طريق حلزوني، وكأنها تقطع كلّ سنة مسافة تتغير وتطول، ونفهم من كل هذه الحركات المتداخلة أن الشمس في تحرُّك دائم، وكل ذلك لا يعني أنه تحرُّك لا نهاية له، فستنتهي هذه الرحلة عند النقطة التي حددتها القدرة القدسية، وحينذاك ستقوم القيامة على حسب أحد الاحتمالات في هذا الباب.
والحقيقة هي أن المنظومة الشمسية لا تَشغل إلا حيزًا صغيرًا جدًّا ضمن مجرة درب التبانة؛ لأن الشمس ما هي إلا واحدة من مليارات النجوم الموجودة في درب التبانة، فالله تعالى نظَّم درب التبانة بحيث إن الشمس تبعد عن مركزه بمسافة 30 ألف سنة، بمعنى أن الشمس إذا سارت بسرعة الضوء فليس لها أن تصل إلى مركز درب التبانة إلا بعد 30 ألف سنة.
وعلى غرار سائر المنظومات صغيرها وكبيرها، فإن مجموعة درب التبانة أيضًا تتحرك وهي تدور حول نفسها، وبالتالي فإن الشمس أيضًا تدور، وفي الوقت نفسه تتقدم وتسير مع أُسرتها حول مركز مجرتنا التي تتشكل من الأجرام السيارة والمُذَنَّبات وسائر الأجرام السماوية.. وسرعةُ الشمس في سيرها في هذا المجال أشد هولًا، حيث إن هذه السرعة تقدَّر بـ 268 كم في الثانية، ولكن من حيث إن مدارها واسع جدًّا فهي لا تستطيع أن تكمل شوطًا واحدًا في هذا المدار إلا في حوالي 250 مليون سنة، إلا أنها كما قلنا على غرار الأجرام السماوية الأخرى على اختلاف أحجامها، “تَسبح” -حسب التعبير القرآني- وتسير نحو نهايةٍ مقدَّرة لها.
وكل المجرات تقريبًا تابعة لمجموعات معينة، ومجموعة درب التبانة أيضًا تابعة لمجموعة صغيرة تحتوي على 20 مجرة.. وفي كل مجموعة تدور المجرات بقوة جاذبية حول بعضها البعض، وكما أن في كل مجموعة هناك حركة داخلية منتظمة، فكذلك المجموعات بشكل عام هي أيضًا تتحرك بحركة كلية متّسقة مع عموم المجموعات الأخرى، وفي هذا السياق ننبّه إلى أن كل مجموعة تتحرك مبتعدة عن الأخريات، وبناء على هذا فإن من يرصد من الأرض هذه التحركات فسيلاحظ أن كل المجموعات تبتعد بسرعة عن مجموعة درب التبانة، في حين أنه إذا كان هناك من يرصد من أي مجرة أخرى فسيلاحظ أن المجموعات الأخرى تبتعد عن مجموعته هو.
إن كل مجموعة من المجرات تتحرك بسرعة تتناسب طرديًّا مع بُعدها عن غيرها، فمثلًا إن سُدُمًا بعيدة عن الأرض بمسافة مائة مليون سنة ضوئية، تتحرك في ثانية واحدة بسرعة 2500 كم، بينما المجرة التي تبعد مسافة 500 مليون سنة ضوئية تتحرك في ثانية واحدة بسرعة 12 ألف كم، فحركات الشمس التي تبدو متداخلة ومعقدة جدًّا هي في حد ذاتها منتظمة بدقة وانتظام ستنتهي في “مستقر لها”.. وبطبيعة الحال إن الشمس التي ظلَّت منذ أربعة مليارات و600 مليون سنة مُنْتِجة للطاقة وباعثة فيما حولها الضوءَ والحرارة سينتهي وقودها يومًا ما، ويقول العلماء: إن الشمس لن تُواصل وضعها الفعال الحالي إلا مدّة خمسة مليارات من السنين، فهذا كلامهم.. ليقولوا ما يقولون.. ولكن الموضوع قابلٌ للنقاش، ومن المحتمل أن الشمس في نهاية المطاف ستنتفخ إلى أقصى درجة وتصبح عملاقة حمراوية فتبتلع كرتنا الأرضية، وبعد هذه المرحلة بمليار سنة ستنهار فجأة وتتحوّل كرةً بيضاءَ منطفئة، هذا إذا لم يَسبق عليها الكتابُ ولم يَقطع سببٌ آخرُ طريقها نحو هذه النهاية.
وأيضًا فالشمس إنما تتحرك ضمن مجرتها مرتبطةً بمركزها، فكل حركاتها محددة بدرب التبانة، كما أن كل تحركات منظومة درب التبّانة محدّدة بمجموعتها، ومن وراء كل هذه المنظومات والمجرات هناك قوة قدسية، وهي التي تمنح كل شيء قابليةَ وإمكانيةَ الحركة، هذه القوة القدسية تتصرّف بشكل كامل في كل الأنظمة والمجرات، وتنظِّم كل الأحداث الهائلة باعتبارها قصائد تكوينية دالة على وجودها وأحديتها، وهذه القوة القدسية تَنبُع من الأسماء الإلهية والصفات القدسية. أجل، إنها الكامنة وراء كل شيء، وعلى حسب تعبير الإمام الرباني أحمد السرهندي: إن وراء وراء وراء الوراء هناك تصرف الله وتقليبُه كما يشاء. أجل، إذا كانت اللام في “لِمُسْتَقَرٍّ” بمعنى إلى فيكون فيه إشارة إلى هذه المعاني.
ولا بدّ من الاعتراف بأنه لو لم تحثّ الآيات على العلوم والتقنية، ولم يَستتبع ذلك اختراع المقراب، ولم يرصُد العلماءُ المكتشفون للفضاء لما كان لنا أن نفهم أيًّا من هذه الأمور، فبفضل هذا كله نستطيع أن نستخدم ما بأيدينا من المعلومات التقنية في فهم الآيات القرآنية المتعلقة بالمنظومة الشمسية، وكلما تهيَّأ لنا من الأدوات والوسائط ما نمضي به قدمًا في هذا الباب، فإننا نكون أوفرَ حظًّا في الاطّلاع على الآفاق الجديدة التي أشار إليها القرآن.
ومن يدري لعل القرآن يشير إلى حقائق كثيرة من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للعلوم والتقنية هي بانتظار الباحثين من عشاق الحقيقة ومحبّي العلوم، فالقرآن يشير إلى مثل هذه الأمور بأسلوبه الخاص به ويأتي بتذكيرات مجملة فيذكُرها في إطار التأكيد على القضايا الإيمانية حتى نؤمن به.
أجل، هذا هو أسلوب القرآن؛ فنراه يثير في الإنسان حسّ الفضول بقوةٍ نحو آفاق مجهولة بالنسبة إليه ويحفز فيه الجنوح إلى التفكر، فيصرّح أحيانًا ويكتفي بالإشارة الخفيّة أحيانًا أخرى، فصحيحٌ أن فيه تبيانًا لكل شيء، إلا أن الذين يدَّعون أن فيه كلَّ شيء بتفاصيله يكونون مبالِغين في قولهم هذا، بينما يكون الذين يتغاضون بالكلية عما فيه من الإشارات والتوجيه نحو بعض الأهداف والأمور الإجمالية من جملة العُمي تجاه القرآن.
وبعد هذه الآية التي تتحدث عن الشمس تأتي آية تشير إلى القمر وأنه هو أيضًا يسير في طريق له قائلةً: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ (سورة يس: 36/39).
أجل، إن القمر يسير فيما عُيِّن له من مسار، وإذ يتحرّك في محوره يواصل -في الوقت نفسه- طريقَه في محوره حول الكرة الأرضية.. فهاتان الحركتان كلتاهما تنتهيان في كل سبعة وعشرين يومًا وثلث اليوم.. فمدتهما متساويتان إلا أن القمر حينما يدور في فلكه حول الأرض يختلف مقدار ضوئه الذي يقتبسه من الشمس ويعكسه على الأرض، فلذلك نرى منظره أحيانًا مثل العرجون القديم، بمعنى أنه يكون في شكله مثل ورق النخيل الجاف، والعرجون عود العذق اليابس المنحني من النخلة إذا أعتق ويبس وتقوس وهو يشبه الهلال إذا انحنى واصفرَّ.
ومن السهولة فهمُ أن هذه الآية تتحدث عن القمر، فالقمر يتنقل من منزل إلى آخر، وفي كل منزل يكون له منظر مختلف، فيبدأ من مرحلة لا يعكس فيها أي ضوء، ثم ينتقل إلى مرحلة يبدو فيها هلالًا، ثم يكبُر الهلال شيئًا فشيئًا إلى أن يبدو بنصف قطره، ثم يعقبه البدر، فنرى وجه القمر المتوجه إلى الأرض قطرًا نيرًا بكامله، ثم يبدأ الأمر بعكس ما بدأ، فينقص الوجه المتلألئ إلى أن يصل إلى مرحلة يرجع هلالًا يبدو فيها كالعرجون القديم.
والقمر أيضًا في ضمن المنظومة الشمسية، يكون في دوران مستمر حول الأرض بقوة الجاذبية، وبالتالي يتحرك بتحرك الأرض والشمس.. والآية المذكورة تقول بتحرك القمر في منازلَ مختلفة، كما أن قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾ (سورة الشَّمْسِ: 91/1-2) يدل دلالة واضحة على أن القمر يدور مع الأرض في مسار تابع للشمس ويدور حولها، كما يفهم من قوله: “تَلَاهَا” أن القمر يتبع الشمس، فاختيار هذا التعبير من الدقّة والتصوير بمكان.
وقضية دوران القمر حول الأرض من الحقائق التي كانت تُعرف منذ زمن بعيد، وأما دورانه حول محوره فيتطابق مع دورانه حول الأرض، ويُنهي سياحته التقويمية في حوالي تسعة وعشرين يومًا ونصف اليوم، وقد تقرر لدى علماء هذا الشأن أن سرعة دوران القمر حول نفسه أثناء سيره في محور الأرض تكون في الساعة الواحدة (3683) كم.
إن القرآن الكريم لا يدخل في التفاصيل بل ينوط الأمر بالغاية من وضعه، ويتطرق إلى موضوع دوران القمر حول الأرض، وما يعتري القمرَ من اختلاف في المنظر لوقوعه في زوايا تختلف عن الأرض، لمروره بمنازل في غضون الشهر الواحد، ويسمي ما يتراءى لنا نحن باعتبار تطابقه أو تقاطعه مع بعض الأبراج السماوية “منازل”.. وحينما يمرّ القمر بهذه “المنازل” تتغير ساحة الضوء الذي يقتبسه من الشمس، فلذلك نراه
في مَظاهرَ مختلفة.
وظهور القمر في كل منزل بمظهر مختلف على مدى الشهر الواحد يمنحنا فرصةَ حسابِ الشهور والأعوام، كما أنَّ تكرُّر هذه الأمور ذو أهمية بالغة لنا من حيث تعيين أوقات عباداتنا، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/189).
ويتلخص من هذا ومما ذكرناه عند حديثنا عن الحركات الدائرية للشمس، أن الشمس والقمر والنجوم تجري وتَسبح كل منها على حدة في أفلاكها، وتُعلن بذلك تقدير العزيز العليم.
هـ. الأنظمة التي تَسبَح في الفضاء
لو قام شخص قبل أربعة أو خمسة عشر قرنًا من الزمان وقال للناس: إن الشمس والقمر والكرة الأرضية ومليارات من الأجرام السماوية تَسْبَح في محاور معينة من الفضاء، فلست أدري ماذا عسى أن تكون ردة فعلهم؟ ولكن هذا الأمر الذي أصبح اليوم في عداد البدهيات هو من الحقائق التي تحدَّث عنها القرآن في تلك العهود الغابرة، وذلك ما يصرح به قوله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (سورة يس: 36/40).
ولفظ “كُلّ” من ألفاظ العموم، وقد ورد في هذه الآية منوّنًا، والتنوين يفيد التنكير، وهذا يعني أن اللفظ شامل لجميع الأجرام الموجودة في الفضاء، وهي كثيرة لا يكاد يُحصى عددها، وكلُّها تَسبح في أفلاكها.. ويمكن فهم كلمة “فَلَك” هنا بمعنى المدار الذي تسير عليه الأجرام السماوية، أو الالتزام والانضباط ضمن الدائرة العامة والانسجام العام، حيث إنه من المعلوم لدى الجميع أن جميع الأجرام السماوية تَجري نحو نقطة معينة على هيئة مجرات بسرعات مختلفة، وكلُّ مجموعة من المجرات تأخذ بالابتعاد عن سائر المجرات الأخرى أثناء هذه السياحة الفضائية، وحينما يتحدث القرآن الكريم عن هذا النوع من التحرك لا يستخدم تعبير “التجول” أو “التحرك بتأثير من جسم آخر”، بل يختار تعبير: “السباحة”.
أجل، إن كل الأجرام السماوية في الفضاء تَسْبَح مثل ما تَسبح السفن أو الأسماك، فقد تم التعبير عن هذا الأمر، بجملة واحدة، بمنتهى الجمال والوضوح، وروعيت فيها الأحاسيسُ الشاعرية مع الأسلوب العلمي، حيث يُفهم منها بجلاء أن كل شيء بدءًا من الكرة الأرضية وانتهاءً بالشمس والقمر وسائرِ الأنظمة يجري ويَسبح في مَدارات معينة.
والواقع أننا تناولنا هذا الموضوع هنا بأسلوب إجمالي يلائم مستوى العامة، وإلا فلو تم تناول الموضوع بأسلوبِ علم الفلك لجذب وشد انتباه أهل الاختصاص في هذا العلم أيضًا.
وهناك أمر آخر تمت الإشارة إليه هنا وهو أن السباحة لا تتم في الفراغ بل في المادة، فالآية الكريمة حينما تقول: إن الأجرام السماوية تَسبح، تكون مشيرة إلى أن تلك الأجرام العملاقة حينما تجري في الكون لا تكون جارية في فراغ بل تتحرك في المادة، بمعنى أن الفضاء ليس فراغًا هائلًا بل إنه بحر من مادة لطيفة تَسْبَح فيها هذه الأجرامُ العملاقة.
وهناك مادة لا تُرى بالبصر يسميها العلماء “المادة المظلمة” (مادة الأثير)، وإذا تم الكشف عنها وتجليتُها في إطار البحوث الفلكية، فسيؤدي ذلك إلى إعادة النظر في كثير من القضايا، علاوة على أن الكشوفات في هذا الحقل ستشكل نقطةَ تحوُّلٍ في بحوث علماء الفلك، فهناك مَنْ يدَّعون بأن “المادة المظلمة” التي لا تُرى تُشكِّل تسعين بالمائة من إجماليِّ المادة في الكون، بمعنى أن النجوم ومجموعاتِ الكواكب والمجرات والغازات وسائر المواد التي تم اكتشافها لا تُشكِّل إلا عُشر هذه المادة التي لا بد
من وجودها في الكون.
ولذلك لا بد من وجود عشرة أضعافِ ما تم اكتشافه في الكون من المادة حتى تتشكل -بالإذن الإلهي- الأجسامُ الموجودة في الفضاء وتؤدي وظائفها، وكان العلماء في السابق يعتقدون أنه لا يوجد فيما بين الكواكب أية مادة، وأن الفضاء عبارة عن فراغ هائل، وعلى هذا فإن دلالة قوله تعالى: “يَسْبَحُونَ” -ولو بطريق الالتزام- لهُو أمر مهم من حيث تحقيق أهداف القضايا التوحيدية، وهناك كثير من رجال العلم في وقتنا الحالي يشددون على احتمال أن تكون تلك “المادة المظلمة” (المادة غيرُ المرئية) التي تملأ الفضاء عبارةً عن بعضِ ما سنذكره من المواد أو من جميعها.
النيوترونات: وهي أقارب الإلكترونات التي هي أصغر بكثير من الذرات، فهذه المواد ليس لها شحنات كهربائية، وتتفاعل مع المواد العادية بشكل ضعيف جدًّا فلا يتم الإحساس بها، ويقال: إن هناك كميات لا حصر لها من هذه الموجودات التي هي في غاية الصغر، وكتلتها خفيفة جدًّا بحيث إنه يمر من سنتيمتر مربع من أي مكان من سطح أجسامنا مثلًا في كل ثانية ستون مليونًا من جسيمات النيوترونات.
الجسيمات الثقيلة ضعيفة التفاعل: (WIMPs) (Weakly Interacting Massive Particle)
وهي جسيمات ذات كتلة لها تأثير ضعيف، وهي مادة باردة (قليلة الحركة) مظلمة وداكنة، ولها وجود نظري.
الأجسام الهالية المضغوطة الثقيلة: (MACHOs) (Massive Compact Halo Objects)
وهي إما كواكب مجهولة المعالم بحجم كوكب المشتري، أو هي النجوم النيوترونية الأقزام البيضاء.
الثقوب السوداء: هي كائنات تتمتع بحالات جاذبية شديدة، لا يستطيع شيء حتى الضوءُ من التفلت منها.
ومن المعروف أن قدرًا كبيرًا من الأدلة يدل على وجودها في إطار النظرية النسبية العامة.
كرات البولينج: هذه أشياء يجد علماء الفلك صعوبة في التعرف عليها وتحديدها؛ لأنها بالإضافة إلى كونها خارج القوانين الفيزيائية المعروفة، تكتنفها مشاكلُ مشابِهة للأجسام الهالية المضغوطة الثقيلة.
وكما يفهم مما ذكرناه إلى الآن، فإن التعبيرات القرآنية تتسم بخاصية يستفيد منها الناس من كل المستويات بدءًا من العامي، مرورًا بالعالِم المتخصص في علم الفيزياء الفلكي، ووصولًا إلى الأديب الذي يتمتع بذائقة أدبية، كما أن العلماء في كل الأدوار التاريخية يستنبطون منها معاني مختلفة ويلتقطون منها رسالات توجههم إلى أهداف جديدة تختلف على حسب التطورات الجديدة وتفسيرات الزمان.. صحيح أن القرآن لن يشرح لنا القضايا العلمية بتفاصيلها التي نأخذها من المختبرات والمراصد الفلكية، لكنه يذكر حقائق هي مقاصد أساسية لها ويشرحها لنا بالقدر الذي ينبغي شرحه، نلاحظ أنه إذ يلقي علينا خطبته سيؤكد لنا إما بطريق الإيماء أو الإشارة أو الرمز أو بالمعاني الثانوية التي توحي بها الهيئة التركيبية العامة على أن الكون الذي هو كتابه المنبثق عن صفة “القدرة والإرادة” متّصلٌ اتصالًا وثيقًا بالقرآن الذي هو بيانه المنبثق من صفة “الكلام”.
ونحن بهذا نكون قد أكّدنا على أن القرآن ليس كتاب علوم ولا فلسفة، كما نكون قد أشرنا إشارة صغيرة إلى ما عسى أن يدور بخَلد بعض من لا يعرف الحكمة من نزول القرآن، وإلى ما قد ينتابه من اعتراضٍ مفاده: لماذا لا يصرح القرآن عن كل شيء وكل حادثة بوجه صريح؟
و. إزالةُ نور القمر، وآيتا الليل والنهار
إن العلوم كلّما تطوّرت وتقدّمت فسيقترب الإنسان من القرآن وسيحظى بالتعرف على آياته. أجل، إن الإنسان إذا تناول الآيات القرآنية وتأمَّل ما في كلماتها من الفروق الدقيقة فسيرى بجلاءٍ مدى تطابُق بعض الحقائق العلمية مع البيان القرآني، فمثلًا إذا نظر فقط إلى مجمل معنى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ (سورة الإِسْرَاءِ: 17/12)، فسيرى أنه قد ذُكر فيه كثير من الحقائق المتعلقة بالليل والنهار. أجل، سيفهم هذا وإن لم يدقِّق ولم يتعمق في تفاصيل الكلمات.
فحينما ينظر الإنسان ليلًا أو نهارًا إلى السماء، فأوّلُ ما يشاهده آيتان دالتان على وحدانية الله تعالى، وهما: الشمس التي هي آية النهار، والقمرُ الذي هو آية الليل.. فالله تعالى حينما يذكر هنا علامتين إحداهما من علامات النهار والأخرى من علامات الليل، يذكر في سياق ذلك أمرًا له مغزى كبير وهو أنه قد أطفأ نور القمر الذي هو علامة الليل، فلم تَبق له خاصية الإشعاع الذاتي كما هو الأمر بالنسبة للشمس.
ومن المعلوم أن القمر لا يعكس إلينا إلا جزءًا من الضوء الذي يأتيه من الشمس، ولذلك نرى أن الشمس بما تبعثُه من الإشعاع يُحوِّل الليل إلى نهار ويَظهر كلُّ شيء تحت ضوئه واضحًا جليًّا، في حين أن القمر لا يعكس النور إلا في إطار محدود، بحيث لا ينجلي تحت ضوئه إلا شيءٌ يسير، فالآية الكريمة تقول: ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ وهذا يبيّن بوضوحٍ أن القمر ليس له ضياء، حتى إن المفسّرين في العهد النبوي (عصر السعادة) قد فهموا بكل سهولةٍ من الآية نفسَ ما نفهمه نحن في هذا العصر، كما في تفسير المفسرين في القرون الأولى، كابن عباس وكذا ابن جرير الذي جاء بعده بثلاثة قرون، حيث إن ابن جرير الذي ألف تفسيره قبل (1100) سنة من الزمن، يَروي عن ابن عباس قوله: “كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، وهو آية الليل فمُحِي، فالسواد الذي في القمر أَثَرُ ذلك المحو” .. مع العلم بأنه يكون من الصعب علينا أحيانًا أن نُقنع بعض الناس في زماننا بأن القمر قطعةٌ انفصلت من الشمس، ولكن ابن عباس استطاع أن يعبِّر عن هذا قبل أربعة عشر قرنًا من الزمن، ولم يتصد أحد للاعتراض عليه!
وهنا قد يخطر على البال سؤال مُؤَدّاه: ما الحكمة في محو علامة الليل، وإبقاءِ ضوء النهار؟
والجواب على ذلك يأتي في ذات الآية وهو قوله تعالى: ﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ (سورة الإِسْرَاءِ: 17/12).. بمعنى أن ضوء القمر قد أُطفِئ مثل ما يُطفَأ المصباح، ليَعمل الناسُ بالنهار ويَخلدوا إلى الراحة بالليل، ولولا ذلك لانقلب كل شيء رأسًا على عقب واختلّ التوازن، ومن المحتمل أن الطبيعيين يُسنِدون كل ذلك إلى الصدفة، ولكن الحق أنه ليس للطبيعة أي تأثير على سبيل الحقيقة، لا في هذا ولا في غيره من الأمور.
ولا أريد أن أسهب في الكلام هنا حول هذا الموضوع، ولكني أريد أن أقول باختصار: إن هناك بعض الطبائع الذين تشوشت أذهانهم بالعديد من الفرضيات لا يريدون أن يفهموا هذا الأمر على حقيقته، ولكن الحقيقة هي أنه ليس للطبيعة والأسباب أيُّ تأثير لا في وجود الكون ولا في ديمومته، فكون كل ما في الكون في مكانه المناسب، وإناطتُه بمئات من الحِكم والمصالح يناقض هذا ويرفضه رفضًا قاطعًا، والمُحزِنُ أنَّ إنسانَ عصرنا لم يُشرَح له روحُ الدين وأسرارُ الكتاب المبين وجوهرُ الإسلام، فنشأ قابلًا لابتزاز الآخرين وخداعهم، بل إن الجموع في بعض المناطق انجرفوا إلى مهاوي الإلحاد والطغيان. وعلى الرغم من أن القرآن يتناول هذه المواضيع، ولكن قَلَّ أن تجد مِن الذين يؤمنون به ويَتْلُونه مَن يَطَّلِعون على ما فيه من الإيماءات والإشارات والدلالات المتعلقة بالعلوم والفنون والتقنيات، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون إنساننا البعيدُ عن القرآن ومعاني القرآن بمنأى عن التطورات العلمية والفنية، فنحن نعيش في عصر يُهمِل فيه حتى رجالُ العلم هذه الحقائقَ، فما بالك بالجموع الجاهلة.
وهناك أمر آخر، وهو أن المعلومات المتعلقة بالعلوم الطبيعية حتى تلك المتعلقةُ بالفيزياء والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء لم تكن من الحقائق الثابتة التي لا تقبل النقاش، بل فيها كم كبير من المعلومات التي قالها أصحابها تحت تأثير ثقافات عصورهم وأصبحت اليوم في عداد الأساطير. أجل، لقد كان علماء الفلك إلى هذا العصر قد طرحوا على بساط البحث عديدًا من الأفكار المتعلقة بعلم الفلك، ولكنهم بسبب شحّ إمكاناتهم المتاحة، وبدائيةِ ما بأيديهم من آلات الرصد والمراقبة وغيرِها من الأسباب، بقيتْ معظمُ ما لديهم من المعلومات في مستوى التخمين.
فإذا أخذنا هذه الأخطاء بعين الاعتبار ثم نظرنا إلى القرآن الكريم فسنرى أنه أشار في مرحلة مبكرة جدًّا إلى أمور مختلفة.
وكما هو الحال في العديد من فروع العلم، قد أدى نشوءُ التخصصات الجديدة في علوم الفلك والدراسات الجيولوجية-الجيوفيزيائية في القرن العشرين إلى تكوُّن نظرات ورؤى جديدة، فالتقنيات والعناصر التكنولوجية المؤسَّسة على هذه التركيبات والرؤى الجديدة ستساعدنا على الوصول إلى معلومات أكثر دقة وصحة، وستكون هذه التطورات في معظمها بحيث تُصدِّق ما يقوله القرآن في هذا الباب، وسيتَّضح جليًّا على الأقل أنه ليس بين الحقائق العلمية والقرآنِ أيُّ تَعارض وتصادم.. ونحن نعتقد أنه سيكون بإمكان القرآن أن يبين لنا بكثير من آياته الحقائقَ العلمية المتعلقة بالكرة الأرضية أو السماء تِبيانًا مختصرًا غيرَ بعيدٍ عن الصراحة.
ز. توسيع السماء
لقد دأَبَ رجال الفكر والعلم على رصد السماء، وطوروا في هذا السبيل مختلف الأدوات التقنية، إلا أنه لما لم يتسن إذكاء جذوةِ تحري الحقيقةِ وحبِّ العلم وشوقِ البحث في النفوس، لم يُكتب لهذه الدراسات التطورُ والتقدم إلى الأمام على الوجه الذي ينبغي، أما علماء عصرنا فإنهم توجهوا مرة أخرى نحو أعماق السماء فاستخدموا مرة أخرى كل الإمكانات التقنية والتكنولوجية، واستطاعوا أن يحصُلوا على معلومات جديدة أدقَّ وأعمقَ من تلك المعلومات السابقة، فظهر في ضوء هذه المعلومات مجددًا أن القرآن الكريم لا يتعارض مع العلوم الحديثة بل إنه في مجمله متطابق معها تمامًا، حتى إنه بما يورده من إشارات في خواتيمِ الآيات يذهب بالموضوع إلى شوط أبعد.
فهاك مِن ضمن بيان الله المعجز آيةً تتعلق بذكر توسُّع الكون بشكل مستمر وهو قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (سورة الذَّارِيَاتِ: 51/47).
فكثير من المفسرين المتقدمين والمتأخرين من أمثال ابن زيد وفخر الدين الرازي والزَّجَّاج وابن كثير وأبي السعود فهموا الآية على أن معناها: إننا نوسع السماوات، أو قد وسّعنا أرجاءها، فإذا لم ندخل في التفاصيل نلاحظ أن هذا المعنى لا يتعارض مع البحوث والاكتشافات العلمية الحديثة، حتى إننا نلاحظ بشكل واضح أنها متطابقة معها في الإطار العام، خصوصًا أن قوله تعالى في سياق الآية: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ أي بقوتنا وقدرتنا يؤيد هذا التفسير.
وقضيةُ توسيعِ السماء أصبحت في أيامنا هذه من القضايا التي لاقت رواجًا لدى كثير من رجال العلم؛ ففي بدايات القرن العشرين، نَشَر مَرصدُ “ويلسون (Wilson)” بالولايات المتحدة خبرًا يشتمل على ادعاء لم يُطرح من قبل ولم يُسمع به على هذا الوجه، صحيح أنه كانت تنتشر قبل ذلك أخبار مشابهة لهذا ولكن لم يكن أي من ذلك مؤثرًا بدرجة ما أعلنه مَرصد “ولسون” من هذا الخبر المدعوم بالصور.
فكان محتوى هذا الخبر والاكتشاف أنه قد تم توثيق قسم من أطياف ضوء النجوم والمجموعات النجمية بالصور، وببيان أبسطَ نقول:
إذا نظرنا إلى أطياف الألوان نفهم منها أن بعض النجوم تبتعد عنا، وأن الخطوط الطيفية تميل في نهايتها إلى اللون الأحمر.. وبعد عمليةِ رصدٍ وبحثٍ لمدة طويلة أعلن الخبير الأمريكي الدكتور “هابل (Hubble)” تقييمه لهذه الظاهرة، فطَرَحَ قضيةَ تَوَسُّع الكون لأول مرة في العالَم الغربي مما أثار نوعًا من الحيرة والروعة في الأوساط العلمية في عام (1929م).
ثم جاء عالم الرياضيات القسُّ البلجيكي “لومتر (Lemaitre)”، فأجرى بعض الحسابات الرياضية، وأعلن أنه يوافق طرح الدكتور “هابل”، وعلى حسب هذه النظرية التي تدعى “بيغْ بانغ (Big Bang)” أي الانفجار الكبير ظلت المجرات تبتعد عن بعضها البعض، ويتمدد الفضاء وكأنه منطاد، وظَلَّ الكون بحجمه العملاق يَكبر وينمو، فأصبح اكتشاف هذا الابتعاد في عالم المجرات يتبوأ مكانه باعتباره من أروع الاكتشافات في تاريخ العلوم.
ويسمَّى العاملُ الذي يُستعمل في حساب تباعُد المجرات عن بعضها البعض “ثابت هابل”، وحسبَ هذا المقياس فإنه إذا كان هناك مجرتان تَبعُد إحداهما عن الأخرى بمسافة مليون سنة ضوئية، فإنهما تتباعدان عن بعضهما البعض في كل ثانية 20 كيلومترًا.. فإنْ تضاعفت المسافة بين المجرتين إلى ألف ضعف، فإن سرعةَ تَباعُدِهما أيضًا ستزيد إلى ألف ضعف، فإذا طبقنا هذا المقياس على مجرةٍ تبعُد عن الأرض بعشر مليارات من السنين فإن هذه المجرة تبتعد منا في كل ثانية بسرعة 200 ألف كيلومتر، بمعنى أن هناك توسّعًا بسرعة هائلة تساوي ثلثي سرعة الضوء.
وبالنسبة لما قيل في تفسير الآية في الماضي وما أُورد من الأمثلة لتوجيهها كان من الطبيعي أن تأتي اعتراضات من أهل تلك المرحلة حيث إنه كان من الصعب إدراك مغزى الآية، ولكن في هذا الزمان الذي بدأ العلم يتهجى بعض الأمور، إذا بالقرآن يقول بلسان بسيط وبتقرير للواقع: “إننا نوسّع السماء”، فهذا أمر يستحق الوقوف عنده بجدية، فإن فيه من التحدي ما يهم إنسان عصرنا أكثرَ بكثير من إنسانِ القرونِ الماضية.
فإذا تنبه الإنسان فسيلاحظ أن الآية بَـيَّـنت هذه الظاهرةَ بطريقة موافقة لمستوى فهم عصرنا وللمستوى الذي وصلت إليه العلوم من دون حاجة إلى تأويل أو تفسير، وإذ بيَّنتْها استخدمتْ تعبير “لَمُوسِعُونَ” باللام للتأكيد على أن توسيع السماء من الأمور المحققة التي لا ينبغي لأحد أن يَشك فيها، وأيضًا فالجملة هنا اسمية، فلو استُخدمت “نوسع” لأفادت التجدد والتكرار، لكن الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبات.. وهذا له مغزًى آخر، من حيث إفادته أن توسيع السماء أمر مستمرٌّ دائم الوقوع.
وإنَّ عدمَ تناقُض كلام نزل قبل أربعة عشر قرنًا، مع الكشوفات العلمية التي تَحققت في القرن العشرين كاف في الدلالة أنه كلام الله، والحق أنه من غير الممكن عدم ربط مثل هذا الكلام بعلم الله الأزلي. أجل، إن القرآن كلام الله المعجزُ، ومن غير الممكن إسناده إلى موجود غيره .
وحين يشار هنا إلى توسيع الكون، تتم الإشارة إلى حقيقة أخرى، وهي أنه يترتب على توسع الكون بوتيرة ثابتة نتيجةٌ قطعية وأساسية، وبالتالي لو أمكن الرجوع بالزمان في الكون إلى الوراء للاحظنا تقلُّص الكون؛ بمعنى أن الكون من حيث إنه يتوسع على الدوام فهذا يعني أن الكون كان قبل مائة سنة أصغر منه في وقتنا الحالي، وهذه حقيقة علمية ليس لأحد أن يعترض عليها، فإذا واصلنا الرجوع إلى الوراء بأقصى قدر ممكن فسنلاحظ أن الكون كان نواة صغيرة بحجم النقطة ولكنه كان على درجة غير متناهية من الحرارة.
فبناء على هذه النظرية، فإن بداية خلق الكون قد حصل -بأمر الله وإرادته- نتيجةً لانفجار عظيم يسمى (Big Bang).. بمعنى أننا إذا نظرنا إلى الأمر من الناحية الفيزيائية فإن بداية الكون هي بهذا الشكل أي إنه خلق من العدم، والعلماء في عصرنا متفقون على أن الكون قد خرج من العدم إلى ساحة الوجود المادي نتيجةً لانفجار كبير، ويُعتبر خلق الكون نتيجةً لـ”الانفجار الكبير” نظرية قوية من حيث إنه قد تم دعمه بالبحوث الأخرى.
أجل، إن الكون قد خرج من العدم إلى الوجود بقوله : “كُنْ”، فحصل على أشكال وكيفيات مختلفة، وحسب آخر التقديرات، فإن عمر الدنيا قد وصل إلى (13-14) مليار سنة.
ح. تكوير الليل والنهار
إن التعبيراتُ القرآنية المجازية تعتبر من البيانات التي من شأنها أن تفتتح آفاقًا جديدة أمام العلوم والفنون والتكنولوجيا، فهي تتحدث عن تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل، أي لفِّ أحدهما على الآخر كما تلف العمامة على الرأس، فهذه الآية -من جانب- راعت المستوى المنطقي والإدراكي لمن عاشوا قبل أربعة عشر قرنًا، وفي الوقت نفسه جاءت بتعبير ينيرُ الطريق لأهل القرن العشرين ومن سيأتي بعدهم؛ حيث إنها بينت العلاقة بين الشمس والكرة الأرضية بأسلوب غاية في الطرافة والبداعة:
﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (سورة الزُّمَرِ: 39/5).
إن كلمة “التكوير” تأتي في اللغة بمعنى لف شيء على آخر، وجعلِه على هيئة كرة، ومنه كور العمامة، فاختيار هذه الكلمة بما توحي به من المعاني في الآية الكريمة يؤكد بوضوح على أن الأرض كروية، فالقول بأن الليل والنهار يُلَفَّان على الأرض كما تلف العمامة على الرأس لذو مغزًى كبير، وأيضًا فإنّ استخدام صيغة المضارع في الآية يدلّ على أن هذا الوضع متجدّد، وأن الليل بظلامه يتبع النهار، وأن هذا النظام يعمل ويتكرر وكأنه مكوك، وهذه أطراف خيوط علمية مهمة.
وهناك آية أخرى تزيد هذه الآية توضيحًا وتزيل ما فيها من الإبهام، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾ (سورة الأَعْرَافِ: 7/54).
فكلمة “يُغْشِي” هنا من الغَشْي وهو التغطِيةُ والستر ووضعُ غطاء آخر على الغطاء، وهذا التعبير يدل بوضوح أن كلًّا من الليل والنهار يغطي الآخر.
وإذا حللنا الموضوع من الناحية اللغوية فقوله تعالى: “اللَّيْلَ النَّهَارَ” كلاهما مفعول به، وعلى حسب القاعدة النحوية إذا تعدى الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر فإن المفعول الأول منهما هو بمنزلة الفاعل، فعلى حسب هذه القاعدة فإن الليل بمنزلة الفاعل، أي هو الذي يغطي النهارَ، وهذا أمر مهم للجواب على ما يدور في الذهن: أيهما يتبع الآخر؟ الليل أو النهار؟ لأن مدلول الكلمة الأولى هنا هو أنها هي التي تُغطي مدلول الآخر، ويكون الثاني هو المغطَّى والمتبوع، فيتلخص من هذا أن الليل هو الذي يتبع النهار، وأن الظلام هو الذي يغطي الضياء.
وقوله تعالى: “حَثِيثًا” فيه إشارة إلى تفاصيل أخرى، لأن “حثيثًا” معناها أنه يجري بسرعة هائلة تذهل الناظرين.
إن رائد الفضاء الروسي الشهير “جاجارين (Gagarin)” قد قال شيئين، أحدهما قبيح، والآخر جيد؛ فالقبيح هو أن هذا الإنسان التعيس بعدما رجع من رحلته الفضائية قال ما معناه: إنني صعدت إلى السماء وتجولت فيها فلم أجد شيئًا يسمى: “الإله”، والأمر الثاني هو قوله: إنني كلما ابتعدت من الأرض وجدت في الدوائر التي على الأرض ظلامًا يلاحق الضياء. أجل، إنّ في الطرف المعاكس للشمس حجابًا مظلمًا يدور حول الأرض.
ولا غرو، فمن حيث إن الأرض كروية تدور حول الشمس، فإن الظلام الذي هو في الجهة المعاكسة يبدو وكأنه غطاء يلاحق الضياء، ولكن لا بد لفهم هذا الأمر جيدًا أن يقوم الإنسان برحلة فضائية، وقد جلب القرآن الكريم الأنظارَ قبل عصور إلى هذه الحقيقة بقوله: “يَطْلُبُهُ حَثِيثًا” بمعنى أن الظلام يلاحق النور.
ويُفهم من هذا أن المظلم هو الأرض، وأن المضيء هو الشمس، ووفقًا لذلك فإن الأرض هي التي تلاحق الضياء وتطلبه، وأنها هي التي تدور بسرعة هائلة حول الشمس وكأنها حجر مقلاع، ولو كانت الأرض مسطحة غير كروية لم يكن للظلام أن يواصل مطاردةَ الضياء، ولكان أحدُ وجهي ذلك المسطَّح مضيئًا على الدوام، بينما يظلّ الجانب الآخر في ظلام دائم.
أجل، إنّ كلًّا من هذه إشاراتٌ لا تتناقض مع الكشوفات العلمية، وقد ذكرها القرآن في بضع كلمات، ولكنها تعبيرات مركّزة جدًّا، لو تم تحليلها في عصرنا وأُجريت حولها البحوث، واستعين بالتلسكوبات العملاقة لظهر للعيان مدى تلألؤِ الحقائق القرآنية وتالُّقها.
والإنسانية كلما تقدمت في العلوم والتكنولوجيا اتّضح لها من التعبيرات القرآنية نكات ذات أسرار، وسينادي القرآن على رؤوس الأشهاد مرة أخرى أنه كلام الله تعالى.
ط. رفعُ السماء بغير عمد
هناك العديد من الفرضيات التي طُرحت حول السماوات الممتدة فوق رؤوسنا بهذه الحالة الرائعة التي تذهل العقول، وقد عُبر في القرآن الكريم عن دوران الأرضِ في الفضاء بـ”السباحة” و”الجريان”، كما عُبر عن رفع السماء بقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾ أو ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ أي إن هناك أعمدة غير معلومة الماهية.. لكنها لم تُفهم في القرون الأولى على وجهها، ولذلك طُرحت حول الموضوع نظريات بسيطة من شأنها أن تُضحك الإنسان، فمثلًا هناك بعض علماء أهل الكتاب الذين لم يستوعبوا القضية حاولوا أن يصوروا أن الكرة الأرضية محمولة على ثور أو حوت أو صخرة وغير ذلك من الأمور التي يأباها العقل والمنطق، فعلى حسب تفسيراتهم هذه فإن الكرة الأرضية هي بين قرني ثور عملاق، فكلما هز الثور رأسه أدى ذلك إلى حدوث هزات أرضية، والحقيقة أننا إن اعتبرنا الروايات التي يرِد فيها الحديث عن الثور أو الحوت، فمن الممكن أن نجد لها وجهًا صحيحًا بأن نحملهما على معناهما المجازي .
أجل، إن إنسان تلك العصور لم يكن لديه من المعلومات ما يوصله إلى مستوى من الإدراك والمحاكمة العقلية ويجعلُه يتعقل إمكان سباحة الكرة الأرضية في الفضاء،
بل لم يكن مطَّلِعًا على المواضيع من أمثال قوة الجاذبية والدافعة، في حين أن القرآن الكريم يَذكر أنه ليس للسماوات والأرضين أعمدة مرئية، وأن هذه الأجسام السماوية تربطها روابط غير محسوسة ولا مرئيةٍ، وبذلك يَهدِم تلك الأوهامَ القديمة من الأساس؛ حيث يقول الله تعالى في هذا الصدد: ﴿اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ (سورة الرَّعْدِ: 13/2).
ولنركز على الكلمات التي استخدمت في الآية الكريمة وخصوصياتها الدلالية: إن قوله: “رَفَعَ” يدل على نقل الشيء من مكانه نحو العلو، ولا يرادفه “نَصَبَ”، فقد يكون الشيء عاليًا ومنتصبًا ولكن لا يكون مرفوعًا، لأن قاعدته غير مرفوعة ولا منقطعة عن أرضيته.
وعلى حسب ما نفهمه من الآية الكريمة فقد رفع الله الأرض والسماوات من دون أن تستند على شيء، فهي قبة ممتدة على رؤوسنا، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ (سورة الطُّورِ: 52/5).. فالله قد وضع قانونًا يحمي به الكرة الأرضية من آلاف النيازك التي تأتي كل يوم فتصطدم بالغلاف الجوي الذي لولاه لدمرت الأرضَ.. وهناك قانون آخر به يَحُول بين أن تتصادم الأنظمة السماوية كما يحميها من غير ذلك من المخاطر.
ورُوي عن متقدمي المفسرين من أمثال مجاهد وعكرمة وقتادة والحسن البصري أن ابن عباس فسّر الآية التي تدل على أن السماء بغير عمد بقوله: “لَهَا عَمَد وَلَكِنْ لَا تُرَى”، أي لأنها ليست من جنس المحسوسات التي تدخل تحت الحواس.
فهناك عمود وسند للسماء يمسك بها لكنه لا يُرى بالعين لأنه ليس من المحسوسات.. فقبل مائتي سنة تقريبًا اكتُشفَ هذا العمود والسند الذي لا يرى بالعين، ألا وهو قانون “الجاذبة والدافعة”، وهذا يدل على أنَّ كل الأجرام تتحرك في إطار هذا القانون.
وما أشارت إليه الآية بشكل موجز لهو من الأمور المثيرة للاهتمام، حيث إنها تدل على المراد وتُسمِّيه باسمه (عمد)، ولكن الواقع أن هذين الأمرين المتناقضين (الجذب والدفع) ما يزال كلٌّ منهما مجهولَ الماهية، صحيح أن أمثال نيوتن وآنشتاين أدْلوا بدلوهم في الموضوع وقدموا حوله أفكارًا، إلا أنهم لم يستطيعوا بعدُ أن يبينوا الأمر بماهيته وطبيعته الحقيقية، بل جلُّ ما قاموا به هو أنهم عرَّفوا القانون ووضعوا له اسمًا، وأما من يَعرف ماهية الأمر على وجهه الحقيقي فهو الله وحده الذي وضع ذلك القانون، ولا بد في هذا الباب من معرفة أن الله تعالى يرفع السماوات بهاتين القوّتين المتناقضتين، بقطع النظر عن اسمهما وعنوانهما.
ولا شك في أن التوازنات التي خلقها الله تعالى لتحقيق النظام على وجه الأرض قد أُسست -في دائرة الأسباب- على بعض القوى والحركات، وهناك أمور أخرى لها تأثير على هذا الأمر مثل: نوع المواد المكوِّنة للكتلة، وأوصافها وحجم الكتلة ووزنها، وقوّة جذبها، وحركيتها، والمسافة بينها وبين غيرها، حتى -من المنظور الآينشتايني- الأجرام السماوية التي تشغل حيزًا في الفضاء، وكل الجزر الفضائية، ولكن الأمر يرجع في نهاية المطاف إلى ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ (سورة لُقْمَانَ: 31/10) وقوله: ﴿اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ (سورة الطُّورِ: 52/5).
ي. المنظومة الشمسية ونشوء الكرة الأرضية
تُعتبر الشمس مركز المنظومة التي نعيش فيها، وهي جرم سماوي كبير يبث الحرارةَ والضياء إلى ما حوله من الكواكب وما تمر به من سائر الأماكن، وهي من حيث الحجم أكبر من الكرة الأرضية بـمائة وتسعة أضعاف، وقُدِّر عمرها بـ(4.6) مليار سنة، وترتفع درجة الحرارة في داخلها إلى خمسة عشر مليون درجة، ويقال إن طول الأعمدة الغازية الساخنة المتدفقة منها في الفضاء يبلغ 400.000 كم.. ومن يرصدها بأجهزة التلسكوب فإنه لا يتمالك إلا أن تأخذه مشاعر الدهشة والروعة تجاه ذلك المظهر الباهر.
ولكنا إذا نظرنا إلى الشمس من زاوية كونها مسخَّرة لأوامر الله الذي هو آخذ بزمامها ومتحكم فيها، فإننا سنرى أن هذه الشمس العملاقة المدهشة والعظيمة مخلوقٌ ضعيف وحقير قد سخرها الله للإنسان وجعلها خادمة له على وجه الأرض.
فنراها تنشر فيما حولها الحرارة والضوء فتُدفئ مِن جانبٍ وجهَ الأرض وتُنيره، ومن جانب آخر تكون وسيلة إلى التركيب الضوئي في النبات فتخدم مواصلة الحياة على الأرض.
وأما الكرة الأرضية فإنها تعتبر طائرة أو سفينة فضائية، أو مركوبًا خصّصه الله تعالى لخدمة بني الإنسان، وسماها في القرآن الكريم “مهدًا”، وأودع فيها شتى أنواع النعمة التي ننعَم بها.
فتجهيز الأرض بهذا الشكل الرائع، وطلوعُ الشمس وغروبها في أوقات معينة، وإضاءتها للدنيا وكأنها شمعة عملاقة، وغيابها لفترة معينة من الزمن لإتاحة فرصة الاستراحة للإنسان، وتَحرُّكُها ضمن منظومتها، وتأثيرُها على الأجرام المرتبطة بها، وضياؤها، وألوانها.. كلُّ ذلك لم يزل يشغل عقول المفكرين ويُلهِمُ قلوب أهل الاستعداد بشتى ألوان الإلهامات.
ومنذ القديم ظل رجال الفكر والعلم يضعون نظريات حول تكوُّن المنظومة الشمسية، وتَشَكُّل الأرض وعلاقتها بالمنظومات السماوية وغيرها.
وأول من قدَّم معلومات منظمة -ولو على مستوى النظرية- حول الكرة الأرضية والشمس هو “بوفون (Buffon)”؛ حيث افترض أن مذنّبًا ضخمًا اصطدم بالشمس، ونتيجة لهذا الاصطدام تناثرت من الشمس كمية ضخمة من الغاز نحو الفضاء في مسافات وأمكنة مختلفة، ثم بردت هذه الغازات بسبب ابتعادها عن الشمس وتشكلت الكواكب السيارة، أما الأقمار فتشكلت من خلال كتل صغيرة من هذه المادة كانت تدور حول الكتل السَّدِيمِيّة الكبيرة أي الكواكب السيارة.
وقد تبدو هذه النظرية في أول وهلة وكأنها معقولة ومنطقية، إذ من الممكن إذا أراد الله تعالى ذلك أن يُصدم مذنَّبًا بالشمس ثم يُحدث من ذلك قطرات، ثم تبتعد تلك القطرات بقوةِ الطرد المركزي، ثم تبدأُ بالدوران حولها بقوة الجذب المركزي، إلى أن تتشكل الكرات والأقمار التوابع على هيئتها الحالية، إلا أن نظرية “بوفون” هذه لم يمكن إثباتها حسب المبادئ الرياضية، كما أنها قوبِلَت بكمٍّ هائلٍ من الانتقادات.
ثم جاء الفيلسوف الألماني “كانْط (Kant)” فأعاد صياغة هذه النظرية بشكل أكثر منهجية، فعلى حسب ما قاله “كانْط”، لم يصطدم أي مذنَّب بالشمس، بل إنه بينما كانت الشمس كومة هائلة من الغازات تدور في مدارها، إذا بها تزداد سرعتها، وكلما زادت سرعة دورانها، بدأت هذه الكتلة الغازية تبرُد بسرعة كبيرة، ونتيجةً لهذه البرودة انفلتت بعض القِطع من الشمس، وهذه القِطع المنفلتة منها بدأت تدور حولها في إطار قانوني الطرد والجذب المركزي، وهكذا تشكلت المنظومة الشمسية، ومع أن “كانط” لم يكن من علماء الرياضيات إلا أن آراءه هذه لاقت قبولًا واسعًا في الأوساط العلمية.
ثم جاء بعد “كانط” عالمُ الرياضيات الفرنسي “لابلاس (Laplace)”، فتناول الموضوع بطريقة أكثر إحكامًا، وطوَّر نظريته، حيث إنه أثبت نظرية “كانط” بالرياضيات، وحقَّق لها الشهرة بين الناس، إلا أن هذه النظرية تقادمت بعد فترة زمنية معينة بعامل الزمن، فتلقت نصيبها من انتقادات “ماكسويل (Maxwell)” الذي جاء بعده، حيث إنه ادّعى أن كلًّا من “كانط” و”لابلاس” وقعا في الخطإ، معتبِرًا أن الساحة التي تضمّ الشمس والكواكب واسعة شاسعة جدًّا، وأن هناك كثيرًا من المنظومات هي من البعد بحيث تخرجُ عن نطاق جاذبية الشمس، وليس من الممكن أن تدخل تلك المنظومات في مجال جاذبية الشمس، فعلى حسب ما قاله “ماكسويل” ليس لجاذبية الشمس أن تجذب تلك الكواكب البعيدة ولا أن تديرها حولها.
ولكن أفضل من انتقد نظرية “كانط” و”لابلاس” بطريقة علمية هو الفلكي الكبير السير “جيمس جينز (Sir James Jeans)”، فإنه قدَّم أفكاره مدعومة بالأدلة العلمية، وظلت نظريته تشغل الأوساط العلمية إلى أن برز على الساحة “نيلس بور (Niels Bohr)” المتخصصُ في علم نشأة الكون، الدنماركي الأصل والعضو في الأكاديمية الفرنسية للعلوم والذي
لا تزال نظريته سائدة حتى في أيامنا هذه.
يقول “بور”: في البداية كانت جميع الأطراف على شكل الدخان كالغاز والبخار، ثم تجمّعت الجُسيمات الذرية شيئًا فشيئًا وشكّلت الكُتل، فكل كتلة بما فيها من قوة الجذب المركزي جذبت ما حولها، فأخذتْ هذه الكتل تَكبُر شيئًا فشيئًا، ثم تواصلت الانشطارات والتكتّلات بشكل مستمرّ كما كانت في البداية، ولم تزل هذه الانشطارات والانحلالات تتعاقب في الكون على الدوام، وستظلّ فيما بعد أيضًا، بمعنى أن الذرّات تتجمّع فيما بينها فتحصل منها تركيباتٌ وكتل جديدة، وهناك شموس أكملت عمرَها نوعًا ما، فهي تتفكّك وتنحو صوب الانشطار من جانب، بينما في الجانب الآخر تتجمّع الجسيماتُ دون الذَّرِّية، ومعها الذرّاتُ، إلى أن تتجمّع الجزيئاتُ، فتتشكّل في نهاية المطاف كتلٌ كبيرةٌ مرة أخرى.. وستستمرُّ هذه الحالة متكرِّرة إلى ما شاء الله تعالى.. ويتحدث “آينشتاين” أيضًا عن نشوءِ كائنات جديدة في أمكنة مجهولة بالنسبة لنا، وقد يكون ما قاله تعبيرًا عن هذه النظرية الأخيرة.
وإذا أردنا أن نضع قاسمًا مشتركًا بين جميع هذه النظريات، فإننا نستطيع القولَ بأن الأقدمين والذين جاؤوا من بعدهم من العلماء ينظرون إلى الكون ككلّ، وعلى حسب ما قالوه فإن الكون كان كومةً من الغازات، ثم تواصلت رحلتها على هيئةِ تَصادُم الجزيئاتِ والجسيمات الذرّية وتجمُّعِها وتشكيلها فيما بينها قوة الجاذبية، إلى أن تكوّنت منها كتلٌ جسيمة كبيرة، ويمكن أن نشبِّه هذا النمو -في الجملة- بنمو الجنين في الرحم؛ حيث إن الجنين في بداية أمره يكون عبارة عن بويضة، ثم يتغذّى شيئًا فشيئًا إلى أن يتطوّر وينموَ ويصلَ إلى حد معين من الجسامة، وعلى الشبه من ذلك، فإن جزيئات الذرة تتجمّع، فتتفاعل فيما بينها فتُشكِّل الكتلَ إلى أن تنمو هذه الكتلُ فتشكّل في نهاية المطاف تلك الأجرامَ الفضائية العملاقة.
فكلّ ما سردناه هنا إنما هو نظريّات طُرحت منذ فترة طويلة على بساط البحث حول خلق الكون، والفارق فيما قلناه هو تبسيط الأسلوب ليفهمه العوام، وإلا فإن معظم الآراء تتركّز حول ما ذكرنا، ولْنلخصِ الموضوع ثم ننتقلْ إلى ما ذكره القرآن في هذا السياق:
إن الفرضيات التي طرحها كل من: بوفون وكانط ولابلاس وماكسويل والسير جيمس جينز حول نشوء الكون هي نظريات تأثرت ببعضها البعض إلى أن وصلت إلى يومنا هذا، أما القرآن المعجز البيانِ فهو يستخدم في هذا الباب أسلوبًا مختلفًا، فلا يدخل في التفاصيل ولا يتطرّق للقضايا الجزئية، بل يربط كل شيء بالمشيئة والإرادة الإلهية، ويُغلق الأبواب أمام إسناد الأمور إلى الطبيعة أو الأسباب أو الصدفة فيقول: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/30)، فالآية الكريمة تصرّح بأن جميع الأنظمة كانت “رَتْقًًا” أي متصلة ثم انفصلت عن بعضها البعض، ففي هذه السورة عبر عن هذا الوضع بـ”الرتق”، وفي سورة الدخان بـ”الدخان” أي شيء يشبه الدخان-السحاب، وكلا المعنيين يعني أنها كتلة واحدة، وليس لأحد أن يعترض على هذا الإجمال الرائع، ومن الطريف أن هذه الآية فهمها العلماء المسلمون منذ القرون الأولى بهذا المعنى بفوارق طفيفة.
فبالنسبة لقوله تعالى: “رتقًا” هناك بعض التفسيرات نوجزها فيما يلي:
1- يروى عن ابن عمر وابن عباس أنه لم تكن بين السماوات وأجزائها وبين الأرض أية علاقة وتبادل، فكانت الأرض يابسة والسماء بدون سحاب.
2- وهناك رأي آخر رُوي عن تلاميذهما وهم مجاهد وعكرمة والحسن البصري، وهو أن السماوات والأرض كانتا متلاصقتين عديمتي النفعِ.. ثم فتح الله بينهما وفكهما على شكل منظوماتٍ.
3- روي عن أكثر الصحابة والتابعين أنهم فسروا الآية بأن السماوات والأرض كانتا موجودتين ولكنهما لم تكونا مرئيتين (كانتا ركامًا غازيًّا)، فجعلهما الله بحيث تنفتحان وتتفككان وتُريان بالعين.
وهذا الوجه رواه مجاهد وهو من مشاهير تلامذة ابن عباس، ورواه كذلك كبير الأولياء الحسن البصري.. وهما إمامان من أئمة التابعين، وقد أورده ابن جرير الطبري وابن كثير في تفسيريهما بالتفصيل.
ويتلخص من هذه الآراء أنه لم تكن في البداية أية علاقة بين السماوات والأرض؛ لأن الأرض والسماء في ذلك الحين كانتا عبارة عن قطعة نار أو دخان، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ (سورة فُصِّلَتْ: 41/11)، حيث تَذكر الآية بوجه صريح أنه لما توجهت إرادة الله إلى السماء كانت عبارة عن دخان.
ثم بعد ذلك انتهت هذه القطيعة بين السماء والأرض فبدأت بينهما مناسبة، ولما أوجد الله بإرادته وقدرته هذه المناسبة بين السماوات والأرض، بدأ بينهما التبادل، فأرسلت السماء أطياف النور، فخلق الماء على وجه الأرض بأمر إلهي، فأعقب ذلك تبخُّرُ الماء، فالغلافُ الجويُّ، فالسحبُ، فالمطرُ، وفي نهاية المطاف تمت مرحلة المواءمة بين الأرض والسماء، وبذلك تكوّنت بيئة ملائمة للحياة، فنلاحظ أن الله تعالى يسند كل ذلك إلى ذاته وينوطها بمشيئته قائلًا: “ففتقنا.. وجعلنا..”.
أجل، إن الله تعالى هو الذي أنشأ كل هذه التكوّنات في تناغم مذهل؛ لأنه ليس من الممكن شرح هذه الأحداث بالمصادفة، ولن يكون ذلك الادعاء مما يقبله العقل، وإذا لاحظْنا التعبير القرآني فإننا سنفهم ما يلي: إن السماوات كانت على هيئة “دخان-غاز”، فأردنا أن نمنحها ماهية مختلفة، ففصلنا هذا الركام الغازيَّ إلى قِطع فخلقنا منها منظومات شمسية، ونظمنا تلك القطع الصغيرة والكبيرة على شكل توابع وأقمار في نظام معين؛ والكرة الأرضية التي نعيش عليها هي من ضمن أفراد تلك المنظومة، وتظلّ تدور حول الشمس.
إن أسلوب الآية الكريمة في منتهى الرصانة والوضوح والشمول، وغيرُ قابل للنقاش، ولن تجد فيه ما تلاحظه في أسلوب البشر من أمثال: “يا ترى” أو سائر الكلمات الموحية بالتردّد أو التخمين.
أجل، إن الآيات الكريمة تُورِد القضايا بأسلوب محكم للغاية وعلى شكلِ قوانينَ مقررة؛ حيث إن الآية -من جانبٍ- تحثُّ رجال العلم والباحثين على إجراء البحوث من دون تردد، ومن جانب آخر تفسح المجال لمن يريد أن يدلي بتفسيره في حذر.
ولعل هذه القضايا التي ذكرها القرآن حول الشمس والسماء والأرض وكأنها قوانين، إذا تم تحليلها بشكل جاد من منظور الفيزياء الفلكية فسيتبين أنه قد سبق كل العصور، وسيَظهر مرة أخرى مدى إحكام هذه القوانين التي أتى بها القرآن، خصوصًا ونحن في عصر يتيح لنا هذا الكمُّ الهائل من الأدوات التكنولوجية والتلسكوبات فرصةَ رؤيةِ الأجسام التي تَبعد عنا بمسافةِ ملياراتٍ من السنوات الضوئية، ومهما أورد الباحثون من نظريات فإن التعبيرات المعجزة للقرآن الكريم ستبقى في آفاق تفكيرنا وبحوثنا مشرقةً متلألئة، فأسلوب القرآن جامع شامل لما في كل العصور من العلوم والمعارف، وستظل الألسنُ تذكره بهذا الجانب باعتباره رمزًا للتفرّد.
والحاصلُ أن كلّ شيء قبل أن تتجلّى فيه إرادة الله مرة ثانية كان في حالة “رتق” و”دخان”، ففتقه الله تعالى وفرّقه وشكَّله، وكانت الكرة الأرضية أيضًا جزءًا من هذا الرتق، ولكنها بمرور الزمن تحولت إلى وحدة مهمة من وحدات الفتق، فهي أيضا كانت في البداية كتلة غازية، ثم بردت فأصبحت فِراشًا دافئًا ومهدًا وعشًّا وحديقة وبستانًا يستفيد منه بنو الإنسان.
وأما الشمس فإنها بحكم مهمتها ظلت في موقعها وواصلت حالتها السابقة بتغير طفيف بصفتها فرنًا يتحول فيه الهيدروجين إلى هليوم ومصدرًا للضياء باعتبارها أهم حلقة من حلقات السلسلة التي تُمِد بالحياة، ومصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (سورة التَّكْويرِ: 81/1)، فإن الشمس التي خلقت من العدم وأنشئت من الأثير والدخان وكانت مصدرًا للضوء والحرارة بالنسبة لكثير من الأجرام السماوية، إذا انتهت مهمتها في هذا العالم فإنها ستُكوَّر في العالم الآخر، وستُواصل هناك طريقَ التغير حسب تقديرِ الله.
لم يلتق الإنسان بالكرة الأرضية إلا بعد أن أصبحت مهيَّأةً للحياة وكأنها مهد، وليس من الممكن إسناد أي كائن حي في الكون إلى المصادفة أو التطور أو الطبيعة، فإن كل شيء ينمُّ بوضوحٍ عما وراءه من القصد والإرادة، ولعل السبب الأساس لوقوع أنصار نظرية التطور في مأزق هو أنهم لا يرون -أو لا يريدون أن يروا- ما في الكون من الإرادة والشعور والقدرة والحكمة، وهذا مأزقٌ ليس لهم أن يتخلصوا منه إلا إذا أراد الله لهم ذلك بقدرته وإرادته، وبدلًا من أن يكون هذا الوضع الرائع في الكون دليلًا لهم على حقيقة خلق الكائنات الحية ومِن أدلّ الدلائل على وجود الله ووحدانيته إذا بنا نُفاجَأُ بهم وقد عكسوا القضية وقلبوا الحقيقة رأسًا على عقب، ولم يروا يدَ القدرة، فأسندوا هذا النظام الكوني الهائل، ونسبوا قضية الحياة -التي هي من الظواهر المهمة- إلى الطبيعة والمصادفات.
يقول الله تعالى في حديثه عن خلق الإنسان: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (سورة السَّجْدَةِ: 32/7).
وهذا الخليط من الطين أو الصلصال أو مما على وجه الأرض من المعادن هو المكوّن الأساسي للإنسان، فمُعظَمُ ما في جسمِ الإنسانِ موجودٌ في التراب أيضًا؛ فقد خلق الله تعالى الإنسان من مزيج من العناصر التي تشكِّل الأرض مثل النيتروجين والكربون والهيدروجين والأوكسجين والكبريت وغيرها كعناصر أساسية للكائنات الحية، فهو تعالى جعل هذا الخليط شيئًا وكأنه حساء من البروتين، ثم شكَّل ذلك المزيج وصوَّره وخَلق منه بني الإنسان.
ويتحدث الله تعالى في آية أخرى عن مرحلة أكثر تقدُّمًا لخلق الإنسان فيقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ (سورة الْحِجْرِ: 15/26)، أي من طين مطبوخ بالنار، وترَاب مُبْتَلّ مُنْتِن.. أو من طين جاف مطبوخ، ومن طين أسود مشكَّل.
ويقول تعالى منوِّهًا بشأن الماء وأهميته بالنسبة للحياة: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/30).
ويقول: ﴿وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة النُّورِ: 24/45).. فكل من هذه الآيات تدل بأسلوب مختلف على هذه الحقيقة.
والمبدأ الأصلي للإنسان في معظمه هو الماء، فالماء الذي تحتويه ماهيةُ أي كائن حيّ بدءًا من الخلية الصغيرة وانتهاءً بشجرات الصنوبر العملاقة بكاليفورنيا، هو أكثر بكثير مما تحتوي عليه من الجزيئات الأساسية بأضعاف الأضعاف، ويشكِّل الماء قرابة ثلاثة أرباع جسم الإنسان أيضًا، وجميعُ ما في داخل الخلية من العضيات والكربوهيدرات وجزيئات الدهون والأحماض الأمينية إنما تعوم وتتحرك في وسط مائع، فالماء هو القسم الحاكم في الكائن الحي.
والماء له موقع أساسي في سائر الكون أيضًا، فأُولى الكائنات الحية قد خلقت في شواطئ المياه، ولذا نلاحظ أن القرآن الكريم يصرح بأن الماء هو أساس الحياة، ولم يفهم العلمُ الحديث هذه الحقيقةَ على هذا الوجه إلا بعد قرون طويلة، في حين أن القرآن الكريم قد أشار قبل أربعة عشر قرنًا إلى هذه الحقيقة بأسلوب واضح جليّ كما نفهمه من الآيات التي مرّت بنا آنفًا.
وحاصل القول: إننا إذا تناولنا أيّ مرحلة من مراحل الحياة، بدءًا من ذوات الخلية الواحدة وانتهاءً بالكائناتِ بالغةِ التعقيد فإننا نرى أن الماء هو العنصر المهيمن فيها، ولكننا سنلاحظ أن القرآن الكريم عبَّر عن هذه الحقيقة العظمى في جملة قصيرة، وذلك مثير للاهتمام وفي الوقت ذاته ذو مغزى كبير، فإن إنسانَ ما قبل (1400) سنة لم تكن لديه أية معلومة لا عن كيفية الخلية ولا عن نسبة الماء في تكوين الحياة.
فبالآيات الآنفة الذكر، يلفت القرآنُ الكريم الأنظارَ إلى جميع العناصر الأساسية في خلق الكائنات الحية، فيقوم بدور المرشد للعلوم بشكل إجمالي، ويترك أمر الدخول في تفاصليها وفروعِها لرجال العلم في مستقبل الزمان، فمن لا يراه من وراء هذا الإجمال فهو أعمى، كما أن من يخوض في حقه تعالى في التفاصيل فهو عديم البصيرة.
ك. القرآن الكريم وحياتنا العلمية
إن القرآن المعجز البيانِ قد اهتم بكل ما يهم الإنسان من القضايا، لأنه نزل منبعًا للهداية والسعادة لبني البشر، ولقد ظل العلم والتكنولوجيا يتطوران مرتبطَين ارتباطًا وثيقًا مع حياة البشر، وبالتالي فإنه من الطبيعي جدًّا أن توجد في القرآن ألفاظ مجملة متعلقة بمثل هذه التطورات، ومع أن المبادئ التي جاء بها القرآن مبادئُ تنظِّم الحياة الدينية والأخلاقية والروحية والاجتماعية، إلا أن فيه أيضًا إشاراتٍ علميةً في آياتٍ تشوِّق إلى العلم والتكنولوجيا صراحةً أو ضمنًا.
إن النظام الذي جاء به القرآن هو في حد ذاته من الكمال بحيث لا يدع مجالًا للفراغ لا في الجوانب الأنفسية ولا الآفاقية، وكما سبق أن قلنا: إن القرآن يتحدّث عن كل شيء بدءًا من قلب الإنسان وانتهاءً بأعماق السماوات، فيُجمِل في بعضها ويفصِّل في البعض الآخر، فأسلوبه يتمتع دائمًا بالأكملية، ولقد أدرك المسلمون في العصور الأولى هذه الأكملية فتعمقوا، إلى جانب العلوم الدينية، في العلوم الكونية، فأسسوا على وجه المعمورة مَراصد ومراكز طبية وقاموا بأبحاث جادة.
فكانوا في البداية يُجْرون بحوثهم بالعين المجردة، ثم طوروا في المراحل التالية أدوات تُسهِّل عليهم عملية البحث وتُوصِلهم إلى نتائجَ أقرب إلى الصحة، فمِن خلالهم سَمِع الأوروبيون معلومات حول كسوف الشمس وحركات النجوم وكروية الأرض ودورانها حول الشمس وغيرها من الظواهر الفلكية.
فهذه الجهود منهم إنما هي مثالٌ على مدى امتثالهم للأوامر القرآنية المتعلقة بالكون، فقد تَناوَل القرآن قضايا الشريعة الدينية مع الشريعة الفطرية وقدمهما لأهله معًا وكأنهما وجهان لحقيقة واحدة، فكما أنه أمر بالصلاة والزكاة فقد حثّ على رصد الكون بكل جوانبه، والبحثِ والتدقيق حول آثار الله التي خلقها في الأرض والسماء، وفي ظننا أن هذا هو التقوى بالمعنى الحقيقي.
أجل، إن إهمال أية واحدة من الشريعة الدينية أو الفطرية يعني ممارسة الحياة في بُعد واحد، ولعل هذا هو السبب الرئيس وراء الانقراضات التي ظلّ العالم الإسلامي يعاني منها منذ قرنين أو ثلاثة قرون.
ومع أن القرآن شجّع على العلم والتكنولوجيا والتفكرِ في الوجود والكون، فقد ظهر من بينِ أظهُر المسلمين جَهَلةٌ ليس لهم نصيب من القرآن يتحاشَون التفكر فيما أوجده الله من المخلوقات، وقد وصلت بهم التعاسة إلى أن يقولوا: ماذا يجدي التفكر وإجراءُ البحوث حول الأجسام الموجودة في الأرض والسماء؟ ففي حين أن الله أمر المؤمنين بتدبر ومشاهدة آياته في الأرض والسماء، فقد نشأ من بينهم عديد من المحرومين فسروا هذه الأوامر على حسب فكرهم، ومع أن المسلمين الأوائل كانت قلوبهم وعقولهم متنورة بالعلوم والفنون والتقنيات، وبذلك تعمقوا في العالم الداخلي الأنفسي والعالم الخارجي الآفاقي؛فقد ظل الذين قطعوا الصلة بين الشريعة الفطرية والأوامر الدينية يتخبطون في مآزق حلقتهم المفرغة ودائرتهم الفاسدة، فتقهقروا بالعالم الإسلامي إلى ما وراء الوراء كما هو عليه حالنا اليوم.
أما القرآن الكريم فقد ظلَّ يلقي بآياته النورانية الضوءَ على الحقائق العلمية التي ستُكتَشف في المستقبل، ويدأَبَ على الحديث عما ينير العصور من ضياء القلوب ونور العقول، والعارفون بكنه الأمور هم على وعيٍ بأن العلم والتقنيات مهما قطعت من الأشواط وبلغت من المستوى فإنها ستظل محتاجة إلى نور القرآن وضيائه، وكلما شاخ الزمانُ فسيزداد القرآن شبابًا وطراوة، وإن بياناته الطرية لهي بمثابة مفاتيح سحرية من شأنها أن تُنَوِّر رجال العلم والفكر في كل عصر، وتعيدَ فتح الآفاق المُنْسَدّة، ولكن للأسف لا تزال الجهود المبذولة في فهم هذا الجانب منه ضئيلة على الرغم من وجود توجه جديد نحو القرآن، وإننا لعلى قناعة تامة بأنه إذا أتى يوم يُجرِي فيه رجالُ العلم والفكر بحوثهم في محور القرآن، فإن القرآن أيضًا سينفتح عليهم بكل وارداته، وكما أنه أَخذ بيدِ إنسانِ عصرِ السعادة -أعني العصر النبوي والراشدي- فسيأخذ بيد إنسانِ القرن الواحد والعشرين أيضًا، وسيرتقي بالبشرية إلى أرقى مستوى.
إن نظرتنا ههنا إلى القرآن، وتحليلنا للآيات التي لها علاقة بالعلوم والتكنولوجيا، إنما هو من باب تحفيز همم أرباب الاختصاص والأهليةِ في هذه المجالات، فإن الحديث في المجالات التقنية إنما هو شأن أرباب العقولِ النيّرة من أصحاب التخصّص في تلك الميادين، وما نريد أن نفعله هنا هو أننا في سياق بيان أن القرآن معجز من هذه الناحية سنركز على بعض الآيات مُحاوِلين جلب أنظار المشتغلين بهذه المجالات من أهل الاختصاص ولفْتَها إلى هذه الآيات.
ولقد حُرِّر في هذا الموضوع العديد من الكتب، إلا أن المؤلِّفين حاوَلوا في معظم ما كتبوه أن يبينوا أوجه التوافق والتطابق بين الحقائق العلمية وبين الآيات التي تُلْقي الضوء عليها، مما يعني أنهم أرادوا أن يُرَكِّزوا في معظم أعمالهم على إثبات جوانبِ الموافقة بين القرآن وبين التطوّرات الحاصلة في الوقت الحالي.
وهناك أسئلة حاول الكثير منهم الإجابة عليها، منها:
إلى أين سيتوجه العلم في المستقبل؟ وماذا سيمتلك الناس بالنسبة للتقنية والتكنولوجيا؟ هل سيكون للقرآن وعود بأمور خاصة في باب العلوم التقنية؟ وإن كان هناك أشياءُ من هذا القبيل فعلًا فهل من الممكن التنبُّؤ بها من الآن؟ ما الغاية من التطورات الحديثة؟ هل الغاية المُثلَى من الحياة هي التطور في المجال التقني؟ ما هي أوامر القرآن وتوصياته
في هذا الباب؟
ومنذ القرن الثامن عشر تحولت أيام المسلمين من إقبال إلى إدبار وأصبح المثقفون منهم يعيشون تزعزعات في القيم، ولكنهم لم يزالوا في أثناء غفواتهم هذه يدندنون بين النوم واليقظة بمثل هذه الأمور.
ونأمل من الباحثين المسلمين في أيامنا هذه أن يتوجهوا مرة أخرى بكل ما يملكون من جهد وطاقة إلى القرآن ويتخذوه أساس بحوثهم العلمية حتى يحرزوا ما وعد الله به في القرآن من شرفِ وراثة الأرض الحقيقية في مجال العلم والتقنيات والثقافة والحضارة.
وأرى لزامًا عليَّ أن أبادر بالقول بأن عصرنا قد صار مسرحًا لتطورات علمية كثيرة، وذلك يحفِّز فينا الأمل في المستقبل، ولكن الحقيقة هي أنه كلما بلغت التقنيات والحضارة الذروة فسيعني ذلك أن هناك في الوقت ذاته أنواعًا من التهديدات والمَخاطر، ولا يمكن تخطيها والحدُّ من أخطارها إلا بالأسس التي جاء بها القرآن، فقد أثبتت الأزمات الاجتماعية والروحية والثقافية التي يعيشها الإنسان في الأعوام الأخيرة أن العالم البَشَري بحاجة إلى نظام معنوي جديد يسد الفراغ المادي الذي تردى فيه، وسيوجههم هذا الإحساس بالنقصِ إلى الإسلام عاجلًا أو آجلًا، ومن هذا المنطلق يجب على المفكرين والباحثين المسلمين القيام بمهام ووظائف كبيرة في هذا المجال.
إن المسلمين في القرون الأربعة الأولى توجهوا إلى القرآن بمنظور كلي ولذلك تقدموا في العلوم المادية والمعنوية حسب موازين عصرهم، فالقرآن أخذ بيد هذه العقول المتوجهة إليه بصدق وإخلاص، وجَعَلَ أصحابها من أكثر الأمم تحضّرًا.
أجل، إنهم من جانب توجهوا إلى فهم الآيات القرآنية التي تحفِّز التفكر، وبنوا مراصد لاكتشاف الأجرام السماوية خاصة، فأصبحوا بذلك رُوَّادًا في فتح الطريق لمن أتى بعدهم من الباحثين الأوائل في علم الفَلك الحديث، وجاشت ضمائرهم وتحفَّزت هممهم بقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (سورة فُصِّلَتْ: 41/53) فوجّهوا جهودهم نحو الإنسان، ودققوا في كل جزئية من جزئيات بنيته المادية والمعنوية، وفتحوا الطريق إلى ما نسميه اليوم الطب الحديث، حيث إن الطب الحديث اليوم مَدين فيما وصل إليه من هذا المستوى الرفيع لتلك البنية التحتية التي أسسها علماء المسلمين في ذلك العهد، ومن جانب آخر اعتَبر هؤلاء العلماءُ الآياتِ المتعلقةَ بالفضاء والسماوات على أنها أمر إشاري من الله فسخروا كل إمكانياتهم لفتح آفاق السماوات.
فقبل كل شيء نلاحظ أن مسلمي ذلك العهد كانوا يقفون عند كل آية، ويتساءلون: ماذا يريد ربنا أن يقوله لنا؟ وكانوا يعتبرون هذه الفكرة هي الغاية الوحيدة لهم في حياتهم، فيحاولون فهمها من خلال مختلف التفسيرات، وبذلك كانوا يتناولون كل قضية من القضايا التي تَطرَّق إليها القرآن، كل قضية على حدة، ويدققون في كل ما يتناوله القرآن، بل إن أُولى الاجتماعات والمذاكرات العلمية كانت هي أيضًا من هداياهم إلى الإنسانية، حيث إن كثيرًا من القضايا التي كانت تُنَاقَش في هذه المجالس لا تزال تحافظ على صحّتها وجدَّتها، ولن يكون من الصحيح مقارنة ما وصل إليه العلم اليوم من التطورات بما كان عليه من الحالة البدائية في عهوده الأولى، فمن المعلوم أن المستوى العلمي حينذاك كان بسيطًا جدًّا، ولكن إذا قيَّمْنا المسألة في حدود الظروف والفُرَص والإمكانات المتاحة في ذلك الحين، فسنلاحِظ أن الباحثين المسلمين في تلك الحقبة قد أدوا ما وقع على عاتقهم حق الأداء، وبالأخص إذا أخذنا بالاعتبار مبادرتهم لهذا الأمر وكونهم بادئين من نقطة المركز؛ فإن ذلك سيزيد من قيمة نجاحهم أضعافًا مضاعفة، بل تُعتبر نجاحاتهم أكبر من نجاحات عصرنا؛ اعتمادًا على القاعدة التي تقول: إن نقطةً في وسط الدائرة تتحوّل إلى زاوية كبيرة في محيط الدائرة.
ومما لا مرية فيه أن الأمر الذي يجب علينا الوقوف عنده مليًّا هو قضية الجمود الذي خيم علينا منذ ثلاثة أو أربعة قرون، فعلينا أن نحاسب أنفسنا ونراجع موقفنا تجاه هذه القضية. أجل، إن العالم الإسلامي يعيش منذ قرون انقراضاتٍ خطيرةً؛ حيث إن الحياة العلمية قد توقفت في هذه المرحلة توقفًا تامًّا، ولم يبق في التكايا والزوايا ولا في المدارس الشرعية حيويةٌ ولا تحرُّكٌ جاد؛ بمعنى أن الحياة الروحية والقلبية كانت قد أفَلَتْ شمسُها، كما أن الساحة العلمية أصبحت عرضةً للإهمال، وتَرَكَ الناس محاولةَ فهمِ المقاصد الإلهية في القرآن المعجز البيان، وأصبح المسلمون ينجرفون إلى دائرة فاسدة وحلقة مفرغة من دوّامات التخلف والانحطاط.
والأدهى والأمرّ هو قيام بعض المفكرين والكُتاب المقلدين للغرب المتجاوزين لحدهم بالتصدي لقطع فاتورة هذا الإهمال على حساب الإسلام ذاته، فكما أن الأصدقاء لم يُوَفُّوا حقّ الصداقة بل ظلوا في سبات عميق، فالأعداء كذلك حافظوا على مواقفهم العدائية المخاصِمة، وهكذا لم يكن للإسلام فرصة الدفاع عن نفسه، وخصوصًا أنه شبَّ في العهود الأخيرة نزاع بين المدارس الشرعية القديمة والمدارس العصرية، فأخذ كل فريق يجتهد لهدم الآخر، وفي نهاية المطاف حاول كل منهما أن يلقي بذنبِ التخلف الحضاري على عاتق الطرف الآخر.. فكان أحدهما يهتف دائمًا باسم “الغرب” ويغيّر
كل حين قبلته ووجهته، بينما كان الطرف الآخر يعتبر التفكر في آيات الله الآفاقية والأنفسية من باب العبث، فقضى بذلك على نفسه.
وإننا لا نريد أن نفتح الباب أمام إذكاء جذوة تلك النزاعات، إلا أن هناك واقعًا وهو أن هذا الذنب الذي ارتكبه الفريقان ليس من النوع الذي يُغتفر. أجل، إن الذين ارتكبوا هذا الأمر كان لا بد أن يَلقَوا جزاء إساءتهم الأدب مع الله صاحبِ الكون، ومع القرآن الذي هو كلامه المعجز، وقد لقُوا بالفعل هذا الجزاء.
ومع أن الله تعالى أمرنا -بشتى الوسائل- بالتفكر، وحضَّ المؤمنين على أن يتعمقوا في البحث والتنقيب في الأرض والسماء، إلا أن أهل التكايا والزوايا التي أصبحت مأوى لآلاف الناس اللاهين عن الحياة القلبية والروحية كانوا يتصرفون بشكل أحادي ويعملون في وجهة واحدة، يلهج لسانهم بترديد الحديث عن “القلب” ولا يتجاوزون منه إلى غيره، ليتهم كانوا يعرفون أمور القلب حقًّا، ولكن هيهات لهم ذلك، وأما المدارس العصرية فقد كانت بكل أفرادها مستلقية على قفاها، تُدنْدِن حول الحديث عن الغرب والفكر الغربي لِتُغَطِّي جهلَها بأحاديث لا تتجاوز أن تكون من باب الديماغوجية، فكانت تبدو وكأنها حصرت همتها في الدنيا، ولكن كل حملة منها كانت إما ردّةَ فعلٍ تجاه المدرسة الشرعية، أو تقليدًا أعمى للغرب.. ومصداقًا لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/134) كان العالم الإسلامي كله يعيش حالةً مزريةً من الإهمال وعدمِ الإدراك وفقدِ الشعور والإحساس تجاه القرآن الكريم، ولا شك أن نتيجة كل ذلك فاجعة كبرى.
وكم نرى في واقعنا أنه إذا قام أحد رجال السياسة بتصريح في بضع كلمات، فإذا بأناس من مختلف الفئات العمرية ينشغل بالُهم على مدى أيام بل شهور ويتعمقون في فهم مغزى هذا التصريح، في حين أنهم لا يهتمون بالقرآن الكريم حتى بمقدار كلام هذا الرجل على الأقل، فكنا على مستوى الأمة، نقترف ذنبًا عظيمًا، واللهُ يعلم ماذا نفعل الآن، ولذلك أقول: إذا لم نتخط بشكل سريع هذه الغفلةَ وهذا الإهمال الذي نعيشه وإذا
لم نتوجه بكليتنا، شِيبًا وشبّانًا، رجالًا ونساءً إلى القرآن، ولم نكثّف انتباهنا وكلَّ جهودِنا حوله، فإنه سيكون من الصعب خروجنا من هذه الهاوية السحيقة.
فالله يوجه في القرآن أنظارَ بني الإنسان وانتباههم نحو الكون ونحو أنفسهم، فلا يفرق بين أصناف العلوم، بل يحثّنا على إجراء البحوث في الأوامر التشريعية والتكوينية معًا، ويطلب من الناس أن يكونوا عشاقًا للحقيقة وعشاقًا للعلم وعشاقًا للبحث. أجل، إن القرآن والإسلام يدعوان دائمًا منتسبِيهما إلى إجراء البحوث والتنقيب، وتاريخُنا زاخرٌ بالأمثلة الحية من فحول العلماء الذين لبَّوْا هذه الدعوة واستجابوا لهذا النداء.
لقد استجاب أصحاب العقول الكبيرة لهذا الأمر الإلهي على حسب وسعهم، فجعلوا الإسلام روحًا للحياة، ونحن أيضًا مخاطَبون بهذا الأمر الإلهي على قدر ما أُمِرنا به، بالإضافة إلى أن مسلمي هذا العصر هم أوفرُ حظًّا من أسلافهم من حيث توفر الإمكانات التي أتت بها التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، فنحن نمتلك أدوات البحث في القرآن في ضوء التطورات العلمية والتقنية، وليس علينا الآن إلا أن نتجه إلى المستقبل تحت رعاية القرآن بهمة عالية وأملٍ حيٍّ في أن نتدارك ما أهملناه وغفلنا عنه على مدى قرنين
أو ثلاثة قرون.
ل. شكل الكرة الأرضية
إن الله تعالى بعد أن ربط السماوات بقانون ونظام، وجَّه إرادته وقدرته نحو الأرض، ووضع لها أيضًا نظامًا وجعلها كروية الشكل.
ويَذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (سورة النَّازِعَاتِ: 79/29-30)، فيفهم من الآية أن السماء قد تم ترتيبها وانتهى تنظيمها وقُدر ليلُها ونهارها، ثم جُعلت الدنيا على شكل “أَدْحِيَة”.
وقبل الانتقال إلى شرح بعض التعبيرات في الآية أودّ أن ألفت النظر إلى نقطة، وهي أن أحدنا إذا أراد أن يصف أيّ جسم دائري مثلًا فإنه يبدأ بتعريفه على أنه “دائري الشكل”، فإذا أراد أن يزيد الأمر وضوحًا قال: إنه يشبه التفاح أو البرتقال أو غير ذلك من الأمور المعروفة بدائريتها، فبذلك يكون قد أشار إلى دائرية ذلك الشيء بالإضافة إلى ما في تلك الدائرية من مميزات إضافية.
وهكذا القرآن، حينما يريد أن يبيّن حقيقةَ أمرٍ ما فإنه بما يستخدمه من التشبيهات يَلفت الانتباهَ إلى خاصية أخرى لتلك الحقيقة، فهذه الآية الكريمة استَخدمت كلمة “دَحَا” بشكل خاص؛ لأن هذا الفعل مشتق من الدحو أو الدحي أي البسط، ونفهم من كلمة “دَحَا” أن الله تعالى بعدما نظَّم ورتب السماء تَوجه إلى الأرض وجعلها بيضاويةَ الشكل على شكل بيض النعامة.
صحيح أن المفسرين منذ القديم قالوا بكروية الأرض، ولكن هذا الأمر لم ينكشف على حقيقته إلا في عصور متأخرة.. ومع أن هناك من يرى في هذا التفسير نوعًا من التكلف إلا أن العديد من العلماء من أمثال الكندي والغزالي وفخر الدين الرازي وغيرهم من المفسرين المعاصرين استنبطوا من هذه الآية وأمثالها كرويةَ الأرض.
والقرآن الكريم بتعبيراته الخاصة وأسلوبه الخاص به يتناول المواضيع بدقة فائقة بحيث إن العلوم الطبيعية على الرغم مما أتيح لها من الإمكانات الواسعة، ومع توصُّلها إلى المعلومات بشكل غاية في الوضوح، لا تستطيع أن تعبر عن هذه الأمور بمستوى العمق القرآني وبأسلوب منفتح على جميع الاحتمالات.
إن عقلية عصرنا الماديةَ العوراء التي تنظر إلى كل شيء من الجانب المادي فقط تتغاضى عما ينشره القرآن من الحقائق، حتى إنها لا ترى -على الأقل- مسايرته لروح العصر، إلا أنها مهما فعلتْ فلن تستطيع الحيلولة دون وُلوجه إلى الضمائر، بل ستعجز عن ذلك؛ لأن تطور العلوم يجعل الناس يتعمقون في فهم القرآن، ويستوعبونه بشكلٍ أفضل.
وربما سيأتي يوم تُعلِن فيه كلُّ فروع العلوم الطبيعية بلسان حالها بأن القرآن كلام الله، وسيودي ذلك إلى حقبة قرآنية جديدة؛ لأن موقع البحث العلمي إنما هو كتاب الله “المنظور” الذي هو معرض لآثار الله الفنية المذهلة، والحاوي لما أودع فيه من الأسرار.
ذلك الله صاحب القدرة المطلقة الذي أوجد الأرض بشكلها البيضاوي، وأودع الشمس في السماء وكأنها شمعة عملاقة، وأدار السُّدم والمنظومات الكبيرة وكأنها خرزات مِسبحة، وهو الذي ينظر في الوقت نفسه إلى أعماق الإنسان وقلبه ومشاعره، وينظم عالمه الداخلي بكيفية عجيبة.
م. القرآن الكريم والغلاف الجوي
1- الغلاف الجوي، نعمة نحن عنها غافلون
إن الإنسان كثيرًا ما يغفل عما حباه الله به من النعم، وحتى لو كان مُدركًا لها في بعض الأحيان فإنه لا يؤدي شكرها على الوجه اللائق، فأحيانًا تَأسرُه مخالب الألفة والتعوّد، فيرى هذه النعم أمورًا عادية ولا يستطيع تقييمها، فتراه لاهيًا عن آلاف النعم التي تشمله وتحيط به من كل الجهات.
وعلى الرغم من تسخير كل شيء له في الكون، نراه مصابًا بالعمى والغفلة عن إدراك هذا التسخير الإلهي ولاهيًا عنه، وحتى لو كان مدركًا للنعم لكنه لا يقوم بمقابلتها بواجب الحمد والشكر عليه حق القيام، وفي ذلك يقول الله : ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (سورة سَبَإٍ: 34/13).
وفي آية أخرى يبين الله تعالى أن العبد عاجز عن تعداد النعم ناهيك عن شكرها، قائلًا: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (سورة إِبْرَاهِيمَ: 14/34).
أجل، إن الله هو المنعم الحقيقي وهو الذي يعطي كل شيء، ولكن الإنسان، للأسف! كَفور يَنسى المانح لهذه النعم، بل ويَنسى النعمةَ نفسها، فيَسقط في مهاوي الكفران رغم جَوَلانه في آفاق الشكران، فالنعم تنهمر عليه من كل جانب وهو لاهٍ عن كل ذلك.
والحقيقة أن تعداد نعم الله يفوق حدود طاقتنا، ولكننا نوجِّه أنظارنا إلى واحدة منها فقط، فنحاول أن نبدد -ولو قليلًا- ما تَلبَّدَ عليها وغطَّاها من غيوم الألفة والاعتياد.
إن القرآن الكريم يتحدّث، بين الفينة والأخرى، عن النعم المتعلقة بالعلوم والتقنيات، ولكنه كثيرًا ما يتطرّق إليها على وجه الإجمال، وبالتالي فإن الإنسان إذا لم ينظر إليها بدقة فلن يفهم ما فيها من الأسرار، ومن النعم الإلهية العظيمة التي لسنا على دراية بها على الوجه اللائق الغلافُ الجوي الذي لا يزال يحمينا من فوقنا من كل المضارّ مثل الصوبة الزراعية والخيام البلاستيكيّة، ويلبي حاجتنا من الهواء، وينقل أصواتنا.
وسواء سميناه الفقاعة الهوائية، أو الكتلة الغازيَّة، أو “الغلاف الحيوي (Biosphere)” (باعتباره يشكِّل بيئة ملائمة لمواصلة الكائنات الحية لحياتها)، أو سميناه بأسماء أخرى، فلا شكّ في أنه من أعظم النعم التي دامت منذ بداية الحياة على وجه الأرض حتى يومنا هذا، وستستمر بعد الآن أيضًا طالما شاء الله ذلك وقدَّر.
وللغلاف الجوي وظائف لا تُعَدُّ ولا تحصى، ولو كان الناس يعلمون كيف أن الله تعالى قد أوجده لأمور عظيمة مُهمّة لأخذَتْهم الروعة والدهشة من ذلك، وبفضل تقدُّم العلم والبحث العلمي في زماننا هذا استطعنا أن نتعرّف نوعًا ما على مدى ما تُقدمه ركاماتُ الغاز البسيطة هذه للإنسان من الخدمات.
إن الغلاف الجوي يقدم للبشر -بإذن الله- كلَّ حين المقدارَ اللازم من الهواء الذي يحتاجه البشر أكثر من احتياجهم إلى الخبز والماء، ونزداد كل يوم شعورًا بمدى خطورة هذا الأمر بالنسبة لنا، خصوصًا في هذه الأيام التي نعاني فيها من التلوّث جراء اختلال النظام العام في الطبقات الجوية.
وتنهمر كل يوم إلى سماء الدنيا عشراتُ الآلاف من النيازك، لكن الغلاف الجوي بما يملكه من قوة الدفاع الطبيعي يؤدّي وظيفة السقف الواقي تجاه هذه النيازك.
وأيضًا فللغلاف الجوي دورٌ مهمٌّ في تهيئة المناخ المناسب لتشكُّل الرياح، علمًا بأن الرياح على اختلاف أسمائها وأوصافها وشدتها وخفّتها أحيانًا تكون بمثابة نسيم تُربِّت على رؤوسِنا، وأحيانًا تَهُب بشدّة لتحملَ البذور وتلقّح النبات، وأحيانًا أخرى تكون عواصف تُلبِّد الغيومَ وتصبح وسائل لنزول الأمطار، كما أن الرياح تهبُّ أحيانًا من القطبين باتجاه خطِّ الاستواء، وأحيانًا تهبُّ من خط الاستواء إلى القطبين، وفي كل مراحلها تتخذ أسماء مختلفة وتؤدي وظائف متعددة، وإذ تقوم بذلك كله تَكشف لنا بأنها مسخّرة بمشيئة الله لخدمة الإنسان.
وإذ يسرحُ الإنسان ويمرّ في ربوع الأرض، قد لا يَشعر بهذه النعمة، لكن صاحب النعمة جوادٌ والنعمة وفيّةٌ، ولذلك لا يعيش الإنسان حرمانًا أصلًا، وكم ينتظر الإنسان بشوقٍ هبوبَ نعمة النسيم، حينما يعمل تحت الشمس في الصيف القائظ الخانق ويتصبّب عرقًا، فإذا جاء النسيم وتهادى على جسمه شعر بعِظَم نعمة النسيم، وهذا بالطبع إذا كان يعرف مُولي النعمة.
وما يسمع الناسُ أصوات بعضهم البعض إلا من خلال الغلاف الجوي، فمن خرج إلى خارج الغلاف الجوي لن يستطيع أن يُسمِعَ صوته حتى لمن هو بمقربة منه على مسافة متر واحد؛ لأن الغلاف الجوي هو الذي يحمل الصوت.
وإنما يدرك الإنسانُ قيمة الهواء إذا لاحظ ما يفعله في الأرض من تَرْبِيتِهِ للنباتات وتبريده لها وسوقِه للسحاب وربطِه بين أجزائه وتلقيحِه للنبات، فحينذاك يدرك مدى عظمة هذه النعمة، وأنَّ نعمة جسيمة مثلها لا تحصل بفعل المصادفات.
إن الإنسان إذا آمن بالله وأسند إليه كلّ شيء، وخلّصَ الأشياءَ من جو المصادفات الضبابي وسلَّمها لصاحبها الحقيقي فسيَشعر ويُحس بكل شيء بشكل أفضل، وإنْ عانَدَ وجَنَحَ إلى كفران النعم، فإن الأرض والجو سيكفهرّ وجههما تجاهه كما هو الحال بالنسبة لعالمه الداخلي، وسينظر إلى هذه الأمور على أنها مصائب ومتاعب ويعتبر كلّ الظواهر أعاصير وعواصف.
أجل، إن النظر إلى كل شيء من وجهة نظر الإيمان، وتناوُلَ كلِّ ظاهرة وتفسيرَها من منظور القرآن أمرٌ مهم للغاية.
﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَاتُحْصُوهَا﴾ (سورة إِبْرَاهِيمَ: 14/34)، كيف تحصونها في حين أن الله تعالى يقلّب نعمة واحدة فيخلق منها آلافًا من النِّعَم، بحيث إن الإنسان إذا تناول أيَّ نعمة فإنه يكتشف في داخلها نعمة أخرى، ويحسّ بنفسه وكأنه يتقلّب بين نعمٍ متداخلة، وبفضل هذا الإيمان فإنه حينما ينظر إلى هبوب الريح وإحداثِه موجاتٍ صغيرةً على وجه البحر، وتمايُلِ الماء وكأن هناك تبادلًا بين عاشق ومعشوق، وحينما يتفكرُ في تلقيح الريح للبذور، ومروره على شعر الرؤوس برحمة ولمسة أمومية، فإنه يشعر بأنه أمام عدد من النعم ويطفحُ بمشاعر الشكر والامتنان، فهذه في حقيقتها نعمة واحدة إلا أنها تظهر في كل مرة بزيِّ نعمة مختلفة، ولكن من مظاهر عظمة الله تعالى أنه يحوِّل الواحد إلى ألف، فيُبرز في الإنسان النعمةَ الواحدة وكأنها ألف نعمة.
إن الغلاف الجوي من نعم الله العظيمة، فلنتناوله من مختلف جوانبه حتى نشاهد كيف أن ما وصل إليه العلم الحديث يتوافق مع بيان القرآن الذي أنار العصور، وأعترف أنه من الصعب علينا أن نعكس ما في القرآن بخصوصياته وروحه من دون أن نبقى تحت تأثير المستوى العلمي والثقافي لعصرنا.
ومن هذا المنطلق نقول: مهما كانت الفرضيات العلمية المطروحة على الساحة ذات بريق إلا أنها ستَخمد وتَذبل في العصور اللاحقة، وإذا كان هناك شيء واحد لن يتعرض للذبول والخمود فهو الكلام الإلهي.
نعم، ستتعرض الفرضيات العلمية للتقادم وستَتعب الوسائل التقنية والأدوات التكنولوجية، ومن يدري لعله سيأتي يوم تلجأ فيه كل هذه الأدوات في نهاية المطاف إلى القواعد الأساسية القرآنية الراسخة التي لا تتزعزع.
2- تحليق الطيور في جوّ السماء
إن القرآن الكريم يتحدث عن كيفية تحليق الطيور في الجو وإلى أي طبقة ترتفع الطيور، وفي هذا السياق يستخدم تعبير: ﴿جَوِّ السَّمَاءِ﴾ (سورة النَّحْلِ: 16/79)، والمقصود بهذا هي الطبقة التي يتجوّل فيها الأحياء، وهو ما يسمى “الغلاف الحيوي (Biosphere)”.. والقرآن الكريم يستخدم أحيانًا تعبير: ﴿جَوِّ السَّمَاءِ﴾، وأحيانًا أخرى يستعمل تعبير “السماء” فقط، فالأول هو الطبقة الهوائية المناسبة لعيشِ الكائنات الحيّة، بينما الثاني هو الطبقة التي لا يوجد فيها المقدار الكافي من الأوكسجين على الرغم من وجود بعض الغازات الأخرى، وبالتالي لا تلائم الكائنات الحية.
إن لكل كائن حي يعيش في الماء وأعماق الماء وفي التراب وأعماق التراب وفي الجو وأعماق الجو حدودًا ومجالاتٍ معينة ليس له أن يتخطّاها، فالساحة التي يمكن للطائر أن يحلّق فيها هي المجال الذي عبر عنه القرآن بـ”جو السماء”.. ولا بد أن لله حكمة وغاية تهمّ الناس من وراء تناوُله هذا الموضوعَ في القرآن الكريم ولفتِه أنظارَ المؤمنين إلى هذه النقطة، وإلا فليس المقصود مجرد سرد معلومات حول الحياة في مجال الغلاف الجوي، أو الإدلاء بمعلومات حول ما يعيش على الأرض من الحيوانات.
إن من طبيعة الإنسان أنه يألف كثيرًا من الأمور التي تدهشه في أول وهلة، ولذلك نراه يتأقلم مع كل ما كان في البداية في عداد المفاجآت، ويأنس به ويعتاده، فتخيِّم عليه غيوم الألفة والاعتياد، وتصبح كثير من المعلومات المهمة وكأنها أمور اعتياديّة، كما هو موقفه تجاه كل ما يلاقيه في حياته اليومية، فيكتفي بما لديه من المعلومات حولها ولا يتجاوزها ظنًّا منه أن هذه المعلومات كافية.
فالله تعالى في بعض الآيات القرآنية يلفت أنظارهم إلى هذه الأمور لتبديد ما تَلبَّد من غيوم الإلف هذه وسوقِ الناس إلى التفكُّر فيها مرة أخرى.. فحينما يأمرنا الله في القرآن بالنظر في أمر من الأمور فإنه يريد منا التركيزَ على تصرُّفاته الحاوية على عشرات من الحِكم، وبهذه الطريقة يُنقذنا من براثن الألفة، ويجعلنا متيقّظين ومرهَفي الحسّ تجاه روعة الصنعة الإلهية، مدقِّقين بجدٍّ فيما يتعلق بذلك من البيان القرآني الخالد، حتى ينمو وتنكشف فينا الحياة القلبية والروحية، بالإضافة إلى تحقيق عدد من الأهداف والغايات النبيلة أكثر فأكثر، ومن هذا المنظور نقول: إن الوقوف عند كل بيان قرآنيّ ومطالعتَه بدقة فائقة لهو في منتهى الأهمية.. فمثلًا عندما نتأمل في قوله تعالى: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ (سورة الْمُلْكِ: 67/3) نلاحظ أن هذا الأمر الإلهي يأمرنا بفهم الحكمة والمقصد الإلهي، وأننا لن نستفيد من الكلام الإلهي حقّ الاستفادة إلا بهذا المستوى من الدقّة والتأمل.
وكأن هذه الآية الكريمة تدعو الإنسان إلى أن يتأمل مرة واحدة في أمور متداخلة: من دوران النجوم في الفضاء إلى جولان الكواكب، ومن كيفية المنظومة الشمسية إلى دوران الأرض حولها وكأنها تابعٌ دَوَّار، ومن العديد من خصائص وكيفيات الغلاف الجوي إلى علاقته بكل شيء من الكائنات الحية وغير الحية، ولذلك نرى الحق سبحانه يُردف قولَه: ﴿هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾، بقوله: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ (سورة الْمُلْكِ: 67/4)، وبذلك يأمر بتكرار هذا التأمّل في الفضاء مراتٍ ومرات.
وكأنه بهذه التعبيرات يقول للإنسان: إن شئت فانظر -مرة أخرى- إلى هذه السماء العظيمة من خلال قوانين علم الفلك، ومن خلال نظريات علم الفيزياء والرياضيات، وإن شئتَ فقيِّم الموضوع من جانب آخر في المختبرات، ثم حاولْ أن تنظرَ مرة أخرى، فإذا فعلتَ هذا فلن ترى في نهاية المطاف أيَّ تنافرٍ يُخلّ بالنظام العام، ولن تشاهد أيَّ أمر يتناقض مع العلوم الطبيعية، وقد كان مَن قبلَكم يحاولون أن يفعلوا هذا بالعين المجردة، فلم يكن لديهم مثل ما لديكم من تلسكوب ومقراب ومجهر إلكتروني، ولكنها متاحة لكم، فما عليكم إلا أن تراقبوا ما في تلك العوالم العُلوية من نعم الله وتصرفاته وآثار صنعته، حتى تزدادوا إيمانًا وإذعانًا ومعرفةً، وتُعاينوا ما بين الملايين من الأنظمة من ذلك التناغم المذهل، لتنتقلوا منه إلى ما في ذلك التناغم من الوحدة، حتى تروا في تلك الوحدة موجوديةَ الله بكل وضوح وجلاء، فالقرآن الكريم بهذه التعبيرات يحث الإنسان على مشاهدة الفضاء الواسع، كما يحثه على إجراء البحوث فيه.
أجل، إن الله تعالى يَلفت أنظارنا إلى تحليق الطير في طبقة معينة من السماء قائلًا:
﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة النَّحْلِ: 16/79).
ومن الجالب للانتباه ما في قوله تعالى: “فِي جَوِّ السَّمَاءِ” -كما سبق أن أشرنا إليه- من الإخبار بشكل غيبي بأن الطيور لها مجال معين تطير فيه، ولا أظن كثيرًا من المسلمين يتأملون في هذه الآية بعمق وعلى الوجه اللائق، ومن المحتمل أننا لم نزل نظن أن ما يحيط بنا من الغلاف الجوي والغلاف الحيوي من الأسفل إلى الأعلى عبارة عن طبقة واحدة، ولكن حينما ندرس الموضوع بشكل دقيق وبعمق نلاحظ أن للغلاف الجوي طبقاتٍ تختلف عن بعضها البعض ولكل طبقة خصوصياتُها ومميزاتُها، وهي بحسب توزيع الحرار ة فيما بينها كما يلي:
1- طبقة التروبوسفير (Troposphere)
2- الستراتوسفير (Stratosphere)
3- الأيونوسفير (Ionosphere)
4- الإكسوسفير (Exosphere)
ويَرِد في الآية الآنفة الذكر تعبيرُ: “مَا يُمْسِكُهُنَّ” والإمساك من باب الإفعال، وفيه إشارة إلى أن جو السماء قد هُيئ من قبلُ ليكون مناسِبًا لتحليق الطير، وبالتالي فإن النظام والقانون الإلهي هو الذي أتاح لها إمكانية الطيران ضمن مجال معين ومحدود لتحليق الطير وجولانه وليس له أن يتجاوزه ويصطدمَ بالنظام الموضوع هناك.
وكذلك الوضع بالنسبة إلى الكائنات الحية الأخرى، ولكن الآية تشير إلى ما سيتم اكتشافه من حقيقةِ أن الإنسان سيصعد إلى هنالك بما سيمتلكه من الأدوات، وأن تلك المنطقة صعبة بالنسبة لعيش الأحياء فيها، ومن البدهي أن هذا الصعود لن يتم مرة واحدة، بل ستكون هناك محاولات عديدة للتغلب على الموانع، فإذا تخطى الإنسان مشكلة الجاذبية والاحتكاك وظروف الغلاف الجوي فإن هذا الحُلم سيتحقق.
فهاك قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/125).
إن الموضوع في الآية يدور حول المقارنة بين وضع المؤمن والكافر، أي بين من فتح قلبه للهداية ومن قسا قلبه تجاهها، بين من يلمع نور الإيمان والمعرفة في داخله فشرح صدره وبين من غرق في انحرافات الكفر والضلال فضاق صدره.
فإذا استخدم الإنسان إرادتَه استخدامًا صحيحًا واستغلّها في سبيل تحصيل المعرفة الإلهية، وأراد الله أيضًا هدايته، فَتَح قلبه للإسلام ومَنح فؤاده سعة ورحابة.
ونحن إذ فسرنا هذه الآية، أضفنا أمرًا لم تتطرّق إليه الآية: وهو “دور الإرادة الإنسانية”، لأن السلف في مثل هذه القضايا لم يزالوا يجلبون النظر إلى دور الإرادة البشرية، بمعنى أنهم يرون أنه لن يكون للمشيئة الإلهية تعلُّقٌ من دون أن تكون هناك إرادة للإنسان.. صحيح أن الإرادة والمشئية الإلهية ليستا منوطتين بالإرادة الإنسانية، لأن الله مالك الملك، يتصرف في ملكه كيف يشاء، إلا أن العدالة الإلهية والحكمة الربانية والسنن الكونية جرت بأن الله جعل تعلُّقَ الإرادة البشرية شرطًا عاديًّا لضلالتهم أو هدايتهم.. فنحن أيضًا حينما نتحدث عن إرادة العبد فإنما نذكرها انطلاقًا من هذه الفكرة.
أجل، ينبغي للإنسان أن يجتهد في سبيل ما يريد تحقيقه حتى يشرح الله صدره حينما يريد الله هدايته، فإذا طَلب الإنسانُ الهداية فإن الله سيشرح صدره، وسيجد هذا الشخص لذة الإيمان ويعيش حياته في الدنيا وكأنه من سكان الجنة.
ولنركز على جانب آخر من الآية له علاقة بما نحن بصدد الحديث عنه وهو أن الله إذا أراد أن يُضل من استَعمل إرادتَه استعمالًا خاطئًا ضيَّق صدره، فإنَّ عدم الإيمان وتَرْكَ العبادات التي هي من مقتضيات الإيمان، يُحدث في قلب مثل هذا الإنسان ضِيقًا وحرجًا شديدًا، فالكافر إذا لم يستعمل إرادته في الوجهة الصحيحة فالله أيضًا لا يريد دخوله الجنة، ولكن الذي أدى إلى هذه النتيجة إنما هو الكافر نفسه الذي لم يُرِد الإيمانَ، ولم يضع جبينه على الأرض ساجدًا مبتهلًا قائلًا: “اللهم لا تضلني”.. فهذا الشخص قد استَعمل بإرادته لسانَه وقلبه ودماغَه في سبيل الكفر، ولم يأبه بأي تحذير إلهي، ولم يلتفت إلى مغزَى ما يجري حوله من الأحداث ولا إلى ما تَحْمله من المعاني، ولم يتنبه لها، ولذا أراد الله تعالى إضلاله.
فمن قُدِّر له مثلُ هذا فسيضيق صدره، ويصبح كأن هناك من يشد خناقه، فالآية الكريمة في هذا السياق تُصوِّر لنا إنسانًا يكاد يختنق من قلّة الهواء، أو ترسُم حالةَ مَن قَبع في قعرِ سجنٍ لا يجد فيه ما يكفي من الهواء، أو مَن يختنق بحبل في عنقه.
وقد أوردت الآيةُ الكريمة أثناء تصويرها ورسمِها لهذه الحالة الحرجة فِعْلَ “يَصَّعَّدُ” بدلًا من “يصْعد” أو “يعلو”، وفي ذلك نكتة لطيفة، حيث إن السامع لهذه الكلمة يَلمس مِن جرسها وكأنه يسمع صرير صوتِ الآلات التي يستخدمها في الصعود.. هذا بالإضافة إلى أن صيغة “يَصَّعَّدُ” ترسُم بصيغتها أيضًا تلك الحالةَ، حيث إنها من باب التفعُّل الذي يدلّ على التكلف، وذلك يؤكد ما تدل عليه الآية من الصعوبة والشعور بالحرج.
فقد دلت هذه الآية هنا بصيغة هذه الكلمة على ما يعانيه الكافر من الضيق والعنت بشتى أبعاده، كما أكدت على ذلك من خلال جرس الكلمة وموسيقاها.
وهكذا يوضح القرآن ما وقع فيه إنسان عصرنا من الأزمات، ويَلفت أنظارنا إلى الضلال الذي أحدثه الحرمان من الإيمان، وإلى ما جلبَه هذا الحرمانُ من ضيق وعنت في القلوب، وبالتالي فالمخاطب لهذه الآية هو إنسانُ هذا القرنِ من بعض الوجوه؛ لأنه قد تَعرَّض لأنواع من القلق والاكتئاب بشكل لم يعشه الإنسان فيما مضى من العصور، فالضيق الناشئ مما في عصرنا من الكفر والضلال، يُشْبه ما يعانيه من يصَّعَّد في السماء، حيث إنه كما صعد إلى الأعلى يكون كمن تختنق حنجرته.
إن الإنسان الذي لم يصعد إلى السماء ليس له أن يدرك ما يعانيه الصاعد من قلة الهواء وضيق الصدر، ولستُ أدري ماذا كان يفهمه الناس في العصر النبوي حينما كانوا يتلون هذه الآية، إلا أن التطورات الحديثة في علم الفلك قد ساعدت على تجلية جُلّ ما في الآية من دقائق المعاني ولطائفها، فكما تَبين لنا ما يؤدي إليه الكفر من ضيق وعنت، فقد انكشف لنا أيضًا في عصرنا هذا أنه كلما صعد الإنسان إلى الأعالي وجد صعوبة
في التنفس وعلمنا أن تلك المناطق ليست ملائمة لعيش الأحياء.
ومعلوم أن التشبيه يُستخدم في الكلام لإضفاء المبالغة على أمر ما، أو لإبراز المقاصد الخفية والمكنية، وبتعبير آخر: لبيان أمرٍ مجهولٍ عن طريق أمر معلوم بالنسبة للمخاطب.
فمثلًا: إننا نجهل كيفية نفاذ قوة الله وقدرته في كل شيء وفي كل مكان، وبالمقابل كلنا يعرف كيف أن الشمس تصل بأشعتها إلى كل المناطق فتشمل الجميع بدفئها، فإذا ما شبهنا اطلاع الله على كل مكان وعلمه بكل شيء بأشعة الشمس التي تنساب إلى كل مكان فسيمكننا حينذاك أن نفهم هذا الوضع.
فالآية الكريمة أيضًا تُبيّن حال الكافر من خلال أمر معلوم لنا، فإنه لا يمكن بيان حالٍ من الأحوال من خلال أمر مجهول الماهية؛ لأنه من غير الممكن أن يفهم المؤمن حال الكافر الذي يضيق صدره، فإذا حاولنا تشبيه هذا المجهول بمجهول آخر يتحول الأمر إلى معادَلة ذات مجهولَين، ولكن بيان القرآن في غاية الوضوح ومنتهى الفصاحة: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/125).
وفي سياق الحديث عن تحليق الطير استخدم القرآن تعبير: “جَوِّ السَّمَاءِ”، أي المجال الجوي الذي يلائم عيشَ الأحياء، ولكنه استَخدم هنا تعبير: “فِي السَّمَاءِ”، بمعنى أنكم حينما تكونون على الأرض لن تَشعروا بهذا الضيق، ولكنكم إذا تجاوزتم منطقة “جو السماء” ودخلتم “في السماء” فستشعرون بذلك، ولم يكن الإنسان يعلم بأنه كلما صعد إلى الأعلى ضاق صدره من قلة الهواء إلا بعد أن عاش هذه الحالة أثناء صعوده بالطائرات أو المناطيد، وبالتالي فإنما ظهر المراد من هذه الآية في هذه المرحلة، حتى إنك لَتسمع في الطائرات إعلانًا صوتيًّا مفاده: “ضيوفَنا الأعزاء! إن مستوى الضغط الجوي في الكابينة في حدوده المقبولة، فإذا حدث هبوط في مستوى الهواء فستتدلى أقنعة الأوكسجين تلقائيًّا من فوق رؤوسكم، فالرجاء وضعها على أفواهكم وعدمُ خلعها إلى إشعار آخر”.
ومن هنا نعلم أن الضغط الجوي هناك مختلفٌ عن الضغط الجوي على الأرض، فالله تعالى جعل الضغظ الخارجي للهواء على الأرض متوازنًا مع الضغط الداخلي للجسم، ولكن الإنسان كلما صعد إلى الأعالي يقلّ ضغط الهواء، ويزداد ضغط الدم في الشرايين، فإذا اختل التوازن يشعر وكأن شيئًا يريد أن يتدفق من داخل الجسم إلى خارجه، وهذا هو السبب من وراء ما نراه من الرعاف لدى بعض الناس حينما يكونون في المرتفعات.
وبعد عامِ (1920م) وبفضل التكنولوجيا المتطوّرة سنحت الفرصة للحصول على المزيد من المعلومات الشاملة حول الستراتوسفير ، وتفيد التقريرات أن الهواء في ساحل البحر يضغط على كل سنتيمتر مربع من أي سطح بنسبة كيلوجرام، ويسمى هذا المقدار من الضغط “أتموسفير” (وحدة ضغط جوّيّ)، وإذا اعتبرنا متوسط سطح الجلد البشري بـ1.5 متر مربع، فإن هذا يعني أن ضغط الهواء على كل واحد منا هو بمعدل خمسة عشر طنًّا من القوة، ولكن ما بداخلنا من الموازي لهذا الضغط الخارجي هو الذي يَحُول دون أن نُسحق تحت هذا الضغط الكبير، فكلما زاد الارتفاع عن سطح الأرض قلَّ الضغط الجوي وضعُفت كثافة الأكسجين.. وإذا ارتفع الإنسان لمسافة 10 كم فعليه أن يتنفس الأكسجين الخالص، وإذا صعد إلى 12 كم لم يعُد الأكسجين النقي كافيًا ويبدأ في مرحلة فقدان الوعي، فإذا وصل إلى 13 كم ارتفع الضغط الداخلي لما في الرئتين من بخار الماء وغاز ثاني أوكسيد الكربون، ولا يتمكن الأكسجين من الدخول إلى الرئتين وعند مستوى 18 كم ينخفض الضغط الجوي جدًّا إلى درجةِ أن الدمَ وجميعَ الخلايا المائعة في الجسم تبدأ بالغليان.. وفي مستوى 19 كم يتعرض الجسم لقصف الإشعاع الفضائي.. وفي مستوى 23 كم تكون السيادة لطبقة الأوزون.
فالقرآن الكريم يشير هنا بكلمة “يَصَّعَّدُ” إلى حقيقية علمية، كما أن صيغتها تدل على التكلّف والصعوبة، وذلك يدلّ على حقيقة ثابتة، وهي أن هذه العملية صعبة وأن الصعود إلى السماء لن يكون من الأمور السهلة، وأنه لا بد لتحقيق ذلك مِن تخطِّي العقبات في كل مرحلة، والاستعانةِ بالأدوات التكنولوجية التي ستتطور عبر العصور المتلاحقة. أجل، إن البشرية ستتقدم في هذا المجال خطوة فخطوة، إلى أن تنفتح طُرقُ السماء أمامها
في نهاية المطاف.
ومن الواضح البين أن الآية تهُمُّ إنسانَ القرنِ الحالي أكثرَ من الذين مضوا قبله؛ لأن الآية تضع بشكل علمي أقصى حدود الطبقات العليا التي يمكن للأحياء أن يواصلوا فيها الحياة، كما تُبين حدود الطبقة التي يضيق بها صدر الإنسان ولا يُمْكنه العيشُ فيها، ومن المعلوم أن هذه الحقيقة لم تتضح إلا بعد أن انفتحت أبواب السماء أمام البشر في القرن العشرين، فبفضل هذه النكتة اللطيفة فَهِمَ الإنسان أن هناك فرقًا بين ما يشعر به من الضغط الجوي حينما يكون على وجه الأرض وبين ما يشعر به وهو صاعد إلى الأعالي.
وقد كانت هذه الظواهر قبل أن تنكشف هذه الحقائق العلمية من قبيل المجهولات، وبعده أصبحت من الأمور المعلومة البديهية لدى البشر، وإلى جانب هذه الحقيقة ترسم الآية حال الكافر وأطواره وحياته القلبية، وهذا من الأدلة الواضحة على مدى جامعية القرآن.
3- اهتزاز الكرة الأرضية
إن تعبيرات القرآن المعجزِ البيانِ متعددةُ الألوان وذاتُ أبعاد كثيرة، فحينما يوجه الأنظارَ إلى حقيقةٍ ما إذا بنا نراه يذكر في ثنايا السطور حقائقَ أخرى نسميها: “مستتبعات التراكيب”، فكلُّ مَن يَتْلوه لا بدّ وأنه يفهم ويستفيدُ من هذه الحقائق أمورًا على حسب مستواه وعلى قدر تعمّقه الفكري.
فمن أساليب القرآن أنه حينما يتحدث عن قضية ما، فإنه يتطرق في العبارات نفسها لحادثة كونية، وإن لم يتنبه الإنسان لذلك مع إدراكه لبعض الأمور فسيفوته أمر آخر، فمثلًا حينما يتناول القرآن الحديث عن القيامة يسرد الأحداث التي ستجري حينها واحدة تلو الأخرى؛ فحين يذكر تكوير الشمس أي لفَّها والاحتفاظَ بها، يشير في الوقت ذاته إلى المراحل التي مرت بها الشمس، وهذا الأسلوب يعكس جامعية القرآن وكونَه متعدد الأبعاد.
ويتمتع القرآن أيضًا بأسلوب في التعبير يكاد الناس في كل العصور يفهمون منه حقائق عديدة تتعلّق بهم، من دون أدنى تكلُّف أو تصنُّع؛ بمعنى أن الإنسان الذي عاش قبل ألف عام اكتشف منه حقائق تهمه هو ونوّر بها عصره، وكذلك إنسان هذا القرن أيضًا يستطيع أن يستنبط من العبارات ذاتها حقائق علمية تتعلق بعصره الذي يعيشه، فمِن المحتمل أن الناس في القرون الماضية حينما كانوا يسمعون قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/125)، كانوا يفهمونه على أنه مجرد مقارنة بين المؤمن والكافر، أي مقايسة بين إيمان المؤمن وكفر الكافر.. وليس من الوارد أن نقول: إنهم قد فهموا من هذا البيان الإلهي أن الإنسان كلّما صعد في الجوّ ضاق صدره، وأن الكائنات الحية ليس لهم أن يعيشوا إلا في طبقة معينة من الجو، وأنهم إذا تجاوزوا هذه الطبقة فلن يستطيعوا التنفس وبالتالي يموتون؛ لأن المستوى العلمي في تلك المرحلة لم يكن يتيح لهم فَهْمَ هذه الأمور، ولكن إنسان هذا القرن إلى جانب فهمه من الآية المقارنةَ بين الكفر والضلال وبين الإيمان والهداية، يمكنه أن يستنبط من الآية حقيقةً متعلقة بالغلاف الجوي؛ لأنه يمتلك من الأدوات الكافية ما يمكن أن يوصله إلى هذا الأفق.
ولكن لا بد للمرء أن يكون ذا أفق واسع حتى يدرك هذه الجامعية القرآنية، وكلما تقدم بنا الزمان وزادت معلوماتنا بفضل الأدوات التقنية والتكنولوجية، فستنجلي لنا الآيات القرآنية بشكل أفضل، وسنرى كيف يزداد القرآن طراوة وشبابًا في حين أن الزمان يزيد شيخوخة وشيبة.
ومن الآيات القرآنية التي تتمتع بالجامعية من حيث التعبير تلك الآية التي تتحدث عن رجفة الأرض وعن القيامة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ (سورة النَّازِعَاتِ: 79/6-7)، فكلمة “الرَّاجِفَةُ” بمعنى أنها ترتجف على الدوام وهذه هي صفتها الدائمة، فمجيء هذه الكلمة بصيغة اسم الفاعل تدل على أن الأرض تظل ترتجف من تحت أرجلنا، وأنها ليس ثابتة في حد ذاتها، فكأن الآية تعبّر من خلال كلمة “الراجفة” عن هذا الملمح اللطيف:
لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تعتمد على مكان غير مستقر ودائم، فسيأتي يوم ستزداد فيه رجفة الأرض، وترمي بما تحمله على ظهرها وتُبَعثِره، وأنتم أيضًا ستأخذكم الرجفةُ حينما ترون رجفتها، وستزيغ أبصاركم، حتى لتكاد قلوبكم تنخلع من مكانها، فعليكم أن تعتمدوا منذ الآن وتتّكلوا على الدائم القوي الذي لا ينهدم ولا يتزلزل أبدًا، بل هو الذي خلق الزلزال وسخَّره لأمره، سلطانُ الأزل والأبد، الحقُّ ، حتى يوصلكم
إلى دار الأمان.
﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ و”الرادفة” في اللغة تأتي بمعنى: ما على ظهر الدابة خلف الراكب من شخص أو حمل.
فبالقيامة ترتجف الأرض ارتجافًا شديدًا، ولكن تعقُب هذه الرجفةَ رجفةٌ أشد منها، فتبلغ بها القلوبُ الحناجر، ثم تقوم القيامة.
وهذه الآية تتحدث عن القيامة وأهوالها، وفي الوقت نفسه تَلفت النظر إلى ما سيحدث في الكرة الأرضية من الزلازل، وهناك إشارة إلى إحدى الخصائص العلمية للكرة الأرضية، وهي أنها راجفة ومتحركة على الدوام، صحيح أن من يعيش على ظهرها لا يشعر بأي حركة لها، ولكنها في الحقيقة دائمة التنقل من منزلٍ لآخر، فسيأتي يوم تزداد فيه تحرُّكًا أشد مما كانت عليه ويشتد هذا التحرك والتزلزل، فترمي الأرض كل ما على ظهرها وتُبعثِره، وستَهيج بحارها وتتدفق، وتُسيَّر جبالها وتتفرق، ويحترق كل شيء فيصبح رمادًا. أجل، إن كلمة “الراجفة” تحمل كل هذه المعاني، وتشير بالأخص إلى أن الأرض تتّصف بصفة الرجفة الدائمة.
إن المفسرين في القرون الأولى نظروا أثناء تفسيرهم لهذه الآية إلى القضية من حيث النتيجة، ففمهوا من الآية أنه “سترتجف الكرة الأرضية ارتجافًا شديدًا جراء واقعة القيامة، وفي نهاية المطاف سيختل نظامها”.. وهذا المقترب في حدّ ذاته صحيح، إلا أنه لما انكشف لرجال العلم حقيقةُ أن الأرض تتحرك وتدور، تَبيّن لهم من خلال تعبير “الراجفة” معنى آخر وهو أن الأرض في حركة مستمرة، ولما انكشف من خلال البحوث الجيوفيزيائية في القرن العشرين أن الأرض تهتز بالفعل زادت الإشارة القرآنية وضوحًا؛ حيث كَشفت هذه البحوثُ أن الكرة الأرضية تهتز باستمرار، فتتسبّب بتغيُّراتٍ مرتبطةٍ بالشمس والقمر، منها ما يُسمّى بعمليات المدّ والجزر، فكأن هذه الأحداث تقوم بدور التعديل لما يعتري الأرض من الاهتزازات، وكما أن الله تعالى يدوِّر الأرض بقانون الجاذبية حول الشمس وكأنها حجر مقلاع، فكذلك يَجذب بحار الأرض بتأثير الشمس والقمر، وفي النهاية تقع أحداثُ المد والجزر التي يرتفع بها منسوب المياه وينخفض، وهذه الحادثة من تأثيرات الشمس والقمر على الكرة الأرضية.
ولم يزل الباحثون في العلوم والتكنولوجيا يَلفتون الأنظار إلى حركات الأرض، ويحاولون أن يُثبتوا مدى تأثير هذه الحركات والاهتزازات على عامل الزمان، ويشيرون في كتبهم المتعلقة بذلك إلى أنهم قد لاحظوا تباطؤًا مطّردًا في حركات الكرة الأرضية وهزاتها، فعلى سبيل المثال: من المعلوم أنه في ديسمبر (1989م) تم إعادة عقارب الساعات على مستوى العالم بمقدار ثانية واحدة إلى الوراء، وعلى حسب هذا فإن سنةَ (1989م) أصبحت أطول من سنةِ (1988م) بثانية واحدة.. وهذا ما وقع فعلًا، حيث عدَّل الناس ساعاتهم وفقًا لذلك.. وأيضًا في 30 يونيو/حزيران عام (1992م) تم الإعلان في الصحف العالمية عن تمديد ذلك العام بمقدار ثانية واحدة.. وتَذكر المصادر أنه منذ عام (1972م) تم إضافة ست عشرة ثانية لكل سنة.
وبناء على هذه المعلومات قيل: إن اليوم الواحد على الكرة الأرضية كان قبل آلاف أو ملايين السنين ثماني عشرة ساعةً، وهو الآن أربعٌ وعشرون ساعة، وربما يصل في المستقبل إلى ثلاثين ساعة.. ومن المحتمل أنه إذا وصلت القطعة الزمنية إلى خمسين ساعة فستطول الأيام بحيث يحترق الناس تحت أشعة الشمس الحارقة.
فالله تعالى يهدِّئ سرعة دوران الأرض ويحدّ من سرعتها بشكل تدريجي، وسيدوم هذا التباطؤ إلى أن يُحال الناس إلى المحكمة الكبرى، ويطبقَ الله حكمه الذي أصدره في حق الكرة الأرضية، ثم إن الله سيقيم محكمة جديدة وعالَمًا جديدًا فيَجمع الناس وسائر المخلوقات هناك، فحادثة الحشر التي نسميها: الانبعاث الثاني إنما تقع بعد أن تتعرض الكرة الأرضية والسماء لمثل هذه الهزات والزلازل.
4- تلقيح الرياح
من الوظائف المهمة للرياح في الغلاف الجوي هي تلقيحها للسحب، ومن المعلوم أن السحب منها ما هو ذو قطب سالب (-) ومنها ما هو ذو قطب موجب (+)، وتكوُّن المطر منوط بتلاقي هذين القطبين، ولكن هذا لا يتحقق دائمًا، فالسحب المتعاكسة الأقطاب لا تلتقي، لأن شدة الهواء وكهرباءه تَحُولان دون ذلك، حيث إن كون الهواء مشحونًا بالكهرباء يَمنع مِن تخطِّي الغيوم لهذه الكهرباء ويعرقل تلاقيها، وحبات المطر في الهواء تَحمل الشحنة الكهربائية نفسَها، وحسبَ القانون الإلهي فإن الأقطاب المحملة بنفس الشحنة تتنافر فيما بينها.
وقبل كل شيء لا بدّ لتجمّع الغيوم من تبديد هذه الشحنات الكهربائية المتضادة، وهذا الأمر يتطلّب وسيلة خارجية، فهذه الوسيلة هي الرياح، وهذا نوع من عملية التلقيح، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ (سورة الْحِجْرِ: 15/22) بمعنى أن الرياح تلقح السحب.
وقضية التلقيح بين الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان أيضًا من الأمور المعروفة منذ القِدَم، ونتيجةً لهذا التلقيح يُخلق كائن حي جديد، والأمر نفسه كان واردًا بالنسبة للنباتات أيضًا، فقد كان من المعروف لدى الناس منذ العصور القديمة أنه لا بد في تكاثر النباتات من التلاقح بين إناث البذور وذكورها، وأن ذلك يتحقق عن طريق الرياح، فالقرآن الكريم في الآية الآنفة الذكر، بالإضافة إلى التذكير بهذه الحادثة العامة المعروفة لدى الناس، يَلفت الأنظار على وجه الخصوص إلى تلقيح السحب، وهذا أمر جديد بالنسبة للناس، فسياق هذه الآية يدل على أن المراد باللقاح هنا هو -بالأخص- لقاح السحاب، ليس إلا.
أجل، إن الرياح تلقِّح السحب، وهو “شرطٌ عاديٌّ” لنزول المطر، بمعنى أن مِن عادة الله أن يُنزل المطرَ نتيجة لذلك، فبفضل هذه العملية أمكن تَخَطِّي الخطِّ الكهربائي وتداخَلت السحبُ المشحونة بالتيارات السالبة والموجبة، وحصل التزاوج المطلوب، وأثناء هذا التزاوج تأتي الرسائل المبشِّرة بهطول الأمطار عبر أصوات الرعد ولمعان البرق، فهذا التزاوج بين الغيوم ذواتِ الأقطاب السالبة والموجبة لهو مصدرُ أملٍ
في نفوس كل الكائنات الحية، وهذا كله يتحقق حسب التعبير القرآني نتيجة اللقاح.
ومسألة التلقيح ليست من الأمور التي انكشفت في العهود الأخيرة، بل هناك من المفسرين القدامى من فسروا الآية في نفس الاتجاه؛ لأن التعبير القرآني في هذا الباب يجلِّي الموضوع بكل بساطة، لقد أدرك هؤلاء المفسرون مسألة التلقيح منذ وقت مبكِّرٍ، بل إن أكثرهم فهموا الموضوع وتطرقوا له، وإن لم تكن تعبيراتهم في المستوى والأسلوبِ العلميَّين لعصرنا.
أجل، إن قضية تلقيح البذور أمر واقع لا نقاش فيه، ولكن الواضح هنا هو
أن المقصود باللقاح في هذه الآية هو لقاح السحب.
وكما سبق أن أشرنا فهناك من المفسرين القدامى من فسر الآية بهذا المعنى، فابن جرير الطبري -مثلًا- الذي ألف تفسيره قبل أحد عشر قرنًا من الزمن قد فسر “اللواقح” الواردة في الآية النازلة قبل أربعة عشر قرنًا، بمعنى أن الرياح تلقح النبات في الأرض والسحبَ في جوّ السماء، فهو بذلك قد فسر القرآن بشكل يقارب ما يفهمه إنسانُ عصرنا، متخطيًا بذلك المستوى الثقافيَّ والإدراكيَّ لعصره، وهذا يعكس مدى فهمه الصافي النقيّ للقرآن.
أجل، إن بيان القرآن الصافيَ والواضحَ لهو من الثراء والغنى بحيث يفوق -بكثير- مستوى كل علم وتقنية وكلِّ حضارة ومدنية لكل عصر، ولكن الأمر يتطلّب من يستشعر تلك الإشارات اللطيفة، ومن المحتمل أنه كلما اقترب رجال العلم من الحقيقة، واستطاعوا أن ينظروا إلى القضايا بنظرة محايدة وموضوعية، فإنهم سيدركون الحقائق القرآنية الصائبة، وسيواصلون تنوير عصورهم بما استلهموه من القرآن، وكما تَحقق لهم هذا في الماضي فهذا الأمر وارد بالنسبة لعصرنا الحالي، بل بالنسبة للمستقبل أيضًا.
5- سَوق السحاب والتأليف بينه
يتحدّث القرآن عن خاصية أخرى من خاصيات السحب والرياح، فالمطر لا يحصل فور سَوق الرياح للسحاب، بل إن هناك أحداثًا تتعاقب بفعل الرياح، ثم يتشكل المطر، وهناك عملية أخرى هي تكاثُف السحب وتراكمها، فلا مطرَ من دون هذا التكاثف والتراكم.
فالقرآن الكريم في معرض الإشارة إلى كل ذلك يقول: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ [أي يجعله يتداخل فيما بينه بحيث لا يبقى هناك فراغ] ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا [أي بعضه فوق بعضٍ متراكمًا إلى الأعلى] فَتَرَى الْوَدْقَ [أي المطر] يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ [قِطَع ضخمة متراكمة متكاثفة كقِطَع الجبال] فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ [فيضره] وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ﴾ (سورة النُّورِ: 24/43).
فتعبير “التأليف” يُستخدم عادةً في الجمع بين الأشخاص الذين تختلف أمزجتهم وطبائعهم، ورفعِ الخصومة عن الذين وقعت بينهم مشاحنة وهجران وخصام، ومنه: “المؤلَّفة قلوبهم” ويراد بها مَن تطفح قلوبهم بالكراهية والحقد تجاه الإسلام، فيتمُّ الإحسان إليهم حتى تَطيب قلوبهم وتلينَ تجاه الإسلام، فكلمة “يُؤَلِّفُ” توحي بأن هناك تنافرًا دائمًا بين السحب، إلا أن الله تعالى يزيل هذا التنافر بواسطة الريح، فيؤلف بينها، ثم يجعلها أجسامًا متراكمة.
و”الركام” هو ما تراكَبَ واجتمع بعضه فوق بعض حتى تضخَّم مثل الجبال، فالرياح تؤلِّف بين السحب إلى أن تبدأ بالتراكم فتتكاثف وتكبُر وتصبح على هيئة كائنات ضخمة تحاكي الجبال.
ويُفهم من قوله تعالى: ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أن العملية لا تتم بمجرد فعل الرياح، بل لا بد بعد ذلك لتشكُّل المطر مِن تداخُلِ أجزاء السحب وتكاتفِها جراء هذا الإزجاء المنتجِ لتراكم السحب على هيئة الجبال.
وقد لخص القرآن كل هذه الأحداث على حسب وقوعها مستخدِمًا الفاء الدالة على التعقيب، ورتَّبها بطريقة لا تتعارض مع الكشوفات العلمية الحديثة، فلو تصدى أحدنا لشرح هذه الأمور التي ذكرها القرآن بأسلوب علمي لتبين له أن هذا البيان لا يختلف كثيرًا عما تقرّر في علوم الأرصاد الجوية، كما علينا أن لا ننسى أن القرآن يراعي فيما يتناوله من القضايا أسلوبًا يستطيع الجميع أن ينهل منه، بينما يخاطِب الأسلوبُ العلميُّ الشريحةَ المتعلمةَ من الناس فقط.
وتُواصِل الآيةُ الكريمة: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ (سورة النُّورِ: 24/43)، أي يُنزّل مِن قِطع السحب الضخمة مثل الجبال، وهذه تُعتبَر معلومات مقنعة حول تشكُّل البرَد؛ حيث يفهم من هذا أنه لا بد لتشكُّل البرَد أوّلًا من تراكم السحب التي تماثل الجبال في وطأتها وشدتها ثم لا بد بعد ذلك من كهربة قوية في قطرات المطر بدرجة تؤدّي
إلى صدمة.
وكإشارة إلى هذا تُواصِل الآيةُ الكريمةُ قائلةً: ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ﴾ حيث تومئ إلى أنه تَحدُث هناك كهربة شديدة من شأنها أن تُعمي الأبصار، ويشير القرآن الكريم بهذه العبارات في الوقت ذاته إلى المجال الذي تَحدُث فيه الكهربة في السحب؛ حيث يفيد أن الضغظ الشديد والتضييق من جانب، والكهربةَ والتراكمَ من جانب آخر يؤدي إلى تجمد حبات الماء.
وإذا اعتبرنا أن “مِنْ” في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَرَدٍ﴾ للتبعيض، فتكون دالة على أن بعض السحب تتجمد فتصبح بَرَدًا، فإن الطيارين يتجنبون اختراق السحب الرعدية والسبب في ذلك أن هذه السحب تكون فيها حبات كبيرة من البرد، فيخشون من حدوث شروخ
في جدار الطائرة مما يؤدي إلى سقوطها، لا سمح الله.
فإذا تنبه الباحثون ورجال العلم للكلمات التي يستخدمها القرآن المعجز البيان أثناء حديثه عن القضايا العلمية، فإنهم سيعترفون من دون تردد أن هذه تعبيراتٌ حكيمةٌ صادرةٌ من عِلمٍ محيط.
6- الرياح
إن الرياح تقوم بالعديد من الوظائف في مساحة واسعة بأمر إلهي وإرادة إلهية تحت إشراف الملائكة، ومن تلك الوظائف: التربيت على وجه الأرض وتلقيح النباتات، وإحداث العواصف الشديدة في الجو، ولقاح الزهور والسحبِ.
إن الرياح لتعبّر دائمًا عن تجل من تجليات الرحمة الإلهية، ولكن على الرغم من ذلك فإنها تُؤدي أحيانًا إلى تغير التيارات الهوائية، وقد تتسبب في حدوث عواصف وأعاصير وزوابع شديدة، وفي الآيات الأولى من سورة المرسلات يشير الله تعالى بطرائق مختلفة إلى الرياح المرسلة من قِبل الله تعالى، أو الملائكة الذين يُشْرفون عليها، ولم يزل متقدمو المفسرين والمعاصرون منهم يفسرون هذه الآيات على أن المراد بها الملائكة أو الرياح أو أنواع الوحي أو الإلهامات أو عِباد الله الموظفون المتشبعون بالحقيقة.
وسواء فسرناها بالوحي النازل على الأنبياء أو بالإلهام أو الرياح التي تَهُبُّ على وجه الأرض أو العواصف، فإننا نستطيع القول بأن كل هذه المعاني لها نوعُ مناسبةٍ مع ما يهبُّ من النسمات الإلهية بالمعنى الشامل.
إن الريح كتلة هوائية متحركة، وهذا التحرك يكون نحو جهة معينة، وفي معظمه قريب من الاتجاه الأفقي، وإذا كانت هناك منطقتان متجاورتان وكان الضغط الجوي في إحداهما مرتفعًا وفي الأخرى منخفضًا، فإن الهواء سيتدفق من منطقة الضغط الجوي المرتفعِ صوبَ منطقة الضغط الجوي المنخفض، ويسمى جريان الهواء بهذا الشكل “ريحًا”.. وتختلف شدة الهبوب على حسب ارتفاع الضغط وانخفاضه، فإذا اشتد الهبوب سمي “عاصفة”.
إن الناس قد أَلِفوا هبوب الريح واعتادوا عليها حتى أصبحت هذه الظاهرة وكأنها من الأمور المعروفة المعلومة، بل إن موقفهم منها يكاد يوحي بأنهم نسوا أنها من عند الله، وكأن الله تعالى يلمح إلى هذا في قوله : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ (سورة المرسلات: 77/1)، بمعنى أن الرياح تهُبّ بشكل معروف ومعهود لدى الناس.
إن معظم المصادر الجغرافية تقسِّم هذه الرياح إلى ثلاث مجموعات:
1- الرياح الدائمة
2- والرياح الموسمية
3- والرياح المحلية
أولًا: الرياح الدائمة:
وهي أنواع:
أ. الرياح التجارية: وتهب هذه الرياح التجارية نحو خط الاستواء قادمة من خطوط العرض الموازية لخط الاستواء وتحديدًا من خط عرض 30° شمالًا أو جنوبًا.
ب. الرياح الغربية: وتهبُّ هذه الرياح فوق نصفَي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي بالقرب من خط عرض 30° من نطاق الضغط العالي فوق المداري باتجاه الدائرتين القطبيتين 60° خط عرض، وهي رياح غربية تأتي من العُروض الوسطى والتي تهبّ من منطقة الضغط شبه المداري المرتفع باتجاه منطقتي الضغط المنخفضتين.
ج. الرياح القطبية: وهي الرياح الباردة التي تهب من منطقة الضغط العالي في القطبين باتجاه منطقة الضغط المنخفض عند 60° خط العرض.
ثانيًا: الرياح الموسمية:
وهي منظومة رياح واسعة النطاق، يختلف هبوبها حسب موسم الصيف والشتاء، وينقسم إلى قسمين حسب الصيف والشتاء.
ثالثًا: الرياح المحلية:
وبعض هذه الرياح عبارة عن الرياح المرتبطة بالدوران العام للرياح ولكنها خضعت لبعض التغييرات المحلية، في حين أن بعضها الآخر لا يتكون إلا من فروق الضغط المحلية.. وهي أنواعٌ ثلاثة؛ النسائم، والرياح المحلّية الباردة، والرياح المحلّية الحارّة.. وهي على النحو التالي:
أ. النسائم: وهي نوعان:
النوع الأول: نسائم البحر الأسود: وهذه الرياح شأنها شأن الرياح الموسمية تنشأ بفعل الاختلاف في الحرارة والضغط، وفي المناطق الساحلية كهذه تكون اليابسة بالليل أكثر برودة من البحر، في حين أن البحر يكون دافئًا، ونتيجةً لذلك تهُب الريح ليلًا من اليابسة باتجاه البحر، وهذا يسمى “نسيم البر”، وأما بالنهار فينعكس الأمر؛ حيث ترتفع الحرارة في اليابسة أسرع من البحر، ويؤدي ذلك إلى هبوب ريح من جهة البحر (نسيم البحر) صوبَ اليابسة.
والنوع الثاني: نسيم الجبل ونسيم الوادي: ففي أثناء النهار يَسخن الهواء في الأودية فيتمدد ويصعد إلى أعلى، وهذا الهواء الدافئ المتصاعد يسمّى نسيم الوادي، وبعد غروب الشمس يبدأ الهواء على المرتفعات في البرودة فيزداد وزنه وينزلق إلى أسفل ليجتمع في بطون الأودية ويسمى هذا الهواء البارد “نسيم الجبل”.
ب. الرياح المحلية الباردة: وهذه الرياح تنشأ من مختلف أشكال الضغط، وتهب من جهة الهِضاب الباردة والمناطق الجبلية إلى الشواطئ الدافئة. وأهم أنواعها:
1- “البُورا (Bora)”: وهي رياح باردة تهب من الجبال الخلفية وتمر عبر الساحل الدلماسي باتجاه البحر الأبيض المتوسط.
2- “المِسترال (Mistral)”: وهي رياح باردة تهب من ساحل فرنسا على البحر الأبيض المتوسط على طول وادي الرون.
3- “النكيباء أو الأَيِّر (Poyraz)”: وهي الرياح الباردة التي تهب في تركيا من الجهة الشرقية الشمالية.
ج. الرياح المحلية الحارة: وهذه رياح حارة تختلف حسب مصادرها، ومن أهمها:
1- “الفُهن (Fohn)”: وتتكون هذه الرياح حينما ترتفع الكتلة الهوائية فتتخطى جبلًا وتبدأ بالانحدار في السفح المقابل.
2- السيروكو: وهي رياح صحراوية تهب في الجزائر وتونس من الصحراء الكبرى باتجاه البحر الأبيض المتوسط.
3- الخَماسين: وهي رياح صحراوية حارة تهب في المناطق الصحراوية بمصر.
4- “الدَّبُور (Lodos)”: الرياح الساخنة تهبّ من الجنوب الغربي بتركيا.
نعود فنتابع العرض الإلهي عن الرياح في سورة المرسلات:
﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾ (سورة الْمُرْسَلَاتِ: 77/2)، بمعنى أن هذه الرياح التي تهب بأشكال معينة، تتعرض أحيانًا للتبدلات فتعصف بكل ما تمر به وتثير الدهشة في الأطراف فتأخذ شكل الأعاصير وغيرها.
﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا﴾ (سورة الْمُرْسَلَاتِ: 77/3)، أي الرياح الموسمية التي تنشر السحاب في السماء والبذور على وجه الأرض.
﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا﴾ (سورة الْمُرْسَلَاتِ: 77/4)، ووراء كل ما ذكرنا من أنواع الرياح هناك ملائكة كرام يُشْرفون عليها ويطبقون الأوامر الإلهية، كما أن فوق الملائكة ربًّا يدبر كل ذلك بأمره تعالى.
إن الأسباب ما هي إلا ستارات أمام الأعين، وإنما الذي يتصرف في الأمور هي يد القدرة الإلهية، ومن هذا المنطلق نقول:
إن سورة المرسلات تتحدّث عن تصرّفات القدرة الإلهية التي تجري أمام أنظار الملائكة، وإذ تقوم بذلك تشير -والله أعلم- بشكل وجيزٍ إلى سبعة طرائق للرياح،
التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ (سورة الْمُؤْمِنُونَ: 23/17) بمعنى أننا خلقنا في الغلاف الجوي المحيط بكم سبعة طرق فيها مسارب للذهاب والإياب والجريان.
والذي يحافظ على توازن تركيبة الجو وطبيعتها المتجانسة هي الرياح التي تجري من هذه الطرق؛ فلو لم يُجرِ الله الرياحَ لتكثفت الغازات التي في الجو في منطقة معينة ولفسدت الحالة المتجانسة للهواء، مع العلم بأنه إذا لم يحافَظ على تركيبة هذه الغازات لن يبقى الهواء صالحًا للتنفُّس.
﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾، أي إن الله يعلم حاجات مَن خَلَقهم، فيرسل الرياح مِن سبع طرائق وفقًا لحاجتهم، فالله تعالى ببعض هذه الرياح ينبههم وينذرهم، وببعضها يبثّ الانشراح في صدورهم، وببعضها يربت على رؤوسهم ويلاطفهم، وببعضها يرسل إليهم الوحي والإلهام، وببعضها يجازيهم ويدمرهم تدميرًا.
ن. حركةُ الجبال
لقد فسر العلماء مرور الجبال كَمَرِّ السحاب بتفسيرات مختلفة، يقول تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ (سورة النَّمْلِ: 27/88).
فههنا نكتة مهمّة، إن لم نأخذها بعين الاعتبار فقد نخطئ في فهم الآية، فأوّلًا: يمكن أن تكون في الآية إشارة إلى حقيقة مهمة لم تدرَك إلا في القرن الحالي، هي أن القارات كانت من قبلُ متصلة ببعضها البعض، ولكنها على مدى ملايين السنين أخذت تبتعد تدريجيًّا إلى أن وصلت إلى وضعها الحالي، حيث إنه من المعلوم أن الصفائح القارِّيّة تَسبح على طبقة الماغما (الصهارة)، فبينما تذوب هذه الصفائح في الماغما، تتصاعد مادةٌ جديدة من باطن الأرض المنصهر إلى السطح فتبردُ وتتصلب وتضافُ إلى القارات، وبذلك تكون قد تحركت كل سنة وزادت في كل مرة بمقدار سنتيمتر.
وهناك تفسير آخر، وهو “أن الجبال التي هي بمنزلة أمهات التراب تذوب بمرور الأيام وتصبح ترابًا، ويمكن التعبير عن حالتها هذه بأنها “تمرّ”، وبناء على هذا التوجيه فإن الجبال بمرور الأيام ستضمحل بالكلية، وبذلك سيظهر أنها غير جامدة”.. فهذا توجيه آخر قابل للنقاش.
وهناك توجيه آخرُ ظلَّ إلى يومنا هذا، وهو أنه من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، أو أنه قد ذكر حال المتبوع وأريد التأكيد على التابع، [أي إن المقصود به الكرة الأرضية]، إلا أنه لا يمكن هذا الوضع بالنسبة للكرة الأرضية إلا إذا كان الناظر من خارج الأرض، فالذي ينظر إلى الأرض وهو على وجهها يبدو له الأمر وكأنها لا تتحرك، ومع أن الجبال حالها مثل حال الأرض؛ تبدو وكأنها لا تتحرك، ولكنها حسب التعبير القرآني “تمرُّ مرَّ السحاب”.
فقد تَحدَّثت الآية هنا عن وضع الجبال، فذَكرت الجزءَ وأرادت الكلَّ، بمعنى أنها ذَكرت الجبالَ وقَصدت الكرةَ الأرضية التي تَحمل على ظهرها تلك الجبالَ، لأن الكرة الأرضية ليست في حقيقتها شيئًا غير الجبال، لأن الجبال من الداخل تضرب بجذورها إلى أعماق الأرض، ومن الخارج تشكّل الذرى وتمثل أساس الكرة الأرضية؛ فلذا
من الممكن أن نفهم مِن تحرُّكِ الجبال في التعبير القرآني تحرُّكَ الأرض.
وهناك توجيه آخر، وهو أنك حينما تنظر إلى السفينة القادمة فإن أول ما تقع عيناك عليه هو شراعها، فكذلك الكرة الأرضية إذا نظر إليها الناظر من بعيد فإن أول ما ستقع عليه عينه هو الجبال التي هي بمثابة أشرعة للأرض، فلو ركب الإنسان صاروخًا وجال معه في نفس الخط الذي تدور عليه الأرض، فسيشاهد أنها تدور مثل المولويّ حول نفسها وحول الشمس، ولكن في هذه الحالة أيضًا سيكون أكثر ما يلفت نظره هو الجبال، وأظن أن هذا توجيه آخر لا يتصادم مع الواقع بل يتطابق معه بالكامل.. وتناوُل القرآن لهذه الظاهرة بالحديث يجعلها خليقة بالوقوف عندها بكامل الحساسية والدقة.
وفوق ذلك كله، كما أن السفينة تَثبت وترسو بالمرساة ، فكذلك الجبال، بالإضافة إلى غير ذلك من الفوائد الداخلية والخارجية، تؤدي هذه المهمة من دون قصور.. فالجبال تتعمق إلى باطن الأرض، وأحيانًا تعلو من البحار، فتحتضن الأرضَ وكلَّ ما على وجه الأرض وكأنها سارية راسخة، فتتخلّص الأرض من الهزات، وتَثبُت.. وبذلك يجد كلُّ شيء من الحيوانات والجمادات الراحةَ والسلامة وكأنها تقوم بالسياحة على متن سفينة آمنة.
فحينما تضرب الجبال بثقلها في باطن الأرض وتضغط عليها، فإنها تُوازِن الطبقةَ الخارجية إلى حد كبير، وبذلك تُحقق التوازن للكرة الأرضية، ولكنه بمرور الأيام وبالتوازي مع عمر الكرة الأرضية يدخل هذا التوازن مرحلةَ الاختلال ليبدأ نشوءُ توازن جديد، فتبدأُ القشرة الأرضية باتخاذ شكل جديد، فتتعاقب الأدوار، وتتآكل القمم وتترك مكانَها للبحار، وأما قيعان البحار فإنها تفسح الطريق للمواد التي تأتي للجبال وتغذيها وكأنها رحمٌ تحتضن بداية مرحلة تكوينية جديدة.
وكما أن المجتمعات تتعاقب عليها مراحل الولادة والنمو والوفاة، فكذلك حال الكرة الأرضية تعاقبت عليه على مر الزمان حالاتٌ من المد والجزر، ومن المحتمل أن هذه التحولات تتحقق في السير نحو الكمال، إلى أن تأتي مرحلةٌ تتطلب القفز نحو كمال فوق الكمال، وعندها تتوقف هذه القفزات الصغيرة من المد والجزر والترميمات والتعديلات، ويرتجف هذا النظام الفاني بكل مقوماته وعناصره فتتعاقب الهزات والرجفات، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً﴾ (سورة الْمُزَّمِّلِ: 73/14)، ﴿وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ (سورة الانْشِقَاقِ: 84/3-4).. وحينذاك يتأسّس عالم جديد، وتتوقف حالات المد والجزر، ويأخذ كل شيء شكله على أكمل وجه وأروعِه وأنسبِه.
فإذا اعتبرنا تبادُل الجبال مكانَها مع البحار على مرّ الزمان سيرًا نحو نقطة، فإن هذا سيكون دائمًا سيرًا للوصول إلى الأفضل والأكمل، بمعنى أن كل هذه التقلبات إن كانت حركاتٍ منتظمة للمسير نحو الآخرة التي هي الحياة الحقيقية وهي كذلك بلا ريب
فإن تحركات الجبال تكون جارية نحو الأفضل والأكمل، وذلك من الصنع الإلهي الذي يستحق كل تقدير.. فقوله تعالى: ﴿صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (سورة النَّمْلِ: 27/88)، يُستفاد منه أن الله تعالى بما خلقه من هذه الأمور يُحضِّر العقول ويهـيِّـئُها لإدراك إعادة الخلق
من جديد على أكمل وجه وأحسنِه بحيث يذهل العقولَ ويأخذ بالألباب.
ومن المفيد لفتُ النظر إلى أمر آخر وهو أن قضية الخروج من حدود الكرة الأرضية والتعرف على تحركاتها لم تكن في العهد النبوي من الأمور المعروفة لدى الناس، ولست أدري كيف فَهِم الناس هذا الأمر بمستوى فهم ذلك العصر، ولكننا نحن أبناءَ هذا العصر بإمكاننا أن نستعين بالعلوم حتى نفهم أمورًا مختلفة، بل إن فهم الآية ليس محدّدًا بمستوى فهم إنسان هذا العصر أيضًا؛ فمن الواضح أنه بمرور الأيام ستكون هناك تطورات في العلوم والتكنولوجيا، وحينذاك ستضاف إلى هذه التفسيرات تفسيرات جديدة، والمهمّ في ذلك أن يتوجه الناس إلى القرآن، ويَصرفوا كل طاقاتهم في سبيل فهمه، فإذا جعل الناس فهم القرآن غاية المنى في حياتهم فلا شك أنهم سيخوضون
في أعماقه التي لم يتم اكتشافها بعدُ.
س. التحولات الأرضية
وهناك أمر آخر يتعلق بالكرة الأرضية، وهو التحولات التي تعتريها، فقوله تعالى:
﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (سورة الرَّعْدِ: 13/41) يفاجئنا مرة أخرى بالإشارة إلى هذه الظاهرة بأسلوب علمي، وبشكل مجمل، وعلى صورة الإخبار، وبأسلوب هادف إلى ترسيخ عقيدة التوحيد.
فالآية تؤكِّد على وجه صريح أن حالة الكرة الأرضية الآن تختلف عما كانت عليه
في بدايتها، وإذ تذكر ذلك تستخدم أسلوبًا يجلب الانتباه قائلة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾.
أجل، إن بني الإنسان إذا استخدموا الأدوات التكنولوجية في بحوث الأرض فإنهم سيرون بأعينهم ما اعتراها من التبدلات.. و”مِن” في قوله تعالى: ﴿مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ للتبعيض، وفي ذلك إشارة إلى أن هذا النقص لا يحصل من كل أطرافها بل من بعضها.
وقد لاحظ مختلف الباحثين منذ القرن الثامن عشر في معظم القياسات التي أَجْروها على الكرة الأرضية، أن الأرض قد تعرضت لتغيرات دائمة، حيث إنها مُفَلْطَحَة عند القطبين بينما هي مُنْبَعِجَة عند خط الاستواء فصارت بيضاوية، فالذي فعل هذا هو الله الحكيم وصاحبُ الحُكم، وأما ما نقوم به نحن وسائرُ علماءِ هذا الشأن فليس إلا من باب الحديث عن الأمر الواقع، صحيحٌ أن علماء التفسير قد جاؤوا بتفسيرات توصلوا إليها في ضوء المعلومات التي خوَّلها لهم المستوى العلمي في عصورهم، فمثلًا هناك رواية تُسنَد إلى ابن عباس تدل على أنه فَهِمَ من الآية أن الأرض تتآكل وتتعرى من الأطراف، وعلى هذا الفهم والتأويل يكون المعنى: “أن بعض أطراف الأرض تتآكل، ويتغير شكلها”، وهذا يدل على أن ترجمان القرآن قد فهم من الآية معنى قريبًا جدًّا مما نفهمه في عصرنا من أن الأرض تتآكل من بعض الجوانب.
وقد فهم بعضُ المفسّرين نقص الأرض من الأطراف على أنه نقص الأفراد وقَطْعُ بركة الأرزاق، فيمكن أن يكون في هذا التوجيه أيضًا إشارة إلى انكماش قطر الأرض وتقلُّصه، وهذا يعني أن الأرض تنكمش الآن، وحسبَ تاريخ الكرة الأرضية، قد حصل في آخر 250 مليون سنة في كل 26-30 مليون سنة منها فتراتٌ شبيهة بالقيامة، فانقرضَ نسلُ بعض الحيوانات التي كانت تعيش في تلك الفترات بنسبة تصل أحيانًا إلى 90%.. فإذا أخذنا هذا الطرح بعين الاعتبار، فيمكن أن نستنبط من نقص الأرض من الأطراف
ما يحصل في هذه المراحل من النقص في أعداد أجناس الحيوانات والنباتات.
ومع أن الآية تشمل في عمومها كلَّ هذه التوجيهات، إلا أننا إذا تنبهنا إلى ما فيها من التعبيرات وأخذناها على وجهها المتبادر فسنلاحظ أن أنسب التفسيرات هو ما يوافق تفسيرات عصرنا الحالي، صحيحٌ أنه قد وردت تصويرات صائبة في حق شكل الكرة الأرضية، إلا أن إدراك هذا الأمر في ضوء التطوّرات العلمية والتقنيّة يكون أسهل وأوضح، ويبدو أنه في المستقبل سيكون أسهل وبشكل أفضل.
وقوله تعالى: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ (سورة الزُّمَرِ: 39/5) وقوله: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ (سورة يس: 36/37) ثم قوله تعالى: ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (سورة النَّازِعَاتِ: 79/30) يعطينا أطراف بعض الخيوط، ومن المفسرين من ركَّز في قضية كروية الأرض على هذه الآية، كما أن هناك عددًا غير قليل منهم فَهِم منها أن الأرض مع كرويتها قابلة للعيش عليها وكأنها مسطحة، كما أن منهم من استخرج مِن “دَحَاهَا” أن الآية تشير إلى أن شكل الأرض على هيئة بيض النعامة، حيث إن المكان الذي تَضع فيه بيضَها يسمى “المدحى” لأنه يدحوه برجله ويبسطه ويوسعه ثم يبيض فيه ، مما يعني أن فيها إشارة إلى ما اعترى الكرة الأرضية من التفلطح في المناطق القطبية فأصبحت بيضاوية الشكل.
ومع أن في هذه التوجيهات كلها جانبًا من الحقيقة، غير أننا نقول في ذلك كله: الله وحده هو من يعلم حقيقة الأمر، إلا أن اللازم هنا هو أن لا يكون ما يقال في هذا الباب من الشروح والتفسيرات يُناقض القرآنَ ويعارضه، بل يكون هذا الاكتشاف الجديد من الأمور التي تقرِّب إلى الأوامر التكوينية وإلى ما أتت به من الأحكام على وجه الإجمال.
ع. نظرة القرآن الكريم إلى العوالم الصغرى
1- حقيقة كتاب الكون
إن القرآن المعجز البيانِ يلفت أنظارنا بين الحين والآخر إلى كتاب الكون، ويجلب انتباهنا إلى ما حقّقه قلم القَدر والقُدرة والعلمِ والإرادة، فيسوق المؤمنين إلى التفكّر والبحث والتأمّل، وسنحاول في هذا القسم أن نرى بنظرة عامة حركاتِ الذرات والجزيئات التي تُعتبر الرؤوس الدقيقة لقلم القدر، والإشاراتِ القرآنية حول هذه الأمور، وأن نرى -على الأقل- مدى تطابق هذه الإشارات مع ما وصلت إليه العلوم في عصرنا.
إن الذرّات وكل ما هو أصغر أو أكبر منها من الجزيئات والذرات والإلكترونات والبروتونات والجسيمات وما ضاهاها من الأجسام الصغيرة هي بمثابة الحجر الأساس للكون، وإنما شاهدنا أُولَى التعيُّنات في عالم الشهادة بعالم الإلكترونات والإشعاعات الكيماوية، كما أننا بفضل الجزَيْئات الأصغر من الذَّرية التي تُعتبر أصغر أجزاء المادة استطعنا أن ندرك ونكتشف قوانين الضوء والحركة، والقوانينَ الجاذبة والدافعة.
إن كل الأجسام والحركات لها أطوالُ موجاتٍ تخصّها، وهي تُسجَّل بكل خصوصياتها في المكان بقلم القدر، فلا تُبطِل كتابةُ أيِّ واحد منها الآخرَ، وتُواصِل الموجوداتُ وجودها في طاعة ولطف جبري، فهناك يدٌ واحدة للقدر تتصرف في آلافٍ بل ملايين من الأحداث وتعالجُها بدقة فائقة من خلال فرجار القدر، بحيث لا تختلط أيَّةُ حادثة بالأخرى، ولا تُخِلُّ أصلًا بالنظام العام والخاص.
وإذا نظرنا من هذا المنظور فإننا سنرى مِن وراء كل هذا النظام المذهل يدَ القدرة التي تعطي كل الأشياء شكلَها، وسنلاحظ البرنامج القدري الذي هو لُحمة كل شيء وسَداه، ونعرف خالقَ هذا البرنامج ونُرجع الأمر كله إليه، وسندرك أن الله تعالى قبل أن يَعرض المخلوقات لمشاهدة الأنظار أعدّها ووضعها حسبَ علمه؛ لأننا نشاهد دائمًا ما في الكون من مَظاهر القدرة والعلم والإرادة والتدبير والتدوير والتصوير، فهذه القدرة قد عَينت الأشياءَ أوَّلًا في ضوء القَدر والبرامجِ النابعة من العلم الإلهي، ثم لما حان أوان ظهورها لأداء دورها وُجهت إليها الدعوةُ فأَخذتْ مكانَها في موقعها من الكون والوجود.
وقد يبدو للناظر في أول وهلة وكأن هناك في الكون نوعًا من الفوضى والاضطراب، لكن الحقيقة أن الكون يسُوده نظام وتناغم مذهل، ولْنفكرْ هنيهة فيما نشاهده كل يوم من شمعة أو مدفأة أو مصباح، ولننظرْ في المقابل إلى الشمس التي تنير عالمنا وتُدفئها، فكل واحد منها له ضوء وحرارة، ولكن لا يختلط أي واحد منها بالآخر، فنحن نميز بينها بسهولة بطول الموجات، فالاختلاف بطول الموجات قانونٌ سارٍ في الكون.
وبهذه الخصوصية والقانونِ يتبين لنا كيف أن كل شيء يتحرك في الكون في نظام معين وأن الله تعالى يرى كل شيء ويهيمن عليه، وفي عالم الخلقة تتم كتابة الكتب التي سبق أنْ قُدِّر لها الظهور، وتتحقق ضمن قدَر ونظام، بمعنى أن صاحب مطلق القدرة والإرادة قد عَيَّن كل شيء وقدَّره تقديرًا.
فكتاب الكون قد تمت كتابته وفقًا لهذا التقدير الإلهي، وأما الذرات فهي بمثابة حروفِ هذا الكتاب وألفبائها، والجزيئاتُ كلماتُها، والكائناتُ الحية وغير الحية هي بمثابة جُمَل هذا الكتاب، فحينما يأمر الله بقوله: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (سورة العَلَقِ: 96/1)، بالقراءة يلفت أنظارنا إلى ساحة الخلقة، ويربط قضية القراءة بالخلقة، فيدعو الناس إلى قراءة كتاب الكون والخلقة، وبقوله تعالى: ﴿خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (سورة العَلَقِ: 96/2)، يَلفت الأنظار إلى الإنسان للتذكير بالعالَم الأكبر، والانسجامِ الموجود بين خلق الكون وخلق الإنسان.
وهذا هو السبب في أننا ما زلنا ننظر إلى الكون على أنه “كتاب” كُتب بقلم القدرة والإرادة؛ لأنه كما أن القرآن الكريم هو كتاب الله الصادرُ من صفة “الإرادة”، فالكون بالمقابل كتابٌ نابع من صفتَي القدرة والإرادة، فالقرآن الكريم يتطرق في مواضع عديدة لهذه العلاقة بين الإنسان والكون، ونحن أيضًا بناءً على ذلك نعتبر الإنسان “الكون الصغير” وننظر إلى الكون على أنه “الإنسان الكبير”.
إن القرآن الكريم كثيرًا ما يجلب الأنظار إلى تركيبة الإنسان والكونِ، ويَكشف أسرار الخلقة على المستوى الكلي والجزئي ويركز على العناصر المكوِّنة للوجود، ونتيجةً لذلك نلاحظ أن هناك وحدة مهمة بين عين العلم وعين القرآن؛ أي تطابقًا وتوافقًا جادًّا في وجهات النظر بين العلم والقرآن؛ فالعلم يحاول أن يَنفُذ إلى داخل المادة فيتعمقَ فيها ويصلَ إلى الأعماق التي لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر الإلكتروني، وهناك يشاهَد
أن القرآن الكريم قد أشار إلى الحقائق نفسها من خلال آياته وبيانه.
وهذا يدل على أن كتاب الكون والقرآنَ المعجز البيان يتحدثان في الأساس عن الحقيقة نفسها، والقرآنُ من هذه الحيثية يُعتبَر الترجمان الأزلي والأبدي للكائنات، وبدونه لا يمكن قراءة الكون بشكل مفهوم، كما أنه ليس للعلوم أن تتطوّر من دون انحراف
عن المسار الصحيح إلا إذا استرشدت ببياناته المعجزة.
2- العالَم الذي كتبه قلم القدرة والإرادة: عالم الذرات (Micro)
الذرة جزء صغير للمادة، وقد قام العلماء حتى بتشريح هذا الجزء الصغير للمادة، فتوصّلوا إلى أن مكوناتِ الذرة هي:
أ. جُزَيئات تسمى النيوترون والبروتون.
ب. إلكترونات تدور بسرعة حول هذه النواة.
وهذه الجُسيمات الصغيرة هي الحجر الأساس لكل الكائنات التي خلقها الله
في الكون بدءًا من أصغر عالم وانتهاءً بأكبره.
وهذه الجسيمات هي اللبنات الأساسية لكل ما في الكون من أصغره إلى أكبره؛ بدءًا من الخلايا التي تشكل جسم الإنسان إلى الخلايا التي في فاكهة الأشجار، ومن المجرات إلى السدم وكلِّ النُّظم الكبيرة، فقد جعل الله هذه الجسيمات في مجموعات مختلفة وشكَّل منها تراكيب لا نهاية لها؛ بحيث حرَّك الذرّات نفسها ولكن في تراكيب مختلفة، فخَلق من هذه الجزيئات المحدودة المعينة مئات بل ألوفًا بل عشرات الآلاف من التكوينات.
أجل، إن الحق يُنشئ من شيء واحد ألفَ شيء، ويُحمِّل كلًّا من هذه الأشياء عديدًا من الوظائف؛ فالذرات التي تَنفُذ إلى داخل الأشجار عن طريق أشعة الشمس تَأخذ هناك ماهياتٍ مختلفةً، في حين أنها تشكِّل تراكيب مختلفة إذا دخلت في كائنات أخرى.
فالله تعالى قد وضع في كل شيء نفسَ الجزيئات بدءًا من الكائنات الدقيقة والحيوانات والنباتات وانتهاءً بعالم المجرات والأنظمة البعيدة عنا بمليارات من السنوات الضوئية والتي تذهل العقول بعظمة أحجامها، كما أنه بنفس اللبنات أَوجد شتى المناسبات بين هذه الأنظمة المختلفة عن بعضها البعض؛ فبين الإنسان والكون علاقةٌ رائعة، وكل هذه الأمور تتحقق عن طريق هذه الذرات الصغيرة التي هي بمثابة رؤوس قلم القدر الإلهي، فكما أن الإنسان يواصل حياته عن طريق الذرات، فكذلك الأشجار بكيفياتها المتلونة والتي تلامس القلوب بأزهارها وثمارها، هي أيضًا تتكون وتواصل وجودها بالذرات نفسها.
وكل أنواع اللباس الموجودة في الكون والتي تُناسب ملبوساتِها في قاماتها وطبائعها وأشكالها ما هي إلا تَشَكُّلٌ لهذه العناصر بأشكال مختلفة، إن مَعرض الكون يعمل وكأنه متجر الملابس؛ بحيث إن كل موجود يجد بكل سهولة ما يناسب قامته وحجمَه من اللباس فيرتديه، بالإضافة إلى أن كل ذلك يتحقق بتكلفة قليلة ليس من الممكن تحقيقه بطريقة أخرى بهذا المستوى من الرّخص والسرعة والوفرة.
فمثلًا، إذا غرس أحدُنا فسيلة في التراب فإنها تمتص الماء قطرة قطرة، وتأخذ ثاني أوكسيد الكربون من الجو، وتجمعها بالأشعة القادمة من الشمس، وتصنع تركيبًا سُكَّريًّا، ولكن هذا كله يتحقق بمنتهى السهولة والرخْص، ولكن الإنسان لم يستطع بعدُ
أن يؤسّسَ مصنعًا ينتج السكّر بهذه السهولة.
ففي هذا المصنع الذي أوجده الله، تَمسح الشمسُ بأشعّتها رؤوسَ الأغصان التي تلتقط المواد من الهواء، وتمتصها من التراب، فتصنع التركيب السكري بمهارة فائقة تحيِّر الإنسان؛ حيث إن البشرية رغم كل ما تمتلكه من الأدوات التقنية لم تستطع أن تحقق عُشر تلك المهارة التي تُحقِّقها أغصانُ الأشجار، وهكذا وبهذه السهولة يُنتج كل شيء في مصنع الله.
إن كل الذرات المنتسبة إلى سلطان الكون، وكلَّ التموجات الجوية، وأنواع الغازات الموجودة في الهواء، والأشعة القادمة من الشمس، وكل الرشحات المائية تمتصها الأشجار من التراب فتصعد عبر الجذور والأغصان.. كل واحد من هؤلاء يتصرف وكأنه مأمور إلهيّ، في تناغم تام، حتى تُقدِّمَ للإنسان العديدَ من النعم، وتلبيَ حاجاته الضرورية في أبهى حلتها وألطفِها وأكثرِها جاذبية، وبذلك تُجيش فينا مشاعرَ الشكر والامتنان.
3- أصغر أجزاء الكون في القرآن الكريم
سبق أنْ تناولنا آنفا في ضوء الآيات القرآنية قضيةَ الذرة التي تُعتبر هي ومكوناتُها أصغرَ أجزاء الكون، ولكنْ بدلًا من الحديث حول ماهيتها الأساسية تَحَدَّثْنا هناك حول كيفياتها المتنوعة وكيف أن الموجودات تتشكل وفقًا للبرنامج القدري، وأن لها خطة سابقة، وأن القدر والإرادة الإلهيتين تحيطان بكل شيء وتهيمنان عليه، بدءًا من الذرات وانتهاءً بالأنظمة الكونية الكبرى، وسنفصل الموضوع أكثر بأن نشرح هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن إحاطة علم الله وإرادته وقدرته: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (سورة يُونُسَ: 10/61).
وفي هذا السياق قد يتساءل الإنسان: هل المواد المستخدَمة في الكون من أصغر دائرة إلى أكبرها، ومن الذرات إلى المجرات، هي نفسُ المواد الأساسية؟ وهل البنية المادية هي نفسها في كل أطراف الكون؟
لقد ذكرنا سابقًا أن اللبنات الأساسية في الكون هي نفس الأجزاء؛ حيث إن قول الله تعالى: ﴿مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ يشير إلى هذه الحقيقة، وأن الله تعالى قد خلق كل ما في الأرض والسماء من نفس اللبنات الأساسية ومن نفس الذرات-الجزيئات أو الجسيمات.
﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾، يقول أهل التحقيق: إن “الإمام المبين” هو اللوح المحفوظ والكتاب المبين هو الذرات التي تملأ كل الأنحاء وتحتوي على قصةِ حياةِ الشخص وكأنها شريطُ محوٍ وإثبات، وتشتمل على كل ما يتعلق بالإنسان وكأنها شريط سينمائي، وتسجيل الذرات لنشاطات معينة، وتعلُّقُ تصرفات الإنسان بشريط الزمان هما من الأمور التي توضح لنا مفهوم “الكتاب المبين”.. فهو اسم للكتاب الذي كتبه الله بقلم القدرة، وقدّره منذ الأزل.
وتعبير “الكتاب المبين” هنا له مغزى مهمّ، حيث تقول الآية: إن كل شيء سواء أكان أكبر من الذرة كالجزيئات مثلًا أم أصغر كالإلكترونات والكواركات -مع اعتبار الخلاف في النظريات- يتحرّك بقدرة الله ويُسجَّل في كتاب مبين.
و”المثقال” هو وحدة القياس المستخدَمةُ لقياس وزن الذهب، وحينما يطلق “مثقال ذرة” فلا يقصد منه سوى المعنى المصطلح عليه في قياس الذرة (Atom).. وقد تم قياس نصف قطر الذرة على أنه ثمانية في عشرة أُسّ ناقص ثمانية (0.8-8) وهذا المقدار يحتل مساحة صغيرة جدًّا؛ بحيث إنه لو تم إضافة 75 مليونًا من ذرات الهيدروجين إلى بعضها البعض بشكل متسلسل لَمَا شغل إلا سنتيمترًا واحدًا.. وبتعبير آخر: يوجد في 56 جرامًا من الحديد:
(1023×6.02) = (602.000.000.000.000.000.000.000) من الذرات
والشخص الواحد أكبر من الذرة من ناحية الحجم بمقدار (1028) ضعفًا، كما أن الشمس هي أكبر من الإنسان بمقدار (1028) ضعفًا، فحجم الإنسان هو في نقطة وسط بين حجم الذرة وحجم الشمس، وحجم الشمس من السعة والعظمة بحيث تَسَعُ
ما يعدل مليونًا ومائتين وسبعةً وتسعين ألفَ كرةٍ أرضية من طراز كرتنا الأرضية التي نعيش عليها، ومن هذه المقارنة ندرك مدى صغر حجم الذرة.
وتعبير “مثقال ذرة” في الآية الكريمة يَلفت النظر إلى ما هو أكبر من الذرة وما هو أصغر منها مثل: البروتونات والنيوترونات والإلكترونات والميزونات والنيترينتو والكواركات، وفيها إشارة إلى أننا مهما دخلنا في ساحات ومهما تعمقنا ومهما اكتشفنا فإننا لن نتخطى حدود ماهية الذرة، ولن نخرج خارج حدود نطاقها، ولا بد من تناول القضية على إطلاقها، ويبدو أنه ليس هناك من تناقض بين قوانين الذرة المطروحة على بساط البحث والتي لا تزال قيد التطور، وبين تعبيرات القرآن المعجز البيان، ولا شك أنه ليس من الصحيح أن نحاول تكييف القرآن الكريم مع نظريات لا تزال في طريقها نحو النمو والتطور، ولكن إذا كان الكون الذي هو أساس العلوم هو الكتاب المنظور للذات الإلهية التي تتكلم بالقرآن -ولا نشك في ذلك- فليس هناك مجال لتناقض التفكير العلمي الصافي مع القرآن الكريم.
ففي وسط الذرة نواة تدور حولها إلكتروناتٌ بسرعة، وفي كل الذرات باستثناء الهيدروجين يوجد في نواة الذرة النيترون بجانب البروتون؛ لأنه إذا وجد في النواة أكثر من نيوترون واحد فإنها ستتدافع فيما بينها لكونها محملة بنفس القطب الكهربائي؛ حيث إن شحنتها موجبة؛ فالنيوترونات الموجودة في النواة تَحُول دون تدافُع البروتونات فيما بينها وتقوم بدور الرابط بينها، وهذا يعني أنه لا يمكن للبروتونات أن تتعايش فيما بينها من دون النيوترونات.
والعكس صحيح؛ حيث إن النيوترونات هي بحاجة دائمة إلى البروتونات، فإذا خُلِّي بينها فإنها سرعان ما تَفسُد نصفُها وتتحول إلى بروتونات وإلكترونات، ولكن كلما كبرت النواة فإن أعداد البروتونات والنيوترونات هي أيضًا تتكاثر ولكن ليس بالتوازي بل إن عدد النيوترونات يكون أكثر، صحيح أن لهذا التكاثر أيضًا حدودًا ومَوازين معينة، فإذا اختلت هذه الموازين وتم تجاوُز الحدود فستبدأ حالةٌ من عدم الاستقرار في النواة، وأما الرجوع إلى حالة الاستقرار فإنما يتحقق بما يحصل داخل النواة من النشاط النووي.
ولا ينحصر اختلال النشاط النووي في التوازن بين النيوترون والبروتون؛ فقد يؤدي مجرّد الارتفاع في أعداد البروتون إلى ذلك؛ فالعناصر التي تحتوي نواتها على أكثر من أربعة وثمانين بروتونًا فإنها ستكون غير مستقرة مهما زاد عدد نيوتروناتها، فلا يمكن الاحتفاظ بهذه الكمية من الشحنة الموجبة في نواة الذرة، فالنواة بدروها تتقلّص إلى أن تصل إلى وضع الاستقرار، وأكثرُ الذرات استقرارًا هو الهيدروجين، وأكثرُها اضطرابًا هو اليورانيوم، فبروتونات اليورانيوم تثير الضجيج المستمر مع محيطها وتؤدي دائمًا إلى الانفجارات، ولهذا فإن اليورانيوم من العناصر الأساسية المستخدَمة في تصنيع القنبلة الذرية.
وتنبعث من اليورانيوم 238 نوعًا من جسيماتُ “أَلْفَا” فينزل عدد البروتونات من (92) إلى (90) وعددُ النيوترونات من (146) إلى (144).. ولكن (90) بروتونًا ثقيلٌ على (144) نيوترونا! ففي هذه المرة تنبعث من اليورانيوم جُسيماتُ “بِيتَا” فيزيد من عدد البروتونات، فيأخذ مكانه في الرقم (91) كعنصر جديد، وتتواصل هذه العملية، وفي النهاية يبقى اليورانيوم في مكانه في الرقم (82).
ويدَّعي “لورنتز” أن المسافة والمناسبة بين نواة الذرة والإلكترون تبدو وكأنها مثال مصغر للمنظومة الشمسية؛ فكما أن هناك نجومًا توابع تدور حول الشمس باستمرار، فكذلك الإلكترونات تتحرك وتدور حول نواة الذرة، وتختلف حركة الإلكترونات على حسب المسافة بينها وبين النواة، وتكون المسافة بين الإلكترونات والنواة بمقدار واحد بالمليون من المليمتر، فتتراوح سرعتها في الثانية الواحدة بين (1000) إلى (15000) كيلومتر، فتدور في الثانية الواحدة في ذلك الطريق القصير حول النواة قاطعةً مليارات الجولات.. والفرق بينها وبين الكواكب الدائرة حول الشمس هي أن منظرها يحاكي منظر السحاب، فتكون هي كل حين في منطقة من ذلك السحاب.
وتقوم الإلكترونات بهذا الدوران السريع حول النواة بحمايتها، ولو كان هناك قطار يتحرك بسرعة الإلكترون لَقَطَعَ المسافةَ بين صنعاء إلى حضرموت ذهابًا وإيابًا في ثانية واحدة.. فبسبب هذه السرعة الفائقة للإلكترونات يبدو داخلُ الذرات وكأنه مليءٌ، وأولُ من اكتشف أن داخل المادة فارغ وسجَّله في كتابه هو العالِم المسلم الكبير الإمام الرباني السرهندي، وفي أثناء دوران الإلكترونات حول النواة تحدُث داخلَ الذرة عواصفُ وأعاصير تجتاح الأطراف، ولكن الناس لا يشعرون بكل هذا الذي يحدُث.
أجل، إن الإلكترونات رغم صغر حجمها تُقيم القيامة فيما حول النواة.
ولننظر كيف تُلقي كلمة “الذرة” بمختلف معانيها الضوءَ على ما نحن فيه:
﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا [أي أُقسم بالرياح التي ترفع السحب وتثير الغبار، وبالقوانين الطبيعية التي تثير الحمم البركانية، وبالذراتِ] فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا [أي السحب المحملة بالمطر] فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا [أي السفن والكواكب التي تَجري بيُسر وسهولة]﴾ (سورة الذَّارِيَاتِ: 51/1-3).
ففي الآية الكريمة يَتم القَسَمُ بالله الذي يُحرِّك الذرات والأجسامَ ويقلبها كيف يشاء.
وكلمة “الذر” تأتي في العربية بالمعاني التالية أيضًا:
أ. عندما يصنع الإنسان طعامًا لزِجًا قريبًا من الجاف، فيبدأ بخلطه، يحصل من وراء الآلة الخالطة تَتابعٌ ومطاردة من الطعام للآلة فهذا يسمى ذرًّا.
ب. يرى أكثر المفسرين أن الذاريات بمعنى الرياح، بمعنى أن الرياح تَذْرُو وتُبدِّد، وتُثير الغبار، فتؤدي إلى الأعاصير.
ج. ويرى بعضهم أن المراد بها الملائكة الموكَّلون بهبوب الرياح، ويمكن العثور على هذه الآراء في كثير من التفاسير القديمة والمعاصرة.
ويفهم من هذه المعاني أن الله تعالى لا يُحدث التغييرات في عالم الذرات فقط، بل يجري بعض التغييرات عن طريق الرياح أيضًا، وتحريكُ الله تعالى للأشياء بالرياح والعواصف هو شبه قانون عام جارٍ في الكون بدءًا من أكبر العوالم وانتهاءً بأصغرها، فهناك مليارات من المجموعات النجمية تدور حول مركزِ مجرةِ درب التبانة بسرعة (250) كم في الثانية أي (15000) كم في الدقيقة الواحدة، فالله الذي يدير الإلكترون حول نواة الذرة ضِمنَ قانون معين، يدير الكرة الأرضية ويجري الرياح بالقانون نفسه، كما أن هناك أجرامًا سماوية في الفضاء الفسيح هي أكبر من الشمس بملايين الأضعاف يُجريها الله بالقانون نفسه إلى نقطة معينة، وتتراءى للناظر وكأنها غيوم تشكلت من الغبار.
فنحن إذ نتأمل في قوله تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾ (سورة الذَّارِيَاتِ: 51/1) [أي الرياح التي تَرفع السحبَ وتثير الغبار] ننظر نظرة شاملة إلى كل العواصف والأعاصير التي تهُبُّ في الكون بدءًا من أصغر العوالم وانتهاءً بأكبرها، ونحاول مشاهدة عظمة الله في كل شيء.
أجل، إن أعظم النُّظم في العالم الأكبر الواقعِ في دائرة القدرة الإلهية تتحرك مثل أصغر جزيئات الذرة، والعواصف التي تهبُّ على وجه الأرض تحت إشراف الملائكة، تحصل -بالقانون نفسِه- في عالم الذرات عن طريق الإلكترونات، وأينما تذهب فلن تجد لسنة الله تبديلًا، فلو تغيرَتْ أمثال هذه القوانين ولم تَطَّرد لما تبينتْ لنا العلوم، ولَمَا أتيح لنا الحديث عن الثوابت جرَّاء عدم اطّراد القوانين في الكون؛ لأن العلوم إنما تتشكّل بفضل هذه القوانين المطّردة.
وتوجد في نواة الذرة بروتونات ذات شحنة موجبة، بينما توجد حواليها إلكترونات سالبة الشحنة، فهاتان القيمتان المتضادتان تتجاذبان فيما بينهما، ولا بد لمادة النواة أن تكون ثقيلة جدًّا حتى تستطيع جذب ما حولها من الإلكترونات وتديرَها فيما حولها، ولهذا فإن البروتونات هي أثقلُ بمئات المرات من الإلكترونات؛ فمثلًا: إذا كان وزن الإلكترون وحدةً واحدة، فإن البروتون أثقل منه بـ(1836) مرة، فالإلكترونات الخفيفة تدور حول البروتون الثقيل وفقًا للقانون الذي وضعه الله.
ولزيادة الأمر تصويرًا نستطيع القول: إن للبروتون مهمةَ التحركِ في الأطراف بسرعة فائقة، وأما النواة فعليها حملُ الأثقال، فهي مركز الثقل وعليها الحِمل، ومن يدري لعل قوله تعالى: ﴿فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ (سورة الذَّارِيَاتِ: 51/2) يشير إلى هذه الحقيقة.
فالله تعالى يُقْسِم في هذه الآية بالحاملات الأحمال الثقيلة، ونلاحظ أن الله تعالى يلفت الأنظار إلى ما على وجه الأرض من الغبار والتراب، في الوقت الذي يجلب الانتباه إلى الأشياء العملاقة التي تدور حول الأنظمة السماوية، كما يشير إلى الإلكترونات التي تدور حول نواة الذرة؛ فالآية تتحدّث عن دوران الكرة الأرضية بثقلها وترابها وغبارها حول محورها، كما تتحدث عن دوران الإلكترونات حول الإلكترونات، بالإضافة إلى الإشارة إلى الأنظمة السماوية الكبيرة وما ترتبط هي بها من النَّوَيات العظيمة، وفي الآية إشارة أيضًا إلى قانونِ: “ثقل المركز” في الأنظمة بدءًا من أصغر الأنظمة وانتهاءً بأكبرها؛ حيث يقول الله تعالى في سياق القسم: ﴿فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ (سورة الذَّارِيَاتِ: 51/2) مشيرًا إلى أهمية النواة أو هذا الثقلِ الموجود في المركز؛ فإنه لولا هذا الثقل لتبعثرت الإلكترونات ولأدى ذلك إلى انفجارات مُدَوِّيَة في الأطراف.
وتوجد أيضًا في النواة نيوترونات غير مشحونة من حيث الطاقة الكهربائية، وتكون سرعة دوران هذه الأجزاء الثقيلة على حسب وزنها، فتتراوح سرعتها في الثانية الواحدة بين سرعة الضوء وبين عدة كيلومترات، ومن حيث إنها غير محملة فإنها تستطيع أن تَقطع مسافات طويلة في المادة، وهي بهذه السرعة تستطيع أن تخترق الحديد والرصاص بسمكِ (30) سم، ولكنها تَفقد طاقاتِها أثناء تصادمها مع النويات الذرية، ومع أن بعضها ثقيلٌ للغاية لكنها من شدة سرعتها تستطيع أن تخترق أشد المواد كثافة وتثقبَها بكل سهولة، وهي بفضل هذه السرعة الفائقة تتحرك بكل سهولة كما يحلق الطير في الهواء ويعوم السمك في الماء بكل راحة، تُرى! هل هناك إشارة إلى هذا في قول الله تعالى:
﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾ (سورة الذَّارِيَاتِ: 51/3).
فالله تعالى يُقْسم في الآية على أشياءَ تَجرِي بيسر وسهولة؛ أي الرياح والسحب والكواكب السيارة والأنظمة السماوية التي تجري في الفضاء بسهولة، بالإضافة إلى النيوترونات والإلكترونات في العالم الأصغر.
4- كل ما في الكون خاضعٌ لنظامٍ وميزان
إن كل ما في الكون تابعٌ لنظام وميزان في الإطار الذي وضعه الله، فلو لم يخلّ الناس بمحض إرادتهم بهذه القوانين ولم يشوّهوا ظروف حياتهم لبقي هذا الكون وهذا القَصر وهذا المعرض الرائع نظيفًا هادئًا وفي منتهى الانسجام والتناغم. أجل، إن كل ما في الكون؛ من الأحياء وغير الأحياء العاقلة وغير العاقلة، من الذرات إلى الأنظمة الكبرى، كلها تقوم بما نيط بها من المهامّ الخارقة، فالذرات تُجرِي أنشطتها في سرعة معينة وفي تناغم خارق، وتُواصِل كلَّ حركاتها وفعالياتِها في إطار القوانين التي وضعها لها الله تعالى.
ولنتصور أننا وضعنا في أفواهنا فاكهة، فسنشاهد أن بين هذه الفاكهة وبين ما أُودع في أفواهنا من الخلايا الذائقة تواؤمًا فائقًا يفوق التصور، فقد وَضَعَتْ يدُ القدرة بعلمه المحيط في فم الإنسان شبكة من العلاقات ورَبَطت نشاطَ عامةِ أجهزة الجسم من الأعضاء كالغدد اللعابية والمعدة والأمعاء والكلى والكبد وغيرها بهذه الشبكة؛ فإن الذرات التي تؤدي وظائف في تركيبة خلايا فم الإنسان هي الذراتُ نفسها التي تؤدي دورها في تركيبة الفاكهة.
فالله تعالى بقدرته اللانهائية ينيط بهذه الجسيمات الصغيرة في كل كائن في الكون وظائفَ على حِدَة، بحيث إنها حينما تكون في فم الإنسان تتحمل وظيفةَ تشغيلِ الغدد اللعابية وتحفيزِ الشعور بالتذوّق والتفكّه، وحينما تكون بداخل الفاكهة فإنها تَحْمِل خصوصياتِ الفاكهة؛ بمعنى أنها في كل كائن تقوم بوظائفَ تُناسِب بنيته، وتتكيفُ
على حسب ما تكون عليه من الأوضاع؛ فالكون له ميزان ونظام بهذا الشكل، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ (سورة الْحِجْرِ: 15/19).
أجل، إن كل ذرة تؤدّي وظائفها، وكأنها كلمة سَطَرها قلمُ القدرة الإلهية، فتبدع لكل شيء لباسًا حسب قامته، وتُعطي كلَّ فطرة ما يناسبها من الشكل، والبرنامجُ القدريُّ هو الذي يُنيط بالذرة كلَّ هذه المهامِّ، فهي لن تتحرك خارج نطاق هذا البرنامج، ولن تستطيع انتهاك حدود الموازين التي عُينت وقُدّرت لها، فلو تمرّدت الذراتُ داخل الجسم البشري وأخلَّتْ بالبرنامج لتشكّلت في جميع أنحاء الجسم أورام سرطانية، ولكن الواقع غير هذا، فهي تقوم بوظائفها داخل الجسم بوصفها عضوًا مخلصًا لهذه المهمة، وبفضل ذلك لا نلاحظ في الجسم أيَّة تراكمات زائدة عن الحاجة، فلو حصلت تراكمات مؤقتة في خلايا الدماغ لما أفلح الإنسان، ولَبدأ يهرع من طبيب إلى آخر للبحث عن دواء يريحه عما في دماغه من الأورام، ولكن الأمر بالعكس تمامًا؛ حيث إن كل شيء في مكانه المناسب، وتقوم كل ذرة بنشاطها داخل الجسم في نظام وبرنامج معين، وبالتالي فلن ترى في الجسم أيه تراكمات زائدة إلا في بعض الحالات الطارئة الاستثنائية.
وكلُّ الخلل إنما يحصل عادةً جراء التدخّل الخاطئ والمعالجةِ غير الرشيدة. أجل، فكثيرًا ما يضرّ الإنسانُ نفسَه بنفسه من خلال القيام بأعمال مخلّة بالنظام العام في جسمه، فإذا كان في بعض مناطق الجسم عصيانٌ وتمرُّدٌ فهذا يعني أن هناك تدخّلا لإرادة الإنسان فيها، لأن ذرات جسم الإنسان لا حياة ولا شعور فيها، ولا تؤدِّي أنشطتَها إلا في إطار القوانين والموازين التي حددها الله لها، وليس لها أن تعصي هذه القوانين الإلهية قطعًا، فالمبدأ الأساسي لديها الطاعةُ والانقياد، وهذا الانقياد وهذه الطاعة العفوية منها هما اللذان يوهِمان الإنسانَ في كثير من الأحيان وكأن كل شيء يحصل من تلقاء نفسه.
إن القوانين والنواميس الجارية في الكون تعمل بشكل منظّم ومطّرد بحيث إن الناظر يلاحِظ حتى من وراء الأمور الصغيرة وكأن هناك خططًا تتّسم بالعبقرية والدهاء، وبالفعل إن الله هو صاحب القدرة اللامتناهية الذي يدبّر كل شيء وكلَّ قانون، وهو الذي يدير الكائنات وينظمها، وليس لأحد غيره أن يتصرّف في ملكه تعالى، وإن الذرات وما تخضع له من القوانين تستند إليه تعالى، ولذلك نراها تؤدي مهامها بدءًا من أكبر العوالم وانتهاءً بأصغرها من دون أي تَلَكُّؤٍ أو فتور متجهةً نحو الغاية من خلقها، بالإضافة إلى أنه عندما يُحدِث الإنسانُ أيَّ خلل في النظام الكوني، فهناك نظام يتدارك الأمر فيزيل الخلل بفضل ما يشتمل عليه من قوانين الحماية وأنظمة المناعة.
إن التوازن الفطري لديه آلية تحميه تجاه الأيدي الجاهلة التي تفسد النظام البيئي، وتحافظ عليه ضد القوى الخارجية التي تحاول إفساد النظام العام السائد في الكون؛ بمعنى أنه يوجد بين الأشياء والأحداث خارجَ سير الحركة الطبيعية قوةٌ حامية ورادعة تعمل بواسطةٍ أو بدون واسطة، ولولا هذه الحماية لأدى أيُّ تدخُّل خارجيٍ جارٍ في جهة من الكون إلى فسادٍ يسري بشكل متسلسل في كل ما في النظام الكوني من الأشياء والحركات، ولكن ذلك لا يحصل.. بل إن تلك الذرات الجامدة تتحرك بشكل معين ومقدر، وهذه الحقيقة يعبر عنها بشكل وجيز قولُه تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (سورة الرَّعْدِ: 13/8).
أجل، إن كل شيء يجري بقدر وميزان إلهي، وليس لأية ذرة أن تتحرك عفويًّا وأن تتخذ لها طريقًا تسلكه كما تشاء، فحجر الأساس لهذا النظام والتنظيمِ الذي وضعه الله في الكون هي الذرة التي ما زلنا نحاول أن نوضحها ونتعرفَ عليها بشتى كيفياتها، فالله تعالى ينسج كل شيء في الكون بدءًا من أصغر العوالم وانتهاء بأكبرها من هذه المادة الأساسية، وينشئ بها مفردات كتاب الكون، فلو قام بنو الإنسان بتشطير الذرة إلى أجزاء أصغر وسمَّوها بأسماء مختلفة لَمَا تغيرت النتيجة، ولرأوا عيانًا أن قلم القدرة يُجري حكمه في كل شيء رغمَ أيّ شيء.
ونستنتج من كل ما سبق أن الله تعالى وضع لكل كائنٍ حدودًا تتناسب مع خصوصياته، ووضع له نظامًا وتوازنًا وقانونًا، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (سورة الرَّحْمَنِ: 55/7)، ففسِّر الميزان إن شئت بـ”قوانين التوازن العام” الذي يقال بوجوده بين جميع الأشياء، وإن شئت فسمِّه: “الجاذبية” (gravitation) باعتبارها منفتحة على أفكار أخرى، ولك أن تُضيِّق إطار الموضوع وتختزله وتربطه في قضايا اجتماعية كالحق والعدل والمساواة والأخوة بين الناس، فما يراد التأكيد عليه في الآية هو ما يهم جميع الكون من التقدير والتعيين الإلهي الذي يعمّ النظام العام والتناغم العام والنظام البيئي العام (النظام الإيكولوجي)، كما أن قوله تعالى ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (سورة الرَّعْدِ: 13/8) يؤكّد أن كل شيء، من الذرات إلى أكبر المجرات، خُلق خاضعًا لمقياس وميزان ومربوطًا بقوالب قدرية.
5- زوجية الأجناس
ومن الحقائق العلمية التي أخبر بها القرآن الكريم متخطّيًا بذلك حدود الزمان هو جعل كل الأجناس زوجين؛ يقول الله تعالى ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ[ذكر-أنثى]لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون﴾ (سورة الذَّارِيَاتِ: 51/49).. وتسليط الضوء على هذه القضية مهمّ للغاية، حيث إنه من الممكن مشاهدة هذه الحقيقة في كل مكان في الكون بدءًا من الذرة وانتهاءً بالأنظمة والمجرات السماوية.
فقد خُلق الإنسان والحيوانات أزواجًا، وكذلك الحالُ بالنسبة للنباتات، وقضيةُ التلقيح والتلقح هي هي في كل الأمور تقريبًا؛ فحتى في النبات لو لم تلتقِ بذورُ اللقاح الذكورُ بالإناث لما أمكن للنباتات مواصلةُ حياتها والحفاظُ على أجيالها، وإذا نظرنا إلى جسم الإنسان فسنرى أن القانون نفسَه جار فيه أيضًا، فإن اللبنة الأساسية لخلايا الجسم هي الذرات المحملة بشحنةِ: زائد (+) أو ناقص (-).
فقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة البدهية بقوله: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾ (سورة القِيامَةِ: 75/39). كما أن قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (سورة الرَّعْدِ: 13/3) يذكّر بهذه الزوجية في الثمار.
ولفظةُ “كل” في قوله تعالى ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون﴾ (سورة الذَّارِيَاتِ: 51/49) مضافٌ إلى شيء وهو نكرة، وقد تقرّر أن لفظة “كل” إذا أضيفت إلى معرفة أفادت عمومَ الأجزاء وإذا أضيفت إلى نكرة أفادت عموم الأفراد، بمعنى أن كلّ فرد من أفراد المضاف إليه يدخل تحت الحكم، فـ”شيء” في هذه الآية تعمّ كل الموجودات، وذلك يدل على أن كل ما يدخل تحت عموم “شيء” فقد خُلق زوجين.
وقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ اْلأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة يس: 36/36)، ففصَّل في هذه الآية ما أجمله في الآيات الأخرى؛ حيث ذَكر أولًا أن كل شيء خُلق زوجين ثم أكد أن ما تُنبته الأرضُ من أمثال العشب والزهور والأشجار هي أيضًا داخلةٌ في هذا القانون العام.
﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي ما في أنفسكم هو أيضًا أزواج، فكما أنكم خُلقتم أزواجًا، ذكرًا وأنثى، فأجسامكم هي أيضًا ليست خارجة عن هذا القانون، فهناك مقادير موجبة وسالبة.
وأظن أن قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ يذكّر المخاطبين بما يلي:
كما أن الإنسان والحيوان والنباتات خلقوا أزواجًا لا يمكن تكاثرهم إلا بالتلقيح، فكذلك هناك أزواج كثيرة لا تعلمونها وسترونها في المستقبل، وقد لا تكفي آفاقكم العلمية وإمكاناتكم البحثية الحالية لذلك، ولكن ستنكشف العلوم والفنون في المستقبل وسترون حينها أن هناك عددًا كبيرًا من الموجودات قد خُلقت أزواجًا، فقد خلقنا كل شيء سواء ما في العوالم العُلوية الكبيرة من الأنظمة السماوية والمجرات حتى ما بين النجوم والشمس من القوة الجاذبة والدافعة، أو ما في العوالم الصغرى من الإنسان والحيوان والنبات والبذور والذرات وما فيها من العناصر الأساسية، كل ذلك خلقناه زوجين.
ولقد أسس “موريس ديراك (Maurice Dirac)” لقانون الزوجية في الأشياء بعدما تم اكتشاف البوزيترون، فالإلكترون هو من العناصر الأساسية المكوِّنة للذرة، وهو محمَّل بأصغرِ شُحنة كهربائية سالبة، وأما البوزيترون فمع أنه ذو كتلة يوازي كتلة الإلكترون،
إلا أنه بعكس الإلكترون جُسَيم محمَّل بشحنة موجبة.
وحسب هذا القانون الفيزيائي الأساسي القائل بخلق كل شيء زوجين، فإنه حينما يُخلَق جُزَيْءٌ في أي نقطة من الكون فإن توأمه المعاكس له في الشحنة الكهربائية يُخلق معه، ويمكن سرد أشهرها كما يلي:
1- البوزيترون التوأم المعاكس للإلكترون
2- مضاد البروتون التوأم المعاكس للبروتون
3- مضاد النيوترون التوأم المعاكس للنيوترون
4- مضاد النيوترينو التوأم المعاكس للنيوترينو
فإذا تعمّقنا في المادة أكثر فأكثر فسنلتقي هناك أيضًا بالأزواج، ومن المعروف أن كل مادّة تنشأ من الذرّات، والذراتُ تتشكل من البروتونات والنيوتروناتِ والإلكتروناتِ، والبروتوناتُ والنيوتروناتُ تتشكل من جُزيئات تسمى: “الكواركات”.. وكل هذه عبارة عن الأزواج.
وهناك ستّ كواركات (ثلاثة أزواج) هي:
فوق (Up) / تحت (Down)
جذاب (Charm) / غريب (Strange)
عُلوي (Top)/ سفلي (Bottom)
وكان الكوارك العلوي يعرف له وجود على المستوى النظري فقط، وعلى حسب النموذج القياسي كان لا بد أن تكون الجُزيئات على هيئة أزواج، فكان لا بد من كوارك حتى يصل عدد الكواركات الخمس إلى ست، فأجرى أربعمائة وأربعون من الباحثين بحثًا حثيثًا دام سبعة عشر عامًا إلى أن عثروا عام (1995م) على الكوارك العلوي، مما كان تطوُّرًا مهمًّا في حقل الكشف عن أسرار المادة.
والشحنة الموجبة للذرة هي في نواتها، وأما الشحنة السالبة فهي في الأجزاء الأخرى منها، وهذا يدفعنا إلى التساؤل: ما المانع من أن يكون هناك ذرات نواتها محملة بالشحنة السالبة وإلكتروناتها محملة بالشحنة الموجبة، بمعنى أن يكون للذرة توأم معاكس؟! إن المتخصّصين في هذا المجال يعترفون بوجود المادة المضادة في مجرّتنا المتشكلة من النجوم والشمسِ والغازاتِ والغبارِ، ومن المحتمل أن بعض ما رآه بعض الفلكيين بالتلسكوبات من أنظمة النجوم هي من المادة المضادة تمامًا.
ولأول مرة في عام (1733م) تمّ اكتشاف جنسين (موجب-سالب) من الكهرباء التي لها دور أساسي في خلق الكون وفعاليته، فأنواع الكهرباء ذات القطب الواحد من الشحنة الكهربائية تتدافع، في حين أن ذوات الشحنة المتضادة تتجاذب.
كما أنه من المعلوم أن المغناطيس له طرفا النقيضِ كالشمال والجنوب، بحيث إنك مهما قسَّمت المغناطيس إلى أجزاء فستكون له أجزاءٌ ذاتُ قطبين متعاكسين، بمعنى أنه لا يمكن إيجاد مغناطيس ذي قطب واحد، وإن الوضع هنا كالوضع في الكهرباء؛ تتدافع الأقطاب المتوافقة، بينما تتجاذب الأقطاب المتضادة، وكرتنا الأرضية هي أيضًا تعتبر بمثابة مغناطيس عملاق، لها قطبان متضادان: الشمال والجنوب.
وقد رأينا أعلاه كيف أن القرآن تَحدَّث عن هذا كله قبل قرون، وليس ما يقوله العلم شيئًا مختلفًا عنه، وعلى الرغم من مرّ العصور وانكشافِ العلوم بشكل مذهل لم يحصل هناك شيء مختلف عما قاله القرآن؛ فكما أن ما قاله القرآن كان متوافقًا مع الحقائق العلمية في عصرِ نزوله، فكذلك الحال بالنسبة للعقلية العلمية اليوم، وكلُّ ذلك يدل بجلاء على أن القرآن هو الكلام المعجز لله الذي هو سلطان الأزل والأبد.
6- منشأ الإنسان في القرآن الكريم
ما زال أولئك الذين لا يؤمنون بالله والقرآن والرسول ينتقدون البيانات القرآنية المتعلقة بالحقائق العلمية، كما كانوا يطعنون في جوانبه الاجتماعية والتربوية، فلو أن هؤلاء تأملوا في آيات القرآن بدقّة ودرسوها بعنايةٍ لَتبيَّن لهم أن ما ينتقدونه لا يتناقض بتاتًا مع العلم، بل لانبهروا أمام ما ينجلي لهم فيه من الدلالات والإشارات الإجمالية إلى الحقائق العلمية.
ولزيادة الأمر وضوحا فلْنربط الموضوع بقضيةِ خلق الإنسان؛ فالله تعالى يجلب الأنظار في آية كريمة إلى خلق الإنسان، وينبِّه إلى أن منشأه ماء يخرج من بين الصلب وعظام الصدر:
﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ [أي عظامه] وَالتَّرَائِبِ﴾ (سورة الطَّارِقِ: 86/5-7).
ومن المثير للانتباه أن هذه الآية من الآيات التي تعرضت لانتقادات بعض التعساء الذين تصدّوا لطعن القرآن الكريم.
أجل، إن القرآن الكريم يقول: إن هذا الماء ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ أي يخرج من بين عظام الظهر وعظام الصدر، وهم يقولون بـ”أن الحيوان المنوي الذي يدخل رحم المرأة إنما يخرج من خصيتي الرجل، فهناك تناقض بين الحقائق العلمية وبين بيان القرآن الكريم، وهذا من أخطاء القرآن الكريم، فلو كان الخالق موجودًا -سبحانه- وكان القرآن كلامَه لما كان هناك تناقض بين هذا البيان وبين ما كشفه العلم”.
فهذا النقد منهم يدلّ بوضوح على عدم فهمهم للتعبيرات القرآنية فهمًا صحيحًا، وأنهم لم يَدرسوه دراسة جيدة؛ لأن كلمة “الصلب” اسم للعظام الخلفية التي تبدأ من العنق إلى العَجُزِ.
بالإضافة إلى أن هناك من القواميس الحديثة من يفسره بـ”الكربون”، “الكربوهيدرات” و”المغنسيوم”، وعلى هذا فاختيار كلمة “الصلب” في الآية التي تتحدث عن منشإ الإنسان له مغزى كبير، حيث إن المخلوقات الصغيرة التي نسميها: الحيوان المنوي، والبويضةَ هي من الخلايا المحتوية على هذه المواد.
وأيضًا يمكن أن يُفهم من الناحية التشريحية من تعبير “الصلب” منطقةُ الحوض التي تتلاحم فيها عظام العمود الفقري بشكل قوي، ويفهمَ من كلمة “الترائب” الفقرات الصدرية.
وقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ [أي الماء الدافق] مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ لافتٌ للنظرِ جدًّا؛ حيث يشير إلى أن هذا الأمر ينشأ عن تنبيهات تبدأ من المركز الذي يحتوي على أعصابٍ تخرج من بين الفقرات القَطَنِيَّة التي تقع بين العجز والفقرات الصدرية؛ حيث إن النتائج التشريحية الحديثة تدل على أن الأعصاب المتعلقة بمركز تدفق المني تقع في منطقة النخاع الشوكي (T10-L2) التي هي بين فقرة الظهر العاشرة وبين الفقرة القطنية الثانية.
ومع أن الخصيتين والغدد التي تُنتج المني هي في الأسفل ولكن المركز العصبي اللازم لإثارة المني وقذفِه هو -كما تشير إليه الآية بهذه العبارات الوجيزة- بين الصلب والترائب.
وهناك مَن فَهِم من الآية بناءً على المعطيات العلمية القديمة أن المني ينشأ من الدم الذي ينتجه ما في داخل الفقرات من المخ، ولكن هناك حقيقة وهي أن إنتاج الدم لا ينحصر في العمود الفقري فقط، بل إنه يَنتُج من غيرها من العظام، كما أن الدم لا تقتصر مهمته على إنتاج الحيوانات المنوية، بل يتعدى ذلك إلى تأمين الغذاء لسائر خلايا الجسم أيضًا، ولذلك فإن تفسيرَ ما يخرج من بين الصلب والترائب بالأعصاب المخصَّصة لهذه المهمة قد يكون أليق بالوجه الإعجازي للقرآن الكريم من تفسيره بالدم.
وعند تحقيق القضية بهذا الشكل، يظهر جليًّا مدى استعجال الذين يحاولون مناقشة الآيات القرآنية على نحو سلبي، كما ينجلي مدى انحيازهم لأفكار مغلوطة مسبقة.
7- تشكُّل الجنين في الرحم
لقد فطر الله وحدة بين الخلايا، كما فطرها بين الجُزيئات التي تحتوي عليها الخلايات مثل الحمض النووي (DNA) والحمض النووي (RNA)، وإذا اختلَّت الوحدة في الخلية بين هذه الأنظمة اختلّ التناغم بين الخلايا وفي داخل الخلايا، وتدمرت الأنسجة والأعضاء، وبالإضافة إلى الأحماض النووية هناك في الخلية سلاسل من الأحماض الأمينية لم تتوفر إلى الآن معلومات كافية حول معظمها، وغاية ما نعلمه حول هذه المواد أنها تعمل فيما بينها في وئام تام، وكأنها جهاز حكومي منظَّم.
أجل، إن كل الخلايا قد اجتمعت فيما بينها لِتُشكِّل جسم الإنسان، فالإنسان في حد ذاته يُعتبر وكأنه خلية واحدة تَشكَّلت من بلايين الخلايا، فإن بين الخلايا التي تُشكِّله ارتباطًا وانسجامًا بحيث لا يشعر الإنسانُ ولو مرة واحدة بأنه متشكِّلٌ من كائناتٍ منقطعة العلاقة فيما بينها، صحيح أن ثمة انقطاعًا بين الخلايا، ولكن ما بينها من الوحدة يَجعل الإنسانَ يستطيع أن يرى كائنًا ما في الوقت الذي يستطيع أن يَسمع صوتَ ذلك الكائن أو غيرِه من الأشياء، ويشمَّ غيرها، وفي الوقت نفسه يستطيع أن يمشي ويتكلم، والحال أن الخلايا التي تتحكم في كل هذه الأنشطة هي خلايا مستقلة ومختلفة، ولكن هذا لا يؤدي إلى التشتت بل إنها تعمل بروح الأُسرة الواحدة التي يتعاون أفرادها في وحدة ومحبة قوية.
إن كل أعضاء جسم الإنسان تعمل في وحدة وارتباط وتَضامُن، ومن هذه الأعضاء ما نسميه: “الرحم” الذي يشير إليه ويعدد خصائصَه قولُه تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ (سورة الْمُرْسَلَاتِ: 77/20-23).
إن رحم الأم يستعدُّ بشكل جاد لاستقبال الحيوان المنوي الذي سيَنزل به ضيفًا لمدة تسعة أشهر بعد لقاحه بالبويضة والذي سيكون وسيلة لتكوُّن كائن حيّ، فقبْل أن يَنزل المنيُّ فيه تَحصُل في الرحم تحولاتٌ كيميائية فتتحول خلايا بطانةِ الرحم إلى طبقة من الخلايا السميكة لاحتضان الجنين وتكوينِ المَشِيمة ثم تُواصل بطانة الرحم سماكتها، ويعلوها الدم، وتتجهز بالفيتامينات، وتأخذ الخلايا بازديادٍ مطرد ومضاعف، وتتجهز فجوات الخلايا بالمواد الغذائية اللازمة للطفل الذي سينزل بهذا المكان، فهذه العملية تتكرر في الرحم كل شهر، ويفرز الرحم سائلًا لزجًا في الطريق الذي سيمر به الحيوان المنوي باتجاه داخل الرحم حتى يسهُل مرورُه وينزلقَ، ولكن إذا لم يتحقق لقاحٌ رغمَ كل هذه الاستعدادات؛ فإن كل هذه المواد الزائدة المجلوبة إلى الرحم ستُطرح خارجه بعملية “الحيض”، فهي إذا بقيت في الرحم فستؤدي إلى حدوثِ أمراضٍ فيه.
وأما إذا حصل اللقاح ولم تطرح هذه المواد، فإن البويضة الملقحة (الزيجوت) التي دخلت الرحم وتلقحت بالحيوان المنوي ستتعلق بجدار الرحم وتنغرس فيه، وتبدأ بالتغذي مِن هناك، ثم إن هذه الخلية الواحدة تبدأ بالتكاثر السريع في وقت قصير فتتحول في غضون أسبوع تقريبًا إلى آلاف من الخلايا المنقسمة.
فهذه الآلية في رحم الأم تعمل بشكل رائع جدًّا بحيث إنها توظِّف الخلايا التي تتكاثر كل يوم في مهامَّ خاصة، فتجتمع فيما بينها وتأخذ مواقعَها في الأنسجة التي ستشكِّلُ أعضاءَ الجنين.
وهذه الأنسجة تُشكِّل طبقات، وتَكُون في الطبقة العُلوية منها نتوءات مثل أصابع القفاز، ويكون ما يقابلها من جدار الرحم كذلك ذا نتوءات متناسبة مع هذه النتوءات بحيث تنطبق على بعضها البعض وتتغلغل الأوعية الدموية للجنين مع الأوعية الدموية للأم، ولكن لا يختلط دمهما بل يكون بينهما تبادلٌ للغذاء والفضلات، وهذا ما يسمى: “المشيمة”.
وفي الفترة التي يُواصل فيها الجنينُ نموَّه لمدة تسعة أشهر دون توقف، يكون أداءُ مهمة الكبد والرئة والكلى والجهاز الهضمي موكولةً إلى المشيمة، فأحد أطراف الحبل السُرِّيِّ مربوط بالجنين بينما الطرف الآخر مربوط بالمشيمة التي نراها تَنزل من الرحم مع كل مولود من بني الإنسان وسائرِ الثدييات؛ حيث لا يبقى لها دور في الرحم، وليس لها شكل سوى أنها تُشْبِه الكيس، والحبل السُّرّيّ له تركيبة تشبه اللولب، وهو مرن لا ينكسر مهما تثنّى، وهو يحتوى على شريانين ووريد واحد، فالشريانان يُوصِلان مخلفاتِ الأَيْض من الجنين إلى المشيمة، ويقوم الوريد بجلب المواد المفيدة مثل البروتينات والفيتامينات من جسم الأم إلى الرحم لتغذية الجنين.. فالله الذي يحقق بأشياءَ صغيرةٍ أعمالًا كبيرة يحقق بهذا الحبل البسيط وظائف تذهل العقول.
وقد هُيِّئَ رحمُ الأمّ بشكل آمن ومريح بحيث يلبي كل ما يحتاجه الجنين، وبعد أن يتغذى الجنين هناك لمدة تسعة أشهر يُخرجه الرحم إلى الخارج، وهكذا يولَد الطفلُ، ومن بعد ذلك ينظِّف الرحمُ نفسَه مرة أخرى فيَطرح ما تَراكم فيه خلال تسعة أشهر من بقايا الأنسجة، ويستمر هذا الوضع قرابة أربعين يومًا، وهذا ما نسميه: حالة “النفاس”.
وليس من الممكن إحالة كل هذه الأحداث المذهلة إلى المصادفة أو الأسباب، لأنها إن لم تُسنَد إلى الله بل إلى المصادفة أو الأسباب فستختلط الأمور وتشتبك.. والحال أن هناك وحدةً وانسجامًا في كل هذه الأحداث المختلفة، وذلك يدل بكل وضوح على أن هذه الأمور تُدَبَّر من قِبل الله الواحد الذي ليس له شريك أو نظير.
ولنحاولْ أن نقدم من القرآن الكريم ما يشير إلى الموضوع بشكل ملخص وقابلٍ للتفسير يتوافق مع ما سردناه من تفاصيل الموضوع:
فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ [بويضة ملقَّحة] ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ (سورة الْحَجِّ: 22/5)، يبين المراحل الجنينية التي يمرّ بها الطفل، وفي آية أخرى يذكر الموضوع بشكل أكثر وضوحًا قائلًا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ [الرحم] ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا [الهيكل العظمي] فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (سورة الْمُؤْمِنُونَ: 23/12-14).
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ وكلمة “سلالة” مأخوذة من “السَّلّ”: وهو انتزاع الشيء وإخراجُه في رفق، وسُلالةُ الشيء: ما اسْتُلَّ منه من خلاصته، وهذا يعني أن الإنسان قد خلق من سلالة خاصة مستلة من طين كهذا، وهذا يشير إلى المرحلة الأولى التي خُلق فيها الإنسان الأول سيدنا آدم، وهي المرحلة التي خلق فيها جسم النوع الإنساني وأعضاؤه.
﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ أي جعلنا هذه السلالة (الخلاصة) نطفة في الرحم الذي هو مَقَرٌّ مكين؛ حيث إن الرحم مكان دافئٌ وأمينٌ يتوفر فيه كل ما يحتاجه الجنين من الغذاء والطمأنينة والراحة.
﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ وهذه الآية تفيد أن النطفة التي كانت خلية واحدة تتحول بعد مدة إلى مجموعة من الخلايا تحاكي في صورتها الدم المُتَجَلِّط، وأنها تتعلق بجدار الرحم فتتغذى منه، فلفظ “العلقة” يشير إلى هذه الأمور.
﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ وبعد مدة قصيرة تتحول هذه العلقة التي هي في صورة دم متجلط، إلى شكل قطعة لحم ممضوغ.
أجل، إنك إذا نظرت إلى المضغة بالعين المجردة من دون استخدام المجهر فستبدو لك كأنها قطعة لحم ممضوغ لا شكل له.
﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾ فالخلايا الأولى لهذا المخلوق الحي الصغير الذي هو المضغة، تتحول، بعد مدة، إلى عظام وغضاريف.
والحقيقة أن كل هذه الأمور لا يمكن رؤيتها إلا من خلال وسائل التصوير الحديثة، ومن غير الممكن للعين المجردة أن تُميِّز في هذه المرحلة بين خلايا العظام وخلايا العضلات، فأوَّلًا تُخلق العظام على هيئة غَضاريف شفافة، ثم تُخلق بعدها خلايا العضلات.
فقوله تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾ يشير بتعبيره المعجز الوجيز إلى أمور في غاية الأهمية؛ حيث يفيد أن العظام تُخلق أولًا ثم تُكسى بالخلايا العضلية وكأنها لباس، وهذا من الأمور التي ينبغي التوقف عندها.
فهذه الحقيقة إنما هي من الأمور التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا في هذا العصر الذي تَطوَّرت فيه العلوم والتكنولوجيا فأتيح مراقبة المراحل التي يمر بها الجنين من حالة البويضة الملقحة إلى مرحلة الولادة، وتفيد المعطيات الطبيّة لعِلم الأجنة أنه ليس هناك فرق إلى الأسبوع السابع بين الجنين البشري وجنينِ أيِّ مخلوق آخر من ناحية النموّ.. ولعل هذا التشابه هو الذي خدع داروين والداروينيين الجدد فأداهم إلى القول بما يلي:
“إن الإنسان في المراحل التي يمر بها في الرحم يشبه أسلافه الأقدمين؛ لأن جنينه ينمو في الرحم إلى مرحلة معينة متطابقًا تمامًا مع سائر الحيوانات، وهذا يدل على أن منشأ الإنسان وأصله مرتبط بسائر الحيوانات؛ حيث إن الوحدة في المنشإ مُلاحَظة في بداية النمو في المرحلة الجنينية، ويُستنتج من هذا أن منشأ الإنسان ليس بشريًّا بل حيوانيًّا”.
وهذا الاستنتاج منهم الذي وصلوا إليه انطلاقًا من أوجه التشابه بين الجنين البشري وبين سائر الأجنة، لهو خطأ فيه نوع من الابتلاء الإلهي؛ فإن هذا التشابه بين الأجنة لا يستمر إلا إلى نقطة معينة، وأما بعد هذه النقطة فإن الأجنة البشرية سرعان ما تفترق عن تلك الأجنة التي ليس لها استعداد لأن تصبح بشرًا، وذلك على حسب ما في برامج جِينُومِها من الفروق.
أجل، إن الإنسان ينمو ويتطور على حسب ما أُودع فيه من الكفاءات والاستعدادات، بينما تَبقى الأجنة الأخرى محصورة في حدود فطرتها الضيقة، ولعل هذا ما تشير إليه الآية بقولها: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾، فتعبير “الخلق الآخَر” تدل على أن الجنين البشري على خلاف الأجنة الأخرى يُواصل طريقه بعد هذه النقطة
في مسار مختلف.
﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ إن هذه الآيات بما في تعبيراتها من الموسيقى والانسجام واللهجة تجعل الإنسان يقول: “ما أحسن هذا الخالق العظيم الذي خَلَق الإنسان من ماء مستهان ومستحقَر فسَوَّاه على أكمل وجه ثم بيَّن لنا قصة خلقه!!”.
أجل، إنه يَخلق وينشئ مِن أصغر شيء أكملَ الأشياء، ويُحسِن كل شيء خَلَقه، ويَعرِض لنظر الإنسان القضايا المتعلقةَ بعالَم الخلق حتى يرشدهم، وإذ يذكر هذه الأمور يفتح النوافذ على حقائقَ لم تَخطر على بال الإنسان.
لقد طُرح العديدُ من الأفكار في القرن العشرين حول إعجاز القرآن الكريم، ولا يزال هذا الأمر مستمرًّا، ومن المحتمل أن يكشف لنا المستقبلُ أسرارًا عديدة لم يَصل إليها إنسانُ هذا العصر مما نستطيع أن نسميها: “الحقائق المتعلقة بالآفاق القرآنية”، وحينذاك سيتم تقويم البحوث العلمية بالآيات القرآنية، فتَنتبهُ ضمائرُنا ووجداننا لـ”عصر قرآني جديد”.. إن الآيات القرآنية بمثابة إحدى العينين، والآيات التكوينية في الكون هي بمثابة العين الأخرى.
فإذا نظر الإنسان بهاتين العينين إلى الأشياء والأحداث فسيَرى كلَّ شيء -بما فيها نفسه- على وجه كامل، وسيَعرف نفسه، وفي ضوء ذلك سيصل إلى المعرفة الإلهية، ومن أفضل ما يعبِّر عن هذه الحقيقة ما قاله أحد الأولياء -ويُروى أن سقراط كتبه على باب مدرسته-: “من عرف نفسه فقد عرف ربه”.
8- خلقُ الإنسان
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ (سورة الْحِجْرِ: 15/26)، هذا الكائن الذي تَعرَّض لتحوّلات وتغيرات إلى أن تَشكَّل في صورة إنسان، وتَوازَن بالعناصر الداخلية والخارجية، وأخيرًا تَشرَّف بالنفخة الإلهية، لهو كائن متموقع في نقطةٍ تتلاقى فيها المادة والمعنى، فالله تعالى يبين كيف فَطره، وأوجد ما بداخله من الانسجام العمومي، ووَضَعَ التوازن بينه وبين محيطه، والعلاقةَ بينه وبين سائر الكائنات، قائلًا: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا [أيها المخاطبون بهذا الخطاب في عالم الملكوت] لَهُ سَاجِدِينَ [سجدةَ امتحانٍ وانقياد]﴾ (سورة ص: 38/72).
فإلى ذلك الحين لم يكن معروفًا باسمه وميزاته، بل كان في عالم الملكوت مغمورًا، وفي عالم الملك لم يكن مذكورًا كما يقول تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ (سورة الإِنْسَانِ: 76/1)، فلم يكن لأسلاف هذا الكائن الجديد في عالم الملكوت أن يدركوا كنهه ولا أن يستمرئوا تفوُّقه عليهم إلا أن يأخذوا بعين الاعتبار أن لله فيه حكمة تَدِقُّ عن مَداركهم، فيطيعوه؛ فمنهم من أطاع ففاز، وهناك من عصى فخاب وخسر.
ويتحدث القرآن الكريم في آيات أخرى عن الإنسان بكل مراحله؛ بدءًا من مرحلة التخطيط القدري وانتهاءً بشتى مراحلِ خلقه، بأسلوب يكاد الناظر إليه ببصيرة يشاهد مراحله الجنينية التي قضاها في بطن أمه. أجل، إن القرآن يركِّز بحساسية بالغة على كل هذه المراحل التي مرّ بها الإنسان.
ففي هذه الوتيرة التي مر بها الإنسان هناك مراحل معينة ومختلفة عن سابقتها؛ فالمرحلة الأولى هي “التراب”، والثانية هي كونه من “طين”، إشارة إلى طين مخصوص، والثالثة هي مرحلة “الحمأ” وهو الوحل الأسود على شكل هيكل بشري، والرابعة هي مرحلة “الصلصال” وهو الطين المجفف المشويُّ مثل الخزف؛ فقد تكون كل من هذه التعبيرات إشارة إلى وتيرة معينة، كما يمكن أن تكون إشاراتٍ إلى مراحل النشأة، كما نرى أمثال هذه المراحل بالنسبة للجنين في الرحم، ولا يختلف الأمر من كون هذه المراحل أربعة أو ستة، فقد يمكن إلحاق بعضها بالبعض الآخر، وإنما المهم هنا بيان أن أساس نشأة الإنسان هو هذه العجينة الترابية المحتوية على شتى المعادن المتحولة
في شتى مراحلها إلى إنسان.
ولا شك في أن الماء عنصر مهم في تهيئةِ حساء من المعادن أو البروتينات، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ [أي وحل، أو خلاصة] مِنْ طِينٍ﴾ (سورة الْمُؤْمِنُونَ: 23/12)؛ حيث يؤكد أن أصل الإنسان هو الوحل، كما يشير إلى أهمية الماء في الخلق بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/30)، ويبدو أن تَزاوُج كلٍّ من الماء والتراب بما تحتويان عليه من العناصر هو مرحلة مستقلّة، وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة التشكُّل بصورة معينة، يشير إلى هذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ (سورة الْحِجْرِ: 15/26) [والمَسْنون المُصَوَّرُ، والمَصْبوب على صورةٍ ]، وتأتي بعد هذه المرحلة مرحلةُ التسوية ووضْعِ التوازن بين الداخل والخارج، يشير إليها القرآن الكريم بقوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (سورة الْحِجْرِ: 15/29)، فيذكِّر بأن الإنسان بَوْصَلَة أو محراب للقبلة
فبهذه المرحلة الأخيرة يكُون الأمر قد وصل إلى أن في الكون مخلوقًا يتمتع بالجانب المادّي بالإضافة إلى جانبه المعنوي، وله روحٌ امتزجت ببدنه، وله أعماق ماورائية تُوازي كمالَه المادي، فهذه هي المراحل التي أشارت إليها الآيات القرآنية بالتفصيل، وإن كنا لا ندرك ماهيتها الحقيقية، وقد مر بها الإنسان إلى أن وصل إلى وضعه الحالي؛ كان ترابًا فطينًا فمعادنَ مسلولة، فطينًا لازبًا فحمأً مسنونًا، وكان خليطًا مركّبًا من شتى المعادن أو البروتينات إلى أن حباه الله بالروح الإلهي، وجعله خليفة في الأرض، وأشرفَ المخلوقات.
إن قضية حياة الإنسان التي بدأت بآدم وحواء وخلقِهما بشكل معجز ستستمرّ تحت ستار الأسباب وكأنها من الأمور العادية، وستستمر وتتمادى هذه الحياة الإنسانية بطلب وإرادة من الإنسان وخلقٍ من الله تعالى، والغايةُ المتوخاة والهدفُ الأصلي هو أن يَعرف اللهَ ويعبده.. وعلى الإنسان أن يَعرف أن الله تعالى إنما منحه الإرادة والشعور والحسّ والفؤاد وقدَّمه على سائر الموجودات، وجعَلَه –بإراته ومشيئته- في شخص آدم محرابًا، ليعلمَ أنه موظف بمهمةِ معرفته تعالى وتعريفِ الناس به، ومحبتِه وتحبيبِ الناس إليه، ويؤدي حقّ الحصول على نعمةِ “أحسن تقويم”.
9- تشكُّل الحليب في الكائنات الحية (الثدييات)
إن من يَدرس القرآن الكريم ويتأمل فيه بدقة سيلاحظ أنه ليس فيه سورة أو آية تُناقِض الحقائقَ العلمية، بل سيرى أنه قد أَخبَر قبل عصور -ولو بشكل مجمل- عن الحقائق التي اكتشفها الإنسان بعد ذلك بزمن بعيد، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (سورة النَّحْلِ: 16/66).
فالآية تبدأ بقوله: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ فتُنبِّهُنا إلى أن لنا في عالم الحيونات إشاراتٍ ودلائل على وجود الله ووحدانيته، وهذه الأدلة من الوضوح والبداهة بحيث يمكن للجميع إدراكُها واستيعابها، فتَذكُر الأدلةَ بأسلوبٍ يفهمه العوام وأهل الاختصاص.
أجل، هناك العديد من أنواع الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب والأعلاف والتبن والماء وغيرها، فتُقدم للبشر نعمة اللحم واللبن والبيض وما شابهها من مصادر البروتين.
ثم أَردفت الآيةُ قائلةً: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ مذكِّرةً بأن اللبن يَخرج في المرحلة الأولى من الفرث، ثم في المرحلة الثانية ينفصل من الدم إلى أن يصبح خالصًا نقيًّا لا يؤذي الحلق بل يكون له مصدرًا مهمًّا للغذاء.
ولا بد هنا من التذكير بنقطة استطرادية وهي: من أجل أن يكون الحليب غذاءً فطريًّا مناسبًا للأطفال فلا بد أن يُرضعوا من الثدي مباشرة، وإلا فلو حُلب هذا اللبن إلى مكان آخر، ثم سُقي الطفل بعد تسخينه مثلًا فإن هذا يكون تدخّلًا في حالته الفطرية؛ فكون اللبن خالصًا هو أن يكون غير فاسد ولا متعرّض للميكروبات، فالآية الكريمة تُنيط كون اللبن “خالصًا” و”سائغًا” أي كونه سليمًا من مخاوف المرض وسهلَ المرور في الحلق بالحالة التي ينزل فيها اللبن من الضرع، فإن اللبن ذو تركيبة مناسبة لتكاثر الجراثيم بسرعة.
وأودّ هنا أن أنقل ما سمعتُه من خبير زراعي بالقدر الذي استوعبته؛ حيث يقول: كنا نحلب الحليب من الحيوانات فنحتفظ به ثم نسقيه العُجولَ عند الحاجة، ثم لاحظنا أن هناك فرقًا ملحوظًا بين العجول التي كانت تَرضع من الأثداء النظيفة مباشرة، وبين التي كنا نسقيها الحليب بعد حلبه في مكان آخر؛ حيث كانت الأولى أسرع نموًّا من هذه، ولدى البحثِ عن السبب من وراء ذلك تَوَصَّلْنا إلى الآتي:
لعل العُجول التي ترضع مباشرة كانت تستقبلُ الأمر بفطرية فتستسيغ الحليب فتتشوّق إلى الرضاع وتتحمّس له أكثر من التي تشربه من دون رضاع من الثدي مباشرة، وبالتالي فكانت الرضاعةُ مناسبةً لطبيعتها في التغذي، بينما في الجانب الآخر لا يمكن إعطاء الحليب درجة الحرارة الطبيعية كالذي في الأثداء، بالإضافة إلى أن الحليب
في خارج الثدي قد يتعرّض-ولو قليلًا- للجراثيم، وهذا يؤثر سلبًا من شتى النواحي
على أوصافه وقيمته الغذائية.
فقوله: ﴿لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ يُذكِّر بأن هذا اللبن رغم خروجه من بين الفرث والدم إنما هو نعمةٌ إلهية صافية نقية يستسيغه شاربه من دون الإحساس بأي انزعاج.
من المعلوم أن الكائنات الحية يتناولون الغذاء فيبتلعونه، وهذه الأغذية تنتقل إلى المعدة لتمرّ بعمليات مختلفة، ثم تنتقلُ من المعدة إلى الأمعاء، فهناك تقوم الزغابة المعوية بامتصاص المواد المغذية وتصفيتِها من الزوائد عن طريق شُعيراتها الدموية فترسلها إلى الدم، فهذه هي المرحلة الأولى التي ينفصل فيها اللبن -ذلك الشراب الطيب- عن الفرث، وفي المرحلة الثانية تدور هذه المواد داخلَ الدم بدورانه، إلى أن تأتي إلى الغدد الحليبية، فيتحول هذا الحساء المكون من البروتينات والكربوهيدرات والدهونِ إلى الحليب، ثم تنتقل إلى قنواتِ الحليب.
فالتعبير عن موضوع كهذا في وضوح وجلاء ومن دون أي لبس أو تشويش لهو خاصية من خاصيات القرآن ومعجزاته، فقد أخبر القرآن عن هذه الأمور في هذه وغيرها من الآيات قبل قرون وفي عصر لم يكن أحد من الناس يعلم ماذا يجري داخل الحيوان من هذه الأمور العجيبة، وكأنه يقول:
“إنني لن أكون كلام بشر على وجه الأرض بمن فيهم محمد ، وإنما أنا كلامُ من يربط كل الكون والمكان ببعضه البعض، ويحيط بعلمه كل شيء من الأزل إلى الأبد، فهناك أمور لا تدركها عقولكم ولا تصل إليها مَدارككم وقد كانت رايتي منصوبة عليها ومرفرفة فوقها منذ قرون، وستكتشفون في المستقبل بواسطة مناهجكم وإمكاناتكم التكنولوجية أمورًا بديعة للغاية، وستلتقط تلسكوباتُكم صورًا من السُّدم البعيدة منكم على مسافة بلايين الكيلومترات، فتَعرضُها أمام أنظاركم، وحين تصِلون إليها سترون رايتي هناك أيضًا خفاقة مرفرفة”.
أجل، إن هذه الآية القرآنية على غرار الآيات السابقة التي مرَّت بنا، تتصدى بلسان ما أخبر به القرآن من الحقائق العلمية، لكل ما أثاره الناقدون لبعض من بياناته، فتأخذ اعتراضاتهم وتضرب بها في وجوههم، وتُفحمهم اليوم كما أفحمتهم بالأمس.
ف. الآفاق التي أشار إليها القرآنُ الكريم من خلال المعجزات
1- العلاقة بين المعجزة والأسباب
إن الأنبياء كما أرشدوا المجتمعات إلى طرق الرقيّ المعنوي؛ وجَّهوهم كذلك إلى أسباب الترقي المادي أيضًا، فكلما سارت المجتمعات على الطرق التي أرشدوا إليها فسيكونون سالكين في الطرق المؤدية إلى السعادة الدنيوية والأخروية معًا إلى أن ينالوا الفوز الحقيقيّ.
فمعجزات الأنبياء تنطوي على رسائل مهمّة متعلّقة برقي المجتمعات وأمنهم وسعادتهم، كما أن هذه الرسائل التي قدّموها والمعجزاتِ التي جاؤوا بها ليست مقصورة على عصرهم فقط؛ فكل معجزة تدل على نبوّة ذلك النبي من جانب، وتشير من جانب آخر إلى حقيقة حياتية، وتفتح آفاقًا جديدة حول أمور ستظهر في المستقبل.
فمثلًا إن الريح في قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ (سورة سَبَإٍ: 34/12) ليس من نوع الريح المعهودة لنا، بل هي ريح مخصوصة سُخرت لسليمان، فكان يقطع في الجو بهذه المعجزة التي أعطاه الله مسافةَ شهر من دون أي وسيلة أخرى، ويذهبُ بها حينما شاء.
فالعروج إلى السماوات والتجوالُ فيها هو آخر نقطة سيترقى إليها الإنسان، فقد تخطت البشرية إلى اليوم مسألة الاحتكاك، وحَلَّت مشكلةَ الجاذبية الأرضية فنجحت في باب التحليق في الهواء، فقد فهم إسماعيل الجوهري (ت: 1010م) من هذه الآية القرآنية إمكانيةَ تحليق الإنسان في الهواء، ورَبَط محاولاتِ “هَزَارْفَنْ أحمد شلبي” (1609-1640م)، و”لاغاري حَسن” -من أبناء القرن السابع عشر- وأضرابَهم وتجاربَهم في مجال الطيران بمدى ما تثيره هذه الآية في الأرواح المؤمنة من روح العزيمة والحماس.
فهؤلاء قد نجحوا في الطيران من برجِ “غَلَطَة” إلى ساحل “أُسْكُدَارْ” (من ساحل مضيق البوسفور إلى الجانب الآخر) في تلك الأيام التي لم توضع فيها فكرة الطيران موضع التنفيذ، كما أن مِن هؤلاء مَن جرَّب الطيران بإطلاقِ صواريخَ إلى الهواء، بل إن منهم من ضحَّى بروحه في سبيل ذلك فاستُشهد، ولكن الذين جاؤوا من بعدهم أعرضوا -للأسف- عن القرآن وعن القوانين التي وضعها الله في الكون، فلم يستطيعوا السير في الطريق التي شقّها أسلافهم، ولم يطوروا هذه الفكرة إلى الأمام، حتى إنهم نظروا إليها على أنها من باب العبث فانتقدوها.
وهذه الآية تَهمس في آذاننا برسائل مستقبلية؛ حيث تشير إلى أن المؤمنين إذا راعوا القوانين الجارية في الكون، إلى جانب مراعاة الآيات القرآنية، فلن تبقى هناك ذروة إلا وسيصلون إليها؛ حيث إن المعجزات تشير إلى هذه الأهداف والذرى.
فكل معجزة من معجزات الأنبياء، حتى لو لم تكن جارية في إطار تَناسُب العِلِّيَّة (المناسبة بين السبب والنتيجة)، لكنها بُنيت على بعض الأسباب، فإذا نظرنا إلى تلك الأمور الخارقة الصادرة عن النبي كقضية نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، نلاحظ أنه قد وضع إصبعه ضمن الأسباب العادية، بمعنى أنه وضعها في مقدار من الماء أو صب عليها الماء، وفي حالة أخرى استخدم حفنة أو حفنتين من التمر لإشباع مجموعة متشكلة من ثلاثمائة صحابي من أصحابه، فطرح البركة فيها بمشيئةِ الله وفضله.
أجل، إن الله تعالى لا يعطل الأسباب طالما كان الإنسان في دائرة الأسباب، حتى إنه في المعجزات الصادرة عن أنبيائه ينيطها بأسباب جزئية، وبذلك يشير إلى أهمية مراعاة الأسباب، ومما يؤيد هذه الحقيقة أيضًا أن انفجار العيون من الحَجر بضرب تلك العصا الخارقة لسيدنا موسى كان يستند إلى رشفة قليلة من الماء في الحجر، كما أن العصا أيضًا استُعملت كوسيلة لذلك، وبما أن سيدنا موسى قد اتبع أحكام الكِتاب الذي أُوحي إليه واستَسلم لأمر ربه تمامًا كاستسلام الميت بين يدي المغسل، وتَرَكَ هوى نفسِه وغرائزَه وتغلب عليها، إذا به يَرى من حيث لا يحتسب أنه قد انفجرت اثنتا عشرة عينًا من خلال تماسِّ عصا جامدة في يده بشيء جامد آخر وهو الحجر، وفي ذلك يقول الله : ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/60).
فهذه المعجزة هي النقطةُ النهائية التي توصَّلت إليها البشريةُ في مسألة استخراجها الماء والموادَّ الحيوية الأخرى من الأرض التي تحتضن في باطنها الصخورَ الصلدة، فلن تتخطّى البشرية هذه النقطة قطعًا ولن تستطيع أن تحقق أمرًا حقّقه سيدنا موسى بما في يده من العصا، إلا أن سيدنا موسى بهذه المعجزة يكون قد أشار إلى آخرِ الآفاق التي تستطيع البشرية الوصولَ إليها في مسألة استخراج الماء؛ بحيث إن البشرية إذا راعت السننَ التي وضعها الله فإنها -ولو لم تستطع أن تُخرج الماء بضربةِ عصًا- تستطيع بما تَمتلكه من أدوات الحفر والتنقيب أن تستخرج الماء من أقسى الطبقات الأرضية الصلبة.
2- معجزات سيدنا سليمان
أ. استخدام الطيور
قال تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ (سورة النَّمْلِ: 27/16)، يتحدث الله تعالى عن المعجزة التي أعطاها لسيدنا سليمان ، وبهذه المناسبة يدلّنا على الآفاق التي بها نستطيع أن نَخرج إليها من دائرة عالمنا الضيق.
فأوّل ما نتعلمه من هذه الآية الكريمة هو حقيقةُ تعليم سليمانَ لغةَ الطير بشكل معجز، وفي العصر الذي نزل فيه القرآن لم يكن معلومًا لدى الناس أن للطير لغة خاصة بها وطرائق تتفاهم من خلالها فيما بينها، بل كان من السائد لدى الناس أنه ليس في المخلوقات ناطق، مما أدى بعلماء المنطق أن يقولوا في تعريف الإنسان: إنه حيوان ناطق، فرأوا أن النطق من الخصائص الرئيسة المميزة للإنسان عن غيره.
ولكن فريد الدين العطار الذي أدرك هذا الموضوع وألَّف كتاب “منطق الطير” قد تنبَّه لهذا قبل “لافونتن” بعصور، فذكر حديثَ الطيور فيما بينها، وفَتَح لنا بذلك عديدًا من النوافد المطلّة على موضوع لغة الحيوانات.
صحيح أن تعبير “منطق الطير” في الآية الكريمة يدل على أن للطيور لغة تخصها، وأنها تتواصل فيما بينها بهذه اللغة، ولكن هناك أمر أبعد من ذلك وهو أن الآية تشير
إلى أنه يمكن للبشر أن يتعلموا لغة الطير وأنه بإمكانهم أن يطَّلعوا من خلال بعض الأدوات على طريقةِ حياتها، وأن يحققوا عن طريقها كثيرًا من الأمور.
ب. الاستفادة من الكائنات الغيبية
يقول القرآن في معرض حديثه عن هذا الموضوع: ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/82) مشيرًا إلى أنه كان بين الشياطين من يخدم سيدنا سليمان ، ويُستنبَط من هذا أنه يمكن للبشر أن يتخابروا مع أمثال الجن والشياطين والروحانيين من الكائنات الغيبية، وأن يؤسّسوا معها علاقات ويتفاهموا معها، وهناك بحوث كثيرة تُجرى حول مدى إمكانية تأسيس روابط مع هذه الكائنات والاستفادةِ منها في شتى المجالات.
وأيضًا فالآية الكريمة تتحدث عن نبيّ آتاه الله النبوّة والمُلك معًا، فتُبين لنا وضْعَ مجتمع راق مكتمل في جوانبه المعنوية ومتفوّقٍ في الوقت نفسه على سائر المجتمعات المعاصرة له، فتَخُطُّ لنا الطرق المؤدية إلى مجتمع كهذا منبهةً إلى أن التقدّم في الوسائل التقنية وحدها لا يكفي -ولن يكفي- لتلبية حاجات الإنسان، وتذكِّرُ بأن هناك قضايا عديدة لا يمكن -ولن يمكن- حلُّها في الحدود المادية الضيقة، بل لا بد لحلها من الاستفادة من الكائنات غير المادية، ومن المحتمل أن يجري الحديث في المستقبل حول الاستفادة من الجن في الاتصالات الدولية، وقضيةُ استخدام سيدنا سليمان للجن في أمور عديدة من دون حاجة إلى بعض الآلات والأدوات تُمثل الحدَّ الأقصى الذي يستطيع البشرُ الوصولَ إليه.
ج. نقلُ الأشياء بنفسها أو بصورتِها
يقول الله تعالى في معرض الحديث عن نقل الأشياء: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ (سورة النَّمْلِ: 27/40)، تتحدث هذه الآية الكريمة عن قصة نقل عرش بلقيس ملكةِ سبأ، بذاته أو بصورته عبر تلك المسافة الشاسعة على يد سليمان نفسه أو على يد الخضر أو على يد وزيره آصِف بن بَرْخِيا، فإنْ كان على يد سليمان نفسِه فهو معجزة له وإن كان على يد الخضر -كما روي عن ابن مسعود- أو آصف -كما روي عن ابن عباس- فهو كرامة لهما ومعجزة لسليمان .
فبالإضافة إلى هذه الحقيقة التي تَحدَّث عنها القرآن، هناك طرفُ خيطٍ يُدْليه القرآن لنا بأنه يمكن أن يكون في المستقبل نقلٌ للأشياء إما بذاتها أو صورتها، وبذلك يحفِّز
في الناس التفكيرَ والبحثَ في سبل تحقيق ذلك.
فإذا قارَنَّا تلك الحادثةَ بما يُحققه التلفزيون مِن نقل صور الأشياء ببُعدين فقط، يكون التلفزيون دون ذلك بكثير، ولعله ستُطوَّر في المستقبل آلاتٌ تَنْقُل الصور ثلاثية الأبعاد، بل يمكن أن يُستنبَط من الآية إجراءُ البحوث حول قضية النقل هذه من دون استخدام الأدوات التقنية والتكنولوجية، وإن كان هذا الأمر يُعدّ من شبه المستحيلات حسب المستوى العلمي في عصرنا.
3- معجزات السيد المسيح
يمكن القول بأنه يوجد علاقة قوية بين أمة سيدنا محمد وبين أخلاق السيد المسيح .. كما أن هناك علاقة بين نبينا وبين السيد المسيح وهي علاقة الخَلَف بالسلف، فالرسول يقول في معرض الحديث عن هذه العلاقة القوية بينه وبين السيد المسيح: “أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، الأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ” ، وتَضِيقُ مَداركُنا عن إدراك حجم فوائد هذه العلاقة، وأيضًا فإن السيد المسيح قد طلب من الله أن يكون فردًا من أفراد أمة سيدنا محمد، وهذا أيضًا من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها.
وإن مسألة نزوله في آخر الزمان -ومن المحتمل أن هذا النزول سيكون بشخصيته المعنوية- كأنها إجابة لهذا الدعاء، وما نراه في زماننا في بعض أوساط النصارى الذين بدأت أفكارهم تتصفى من شوائبها وتُحاوِل الاقتراب من الهدي النبوي الصافي النقي، لهو من إشاراتِ انعكاس تلك العلاقة بين السيد المسيح والأمة المحمدية، ومن المحتمل بقوة أن الأمة المحمدية التي واصلت مسيرتها المادية والمعنوية إلى هذا العصر في ظل “المحمدية”، ستُواصل مسيرتها في آخر الزمان وبمشاركةٍ من ظل السيد المسيح وستَأخذ شكلًا جديدًا، وستُفسِّر الإنسانيةُ الأمورَ المتعلقة بالعلوم والتقنية بمسيحيةِ سيدنا عيسى، وستَربط الخوارقَ البشرية بالمعجزات النبوية، وتؤسِّس العلومَ على قواعدَ وأسسٍ متينة جديدة، حتى تُنهي بهذه العملية تلك الازدواجيةَ التي تعاني منها البشرية منذ عصور.
ثم إن النقاط المشتركة بينها وبين الأمة المحمدية سيتم تحديدها ويتحقق الاجتماع على أدنى ما يمكن التلاقي عليه من القواسم المشتركة، وستكافح هاتان الجماعتان وتشكِّلان قوة مضادة ضد فكر الإلحاد وإنكار الألوهية؛ هذا بما تمتلكه من العلوم والتقنيات، والآخرُ بما تتمتع به من الإيمان والعملِ الصالح.. وبهذا الاعتبار يمكن القول بأن معجزات السيد المسيح هي بمثابة آخر نقطة للحدود التي ستصل إليها العلوم في آخر الزمان.
وللسيد المسيح كثير من المعجزات، ولكننا نريد أن نركز على الآية التي تَنقل عنه مباشرةً ما يقوله حول معجزاته: ﴿وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/49).
فقد لفت السيدُ المسيح الأنظارَ إليه بهذه المعجزات، وسرعان ما التفّ الناس حوله، وأَصلح ما فَسد في محيطه من الفكر الديني، وأَسَّس مكانَه عقيدةَ التوحيد، وصار كأنه يمهد الطريق لسيدنا محمد، ومِن بعد ذلك جاء الإسلام فصار مصدرَ إحياء جديد للنصرانية التي تَعرَّض بعضُ جوانبها للتحريف والتبديل، ونأمُل أن يأتي يوم تتصفى فيه النصرانية من شوائبها حتى تُساندَ الإسلامَ وتُشارِكَه في محاربة الإلحاد والكفر المطلق.
ومن المحتمل أن النصارى سيتوسعون في العلوم والتكنولوجيا، كما أن الأمة المحمدية ستتطور وتتعمق من الناحية الروحية والقلبية والأنفسية، وستلتقيان في نقطة معينة وستُشكِّلان بينهما وحدةً واتفاقًا، ولعل البشرية ستجد يومًا ما فرصةَ تحقيقِ أمور قريبة مما كان السيد المسيح يُجريه بشكل معجز، وبذلك ستؤمن بالله وأنبياءِ الله.. وقد أشار الله من خلال نبي من أنبيائه إلى آخر نقطة يمكن أن تصل إليها الساحة الطبية.
وتَلفت الآيةُ النظرَ أيضًا إلى أنه من الممكن الحصولُ على شفاء الأمراض المستعصية؛ كأمراض الجلد والعَمى وغيرهما كالسرطان والأيدز اللذَين يُعتَبَران مِن أفتكِ أوبئة العصر، بل إن الأموات سيصلون إلى مستوى من الحياة أقرب مما هم عليه اليوم، وهذا يدفع بالإنسان إلى أن لا يقع في اليأس جراء أي من الأمراض، بل يحفزه على البحث عن دواء لهذه الأمراض، مصداقًا لقوله: “مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً” .
أجل، إن المعجزات التي وردت على أيدي الأنبياء لهي آخر نقطة تصل إليها البشرية في الترقي العلمي، والقرآنُ الكريم بذكره لهذه المعجزات يحفز البشرية على مواصلة البحث وبذلِ الجهد للوصول إلى هذه الآفاق، ولكن هناك نقطة وهي أن البشرية مهما تطورت في العلوم والتكنولوجيا ومهما أنتجت من الأدوية التي تعالَج بها الأمراض المذكورة في الآية، ومهما سلكت طرقًا جديدة للبحث عن إحياء الموتى، فإن كل محاولاتها لن تكون إلا معالجاتٍ عابرةً ولن تصل إلى نفس المستويات التي وصلت إليها المعجزات بتاتًا.
4- موقف الإنسان من السنن الكونية
لقد حاولنا أن نركز في الفصول السابقة على الآيات القرآنية التي تحتوي على إشارات إلى الحقائق والتطوّرات التكنولوجية، وما نريد أن نذكره الآن هو قضيةُ: أن الله تعالى كتب كتاب الكون بقدرته وإرادته، ثم شَرَح القرآنُ لنا بشكل وجيز هذا النظامَ السائد في الكون حتى تنكشف وتتوسّع آفاقنا الفكرية والعرفانية، ونتجوّلَ جميعًا في التلال الزمرّدية لمعرض هذا الكون، وتنفتحَ أبصارنا وبصائرنا تجاه ذاته الجليلة والعالمِ الأخروي.
إن لكل علم أُسسًا وثوابتَ تخصه، وإنما توضع القوانين العلمية بناءً على هذه الأسس والثوابت، فكما أنه ليس من الممكن قراءةُ كتاب لا تستقر حروفه وكلماته، فكذلك لو تغيرت النواميس الكونية التي كل منها بمثابة حروفٍ لكتاب الكون لما أمكن قراءة هذا الكون أيضًا، ولأصبح من المتعذر مطالعته وفهمه، ولكون هذه القوانين والنواميس ثابتة (ونسميها: سنة الله) فإن البشر يكتشفونها، -وينسبها الناس إلى مكتشفيها، مثل: “قانون نيوتن أو أرخميدس”- ويستفيدون من تلك الأسس والأصول التي وضعها الله، فالقرآن الكريم يرفع النقاب عن وجه هذه القوانين ويدلنا على ما يكمن وراءها من الحقائق الثابتة التي هي من تجلياتِ أسماء الله وصفاته.
ويحتاج كل شيء إلى قاعدة متينة يستند إليها حتى يستطيع الثبات والصمود، وفي الكون نظام وانتظام رائع، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما في روح الكون من بعض الحقائق إلا بواسطة هذا النظام والانتظام، ولا يمكن أن يكون هذا النظام والانتظام سائبًا ومعلّقًا، بل لا بد له من الاستناد إلى سند ثابت، وذلك هو التنظيم الإلهي.
وكلُّ تركيب في الكون إنما يكون مرتبطًا بترتيبٍ وتنظيم، وهذا الترتيبُ حقيقةٌ ثابتة، فحينما ننظر إلى تكوُّن الطفل نلاحظ أن كل مراحله تخضع لترتيبٍ رائع؛ بدءًا من كونه حيوانًا منويًّا ثم تلقيحِه للبويضة ثم سائر التطورات الأخرى التي يمر بها في الرحم.. فهذه حقيقة ثابتة، واستنادًا إلى هذه الحقيقة الثابتة يستطيع الإنسان بعد لقاح الحيوان المنوي أن يعرف المرحلة الزمنية التي يمر بها الجنين ويعدَّ شهوره، وعلى ضوء ذلك يأخذ الترتيباتِ اللازمة، ولكن لا بد لهذه الحقيقة أيضًا من الاستناد إلى سند ثابت،
ألا وهي أسماء الله: “الخالق والرزاق والمصور”.
والبذور أيضًا تبدو وكأنها جامدة لا حياة فيها، ولكنها بعد أن تُرمَى في أحضان التربة إذا بها تَظهَر أمامنا في البداية على شكل رُشَيم ثم تصبحُ برعمًا، وهذا البرعم يضرب بجذوره في الأرض من جانب، ومن جانب آخر تنتشر فروعُه وأغصانه وأوراقه في الأعالي، ولكن لا يتحقّق أيٌّ من هذه الأمور بالمصادفة، بل تستند إلى حقيقةِ:
﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/95)، ونستنتج من هذا كله أن كل شيء يقول بلسان حاله:
“لا إله إلا الله” شاهدًا بالوحدانية، منبِّهًا إلى الحقيقة العظمى.
فهذا الجانب من القرآن الكريم الذي يتحدث عن وجود الله عن طريق شرح القوانين السائدة في الكون بهذه البلاغة الواضحة، لهو دليل مهمٌّ على أنه كتاب وبيان من المتكلم الأزلي ، فمهما ترقَّى الإنسانُ في علم من العلوم، ووصل إلى أي نقطة فسيرى في نهاية المطاف في كل ذروة رايةَ القرآن مرفرفةً ودالةً للإنسانية على الطريق الصحيح، وقد لا يكون هذا الأمر واضحًا بالنسبة لأيامنا هذه، ولكنه في المستقبل القريب سينجلي بكلّ وضوح.
إن الكتب السماوية وجميع الأنبياء قد أضاؤوا الطريق في كل المجالات المادية والمعنوية، وأناروا للناس كل جوانب الحياة، فكما أن البشرية بفضل الرسل وجدت الطريق المؤدي إلى رضا الله وجنته، فهي بفضل إرشاداتهم أيضًا اكتشفت سبل السير وفقًا للسنن التي وضعها الله في الكون، فحَققت النجاحَ والسعادةَ الدنيوية أيضًا.
أجل، فكما أن البشرية استفادت في العلوم الكونية من ضوء الوحي السماوي، فهي أيضًا مَدينةٌ للوحي والأنبياء في تنوير القلوب وترقِّي الأرواحِ وإيقاظِ المشاعر والإحساس بالله وتشبع القلوب به تعالى، ومن أجلِ إعطاءِ بعض الأمثلة المشخِّصة للموضوع من القرآن الكريم ذلك الكتاب السماوي الذي لم يتعرّض ولن يتعرّض للتحريف والتبديل؛ حاولْنا في الفصول السابقة الوقوفَ على بعض الآيات التي تشير إلى العلوم الكونية مع ذكر بعضِ ما يشير منها إلى الحقائق العلمية والتطورات التكنولوجية، وكلما تطورت التقنيات والتكنولوجيا فستظهر بشكل أكثر ثمارُ ما يتعلق بتلك الساحة من الإشارات والبشاراتِ القرآنية، وسيزداد الجميعُ فهمًا وإدراكًا بأن القرآن كلامٌ إلهيٌّ.
والهدفُ من ذكر القرآن لهذه السنن الكونية هو جلب الأنظار إليها وتحفيزُ الناس للتفكّر فيها وإجراءِ البحث حولها، كما أنه يقدّم لهم المنهج الذي ينبغي عليهم اتِّباعُه خلال عملية البحث والتفكير، فمثلًا نلاحظ أن القرآن الكريم يتحدّث عن تمدّد الأرض، وتَحرُّكِ الذرات والسحب والجبال وغيرها من الأمور، حتى يسوق الناس إلى التفكير المنهجي، فإذا راعى الإنسانُ هذا الجانب فإنه سيتخلص من الأفكار المشتتة وفُتات الأفكار العقيمة، ويجدُ إمكانيةَ الفكر المنظَّم والممنهج.
ولنزيد الأمر وضوحًا نقول: إذا كان هناك شخصان يتحدثان عن نزول المطر؛ أحد هذين الشخصين عاميٌّ، والآخر عالِمٌ عارفٌ بقوانين الله السارية في الكون، فإن الأول سيعبِّر عن الموضوع قائلًا: “ظهرت الغيومُ في وجه السماء، وسينزل المطر”.. في حين أن هذا العالِم سيشرح الموضوع نفسه: فيتحدث عن هبوب الرياح وجمعِه بين أجزاء السحاب ذاتِ الشحنات الكهربائية المتضادة، ويستخدم ما يمتلكه من المناهج والآلات التكنولوجية، فيقوم بتنبؤات قريبة من القطعية عن وقت نزول المطر، فيذكُر لنا سَيرَ الأمور من مرحلة إزجاء السحاب إلى مرحلة الإمطار.
فالفرق بين هذين الشخصين هو أن أحدهما ينظر إلى الحدث بعينٍ مجردة ويُعبِّر عن مقصوده من منطلق فكري بسيط، بينما الآخر يربط بين الأسباب والنتائج، ويعبر عن مقصوده من منطلق فكري منهجي، ومِن هنا نستنتج أنه لا يمكن إدراك الأشياء وفهمها مع خلفياتها إلا بنظرة علمية.
فالقرآن الكريم يؤكد أن الكون مرتبط بنظام، وبذلك يَفتح أمام الناس نوافذ التفكير المنهجي، ويخلّصهم من فتاتات التفكير المشتت ويَسوقهم إلى التفكر المنظم ومطالعةِ الكون من منظور الأسباب والنتائج، وبفضل هذه الطريقة سيَحصُلون على إمكانية إيجاد الحلول لقضاياهم الكبرى ومشاكلِهم العَوِيصَة.
إن الإنسان الذي يدرك أهمية طريقة التفكير المنهجي، يكون في الوقت ذاته مدركًا للمستوى الأخلاقي العالي وحائزًا للتربية وسالكًا للطريق المؤدي إلى الكمال الإنساني، وهذا من الجوانب الأخرى للموضوع.
أما بالنسبة للجانب الآخر، فهو أن الإنسان لديه جانب من البيان، فهو بهذا الجانب يكون متكلّمًا ومخاطَبًا في وقت واحد فهو بمثابة محطة الهاتف العجيبة؛ يتلقى الرسائل من الآفاق الغيبية، ويرسل الطلبات إلى العوالم الغيبية؛ فأحيانًا تراه يكون مخاطَبًا لصفة الله: “الكلام”، وأحيانًا أخرى تراه يبثّ نجواه أمام المتكلم الأزلي بصفته متكلِّمًا حادثًا، وفي هذا المجال أيضًا هناك مصدر ومرشد مهم يمكن أن يكون هاديًا للإنسان في سبيل ترقيه الروحي والقلبي، ألا وهو القرآن.
إن القوانين السارية في الكون هي قوانين جبرية، وهي من هذا الجانب تبدو في ظاهرها وكأنها لا تَرحم، فإذا تَصادَم الإنسان مع أحدها ولو قيد أنملة فإنها ستجازيه وتصدِمه، فمثلًا إذا أصابت رصاصة دماغَ الإنسان، فإن الله يميته، تطبيقًا لقانونه الذي أودعه في كتاب الكون.
أجل، إن هذا من مقتضيات قوانين النظام الكوني الذي قدره الله وربطه بشكل جبري، وكذا إذا رمى إنسانٌ بنفسه من مكان عال إلى فراغ فإن هذا الشخص سيصطدم بالأرض ويموت (وفقًا لقانون الجاذبية الأرضية التي هي ستار للإجراءات الإلهية)؛ فالكون تَحكمُه جبريةٌ مشروطةٌ.
إن الله تعالى تجلّى في الكون باسم ذاته -حسب رأيٍ- وباسم الرحمن -حسب رأيٍ آخر-، فأظهرَ حاكميةً مطلقةً؛ بحيث إن الإنسان قد أصبح أمام هذه الحاكمية مجبرًا مغلوبًا على أمره إلى حد معين، ولكن الله تعالى بمقتضى رحمته منح الإنسان خارطةَ طريقٍ لا تضلّ، ألا وهي القرآن، وذلك حتى يصل الإنسانُ إلى هدفه من دون أن يتصادم مع نظام الكون الجبري الذي يظلّ في دوران دائم.
وحالُ الإنسان في مسيرته هذه يُشْبه حال الإنسان الذي يريد استخدام السلَّم المتحرك أو المرورَ عبر الأبواب الدوارة؛ حيث إنه مُجبَرٌ على أن يوافق حركاته مع حركتهما، فكذلك يجب على الإنسان في أنظمة الكون الجبريةِ أن يحافظ على نفسه من الاصطدام معها، في ظل إرشاد القرآن والالتزام بمبادئه، فهذه الأنظمة في دوران دائم طبقًا للمبادئ التي أُسِّست عليها، وليس للبشر أن يتدخّلوا فيها، وبالتالي لن يكتب التوفيق والنجاح لأي حركة بشرية إن تصادمت مع الحركة الكونية، فليس هناك نبي وجَّه رسالة إلى قومه تتصادم في مضمونها مع هذه الحركة الكونية.
ومن هنا ندرك أن من أهداف القرآن الكريم ومقاصد الأنبياء لفت الأنظار إلى الفطرة وتحقيق مواءمة الناس مع نواميس الفطرة وقوانينها، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعيش متوافقًا مع الفطرة حتى يستطيع الصمود أمام الأحداث، وليس لأحد أن يضمن هذا إلا القرآن وصاحبُ القرآن الذي هو رسول الله؛ حيث يقول في الحديث الشريف: “عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ” قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .
وقد يُظن في الوهلة الأولى أن الأمر بالضدّ وأن إعفاء الشوارب والأظفارِ والإبطِ والعانةِ من مقتضى الفطرة البشرية، ولكن الرسول بهذا الحديث الشريف يبين أن الأمر على النقيض من ذلك وأن قصّها وحلقها من الفطرة، ويُستنتج من هذا:
أنه قد يتعسر على الإنسان الاطّلاع دائمًا على أبعاد قوانين الفطرة، وليس له أن يتعلم هذه الأمور إلا من القرآن الكريم أو الرسولِ وفي ذلك يقول الله مخاطِبًا رسوله ومنوِّهًا بهذه القضية المهمة: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الرُّومِ: 30/30).
والواقع أن الإنسان إذا نظر إلى كل ما في الكون من الكائنات الحية فسيرى بجلاءٍ أنها تحكُمها هذه القوانين الإلهية الثابتة؛ فالشريعة الإسلامية تسمِّي هذه الأسسَ التي وضعَها الله، بـ”الفطرة” أو “السنة الإلهية”، فتؤكِّد بهذا أن اليد التي خَلقت الكونَ هي التي خَلقت الإنسان أيضًا. أجل، إن بين الكون والإنسان تناغُمًا يضاهي التناغم بين أبيات الشعر، والقضيةُ الأساسية هي أن يصغي الإنسان إلى القرآن فيتحركَ من خلاله
ولا يخالفَ قوانين “الشريعة الفطرية”.
ولا يحظى الإنسان بالسكينة والطمأنينة ولا يحصل على أذواق خالية من الآلام والأكدار إلا بقدر إصغائه إلى القرآن الكريم وتحرُّكِه وفقَ القوانين السائدة في الكون والنظامِ الكوني، وإلا فإنْ تَصادَم مع القرآن ولم يصغِ إليه فلن يتخلص من الجنايات والاضطرابات وأنواعِ الظلم والشكاوي وشتى ألوان المعضلات، حتى لو راعى القوانين الكونية وقَطَعَ أشواطًا في العلوم والتكنولوجيا. أجل، إن المجتمعات إذا لم تتغذّ بالقرآن فلن تستطيع الحيلولة دون ممارسات الظلم والجنايات وكثير من المعضلات فيها، مهما بلغت من المستوى العلمي والمعرفي.
ص. احتمال وجود كائنات جسمانية من غير الملائكة والروحانيين في العوالم الأخرى
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ (سورة الشُّورَى: 42/29)، من المعلوم أن الكائنات الجسمانية وغير الجسمانية ستُجمع وتحشر يوم القيامة، فهناك آيات كثيرة وأحاديث شريفة تؤيد الموضوع، ولكن هذه الآية تتحدث عن أنه توجد كائناتٌ معبَّر عنها بـ”دابة”، وأنه من الممكن اجتماعها في أي وقت إذا شاء الله، وهذا يضفي على الموضوع أهمية إضافية؛ حيث إن الملائكة والروحانيين لا تطلَق عليهم كلمة “دابة” وليس فيما بينهم ذكورة ولا أنوثة فلا تتكاثر بالمعنى المعروف لنا، وأما هذه الآية فيبدو أن فيها إشارة إلى كائنات جسمانية تتصف بالذكورة والأنوثة وبالتالي تتكاثر فيما بينها، وهذا أدى بأمثال الزمخشري والرازي وأبي السعود من المفسرين إلى النظر إلى الموضوع من زاوية أوسعَ، والقولِ باحتمال أن يكون في السماء كائنات حية تدِبُّ وتتجول كما يدب الإنسان والحيوان على الأرض.
ومن البدهي أن الكائنات الحية في الأرض وفي السماء ستتلاقى في “الحشر الأكبر” وأما اجتماعها في الدنيا فقد نيط في الآية بالمشيئة الإلهية الخاصة؛ فيمكن تحقيقه بشكل خارق للعادة إذا شاء الله تعالى، وإن لم يتحقق بشكل كلي فيمكن تحققه بشكل جزئي وفي حدود معينة، وبالتالي فهذه الآية تَفتح نافذة وتحفّز العقول للبحث في الموضوع وإجراءِ الفتوحات صوب السماء، وقد يبدو تحقيق هذا الأمر بالنسبة لنا غير ممكن علميًّا نظرًا لمحدودية قابلياتنا وتجهيزاتنا، ولكن هذا الإشكال غير وارد بالنسبة لمن يعيشون في الأجرام السماوية الأخرى ممن يمتلكون مثل هذه القابليات والتجهيزات.
ولأن الكون من السعة بحيث يكاد يمكن وصفه باللامتناهي، فيمكن عقلًا أن يكون في هذا الكون الكبير كوكب آخر على شكل الكرة الأرضية، وأما عدم العثور على أيّ أثر يتعلّق بالموضوع، فإما نقول: إنه نابع من سعة حجم الكون وكونه مترامي الأطراف وكونِ الدراسات التي أجريت إلى الآن غير كافية، أو نقول: إن قابلياتنا محدودة ولذلك ما زلنا بحاجة إلى الكثير من الوقت، أو نحيل الأمر إلى غيرنا ليقوم بدلًا عنا بسدِّ الفراغ الناتج عن تقصيرنا في الأمر، وعلى كل حال فليس لنا إلا التوقف والانتظار وإحالةُ كشفِ الحقيقة المشار إليها في الآية إلى عامل الزمن.
صحيح أنه لا يمكن لنا أن نقول شيئًا في حق نوع هذه الكائنات وخصوصياتها، إلا أنه يمكن أن نستنبط من عموم بعض إيماءات التعبيرات القرآنية أنه يمكن لنا أن نتبادل معها بعض الأمور.
وأيضًا فإنه من الممكن أن تكون في ضمن منظومةِ مجرةِ درب التبانة بعضُ الكواكب التي تناسب الحياة البشرية، وقد يأتي يوم تَصِلُ إليها البشرية بشكلٍ ما، فتُحيي هناك كلَّ الخصوصيات الأرضية، وقد يبدو كل هذا عسيرًا من منظور علم الفيزياء أو الفيزياء الفلكية ولكنه سهل يسير بالنسبة لمن ﴿هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة الْمُلْكِ: 67/1)، فإذا شاء فسيكون الذهاب سهلًا، والتكاثرُ سهلًا، والتجمع إذا حان الأوان سهلًا.
وقولُه تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (سورة العَنْكَبوتِ: 29/22)، بمثابة الصفعة على وجه التمرّد الإنساني، والإشارةِ إلى عجز المنكرين في الأرض وفي السماء.
وتعبير “ظلالهم” في قوله تعالى: ﴿وَلِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ﴾ (سورة الرَّعْدِ: 13/15)، يشير إلى أن هذه الكائنات لها “ظلال” ومعلوم أن الظل من خصائص ذوي الأجسام.
فبدلًا من الحسم في الموضوع وإغلاق الباب وسده تمامًا أمام التفكير يبدو أنه من المفيد إبقاء الباب مفتوحًا أمام الإمكان العقلي في مثل هذه المواضيع، بشرط
أن تكون التفسيراتُ غيرَ متعارضة مع محْكمات القرآن.. فالمهم في مثل هذه المواضيع الحفاظ على الإطار القرآني، وإلا فكما أنه ليس من الصحيح حصر الموضوع في جانب واحد بتطبيقه على المستوى العلمي المعاصر كما يفعله المفسرون الحَداثيون، فليس من الصحيح أيضًا التغاضي عن الاحتمالات المختلفة في المجالات التي ليس فيها محذور شرعي؛ لذلك نعتقد أن فتح الباب أمام الاحتمالات المختلفة سيكون نوعًا من العلاوة للباحثين تشوِّقهم وتحفِّزهم لإجراء البحوث، كما أن هذه الاحتمالات ستكون منطلقاتٍ لهم في باب البحث والتقدم العلمي، ونظن أن هذا لن يكون متناقضًا مع التفكير القرآني في الأساس.
ق. الصعود في السماء وصعوباتُه
﴿فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/125)، إن الإنسان منذ أن خُلق لم يزل لديه فضول نحو السماء، وبهذا الفضول بدأت فكرةُ علم الفلك ورَصْد الفضاء، وبعد أن ألقينا نظراتنا إلى تلك العوالم العلوية، كنا نرى أحيانًا نجومًا تتلألأ وكأنها تغمز بعينيها نحونا بغمزات دافئة ناعمة فتثير فينا مشاعر الرجاء والأمل، وأحيانًا أخرى كانت تثير الظواهرُ السماوية فينا الرعبَ بانفجاراتها وسقوطِ نجومها وأصواتِ رعدها.
وخلال نظراتنا هذه انعكست بعض الرسوم عبر عيوننا على خيالنا وانفتحْنا -بفضل ذلك- أحيانًا على تخيّلاتِ وتصورات العوالم التي تتخطّى حدود الزمان والمكان، فبحثْنا خارجَ عالم الشهادة عن أجوبة على أسئلتنا النابعة ممّا فينا من فكر الخلود واللانهائية، وهناك أناس اعتَبروا هذه الأمكنةَ السماوية وكأنها عوالم سرية سحرية بل إنها ربوع ضَربتْ عليها الآلهةُ خيامها، وتوجهوا نحو النجوم والقمر والشمس، واتخذوها آلهة، كما ربط آخرون طالعَهم بهذه الأجرام ورأوا كل ما في تلك العوالم أدواتٍ للفأل والتطيُّر.
وإذا كان المؤمنون اليوم لم يتعلقوا بتلك الأفكار المشوهة فإنما ذلك بفضل الأنبياء، ومن هنا بدأ سيدنا إبراهيم، فصحّح ما في الأذهان من تلك التشوّهات الفكرية، وكشف للناس ماهيةَ النجوم والقمر والشمس، ومدى ما تبلغ إليه، ثم توَّج ما حققه من الظفر في عالم الأفكار، فحطَّم الأصنام، وفي ذلك يقول القرآن الكريم بكل وضوح وجلاء:
﴿وَكَذَلِكَ [أي كما أريناه بشاعة الكفر] نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ [أي أسرارهما الملكوتية] وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ [الواصلين في الإيمان إلى مرتبة القطعية واليقين]﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/75).
ومن المحتمل أن من إحدى دوافع بناء فرعون صروحًا عالية ومحاولته رصدَ السماوات، هو ما في الإنسان من الفضول نحو مراقبة السماوات، كما أن لهذا الفضول تأثيرًا في التخطيط لبناء برج بابل، وينبغي أن لا يُغفَل وجود هذا الدافع وراء المشاريع المطوَّرة لغزو الفضاء، إلى جانب دوافعَ أخرى مثل العوامل الاقتصادية ومثل الهيمنة على الفضاء، واكتشافِ كواكب أخرى ملائمةٍ للحياة البشرية، ومراقبةِ العالم من خلال مختلف الأقمار الصناعية، وغيرِها من الأسباب. فهذه الأسباب كلها تُبيِّن لنا أن الفضاء سيظل في هذا العصر وفي العصور اللاحقة مطمحَ الأنظار لكل الأمم، بل إنه بمرور الأيام سيزداد الإقبال والتركيز عليه بحرص شديد، ولكن تُرى، هل ستسهِّل كلُّ هذه الجهود الصعودَ إلى السماء الدنيا وسائرِ المجرات البعيدة؟ يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/125).
ومع أن قضية ضيق صدر المرء كلما ارتفع في الجو جاء في عُرْض الكلام لبيان حال من ضاق صدره عن الإيمان وانغلق تجاه العقيدة، لكنها ذاتُ مغزًى كبير؛ لأن أحدهما يبين التضايق من جراء انعدام الهواء المعنوي كما أن الآخر يبين الاختناق بسبب انعدام الهواء المادي، فالآية وإن كانت تُجْمِل الموضوعَ بوصف الحالة ورسمها فقط، إلا أنها تشير إلى أكبر مشكلة سيلاقيها الإنسان الذي يرتفع في الجو بالإضافة إلى مشاكل أخرى سيلاقيها؛ مثل الجاذبية الأرضية والاحتكاك وظروف الغلاف الجوي.
وفي القرآن إشاراتٌ تُحفِّز الإنسان إلى الارتفاع في الجو مهما كان هذا الهدف بعيدًا وصعبًا، وذلك برعايته الأوامر التكوينية مع الالتجاء إلى الله، وفي سورة الرحمن ما يدل بتعبير قريب من التصريح على إمكان هذا الأمر إذا تحققت التجهيزات اللازمة؛
﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (سورة الرَّحْمَنِ: 55/33).
صحيح أن سياق الآية هو في ذكرِ أنه لا مفر من عذاب الله، إلا أن التعبيرات في الآية تتّسع لهذا المعنى أيضًا، حتى إنه من الممكن لعشاق العلم ومحبي البحث العلمي أن يستلهموا من هذه الآية دعوةً إلهية لهم إلى أن يتخطوا حدود الكرة الأرضية، ويعبُروا إلى ما وراء الأُسرة الشمسية، وينطلقوا من منظومة إلى أخرى، ويكتشفوا كل يوم عوالم جديدة.
وإذا كانت الآية تتحدث عن النفاذ من أقطار السماوات والأرض -بقطع النظر عن كونه ممكنًا أوْ لا- فهذا يدل بوضوح على أن الآية تؤيّد وجود هذا الشعور الموجود أساسًا في روح الإنسان، وأيضًا فهي تؤكد أن النفوذ إلى أعماق الأرض والسماء ممكن بـ”سلطان”، وأظن أن في هذا إشارة إلى أمر يختلف عما عهدته البشرية إلى الآن.
وهذه الأمور التي سردناها وإن كانت في حد ذاتها من قبيل الإشارة، أو القطرات التي نَبعَت من الأسلوب، أو بعض المضامين التي تناثرت من مستتبعات التراكيب، لكن من الواضح أن القرآن حَسَمَ الأمرَ في بعض القضايا.. ولكنَّ نهجنا هذا مختلف تمامًا
عن منظور بعض المفسرين “العِلْمِيّين” المُفْرطين في هذا الباب.
هدانا الله وإياكم إلى صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وصلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أجمعين.