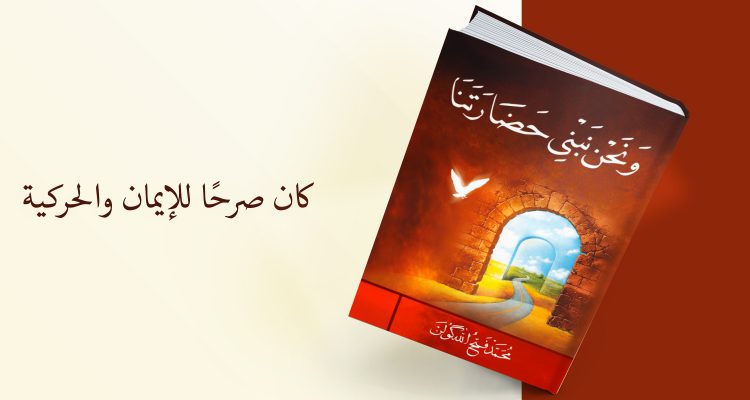ليس في البشرية مَن قَرَن بين الإيمان والحركية قرانًا لازمًا متوازنا، فريدا من نوعه إلا حضرة النبي محمد (عليه أكمل التحايا). فقد ارتبط وتعلق بالله بإيمان غامر، وآمن -بكل كيانه- بأنه رسول الله، وسلَّم له تسليما مطلقًا، وعَمِل -في كل وقت- بشعور عميق بالمسؤولية، ولم ينـزغه نزغ من التردد والتلكؤ في اعتقاده أو دعوته أو استقامة سبيله أو توفيق الله له. وتلقاه الناس بالقبول كصرحٍ للصدق والأمان. فمن سعد بمعرفته صدَّقه واطمأن إليه واعتمد عليه، واحتَسَب الإيمانَ به والاعتمادَ عليه واتِّباعَه حَظوة حباه الله بها.
وكانت الثقة العالية به، واللاهوتيةُ والرصانةُ في الأسس العمومية التي بشر بها، والاستقامةُ والجدُّ في حياته السَّـنِـيَّة، مدخراتٍ وكنوزًا فريدة فيه، جَعلت الآلافَ ومئاتِ الألوف يُهرعون إليه سراعًا من غير توان، لا يأبهون بعاداتهم وتقاليدهم وموروثاتهم الراسخة في دمهم ولحمهم. وكان هذا حدثًا نادرًا لا مثيل له في التاريخ، مؤيِّدًا أنه رسول الحق تعالى. فينبغي أن يَنظر علماءُ النفس والتربية مليًا في أسس هذا الانقلاب العالمي الشامل الذي حققه حضرةُ الذات النبوية، وأن يتفحصوا علومه ومكتسباتِه وأفكارَه تارة أخرى، وقد عجزوا في عصرنا هذا الوافرِ بأجهزة التربية ووسائله، عن نـزعِ بضعِ عادات عن بضعة أطفال!
ولقد نشأ في بيئة يتهالك الناس فيها على المناصب والمواقع، ويتحركون دائمًا بحس التوحش، ويتفاخرون بالنهب والسلب، ويلهثون وراء الشهرة، ويتخذون عيش المتعة والثراء غاية وحيدة للحياة… بيئةٍ مستعدة للاعتداء والظلم والتعصب والأنانية والحسد والفحشاء؛ بيئةٍ لا يُسمع فيها إلا نعرات الظالمين وعويل المظلومين وأنين الضعفاء ودوي القوة العمياء، كما عبر محمد عاكف (في أبيات ترجمتها):
كانت الأرض كلها في ذلك الزمان،
في بلايا أشد من بلايا حاضرِ الأيام
والبَشَرُ أوحش من الضباع طبعًا
فمَن لا ناب له، يفترسه إخوانه من الأنام
والفوضى في آفاق الدنيا،
والنـزاع سارٍ كالوباء،
و-كما اليوم في الشرق- ناخر في العظام
الظالمون زمر وزمر، والمتمتمون بغريزة الثأر أفواج وأفواج، وكان هناك ركام من البشر مصابون بِحُمَّى الهيمنة على الآخرين، وآخرون يظنون الانسحاقَ تحت حكم الظالمين طاعةً وانقيادًا… وكذا هناك متسلطون وحكام وقحون يمثلون القوة العمياء، وجموعٌ من الناس فاقدون للشعور يُستَغَلون كالعبيد، ومنهم منفلتون من ضوابط الأخلاق، ومهدِّدون للفضائل والقيم الإنسانية العالمية، وعابثون، ولاهون، ومغبونون غرباء أُجبِروا على أداء العبودية لله في قيود القواعد التي وضعها العِباد… وغيرهم كثير وكثير… هكذا كان المشهد العام على وجه الأرض. فمِن هذه الجموع البشرية المتخلخلة التي كل جانب منها ينطوي على ثغرة من تلك التي سردناها، استطاع هو أن يبني مجتمعًا ممتازًا ومثاليا وخارقا هو أكمل ما عرفه التاريخ كله.
فبالأسس التي أتى بها كان يسيرُ في طريقٍ فسيحةٍ في لاهوتيتها وقربها من الله تعالى، متطابقة مع النُّظم الكونية العامة تطابقًا تامًا ودقيقا، موصِلة سالكَها إلى الأهداف الدنيوية والأخروية… فتنفست البشرية في أجوائه العجيبة هواءَ الانسجام مع قوانين الطبيعة ممتزجةً بالدين والتقوى والمسائل الماورائية. فليس في رسالته أو في تمثيله للرسالة تصادُمٌ مع الأشياء والأحداث، وليس فيها إهمال الإنسان باعتباراته الجسمانية والروحانية بحال من الأحوال.
وكان ينشئ من أجزاء متفرقة من أبناءِ فلسفات وثقافات شتى مجتمعًا منظَّمًا كالبينان المرصوص، يباري الملائكة… ويرغم أنف الإفراط، ويلجم التفريط، في جموع بشرية غريبة عن بعضها، وسهلة الانجرار إلى كل الانحرافات، وكان يشير إلى العقبى حينما يتكلم عن الدنيا، وينبه إلى الروح حينما يومئ إلى البدن، ويقدر كل شيء بقدره.
وكانت تبليغاته تستوعب أمورًا كثيرة، من العقائد إلى العبادات، ثم إلى المعاملات، ثم -في إطار الأسس العامة طبعا- إلى الاقتصاد والإدارة والحقوق والعلاقات الدولية وقواعد الحرب والسلم وأسس التربية والتعليم وأصول تزكية النفس ونُظُم تصفية الروح. فكان يبين أسس هذه الأمور كلها بلسان يفهمه السواد الأعظم، ويبرهن عمليًا بنفسه على إمكان تطبيقها بيسر، فيكون نموذجا مثاليا لها.
ومِن بعده، تأسست عشرات الدول وحُكمت مئات الشعوب وفاقًا لهذه المبادئ، وبزغت شموسٌ وأقمار في سماء الإنسانية من ملايين الأرواح المنوَّرة والأدمغة المفكرة ورجال “الحركية” الفياضين والفقهاء الأعلام والعلماء المتبحرين، على الرغم من الخصومة اللدودة من الأطراف المعادية وحقدهم وبغضهم وغيظهم وتخريبهم وعدوانهم. فمِن ساعةِ تشريفِه بالنبوة، وَجَد نفسَه حيال جبهة واسعة وعنيدة من أقرب الأعداء إلى أبعد الخصوم، طافحةٍ بالحقد والكره والعداوة. لكنه لم يهتز ولم ييأس ولم يأبه لشيء، بل بقي -من جانبٍ- مُعلِّمًا وملقنا لرسالته ليقيم المجتمع العملي، و-من جانب آخر- استطاع أن يظل مقاومًا صامدًا في وجه أنواع الخصوم من الركام البشري الذين لا إيمان لهم ولا أمان معهم. وفي هذا الخضم، لم يخَفْ ولم يخشَ ولم يهلع ولم يجزع ولم يتردد طرفة عين، وكذلك لم يقع في الاختبار والتراجع وإعادة التجربة، والغلط والتصحيح، ومسايرةِ الباطل وانتظار الفرص.
ولم يقع في خشية ردود الأفعال حينما واجه العالم كله بتفسير جديد للوجود، ونادى بصوت حديد -وأرواحنا فداءٌ لهذا الصوت- معلنًا الحقَّ في وجه الأنظمة الدينية وغير الدينية، واتهم أمورًا كثيرة في الاقتصاد والسياسة والجيش والثقافة، وعالج مثل هذه الأمور أنى وجب ذلك. وإذ لم يهتز ولم يتردد قط، لم يدع عذرًا لمن خلفه للاهتزاز والتردد. فوقف صامدًا في التبليغ والرسالة، وصار مَعينَ أمان واطمئنان للجميع. ونفخ أنفاس اليقينَ دائمًا في وعده وبشارته ونذيره، وهمس بأسرار الانتظار والترقُّب النشط في أذن الذين تآكل صبرهم لاستبطائهم العاقبة التي يرونها بعيدة، فأنشأ أبطالَ صبرٍ يُعجزون الصبرَ! وكذلك أنشأ من أرواح مشلولة وإرادات ضاوية وجِبِلاّت عجولة أبطالَ عزيمةٍ تتحزم بعزم النبوة، بعدما دخلت في فضائه النبوي.
لم ينحن، ولم يُدارِ أبدًا في تبليغه للرسالة إبان عهد الإرشاد الرائق في مكة أو حيال التضييق والحرب والقتال الذي بادر به الطرف المعادي. ولما ضعضع وحده القيمَ الكذابة للإرث الغابر والنظام المتعفن القديم وجعلها قاعًا صفصفًا، لقي معارضة رهيبة، وتعرض لأنواع الخطر والتهديد. فلم يعُقْه ذلك كلُّه عن مواصلة المسير في الدرب.. ولما انسل مهاجرًا من مكة إلى المدينة من بين أعتى القتلة المتَطَبِّعِين بفكر الشقاء، أو حاصره الأعداء في غار “ثور”، وحينما قطعوا عليه الطريق الطويل مرات إبان رحلته، أو واجهوه بالحرب في “بدر”، أو حينما تصدى للذين عزموا على شرب الدم في “أحد”، أو تعرض إلى حصار التنكيل في “الخندق”، أو استَقبل وابل السهام بصدره في “حنين”… في كل هذه المواقف، كافَحَ بصدقٍ وبسالة وصار قدوة في الثبات والصمود لكل من قد يهتز، وبإرادته الصلدة رَفَعَ إلى العلياء إرادةَ الخائرين، وبدَّل رياح الهزائم الحاصلةِ بزَلَّات الآخرين إلى نسائمِ الظَّفَر، وأرَغَم أنف كل الاحتمالات القاتلة حينما حوَّل رثاء النحيب المشعِر بالهزيمة هنا أو هنالك، إلى أناشيدِ الفلاح وأكاليل النصر.
لقد كان شجاعًا لا يضاهَى، ولكن كان مدبِّرًا كيسًا بقدر شجاعته. فنراه في بعض المواقف لا يأبه بحياته، وفي مواقف أخرى يحيِّر العقولَ بما اتخذه من تدابير الحيطة والحذر. لم يكن يأبه بالموت، بل كان ينتظره في كل آن. والحقيقة أن نظرته إلى العمر -حسب فهمه للحياة- هو موضوع تبعيٌّ مدَّخَر لخدمة الدعوة. والحياة إنما تجدُر بالعيش “لإعلاء كلمة الله” ولخدمة الحق تعالى، وإلا فلا معنى للحياة على وجه الحقيقة. فهذه الحياة عنده جسرُ عبورٍ إلى العوالم الأبدية وينبغي أن تقوَّم باعتبارها سبيلاً وممرا إلى الأرباح.
ولقد عاش عمرَه كلًّه ملتزمًا بهذه النظرة. فقام وقعد بشعور “الإحياء”، واكتفى بفرح الآخرين وسعادتهم، وبذل للآخرين كل شي حصل عليه، فأسعدهم وقنع بالكفاف… فأكل وشرب ولبس يسيرًا. فحياته كلُّها تُشعِر المتأملَ بخط عجزه وفقره إلى الله واحتياجه إليه، ولم يتبدل حاله في عمره كله. كان عنده الإحياء أحلى من أن يَحيَى، والإطعامُ ألذَّ من أن يَطْعَم، والإسعادُ أولى من أن يَسعد. فكان ينفق كلَّ ما يجد على المحتاجين، ويَمدُّ يد العون لكل فقير ومسكين، ويقضي دين المَدين، ويتمادى في البذل فيذيب الصدأ عن أصدأ القلوب، فيبدل هذه الدهاليز المظلمة إلى “بيوت لله” تنشر الأنوار.
ولما رحل فريد الكون والزمان، هذا الذي جعل حياته السَّنِيَّة أعظم بركةً من حياة ملايينِ الناس، رحل إلى الآخرة ودرعه المباركة مرهونة عند رجل من أهل الدنيا على دراهم معدودة.
والحاصل أن من ينظر إليه بنظر الإنصاف، ويطّلع عليه بالبصيرة، يظن أنه كائن فوق البشر؛ بإيمانه ومعرفته وصبره وحلمه ووفائه وزهده وشجاعته وكرمه واستقامته وتواضعه ومهابته وحديثه وصحبته وحركاته وسكناته وبأحواله كلها، الفردية والعائلية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية والعسكرية والتربوية. وهذا بدهي، لأن رسول الله r:
1- هو الوارث التام لجميع الأنبياء والمرسلين السابقين. فقد أخذ الله الميثاق من الأنبياء على القبول بنبوته. وبدهي أن هذا الميثاق كان باسم أممهم.
2- وهو المرسَل برسالة عالمية وأبدية، ولم يُبعث إلى قوم معينين خاصة، أو لبلادٍ معينة حصرًا، كغيره من الأنبياء. والشواهدُ الصادقة تجدها في كتب الخصائص.
3- وهو الرحمة المجسَّمة المهداة إلى البشرية وهاديها الأخيرُ. والدليل على ذلك آيات القرآن الكريم، وسيرته السَنِيَّة برهان صريح على هذا.
4- وهذه الرحمة المجسمة صارت درعًا واقية لأمته. والذين اتبعوه أمِنوا به من الهلاك العام من بعده أمانًا لم يُعْطَ لأمم الأنبياء من غيره.
5- وهذا الإنسان الممتاز الرفيعُ الشأنِ أقسم الحقُّ تعالى به وحده من بين سائر الأنبياء، وأيده بحيازةِ امتيازِ “لَعَمْرُكَ”. فحياته انعكاس مراد الحق تعالى في مرآةٍ مجلاّةٍ، وبها أقسم تعالى.
6- وهو الذي امتاز بأن الحق تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم، وخصه في الخطاب بعنوانَي النبوة والرسالة. وفيه عبرة للمؤمنين ليتأدبوا معه.
7- وهو الذي أوتي “جوامع الكلم”، بمعنى البيان الجامع البليغ الوجيز، كما أشرنا فيما سبق.
8- وهو الذي نُصر بالرعب في قلوب الأعداء من مسيرة شهر، وهذا لطف وعناية خاصة به من الحق تعالى.
9- وهو وحده صاحب الحظوة باستحالة اقتراب السيئات منه، بالإضافة إلى أنه كان الوسيلةَ للانفتاح الدائم لباب التوبة من الذنوب.
10- وهو الذي أوتي الكتابَ المحفوظ بحفظ خاص والمصانَ عن التغيير والتحريف والتبديل إلى يوم القيامة، متميزًا بذلك عن الكتب الأخرى.
11- وكذا، هو المكرم بشرف رؤية عالَم الآخرة والاطلاعِ عليها بكل أعماقها وهو لا يزال في الدنيا. وقد كوفئ في لطفِ مقام المعراج بكرامةِ عمقِ عبوديته وبالمواهب هناك في ذهابه، وبثمرات رسالته كهدايا حمَلَها معه في إيابه.
ولقد حظي -مع هذه الخصائص التي هي قطرة من بحر- بدرجاتٍ ومقامات كثيرة كاثرة كمعجزة القرآن الكريم والمعجزات الكونية، أظن أن إحصاءها يستوعب مجلدات. والحقيقة أن أعماقه كلها تنبعث من رحاب وِجهته المَلَكوتية. وهو من هذه الوجهة، يتمتع بماهية يضيق عنها كل تعريف وتوصيف. فإن ماهيته أرفع عُلْوِيةً من الملائكة، وتَعَيُّنَهُ أول الموجودات وأقدمها. فكونُ وجوده أوّلَ الأنوار ونواةً أمرٌ بدهي. وبه تَحرَّك أولاً تسطيرُ القلم المقدس، وبه تَحقَّق البرنامجُ البشري. وهو البرهان الصريح الأبهى لسلسلة النبوة على الوجود الحق. وهو أول مرآة مُجَلاَّة لحضرة ذاته I. فهو أصفى وأشفُّ محلٍ لتظاهُر الصفات الإلهية، وهو أفصح ترجمان قاليٍّ وحاليٍّ للحق I، وهو رحمة الله تعالى المجسمةُ في الدارين، ورمزُ إتمامِ ألطافه ونِعمه علينا.
وبه عُرفت أسرار الألوهية كلُّها بكل الوضوح. وبه تنورت العوالم وانقشع الضباب والدخان الظاهري، فبانت حقائق الوجه الآخر للكائنات عيانا بيانا. و كلُّ الأمور التي عُلِّمها النبيُّ آدمُ u إجمالا، به أَدْرَكتْ التفصيلَ التامَ.
فهو الوسيلة العزيزة الوحيدة التي تُوصِلُنا إلى الحق تعالى من غير حَيْدٍ وزيغ. وعنده مفاتيح أسرار الخزائن الإلهية. وهو المستودع الأمين على سر مبدإ الوجود ومنتهاه.
هذا الذي لا يضاهيه أحد، بوصلةُ حقٍ جَعَل الحقُّ تعالى طاعتَه مِن طاعته. أضاءت الكائناتُ بالأنوار التي نشَرَها فصارت كتابا وقصرًا منيفا ومَعرضا، وتَنوَّرت تلك الظلمات الشاسعة وذلك العمى اللامتناهي.
فبفضله صارت الظلمات ضياء، والتقت السماء والأرض في أُفقِهِ الوضاءِ التقاءً نهائيًا.
هو الذي رسالته القرآن. وهو الذي أُفقُه العرفانُ. وهو الذي بيانه برهان. وهو وسيلة سعادة الدارين. هو الذي نال تلطيف الحق تعالى بألف وسامٍ معجزةٍ، وهو الذي سيظل اسمه وذكراه الطيبة على الألسنة إلى يوم القيامة مرتبطا بتزكية القرآن.
هو مدار شرف الإنسانية، ونقطةُ مركزِ حقائقِ النبوة. هو قائد عسكر جيش الأنبياء وهادي الإنس والجن، الصادقُ الذي لا يضل معه أحد. بيانُه “أمير اللواء لعسكر الأنبياء” كما عبر عنه الشاعر “فضولي”، وكتابه أعظم هدية من الحق تعالى… ولمِا أنه محلَّ التجلي “للروح الأعظم”، -وهو كذلك بدون شك- فتبليغه إكسير الحياة لأرواحنا… وبه استيقظت الإنسانية على القيم الإنسانية الحقة… وبه اصطبغت بالصبغة التي يرتضيها الله تعالى. ففي غيابه الحسرة الخالصة والهجران المحض، وفي الانفلات منه الضلالةُ الصريحة والخذلان المبين.
فهو النقطة المركزية للأسماء الإلهية والصفات السبحانية وهو النجم القطبي في سماء النبوة. الظهورُ الأول والحقيقةُ الإجمالية ترعرعتا مرتبطَين به، والعناية الإلهية المجسَّمةُ الأخيرةُ به عُبِّر عنها، ومفتاحُ الشفاعة الذي يَفتح كلَّ باب يوم القيامة سُلّم -ويسلَّم- إليه.
الرسالة التي حَمَّله الحق تعالى إياها متميزة جدا عما حُمّل به الأنبياء جميعًا، وتوجُّه ألطافِه تعالى إليه ذو لون تكريمي وإعزازي. فحين يكلمه ربه يكلمه بأسلوب خاص يُعزه به ويعلمنا نحن أدبَ الخطابِ معه. فهو المخاطَب العزيز بأفق التكريم والتلطيف بخطابِ: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾(القلم:1-4). فهو مداد القلم الذي كُتب به الوجود، وروحٌ ومعنًى بمثابة الغاية لكتابة سطور الكائنات ومعناها، وأفصحُ ترجمانٍ لمجاهيلِ ظهورِ الأسرارِ الإلهية، ومخزنُ معرفة الحقائق اللاهوتية. هو خير شخص للمنصب السامي في الآية: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾(آل عمران:31)، وأَسْطَعُ مَظهرٍ لمقامِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ﴾(الفَتْح:10)، وأرفعُ إنسانٍ في ذروة مرتبة الرضا، والممثلُ المشع بالأنوار لرضوان الحق تعالى، والنورُ الهادي للسائرين، بفحوَى ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾(الضحى:5). وهو بحقيقةِ مضمونِ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾(الأنبياء:107) المفتاحُ السِّرِّيُّ والبابُ للعوالم الرافلة بالإيمان والمعرفة في الدنيا، وبالجنة وجمالِ الله في الأخرى، والوسيلةُ النورانيةُ للحظوظ الماورائية، والمفسِّرُ للحقائق التي لا يُدرَك كنهُها، والمفتي الخاص لعالم الذات (سبحانه)، والمَشرِق المنوَّر لأفق الصفات، والمُرشد الهادي المؤتمَن لمن اتبعه، وبَوْصَلة الحقِّ لأهل التوحيد، وشعلةُ النور الإلهي المبدِّد لظلمات الضباب والدخان المحيطِ بعوالم الإدراك والإحساس، والخليلُ الوفيُّ الخالصُ للواهبين قلوبَهم للحق تعالى، والخصمُ الألد للشيطان والشيطنة، والسورُ الحامي لمن احتمى به في الدنيا والعقبى، والشفيع الموئلُ للمذنبين.
به خُففت التكاليف الثقيلة التي ما كان النهوض بأعبائها مستطاعًا، وبفضله رُفع عن الأمة الخطأ والنسيان. وفي مناخه وإقليمه بَدَّل العفوُ والعذاب لونَه، ووقع في كل صدر رجاء العفو والغفران.
هو المدعو الخاص الذي دعاه الحق تعالى إلى وليمة السماوات، وهو العارج العابر بـ”قاب قوسين” حيث ترنوا إليه الأبصار. وضيافةُ “سدرة المنتهى” هبةٌ مهداة إليه وحده، وما رآه في مضمونِ ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾(النجم:17) من غير دُوار في الرأس أو غبش في العين، رصانةٌ ووطادةٌ خاصةٌ تَلطَّفَ الله تعالى بها عليه. شاهَدَ ظهور الآية الكبرى بخصائص ذاتِها فما عَشِيَت عينه البتة… وإذ ذاك صار “المشار إليه بالبنان” في أهل السماء كافة… معه صار جبريل –لأول مرة – رفيقًا وخادمًا لبشر في سفر سماويٍّ لا يُدرك… وكان هو في سفره هذا يَمضي إلى ما وراء العوالم المادية عابرًا العوالمَ المادية بسرعة تتعدى سرعة ضوء البوارق.. فيَرى ما لا يُرى. فـ”سدرة المنتهى” أولُ منـزل، و”قاب قوسين أو أدنى” ذروةٌ يستسلم فيها العقل، و”لقاء الله” حظوةٌ تتعدى أُفق إدراكِنا وفهمِنا.
وسيد هذا كله -بتعبير الشيخ غالب-( )، (مترجَمًا من التركية)
“هو سلطان الرسل الشاهُ الممجد،
وهو للبائسين، العز السرمد،
في الديوان الإلهي العميد المعتمد،
الأحمد المحمود المحمد”.
إنه قد رأى… ورجع إلينا ليُرينا ما رأى. وإنه قد سمع، وعاد ليُسمِع أرواحنا ما سَمع. فهَمس في وجداننا بأسرار الأول والآخر، والظاهر والباطن. هو أهم رمز للأول، وهو مرآة الآخِر الباثَّةُ للأنوار. هو أعلى صوتٍ داعٍ للأحدية الذاتية والواحدية الصفاتية، وهو الإنسان الكامل الحقيقي المستودعُ الأمين على عِلم الذات والصفات والأسماء. هو منذ التعيُّن الأول مهاجرُ أفقِ الإنسان بعنوان “أحمد”، وضيف المدينة من مكة باسم “محمد”، وصاحب لواء الحمد من البرزخ باسم “محمود”، وقيِّمُ أستار الجنة وجمالِ الله، ومنهلُ فيضِ العوالم الروحانية والجوهرُ الأصل لعالم الجسمانية بأسمائه الشريفة كلها.
فيا لب الوجود ونواتها، ويا ثمرة شجرة الخلق والصوتَ الجهوري لحقيقة التوحيد، لولاك ما كان لنا ولا للكائنات معنى. ولقد قرأنا ذواتنا، ووقف كل منا حسب موقعه -إن استطاع- في الصف الصواب – بفضلك أنت
بقدومك وَضَح الوجودُ والحوادث وزال الغبش عنها… بتشريف مجيئك تبدلت ألوانُ الأشياء وصارت لسانًا فصيحًا تنطق باسمِ ما وراء الوجود.
ولم يسقط لك ظل على الأرض، ولكننا نجونا بفضل ظلك من السقوط والهلاك الأبدي. واليك أُوكِلَ منذ الأزل حَلُّ عقدة الكائنات المتشابكة، وإليك وُسِّد تقديمُها وتثمينها. والذين جاؤوا قبلك اكتفوا بتهجي مجمَلات هذه العقدة المتشابكة… وأنت الذي حللتَ العقدة وفصَّلت المجمل. وإليك سُلِّمَتْ مفاتيح الدارين بالتقدير الأول والتسليم الآخر… فأنت مُفَتِّح باب الدنيا ومرشد سبيل الآخرة. وصرتَ -برسالتك- الناطقَ باسم حقيقة التوحيد ومُخَلِّصَ الإنس والجان.
وقبل قدومك إلى الدنيا وتشريفك لها نادى مئات بل ألوف من أصحاب الوجوه النيرة بدعوى التوحيد، لكن أحدًا منهم لم يبلغ مبلغ داوُدِيَّتِكَ.( ) فقد كانت لمواهبهم حدود معينة ما كان لهم أن يتخطوها فيَصِلوا إلى آفاقك. وقد سعوا في سبيل نشر رسالاتهم وتبليغاتهم أعظم السعي، وتخطوا ما لا يُتخطى. فمنهم من قُطع أمامه السبل، ومنهم من قُطعت رقبته، ومنهم من ارتحل إلى عالم الآخرة وما زال في بداية الطريق أو منتصفه، ومنهم من لقى أعنف أنواع التمرد، ومنهم من رُجم بالأحجار حيثما حل. كلهم طفح بالعشق والشوق في كل آن، وذاقوا وهم على قيد الحياة مرارة الموت مرات عديدة. وأكثرهم وجدوا ما يبتغون فنجا بفضلهم الألوف المؤلفة من البشر… ولكنك وحدك من بينهم أسمعتَ صوتك القاراتِ المختلفة ووقفت منتصب القامة من غير تزعزع واهتزاز. ولم يتخلف من أصحابك الذين اتبعوك تائه في الطريق إلا عدد قليل من المنفلتين. كان ينبغي إنجاز عمل عظيم، فَكَدَّ مَن اتبعوك كَدًّا كلهم أجمعون، وسعوا بلا فتور، وركضوا، ولكن لم يتعبوا قط، ولم يتخلفوا –البتة- عن المسير.
فهم يليقون بك وأنت تليق بهم. وتحبهم ويحبونك. كأن يد القدرة أعدتهم لصحبتك -وهبنا الله شعور نشوة الصحبة هذه في قلوبنا- فكانوا جديرين بصحبتك ولائقين بها. وحين سرتَ إلى الوصال فرحًا كـ”ليلة العرس”( ) رنوت إليهم بجانب قلبك الناظر إليهم، فبكيت قبالة تلك الوجوه الناضرة.
لم يكن المعراج من نصيبِ أيِّ مباركٍ مِن قبلك… فطفتَ وشاهدت كل ما وراء المادة في أفق الرؤية. لكنك -حتى في رفراف تلك المحاسن التي تبهر العيون بضيائها- لم تفتأ تذكُر أصحابك وتذكُر من يأتون مِن بَعدُ. ولم يخمد في قلبك لهيبُ الرغبة والشوق في أن تُرِي ما تَرَى وتُسمِع ما تَسمَع وتُشْعِر بما تَشْعُر. ما أبدع وما أعظم ذهابك وإيابك وفَتْحَك فرجة في باب الماورائيات للأرواح المستعدة.!. فَرُحتَ كما أنت، ورجعت كما أنت، وفي هذه الرحلة السماوية الفريدة في تاريخ البشرية طرًا، ارتبطتْ ألطاف الأزل بأنفاسك… ولم ينِ مَن في السماوات والأرض مِن السلام عليك توقيرًا ومِن انتظار التباشير. كانت الأنوار فوارة في الأطراف كلها، والأضواءُ هاطلة في الأرجاء جميعها، طافحة على العصور كافة. ونحن احتفظنا برجائنا في أن تسقط قطراتٌ من حُزَم تلك الأنوار فوق صدر هذا العصر العفريت المارد، وسنبقى نرجو ونأمل. فأنت وفيّ، وما كنت لتَحرِم عشاقك في هذا العصر وأنت تهطل كرمًا وعناية وودًا على الأرجاء كلها… وفِعلاً لم تحرمهم البتة. فإنَّ مَن يسير منا إلى النور، فإنما يسير بضيائك.. وإن كنا نحيا -ولو في الجملة- فهو بانتسابنا إليك.
يا أيها النبي المبارك المحلق في الأعالي أبدًا..! أنت روحُ الروحِ لنا، ورسالتُك دواء لأدوائنا المزمنة، نرجوك أن تأتينا كرة أخرى، فلا تدعْنا بلا روح… نرجوك أن تتكلم مرة أخرى، فلا تَدَع عبيدك في مضض الهموم… في طريق مسيرتنا كثير من المتربصين بنا الداوئر، وعظائمُ من نيران الفتن تَغشي آفاقنا بدخانها… ونحن نكدح في السير مهما كان، نسعى مرة، ونكبو أخرى!.. فاجعل معيتك علامة لنا في طرق سيرنا، وأَشعِرْ قلوبنا بطمأنينة دلالتك وهدايتك إلى سواء السبيل. ولقد سار في هذه الطريق الألوف ومئات الألوف، وعَبَرُوا منابت الأشواك والعضاه، فَقَطَفوا ورودًا فضلاً وزيادة، أو تعبوا وأُنهكوا مرات ومرات، واهتزوا وارتعشوا أحيانا… لكنهم كوفئوا دوما مكافأةَ الساعين الجادين الكادّين. وأنت الموجود في بداية طريق المفاجآت هذه، وأنت في نهايتها، وأنت في قرار قلوبنا أبدًا، تعزُّزا ودَلالاً وإن غبت عن العيون. فإنْ كانت قلوبنا مازالت تنبض بالحياة فإنما هي من الإكسير الذي سقيتها أرواحنا. وإنْ كانت صدورنا مفتوحة لك، فهي بفضل جاذبية رسالتك واستيلائها على الألباب. وإذا لم تنادنا من فوق قمم القلوب، فلم نسمع نحن -بدورنا – مِن آفاق أرواحنا أنفاسَك المُحْيِيَة، فسنصفرُّ كالأوراق التي يلتهمها الخريف، ونصير سببًا لهبوب أنسام الحزن في أفقك. وكم كنا نتمنى ألا نتطاير أشتاتا مع الخريف، وألا نكون وسيلةَ حزن يطرأ عليك… لكن هيهات هيهات!.
ولقد جئتَ لتنفخ الروح في القلوب الميتة، ففعلت وأديت ووفيت بما اعتمدتَ عليه من منبع المدد والعناية… فانظر الآن إلى “الجنائز الحية” التي تجوب حيث رَفْرَفَت الحياةُ زمانًا كبساتين إرَم! وإلى الغربان تنعق عنادًا للبلابل! وإلى ضجيجِ مهرجانات الوطاويط في الأرجاء!… فتعالَ رحمةً بحالنا، ولا تقهر الطالبين للحياة بغيابك! ففي كثير من النواحي التي كان اسمُك يحلِّق في سمائها، إذا بالشياطين ترفع فيها ألويتها… والدنيا وقعت في أحابيلِ فقر الروح والمعنى. إن إِطلالك مرة واحدة على الأرواح سيُبدِّد ألاعيبَ الشياطين، وسيبث الحياة في المكبوتة أصواتُهم وأنفاسهم منذ عصور. وكم زُمرٍ حائرة تحبو في الشعاب الصعاب تظن أنها سواء الطريق، وكم زُمرٍ من غير طريقٍ البتة!. وعواصفُ النفاق تهُبُّ في كل جهة وصوب، والشتاءُ الزمهرير ينفث التوحش بلا كلل. وأبناءُ “فاوست” أغرارٌ أكثر غررا من ذي قبل، و”مفيستو” أحذقُ المتمرسين! وإنا مغلوبون دائمًا، وندفع الثمن على الدوام، فكأننا محكومون بدفع الإتاوة… فمنذ أن فتحتُ عيني رأيتُنَا نُهان ونُذَل كالأيتام في مائدة اللئام، ورأيتُنا نَعْلَق في شِباك الأفكار الخؤونة. وكيف نُيَتَّم في مائدة اللئام وأنت موجود؟ وما معنى فقدان الصاحب الحامي والحُكمُ لك؟ كلا.. لسنا أيتامًا، ولسنا من غير صاحب وحامٍ… بل نحن كأمثال أولاد الشوارع الذين انتزعوا أنفسهم من مآويهم الدافئة وألقوها إلى الدروب… ولن ننجو من تعاطي المخدرات هناك وهنالك، ومِن ظلمِنا لأنفسنا، إلا أن نعود إليك ونستنشق روائحك الوردية… قُطَّاعُ الطرق يصولون في كل ناحية، وهريرُ السُّرَّاق والمشؤومين يُسْمَع في كل جهة. أباحوا كل شيء، فنهبوها، وكانت قلوبنا مما نهبوا!. “عقلُ المعاد” مَهيض الجناح في هذا الزمان. الوجدانُ مضطرب في الخفقان وأرواحنا في شِباك الهذيان… فافتح فاك وأرسل إلينا من أنفاسك نفحةً طرية توقظنا فنعود بها إلى ذواتنا… قانون الفناء لن يحُول دون قوة تأثير روحك، ولن يَقْدِر أحدٌ على محو اسمك من القلوب. أنت هبة الأزل إلينا هديةً لا تقدر بثمن، وأنت راعي بستان الآباد. وبكلماتٍ منك يُبَدِّل الشوكُ طبعَه فيغدو وردًا… وإذ تَنطق تكون بيادرُ الأكاذيب كلها رمادًا.
لجأنا إلى أعتاب بابك… نرجوك أن تكلمنا -متجاوزًا بُعدنا عنك- كما كنت تكلم أحباءك. فإذا فَرّجت بين شفتيك مرة بطل سِحرُ سَحَرةِ الكلام، فسنحل عُقَدُ أَلْسِنةِ المحكوم عليهم بالخرس -حتى إن لم يستحقوا ذلك-، وستنطلق الأصوات تنضد خطبا عصماء باسمك. وكم عصورٍ ميتةٍ انبعثت بأنفاسك -فدت نفوسُنا تلك الأنفاس- وكم مرةٍ تَراجَع إسرافيلُ خطواتٍ إلى الوراء ووقف توقيرًا لسماع أنفاسك الداوُدية بصوتِ صُورِك أنت. وكم كرّةٍ أنبتت القفارُ القاحلةُ جِنانا وحدائقَ بأنفاسك. ولستُ أدري هل تَعُدُّ “الرجاءَ كرّة أخرى” وقاحةً؟ وإنها إن تكُ وقاحة فهي هينة بالنسبة إلى حرمان قلوبنا منك. نحن بذورٌ سائبة تنتظر لواقح، وأنت كالرياح المرسلة اللواقح… نحن أجسادٌ ميتة تنتظر الإِحياء، وأنفاسك إكسير الحياة لنا… فهُبَّ فوق رؤوسنا، وأَرِنَا سبيل الانبعاث، وانصبب علينا غيثًا زخاتٍ وزخاتٍ، ودَوِّ فينا ببشرى ربيع جديد. نحن نترقب مفاجآتِ تلطيفٍ وإكرام، ورؤوسُنا نضعها حيثما ستدوس قدماك، وعيوننا ترقُبُ حيثما سيسطع ظهورك المرتقب.
هذا العالَم عالمك… فهل يعني أيُّ قول وصوتٍ لغيرك شيئا في عالمك أنت؟ فمذ وقع ظلك على سطح الأرض لم يبق للنبي سليمان إلا الاسم. السِّكة عندك، والختم بيدك، فما قوة العسكر المقابل ولو كان قائده الإسكندر؟ وإذ تنعكس أصداء صوتك الدَّاوُدِي أناشيدَ في كل العالم فهل من حاجة إلى داوُد u؟ ومادام القول قولك أفلا يُعَدُّ كلامُ متحدثٍ غيرِك وقاحة؟ ونحن الساقطون أرضا لن يُقيمنا على أقدامنا غيرُك… وظهرُ الإنسانية المقصومُ المحدَوْدِب لن يُقوِّمه شيء إلا همتُك.
وإن ظلك على رؤوسنا -ولو من بعيدٍ- صار نفخةَ “انبعاث من الموت”. وإن ولادتك الحقيقية ستطفئ الشموع الشيطانية كلها، وتحفِّز الأرواح المدفوعة إلى الظلمات نحوَ منبعِ نورٍ لا يخبو… قد ربط الله النور الذي يضيء العوالم بك. وزِرُّ نبع النور الذي يضيء الدُّنَى تحت لمسة يدك. ولئن سألت فالله مريد مجيب… ولئن قلت فإنَّا سماعون مطيعون… فاسأل حتى تتجلى المشيئة الإلهية، وقل حتى تَسمَعَ الآذان قولاً سديدًا.
أنت عند الحق تعالى وعند الخلق خير من العوالم كلها. نحن مستعدون لإرضاء دلالك وتعززك، وأنت إكسير حياتنا.( ) يد المسيح كانت تحيي أجساد الموتى بإذن الله، وأنت صرت إسرافيل تنفخ الروح في القلوب الميتة منذ مئاتٍ وألوفٍ من الأعوام. فتعالَ الآن وأذِعْ صيتك كرة أخرى في العالم أجمع حتى تنطفئ نيران النفاق والشقاق والفتنة، وتَتَسربَل كلُّ الأرجاء بلون قريتك.
وإن ما قلتُ هو صدى بؤسي، لكن رجائي هو الرجاء العام. عَرَفناك رحمةَ الرحمن للعالمين أبدًا، وعَرَفنا أنفسَنا سائلين متسولين في الباب:
“أكرِم يا سلطاني ولا تقطع الكرم عن كل بائس متذلل،
وهل يليق بنبع الكرم قطعُ الكرم عن متسول؟”( )
(رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أمرنا رَشَدًا، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا. وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَصَلِّ وَسَلِّمْ أَيْضًا عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، آمِينَ يَا مُعِينُ)( )
المصدر: مجلة “يَنِي أميد” التركية، أبريل 2000؛ الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغْلو.